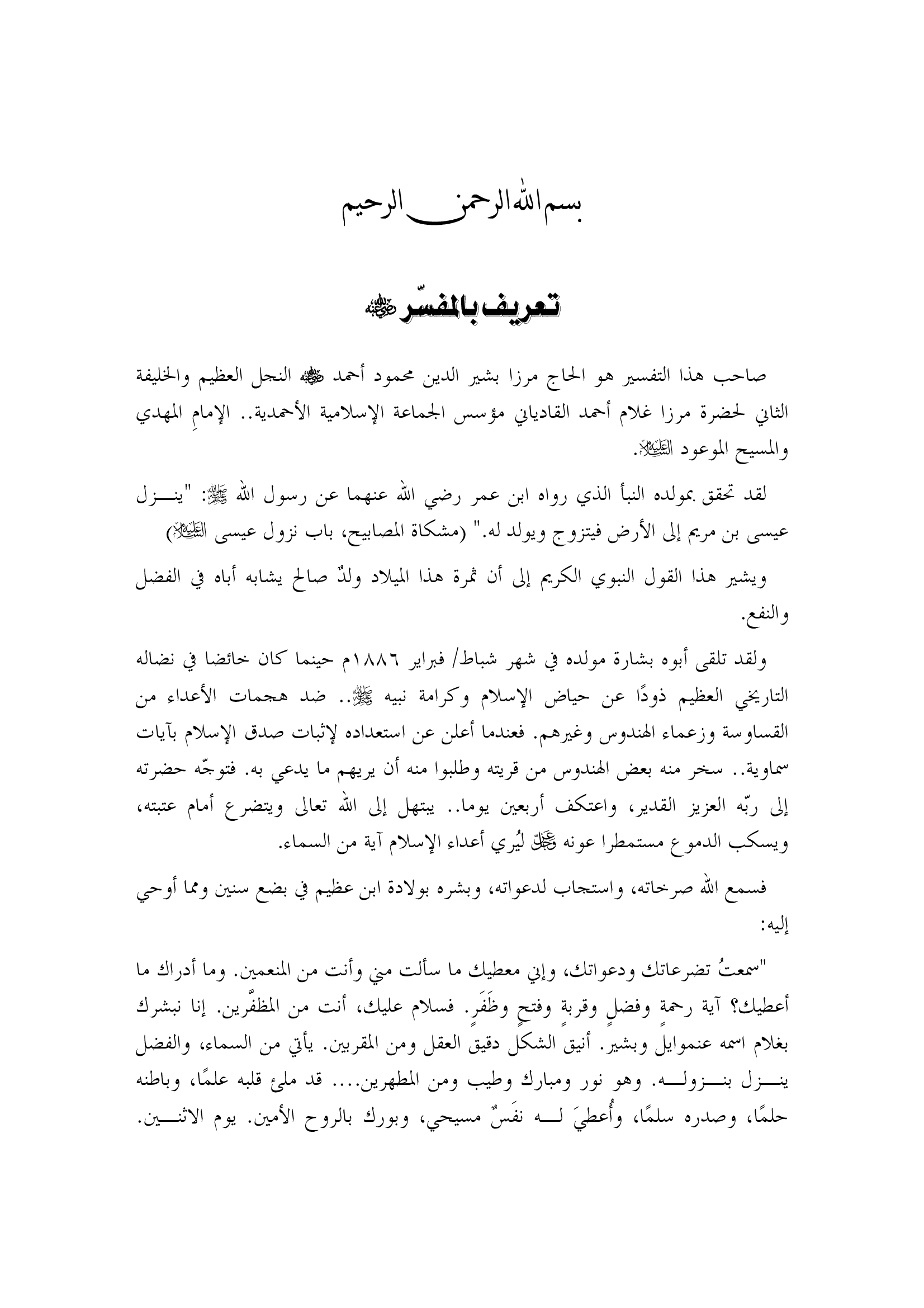Complete Text of Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 1)
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف بالمفسّر هم
صاحب هذا التفسير هو الحاج مرزا بشير الدين محمود أحمد الله النجل العظيم والخليفة
الثاني لحضرة مرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية..الإمام المهدي
والمسيح الموعود الكلية.لقد تحقق بمولده النبأ الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ: "ينـــزل
عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له." (مشكاة المصابيح، باب نزول عيسى ال)
ويشير هذا القول النبوي الكريم إلى أن ثمرة هذا الميلاد ولد صالح يشابه أباه في الفضل
والنفع.ولقد تلقى أبوه بشارة مولده في شهر شباط / فبراير ١٨٨٦م حينما كان خائضا في نضاله
التاريخي العظيم ذودًا عن حياض الإسلام وكرامة نبيه..ضد هجمات الأعداء من
القساوسة وزعماء الهندوس وغيرهم.فعندما أعلن عن استعداده لإثبات صدق الإسلام بآيات
سماوية..سخر منه بعض الهندوس من قريته وطلبوا منه أن
يريهم ما يدعي به.فتوجه حضرته
إلى ربّه العزيز القدير، واعتكف أربعين يوما..يبتهل إلى الله تعالى ويتضرع أمام عتبته،
ويسكب الدموع مستمطرا عونه ول ليُري أعداء الإسلام آية من السماء.فسمع
الله
إليه :
صرخاته، واستجاب لدعواته، وبشره بولادة ابن عظيم في بضع سنين ومما أوحي
=
سمعت تضرعاتك ودعواتك، وإني معطيك ما سألت مني وأنت من المنعمين.وما أدراك ما
أعطيك؟ آية رحمة وفضل وقربة وفتح وظَفَر فسلام عليك، أنت من المظفّرين.إنا نبشرك
بغلام اسمه عنموايل وبشير.أنيق الشكل دقيق العقل ومن المقربين.يأتي من السماء، والفضل
ينزل بنزوله.وهو نور ومبارك وطيب ومن المطهرين....قد ملئ قلبه علمًا، وباطنه
وصدره سلما، وأعطى له نفَس مسيحي، وبورك بالروح الأمين.يوم الاثنين.علماء
Page 2
فواها لك يا يوم الاثنين، يأتي فيك أرواح المباركين.ولد صالح كريم ذكي مبارك.مَظْهَر
الأول والآخر.مَظْهَرُ الحق والعَلاء كأن الله نزل من السماء.يظهر بظهوره جلال رب
العالمين.يأتيك نور ممسوح بعطر الرحمن، القائم تحت ظل الله المنان.يفك رقاب الأسارى
وينجي المسجونين.يعظم شأنه، ويُرفع اسمه وبرهانه ويُنشَر ذكره وريحانه إلى أقصى
الأرضين.إمام همام، يبارك منه أقوام، ويأتي.معه شفاء ولا يبقى سقام، وينتفع به أنام...."
(مرآة) كمالات الإسلام الخزائن الروحانية ج ۵ ص ٥٧٧ - ٥٧٨
"سيكون مليئا بالعلوم ظاهرة وباطنة...وسيأتي لينكشف به على الناس شرف دين
الإسلام ومرتبة كلام الله".وعندما أعلن ال هذه البشارة سخر منه أعداء الإسلام ونبيه.ولكن الله تعالى..الغيور على دينه وشرف المصطفى حبيبه..أنجز للإمام المهدي ،وعده، ووهبه غلاما زكيا
وجيها في ١٢ كانون الثاني/ يناير ١٨٨٩م.6
نشأ الابن المبارك في بيت أبيه، تكلوه عين رعاية الله..فظهرت عليه أمارات النبل والذكاء
منذ نعومة أظفاره.ومع أنه لم ينل من العلوم الدنيوية إلا القليل إلا أن الله تعالى آتاه من لدنه
علما، وأسبغ عليه نعمة حب القرآن المجيد والحديث النبوي الشريف، ونهل منهما الخير العميم
فيما تلقاه من دروس على يد أستاذه مولانا الحافظ نور الدين الله الله الخليفة الأول للإمام المهدي
العلمية الا.كان الإمام له كثير القراءة، حديد العزيمة جمّ النشاط شديد الحماس لتربية الشباب..حتى أصدر، وهو لا يزال صبيًا، مجلة خاصة بهم في عهد أبيه اللي سماها "تشحيد الأذهان"،
وأنفق عليها من جيبه ومساعدة بعض أصدقائه من الشباب.عمل رئيسا لتحريرها وكتب
فيها مقالات قيمة ولا تزال هذه المجلة تصدر حتى اليوم.وبلغ حبه وفهمه للقرآن الكريم مبلغا عظيما في صباه حتى شرع يلقي الدروس القرآنية في
المسجد، ويغوص في بحار معاني القرآن ليأتي بجواهر المعارف ولآلئ الحقائق..تخلب اللب،
وتدهش الفكر..كل ذلك وهو لا يزال دون العشرين من عمره !!
ولقد زادت هذه الموهبة الربانية مع تقدمه في السن بعد أن آتاه الله تبارك وتعالى علما
خاصا حول ترتيب السور والآيات القرآنية والربط بينهما..كما أعلن بنفسه أن ملاكا من
Page 3
ملائكة الرحمن علّمه تفسير سورة الفاتحة.أعماله البارزة:
ولقد أدى حضرته له خدمات جليلة للإسلام والمسلمين نوجزها فيما يلي:
الدفاع عن الخلافة وتمكينها:
لقد أخبر سيدنا محمد المصطفى الله عن عودة الخلافة الراشدة في آخر الزمان.وبالفعل
أعادها الله تعالى عن طريق سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود ال.ولكن عندما اشتد
المرض بمولانا الحافظ نور الدين الخليفة الأول الله ظهرت حركة بين نفر من الجماعة ترمي
إلى إلغاء منصب الخلافة وتوكيل اللجنة الإدارية المركزية في إدارة وتنظيم شؤون الجماعة.وعندما انتخب حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد لمنصب الخلافة عام ١٩١٤م - وهو لا
يزال ابن خمسة وعشرين عامًا - وفقه الله تعالى للخروج بالجماعة سالمة من هذه الفتنة والفتن
الخارجية وتمكين الخلافة بوضع نظام محكم لانتخاب الخليفة.فاستمرت الخلافة الراشدة تعطي
ثمارها وبركاتها للأمة إلى يومنا هذا.ومضت الجماعة تحت قيادتها تنتقل من نصر إلى نصر
ومن ازدهار إلى ازدهار..على الرغم من الصعاب والشدائد والمؤامرات والمكائد.تنظيم الجماعة ومؤسساتها:
أنشأ حضرته عديدا من النظم التي تكفل سير عجلة العمل في الجماعة بما يحقق أهدافها في
خدمة الإسلام وتبليغ دعوته إلى جميع أرجاء الأرض فوزّع العمل على دوائر لبيت المال
والمحاسبة والأملاك، والتأليف والتصنيف، والإشاعة والنشر والتوزيع، والدعوة والتبليغ،
والتربية والتعليم والقضاء والفتوى والضيافة، والأمور العامة والأمور الخارجية، وغيرها.كذلك أنشأ مجلسا لشيوخ الجماعة وسماه "مجلس أنصار الله"، وآخر للشباب وسماه "مجلس
الأحمدية"،
، وثالثا للسيدات وسماه " لجنة إماء الله" ورابعا للبنين وسماه "أطفال الأحمدية"،
وخامسا للبنات وسماه "ناصرات الأحمدية".ولكل هذه التنظيمات فروع في كل الجماعات
المنتشرة في كل أنحاء العالم لها هياكلها الإدارية واجتماعاتها الدورية واشتراكاتها الإلزامية
خدام
ومحلاتها الخاصة.
Page 4
"التحريك الجديد":
في سنة ١٩٣٤م وعلى إثر قيام طائفة الأحراريين * بمساندة من الحكام الإنجليز..بالاعتداء
على مركز الجماعة حينئذ قاديان الهند ومحاولة القضاء على الأحمدية..أعلن حضرته
إنشاء مشروع باسم "التحريك "الجديد" (أي المشروع الجديد بهدف نشر وتوطيد الدعوة
الإسلامية الأحمدية في أنحاء العالم خارج شبه القارة الهندية، وفتح مراكز للتبليغ وتعمير
المساجد.ولقد أعطت هذه الشجرة الطيبة أكلها بإذن ربها فتوطدت الجماعة حتى الآن في
١٨٢ بلدا وبنت آلاف المساجد والمراكز في مختلف أنحاء العالم.خدماته لمسلمي الهند:
في عام ۱۹۱۲م قامت حركة هندوسية متطرفة باسم (شدهي)..تهدف إلى استعادة الهنود
المسلمين وضعفائهم إلى الهندوسية وبالفعل تمكنوا من تضليل ستة ملايين منهم.وعندما
استفحلت هذه الفتنة في عام ۱۹۲۳م تصدى لها مرزا بشير الدين محمود أحمد له، وجمع
حوله المخلصين من جماعته من كل المجالات: علماء، أطباء، تجارا ورجال القانون وغيرهم،
و خاض بهم معركة باسلة ضد الهندوس المتطرفين سلاحه فيها القرآن والسنة والدعاء إلى الله.فهزموهم بإذن الله، وتمكنوا من إقناع المرتدين التعساء وإنقاذهم من براثن الهندوسية.هذا إلى جانب جهوده الجبارة لتحرير أبناء كشمير المسلمين.ولذلك اختاره المسلمون
رئيسا للجنة كشمير ولولا اندساس الأحراريين وإفسادهم تكللت جهود اللجنة بالنجاح
التام.مواقفه المشهودة للعرب:
عندما كان الاستعمار ينفذ مؤامرته في فلسطين عام ١٩٤٨م كتب الإمام نشرتين: "هيئة
الأمم المتحدة وقرار تقسيم "فلسطين" و "الكفر" ملة واحدة، ندد فيهما بموقف الصهاينة
والاستعمار.ودعا العالم الإسلامي إلى نبذ خلافاته وتوحيد صفوفه لمواجهة إسرائيل ومساعدة
العرب..ومما قاله حضرته:
الأحراريون أو حزب الأحرار كانوا بعض المشايخ المتعصبين وأشياعهم المتطرفين المعارضين للجماعة الإسلامية
الأحمدية، وكانوا يوالون الهندوس ويعارضون فكرة تأسيس باكستان.
Page 5
وإنما
هي
"إن قضية فلسطين ليست بقضية عربية فحسب، بل إنها قضية تهم العالم الإسلامي كله.إنها ليست قضية فلسطين وإنما هي قضية المدينة المنورة.والمسألة ليست مسألة بيت المقدس
مسألة مكة المكرمة ذاتها القضيّة ليست قضيّة زيد أو عمرو بل هي قضيّة عرض
محمد رسول الله.لقد أتحد العدو ضد الإسلام متناسيا أوجه الخلاف الكثيرة بينه.أولاً
يتحد المسلمون بهذه المناسبة رغم وجود آلاف من أوجه الاتفاق بينهم." ("الكفر ملة واحدة"
عن جريدة "الفضل" ٥/٢١ / ١٩٤٨م)
ولقد نشرت بعض الصحف العربية ما جاء في "الكفر ملة واحدة" وأثنت على جهود
نقلاً
الإمام والجماعة لإنقاذ فلسطين.(انظر جريدة النهضة عدد ١٢ تموز/ يوليو ١٩٤٨م)
خدماته العلمية:
بالإضافة إلى آلاف الخطب والمحاضرات في شتى المناسبات ألف حضرته عشرات الكتب
منها: العرفان الإلهي حقيقة ملائكة الله حقيقة الرؤيا، منهاج الطالبين، نظام الاقتصاد في
الإسلام، بداية نشوب الخلافات في تاريخ الإسلام دعوة إلى الحق تحفة الملوك، الأحمدية أي
الإسلام الحقيقي، وحياة محمد و لوله ديوان شعر بالأردية اسمه: "كلام محمود".التفسير الكبير :
ولكن أعظم خدماته العلمية هو تفسيره للقرآن الكريم ويسمى (التفسير الكبير).وقد نُشر
في عشرة مجلدات باللغة الأردية، ثم نُقل مختصرا إلى عدة لغات منها الإنجليزية (التي تمت منها
الترجمة العربية الحالية).وأشادت جهات مختلفة بهذه التراجم.وقد قرظت جريدة "وكالة
الأنباء العربية" عليها تحت عنوان بارز: ترجمة القرآن الكريم" ما يلي:
"عمان، تلقى فضيلة الميرزا رشيد أحمد جغتائي المبشر الإسلامي المعروف وعضو الجماعة
الأحمدية والمقيم حاليا بعمان نسخةً من الكتاب القيم الذي أصدرته الجماعة في الهند باللغة
الإنكليزية حاويًا ترجمة القرآن المجيد.ويقع الكتاب في ٩٦٨ صفحة تضم ترجمة السور المجيدة
الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة.وقد قدّم لها
بمقدمة قيمة تقع في ثلاثمائة صفحة كتبها إمام الجماعة حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد
تضم مصادر الكتاب وبحوثا قيمة عن قيمة القرآن المجيد وسيرة الرسول الأعظم وشخصيته
وكيفية جمع القرآن وغيرها.
Page 6
والترجمة الإنكليزية تفوق كل ترجمة سبقتها من حيث الإتقان وجودة الورقة والطبع
والانسجام وصدق الترجمة الحرفية وتفسيرها تفسيرًا مسهبا بأسلوب جديد يدل على علم
غزير واطلاع واسع على حقائق الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السامية.والكتاب الثمين في مجموعه دفاع عن الإسلام ورد على خصومه وخاصة المستشرقين..يُبطل مزاعمهم بأسلوب علمي رائع....ومما يجدر ذكره بأن المسز زمرمان الكاتبة الهولندية المعروفة قامت بترجمة القرآن المجيد من
الإنكليزية إلى الهولندية، وما كادت تفرغ من ترجمتها حتى كانت قد اعتنقت الإسلام".(جريدة "وكالة الأنباء العربية" الصادرة في عمان والقاهرة في عددها ١/٢٠٥ بتاريخ
١٩٤٩/٢/٦م الموافق ٨ ربيع الثاني ١٣٦٨ هـ)
أما فيما يتعلق بشهادة علماء "الأزهر" فقد نشرت مجلة "الأزهر" تحت عنوان: "نقد
الكتب..القرآن "المقدس" تعليق الدكتور محمد عبد الله ماضي على الترجمة الألمانية لهذا التفسير
بما يلي:
"هذه الترجمة أو هذا الكتاب يحتوي على مقدمة مفصلة وعلى ترجمة معاني القرآن باللغة
الألمانية.والمقدمة كتبها رئيس الطائفة الأحمدية الحالي حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد.أما الترجمة نفسها فقد اختبرتُها في مواضع مختلفة وفي كثير من الآيات في مختلف السور،
فوجدتها من خير الترجمات التي ظهرت للقرآن الكريم في أسلوب دقيق محتاط، ومحاولة بارعة
لأداء المعنى الذي يدل عليه التعبير العربي المنزل لآيات القرآن الكريم.وقد نبه المترجم إلى أنه
ليس في الاستطاعة نقل ما يؤديه الأسلوب العربي المحكم من الروعة البلاغية وسمات الإعجاز
التي هي من خصائص القرآن إلى لغة أخرى، فهي خصائص انفرد بها كتاب الله المنزل في
أسلوبه العربي، الذي نزل به من عند الله على نبيه المرسل، والذي لا تبديل فيه ولا تحريف،
فهو يمثل كلام الله في معناه وفي مبناه، ولهذا فمن باب الاحتياط جعل النص العربي بجوار
الترجمة الألمانية، حتى يستطيع القارئ أن يقارن ويختار بنفسه المعنى الذي تطمئن نفسه إلى
صحته.وعلى وجه الخصوص اختبرتُ ترجمة الآيات التي تتعلق بالقتال والجهاد في سبيل الله، بحثا
عما عساه يكون قد ضمّن الترجمة مما يتصل بما يراه الأحمدية في الجهاد، ويخالفون به جماعة
Page 7
المسلمين، حيث إنهم يقولون: "إن الجهاد يجب ألا يقوم على امتشاق الحسام، بل يجب أن
يقوم على وسائل سلمية.....من
تعاليمه
اختبرت ترجمة هذه الآيات المشار إليها فوجدتُها سليمة لا تتضمن أدنى الإشارات إلى هذا
الذي كنت أخشى أن تتضمنه.وفي
المقدمة أورد كاتبها بحوثا إسلامية فلسفية قيمة، وقسمها إلى قسمين: تحدث في القسم
الأول منهما عن حاجة البشرية التي اقتضت نزول القرآن، وبين أن الإسلام كان
وحدة الإله، وكان من عوامل توحيد البشرية.فذكر أنه لما ارتقت البشرية وأصبح الناس على
اتصال يكونون جماعة واحدة، أصبحوا في حاجة إلى تعاليم سماوية شاملة، تشمل الناس جميعًا،
وتصلح لهم في كل زمان ومكان، وتدلّهم على قدرة الله وعظمة رب الناس كافة؛ فكان
القرآن هو الذي أدى تلك الرسالة جميعها.كما تحدث عن كتاب العهد القديم (التوراة) وكتاب العهد الجديد (الإنجيل)، وبين أنه
نالهما التحريف والتبديل، فأصبحا معه لا يمثلان كتب الله المنزلة.وذكر بعض المتناقضات
فيهما، وبعض المبادئ التي تخالف العقل، وبعض الخرافات، وبعض القواعد الخُلقية غير الثابتة.كما تحدث عما ورد في التوراة والإنجيل من التبشير بظهور النبي محمد
ﷺ، إلى غير ذلك مما
أورده صاحب المقدمة في القسم الأول.وفي القسم الثاني من المقدمة كان الحديث عن بناء القرآن فذكر المؤلف ما سبق أن تعرض
له من بيان أن القرآن هو الكتاب المقدس الذي يمثل كلام الله المنزل، والذي حفظه الله
من كل تحريف وتبديل، وتحدث في هذا الصدد عن المحافظة على القرآن بكل الوسائل المختلفة
في عهد الرسول من كتابة الوحي وتقييده، ومن وعي الحفاظ له.وتحدث كذلك عن
ترتيب الآيات والسور، مبينًا أن ذلك كان بوحي من الله نزل على نبيه.وتابع
الأمور الآتية:" هنا يورد هذه المواضيع في قائمة طويلة ثم يقول)
الحديث عن
"وإذا صرفنا النظر عن بعض التلميحات العامة غير الصريحة المتصلة بمذهب الأحمدية في
الجهاد، والتي وردت في صحيفة (١٣٤) من المقدمة تحت عنوان المنازعات الدينية" فإننا نجد
أن المقدمة بقسميها اشتملت في الجملة على بحوث إسلامية رائعة، ونقلت صورةً من الأفكار
والتعاليم الإسلامية المتعلقة بالقرآن في ثوب وإطار إسلامي إلى اللغة الألمانية."
Page 8
بعدها يقول المعلق:
ولكن نعم ،ولكن مع الأسف الشديد ختمت هذه المقدمة بفصل عن المسيح المنتظر
(مرزا غلام أحمد........وحبذا لو كان من المستطاع فصلُ هذا الجزء الأخير عن الترجمة
وعن المقدمة، والعمل على نشرها دون هذا الجزء، فإنه لو أمكن ذلك لكان فيه خير كثير."
("مجلة الأزهر" الجزء الثامن، القاهرة، شعبان سنة ١٣٧٨- فبراير (شباط) سنة ١٩٥٩-
المجلد الثلاثون)
وكتبت جريدة أخرى تحت عنوان: "الجماعة الأحمدية وترجمة القرآن المجيد":
"بدأ الناس يُعجبون، بالرغم من انهماكهم في أمور دنياهم، بنشاط الحركة الأحمدية
وجهادها لنشر الإسلام في القارات الخمس.ومن أعظم ما قام به الأحمديون في السنوات التي
تلت الحرب ترجمتُهم القرآن المجيد للغات الأجنبية الحية كالإنجليزية والألمانية والأفرنسية
والروسية والإيطالية والأسبانية ،وغيرها تحت إرشاد إمام الجماعة الأحمدية حضرة ميرزا بشير
الدين محمود أحمد.وقد طبعت الترجمة الإنجليزية، فرأيناها تفوق كل ترجمة سبقتها من حيث الإتقان وجودة
الورق والطبع والترتيب والانسجام وصدق الترجمة الحرفية وتفسيرها تفسيرًا مسهبًا، بأسلوب
جديد يدل على علم غزير واطلاع واسع على حقائق الدين وروحه وتعاليمه السامية.وقد كتبت الآيات القرآنية في أعلى الصفحات بالعربية في الجانب الأيمن وترجمتها
بالإنكليزية في الجانب الأيسر، وتحت ذلك التفسير بلغة إنكليزية راقية.وإن المطالع لهذا التفسير الجديد يرى أن حضرة إمام الجماعة الأحمدية في دفاعه عن الإسلام
إنما يدافع عن الدين الحي الذي يجد الناس كافة فيه السبيل القاصد للقاء ربهم، وخاصة في
الوقت الذي تعددت فيه الطرق على السالكين، فابتعدوا بها عنه.وحضرته يرد في تفسيره هذا على خصوم الإسلام وبالخاصة المستشرقين، ويُبطل مزاعمهم
ومطاعنهم بأسلوب علمي منقطع النظير.وقد بين في تفسيره هذا علاقة السور ببعضها وكذلك الآيات وأسباب النزول وملخص
مضامين السور في أوائلها ليزيد القراء علمًا وإيضاحًا لحقيقة المعاني.ولإتمام الفائدة ألحق هذه
Page 9
الترجمة النفيسة بسيرة مسهبة للنبي ﷺ بقلمه، فجاءت هذه السيرة غاية في الإتقان والأسلو
والمواضيع." جريدة "الأردن" عمان ۲۰ محرم ١٣٦٨ الموافق ٢١ / ١١ / ١٩٤٨)
هذا ما قاله العلماء العرب من أهل التقوى وخشية الله.وجزاهم الله أحسن الجزاء.وقد اعترف علماء الهند أيضا، علنا وبكثرة، بعلمه الغزير وكونه مفسرا لا يبلغ شأوه،
فأثنوا عليه وكان مثل هذا الثناء والتقريظ من أهل النزاهة والاستقامة أمرا عاديا في حياة
سيدنا الميرزا بشير الدين محمود أحمد.ثم ما هو المعيار للحكم على منجزات شخص أفضل مما
يشهد به أعداؤه ويعلنونه؟
هذا شودري فضل حق - زعيم حركة الأحرار، وهي منظمة نذرت نفسها لمعارضة
الجماعة الإسلامية الأحمدية - يتحدث عن براعة سيدنا محمود له فيصرح:
"إن وراءه عقلاً فذا قادرًا على تدمير أعظم إمبراطورية في غمضة عين".(جريدة "المجاهد"
11970/1/10
وهذا المولوي ظفر علي خان، وهو معارض شديد للجماعة الإسلامية الأحمدية..يتحسر
لما شهده من منجزات سيدنا محمود وينذر زملاءه وأصحابه:
"أعيروني سمعكم وأنصتوا أنتم وشركاؤكم أيها الأحراريون إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا
الميرزا محمود حتى يوم الدين.إن الميرزا محمود يملك القرآن وعلم القرآن.وإنكم لم تقرؤوا
القرآن قط ولو في أحلامكم مع الميرزا محمود جماعة مستعدة للتضحية بكل ما تملك عند
قدميه.الميرزا محمود لديه دعاة مبلغين وعلماء في تخصصات شتى.لقد ثبت رايته في كل بلد
من العالم." ايك خوفناك سازش (أي مؤامرة مخيفة للسيد مظهر علي أظهر ص ١٩٦)
وصيته للمسلمين:
في عام ١٩٥٩م عندما مرض المفسر له و وظن أنه ملاق ربه..كتب وصية لأبناء الجماعة
في أنحاء العالم حثهم فيها على مواصلة العمل في خدمة الإسلام والتمسك بنعمة الخلافة
الإسلامية الراشدة..نقتبس منها قوله:
"كنا أذلاء لا يُعتد بنا، فشرفنا الله تعالى كرما منه وفضلا وجعلنا حماةً لدينه.كنا ضعفاء عديمي الحيلة، فمنحنا الله تعالى القوة وأناط بنا مستقبل الإسلام.كنا فقراء بلا إمكانيات، ومع ذلك فرض الله علينا نشر اسمه واسم نبيه المصطفى ﷺ إلى
Page 10
أقصى أطراف الأرض
لقد كانت مهمة صعبة عجز الملوك عن القيام بها، ولكننا حملناها، ليس بكفاءتنا وإنما
بفضل الله تعالى ورحمته وبركته ثم ببركة رسوله خاتم النبيين..لم تكن بأيدينا الوسائل
ولكنه تعالى نصرنا وأخزى أعداء الإسلام وأذلهم.فسبحان الذي أخزى الأعادي.وإني لواثق
بأن الله تعالى سيظل ناصرا للإسلام إلى يوم الدين.وأرجو أن يتابع أبنائي وبناتي..وأبناء وبنات سيدنا المهدي والمسيح الموعود- عليه الصلاة
والسلام - تضحياتهم لحمل اسم محمد له إلى أقصى أطراف الأرض ورفع لواء الإسلام خفاقا
إلى الأبد.وبنفس الثقة والرجاء..أعهد إلى كل مسلم أحمدي أن يحمل هذه الأمانة.إن كل البركات
تنبع من الخلافة النبوة تزرع البذرة، فتتعهد الخلافة نموها ونشرها في العالم أجمع.فاعتصموا
بهذا النظام السماوي، ولتنتفع من بركاته الدنيا كلها.هذه
هي وصيتي الأخيرة لكم.رحمكم الله وأعزكم في هذه الدنيا وفي الآخرة.أوفوا
بعهدكم حتى الموت".وفاته
بعد حياة مباركة حافلة بجلائل الأعمال والخدمات للإسلام والمسلمين، وبعد قيادة تاريخية
فذة للجماعة الإسلامية الأحمدية لحوالي ٥٢ عاما..لقى هذا الولي الصديق رفيقه الأعلى،
ولبى نداء ربه صباح الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥م في مدينة ربوة التي
أنشأها، ودفن هناك.لقد كتب السيد يعقوب خان - المحرر السابق للجريدة الرسمية المدنية والحربية ( & CIVIL
MILITARY GAZETTE) – مؤبنا سيدنا محمود أحمد له بعد وفاته:
بناة الأمة
عظيم من
بوفاة الميرزا بشير الدين محمود أحمد إمام الحركة الأحمدية – ربوة..أُسدل الستار على مسار
الأحفل بالأحداث والأحشد بمشروعات بعيدة المدى لا تحصى.رجل ذو شخصية
حياة
هي
عبقرية متعددة المواهب، مفعمة بالنشاط والحيوية.لا يكاد يوجد مجال من مجالات الفكر
Page 11
والحياة المعاصرة من العلوم الدينية إلى تنظيم الدعوة والتبليغ بل والقيادة السياسية..إلا وترك
فيها الفقيد أثرًا عميقا في خلال النصف القرن الماضي.هناك شبكة كاملة من البعثات الإسلامية والمساجد منتشرة في أنحاء العالم؛ واختراق عميق
للدعوة الإسلامية في أفريقيا، وإزاحة للإرساليات النصرانية الراسخة منذ زمن طويل عن
مواقعها.كل ذلك ينهض نصباً تذكاريا وأثرًا خالدًا لما كان يتمتع به الفقيد من
تخطيط
مبدع؛ ومقدرة تنظيمية وطاقة لا تنضب لا يكاد يوجد قائد قوم من زمننا الحاضر حَازَ كل
هذا الإخلاص العميق من جانب أتباعه..ليس إبان حياته فقط بل وبعد وفاته.فقد هرع
٦٠,٠٠٠ من كافة أنحاء البلاد ليقدموا واجب التكريم والتقدير الأخير نحو إمامهم الراحل.وفي تاريخ الحركة الأحمدية..سوف يُسجل اسم الميرزا محمود على أنه عظيم من بناة الأمة..شيد جماعةً
متينة محبوكة النسج في مواجهة ظروف ثقيلة الوطأة، وجعل منها قوةً يُحسب
حسابها" (جريدة "النور" ، لاهور، ١٩٦٥/١١/١٦).جزاه
الله
تعالى خير ما يجزي..إماما في قومه، ومعلما ومربيا عن تلاميذه..وأبا روحيا عن
أبنائه وبناته، ونفعنا بعلمه ووعظه وألحقنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم إنك حميد مجيد.الناشر
Page 12
تفسير
سورة الفاتحه
بقلم سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد الله
الخليفة الثاني لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود الكلية
ترجمة الأستاذ المرحوم ملك مبارك أحمد
Page 13
سورة الفاتحة
التفسير
ـبير
بسم
الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
كلام الله
إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يمكن أن يسمى "كلام الله".أما الكتب الأخرى، وإن كانت تُدعى كتبًا ،إلهامية، إلا أنه لا يمكن أن
تسمى "كلام الله"..لأن كلام البشر قد أُضيف إليها وخالطها.أما "كلام
الله" الخالص في كل حرف منه..فإنما هو القرآن الكريم وحده بدءًا من الباء
في قوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم" إلى السين في قولـه "مــــن الجنـــة
والناس".منه كلمة
لا يزال هذا الكتاب إلى يومنا هذا هو هو كما نزل.لم تنقص
واحدة، ولم تُضَف إليه كلمة واحدة.ليس فيه أمر لا يمكن العلـــم بــه.لم
تنسخ منه آية واحدة.كل سكنة أو حركة في ألفاظه بفتح أو ضم أو كسر
وكل وقف كما هو.فلذلك ليس هناك كتاب سوى القرآن
محفوظةٌ
نستطيع أن نتخذه مناراً لحياتنا موقنين بأن لا شبهة في أي أمر فيه.ولكن وا أسفاه!! لقد نسي المسلمون هذا الكتاب القيم، وانشغلوا عنـــه
إلى كتب أخرى، وبدلاً من أن يتبعوا الله ربهم يتبعون زعماء اختاروهم
بأنفسهم.ایک
Page 14
التفسير الكبير
سورة الفاتحة
ولقد أردت بكتابة هذا التفسير لكلام الله تعالى أن يجد فيه من لا يعرفون
اللغة العربية، أو من ليس لديهم لسوء حظهم وقت للتدبر في كلام
الله، أو
من لا تتولد في قلوبهم رغبة في ذلك..الفرصة لأن يفهموا كلام الله تعالى،
ولأن يطلعوا على محاسنه المكنونة.بهذه السطور أستهل المجلد الأول من هذا التفسير.......تَقبَّلَ الله
هذه
مني
المحاولة المتواضعة، وأحيا بهذا التفسير من جديد معاني القرآن الكريم حياةً
ظاهرة وباطنة..ووفقني لإكماله.آمين!
٢٣/
٥
/
١٩٤٨
ميرزا محمود أحمد
رتن باغ، لاهور
Page 15
التفسير الكبير
سورة الفاتحة
تفسير سورة الفاتحة
(مكية وهي مع البسملة سو آيات)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
الله ور
بفضل الله
حمته..هو الناصر
السورة: السورة لغة تعني المنزلة الشرف ما طال من البناء وحسن؛
العلامة (الأقرب).والسورة من الكتاب: القطعة المستقلة.والسورة: ما تم
الأشياء..يقول العرب للناقة الشابة الصحيحة سورة.وجمعها
علامة
وكمل من
سُور.وقد يكون أصل هذا اللفظ من سورة انقلبت إلى سورة للضمة قبل
الهمزة، ويكون معناها البقية..يقول العرب هو في أسأر الناس أي بقيتهم.وعندي أن كل هذه المعاني تصدق على هذه الكلمة، لأن السورة من
القرآن المجيد تورث من يقرأها منزلة، وتشرف من يعمل بها، وهي
اختتام موضوع خاص، وهي بناء روحي فخم، وهي جزء من أجزاء القرآن،
وهي تضم بحثا كاملا من جميع النواحي.ولقد أطلق الرسول بنفسه هذه التسمية على سور القرآن بوحي من
الله تعالى.وقد وردت نفس التسمية في القرآن الكريم كقوله تعالى (وإن
Page 16
التفسير
كبير
0
سورة الفاتحة
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله)(سورة البقرة:
٢٤).وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: "أنزلت على آنها سورة.فقرأ:
بسم
الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر".(مسلم، كتاب الصلاة).أسماء الفاتحة
ولسورة الفاتحة عدة أسماء أخرى، والمعروف منها ما ورد في القرآن
الكريم وحديث الرسول وهي:.١ سورة الصلاة : عن أبى هريرة عن رسول الله أنه قال: يقول الله
عز وجل: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين".(صحيح مسلم،
كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، أي قسمتُ سورة الفاتحة.والمراد أن نصف السورة ذكر لأسماء الله عز وجل والثناء عليه، ونصفها
الثاني دعاء العبد.٢ سورة الحمد.أُمُّ القرآن.٤.القرآن العظيم.ه السبع المثاني.٦.أُمُّ الكتاب: وقد وردت هذه الأسماء الخمسة في روايتين هما: عن أبى
هريرة عن رسول الله أنه قال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع
المثاني".أبو داود، كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب).وعن أبي هريرة عن
رسول الله ﷺ أنه قال: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن
العظيم".(مسند أحمد بن حنبل، ج ۲، باقي مسند المكثرين).
Page 17
التفسير
كبير
سورة الفاتحة
الشفاء: عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال: "فاتحة
الكتاب شفاء من كل داء".(مسند الدرامي).وفي رواية: "شفاء من كل
سم".(البيهقي، شعب الإيمان).الرُّقية: عن أبي سعيد الخدري أن رجلا ذُكِرَ لرسول الله أنه رقى
رجلا سليما..أي من لدغته الحية..فبرأ.فقيل له: "أكنت تحسن رقيةً أو
كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيتُ إلا بأم الكتاب".فعندما ذُكر لرسول الله
قال: "وما كان يُدريه أنها رقية ! ".(صحيح البخاري، فضائل القرآن).٩.الكنز عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إن الله أعطاني فيما
عليَّ فاتحة الكتاب، وقال: هي كنز من كنوز عرشي." (تفسير فتح
به
البيان).النبي
، وأنه
ولقد تناولتُ هذه الأسماء مفصلة لأن جميعها ثابتة عن
بنفسه سماها بإلهام من الله عز وجل، ولأن هذه الأسماء تشير إلى الحقائق
التالية:
أولا : هي
فاتحة الكتاب، لأن الله تعالى وضعها في أول القرآن، وهي أيضا
مفتاح لجميع معارف القرآن.ثانيا: هي سورة الحمد، لأنها تبين علاقة الإنسان بخالقه، وتحدد غاية
خلقه بأنه خُلق لأجل التقدم إلى درجات سامية من القرب الإلهي، وأن
صلته
مع الله تعالى أساسها رحمة الله وفضله.ثالثا: هي سورة الصلاة..أي الدعاء لأنها تعلم الإنسان دعاء كاملا لا
مثيل له.
Page 18
التفسير
بير
رابعا: هي
سورة الفاتحة
الكتاب، لأن جميع العلوم التي يحتاجها الإنسان في شتى
أوضاع حياته قد جُمعت فيها جمعا رائعا، ولأنها بمثابة الأم..أي أن الأدعية
التي تشتمل عليها هذه السورة هي
فاستدرت نزول القرآن.التي
كانت انبعثت من القلوب المتضرعة
تلبي
خامسا: هي السبع المثاني، لأنها وإن كانت سبع آيات فحسب، فهي
جميع احتياجات الإنسان، حيث إن آياتها تحل أعقد المسائل الروحانية، وهي
مرجع يتكرر لحل جميع هذه المسائل، وأيضا لأن آياتها تُقرأ في كل ركعة من
الصلاة.سادسا:
هي القرآن العظيم، لأنها جزء من القرآن.وسميت قرآنا بحسب
عادة العرب إذ تقول: أسْمِعْنا القرآن وتعني جزءا منه.فالفاتحة ليست
خارجة عن القرآن كما زعم البعض.سابعا: هي سورة الشفاء، لأنها تشفي من جميع الوساوس التي تختلج بها
صدور الناس في أمور الدين.ثامنا :
هي
رقية، لأنها تفيد كرقية.كما تمنع عن قارئها الوساوس، وتولد
فيه قوة تصير حيالها دسائس الشياطين عقيمة.تاسعا: وهي سورة الكنز، لأنها خزينة العلوم والمعارف، وجامعة لفرائد
المعاني وغرر المبادئ..كأن البحر على سعته قد انحصر في كوب صغير.وقد ورد النبأ في الكتب السماوية السابقة مشيرا إلى اسم هذه السورة
وعدد آياتها السبع كما جاء في سفر الرؤيا:
Page 19
التفسير
بير
سورة الفاتحة
" ومـ
معه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر
واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد.وبعد ما
تكلمت الرعود السبعة بأصواتها".(رؤيا يوحنا اللاهوتي، الإصحاح
صرخ
۱۰: ۲ و ۳).فضائل الفاتحة
منها ما مر ذكره ومنها ما يقتضي التفصيل، وهاك بيانه:
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ : "ما أنزل الله في التوراة ولا
في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين
عبدي، ولعبدي ما سأل." (النسائي، كتاب الافتتاح).هذه الفضيلة عظيمة الأهمية، لأنها ترشد إلى طريق يساعد الإنسان على
حل الأمور الدينية والدنيوية، وهو أن كل دعاء مصحوب بالفاتحة ينال
القبول ومن البين أن معنى الجملة الأخيرة من هذا الحديث ليس أن مجرد
قراءة هذه السورة وسيلة للإجابة، بل معناها أن الذي يسلك طريق القبول
المذكور في السورة هو الذي يستطيع دعاؤه أن ينال القبول.وهذا الطريق
ترسمه أجزاء السورة كما يلي: ١: بسم الله الرحمن الرحيم، ٢: الحمد لله
رب العالمين، ٣ الرحمن ٤ الرحيم ٥: مالك يوم الدين، ٦: إياك نعبد
: إياك نستعين.فكأن السورة كما أنها
سبع
آيات فهي
كذلك تتضمن سبعة مبادئ
لقبول الدعاء:
Page 20
التفسير الكبير
سورة الفاتحة
المبدأ الأول: الله، وطبقا لهذا المبدأ يجب أن يكون الدعاء لأمر صالح.بسم
فلا ينبغي للسارق مثلا أن يدعو للنجاح في سرقته، لأنها لا تصلح لأن تبدأ
عز وجل.فالدعاء المبتدأ باسم الله والاستعانة به لا بد أن يكون
باسم
الله
الأمر يحبه الله للعبد.رأيت كثيرًا من الناس يدعون على غيرهم بالدمار
والهلاك ثم يشكون أن الدعاء لم يُستجب.وكذلك يدعون لمقاصد جائرة
ثم يزعمون أن الدعاء لم يُسمَع.ومنهم من يتظاهر بالزهد والتقوى ويبيع
التمائم ويدعو لأمور محرمة، والواقع أن هذه التمائم والأدعية مردودة عليه.المبدأ الثاني: الحمد لله رب العالمين، أي ينبغي للداعي أن يدعو دعاء يعم
خيره الناس أجمعين، أو على الأقل يتجنب الدعاء عليهم، وينبغي أن لا
يناقض الدعاء صفة الحمد لله، ولا يكون سببا لتنقيصه.المبدأ الثالث: الرحمن، أي أن يكون الدعاء مستثيرا لرحمة الله الشاملة
ومظهرا لصفته الرحمانية.المبدأ الرابع: الرحيم، أي أن يكون الدعاء أساسا متأثلا للأعمال الصالحة
المستمرة، لفترة طويلة من الزمن، وألا تنقطع إفادته عن الصالحين المحسنين،
أو على الأقل لا يقف في طريقهم.المبدأ الخامس: مالك يوم الدين، أي ينبغي للطالب ألا يتعدى فكره عن
الأسباب التي خلقها الله للإنتاج الصحيح، لأنها أيضا من خلق الله عز وجل،
وليس من المستساغ أن يتوسل العبد إلى الله بغير ما خلق له من الوسائل.فالأسباب المادية يجب استعمالها بشرط وجودها لدى الداعي وتمكنه منها.نعم، إذا لم تكن الأسباب متوافرة تجلت هذه الصفة الربانية متعالية عن
Page 21
التفسير الكـ
كبير
سورة الفاتحة
الأسباب.وتشير الكلمة أيضا إلى أن العبد يجب أن يكون محاملا للناس في
حقه عليهم، وألا يكون فظا عند المطالبة.المبدأ السادس: إياك نعبد، أي أن يتمتع السائل بعلاقة قريبة بالله وأن
يكون مخلصا معه تعالى وأن يتجنب بكل حرص ميول الشرك ونزعاتِ
الشيطان.المبدأ السابع: إياك نستعين، أن يكون حياته ومماته لله، وأن يكون اعتماده
كله على ذاته عز وجل، منقطعًا إليه عن جميع ما سواه، وأن يبلغ في التوكل
الله مكانة تغنيه عن الاستعانة بغير الله في كل الأحوال، مهما دارت به
على
الدوائر.هذه
هي
المبادئ السبعة التي إذا عمل بها الإنسان صار العبد الذي ذكره
الرسول في الحديث: "ولعبدي ما سأل"، ويستجاب دعاؤه.والحق أنه لا يوجد نموذج لمثل هذا الدعاء الكامل إلا عند محمد المصطفى
وأتباعه الصادقين.ففيهم وجدت الدنيا آيات لقبول الدعاء أعادت
للعميان بصارتهم، وللصم ،سماعتهم، وللبكم فصاحتهم.والباب للوصول إلى
المنزلة التي نالها أصحاب النبي لم يغلق، بل إنه مفتوح على مصراعيه،
ومن سعى للوصول إليها فاز بها.وروى سعيد بن المعلى أن رسول الله الله قال له: ألا أعلمك أعظم سورة
في القرآن؛ فعلمهم الفاتحة." (البخاري.كتاب فضائل القرآن).
Page 22
التفسير
بير
سورة الفاتحة
وأراد بقوله "أعظم سورة في "القرآن أن معارف الفاتحة، على صغر
حجمها، أكثر من معارف السور الطوال، ولا مراء في ذلك فإنها بمثابة متن
القرآن.من
الملائكة.وهنا أود أن أبين ما شهدت في نفسي من فضل هذه السورة.كنت
حدثا صغيرا حينما رأيت في المنام أنني قائم في مكان متوجها نحو الشرق،
وأمامي ميدان واسع.فإذا أنا بصوت مثل طنطنة الآنية.وأخذ الصوت
ينتشر في الجو حتى ظننت أن الجو قد امتلأ به.ثم بدأ وسط الصوت يتجسد
لي، وأخذ يظهر بمظهر إطار مثل إطارات الصور، وبدت في ذلك الإطار
ألوان خفيفة، ثم زادت الألوان وشكلت في النهاية صورة.ثم تحركت
الصورة و أصبحت ذات حياة.فخيل إلي أن الصورة لملاك
فخاطبني وقال: ألا أعلمك تفسير الفاتحة؟ قلت له: بلى، علمني تفسير هذه
السورة.فأخذ يعلّمني حتى فسر لي إياك نعبد وإياك نستعين).ثم قال لي:
إن جميع
كتب التفسير انتهت بتفسير هذه الآية، ولم يأت أحد بتفسير ما
بعدها من الآيات ثم قال: ألا تريد أن أعلمك تفسير ما بعدها؟ قلت: بلى.ففسر لي (اهدنا الصراط المستقيم وما بعدها من الآيات.فلما انتهى من
التفسير استيقظت، ووجدت نفسي كأنني لا أذكر من التفسير إلا أمرا أو
أمرين.ثم عدت إلى النوم ثانية، ولما أفقت نسيت جميع ما علمت من
التفسير.وبعد مدة سنحت لي فرصة للحديث حول تفسير هذه السورة، وعندئذ
شعرت بأن نفسي تأتي معارف لا عهد لي بها.فتأكدتُ أنها تلك التي
Page 23
التفسير
كبير
۱۲
سورة الفاتحة
علمنيها الملاك.ومنذ ذلك اليوم ما زلت أتلقى حقائق لطيفة لهذه السورة
المباركة، وقد صرحت بكثير منها في الكتب والخطب..ولم تنفد هذه
الخزينة.والمبادئ السبعة التي ذكرتها هنا عن استجابة الدعاء هي أيضا من ثمرات
تلك التجارب، إذ إنني لما أردت تفسيرها هذه المرة أحببت أن يجدد الله لي
سنته، فانكشفت لي هذه المبادئ السبعة لإجابة الدعاء.فالحمد لله على
ذلك، وما كتبت إلا كلاما موجزا بالنسبة إلى ما تحتوي عليه هذه المبادئ
من حقائق واسعة.وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.زمن نزول الفاتحة
عندي أن السورة نزلت بمكة ثم نزلت بالمدينة.ومن المؤكد أنها مكية لأنها
نزلت أولا بمكة حيث ذكر نزولها في سورة الحجر" المكية في قوله تعالى:
(ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم) (الآية ٨٨)..كما روى بعض
الصحابة والأئمة أنها نزلت بالمدينة.(القرطبي).قراءة الفاتحة في الصلاة
28
وقراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاةٍ واجبة.ومن دخل الصلاة عند
الركوع فقراءة الإمام للفاتحة تكون قراءة له.ويؤكد ذلك أحاديث كثيرة
منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم
Page 24
التفسير
كبير
۱۳
سورة الفاتحة
القرآن فهي خداج." (مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في
كل ركعة).وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب." (البخاري، كتاب الصلاة).فقراءة الفاتحة واجبة على كل مصل إمام أو مأموم، في صلاة الجهر
والسر والاستثناء السابق لمن دخل الصلاة عند ركوع الإمام لا ينقض
القاعدة.كما يجوز لمسلم حديث الإسلام الذي لم يتعلم الفاتحة أو الطفل
الذي لا يعرف ،قراءتها، أن يصلي بدونها حتى يتعلمها.خلاصة معارف الفاتحة
إن الفاتحة كما يبدو من اسمها "فاتحة "القرآن" قد جمعت حقائق القرآن
بصورة موجزة كي يقف عليها القارئ محملةً في أول القرآن.بسم
الله..البدء بها يدل على أن القارئ يؤمن بالله، وبأن الله، على
عكس ما يزعم الفلاسفة، ليس العلة الأولى للكون فحسب، بل إن جميع
الأمور تحدث بحكمه وإشارته.ومن ثم لا بد من الاستعانة به التي تُغني
الإنسان عن آية استعانة أخرى.وأيضا يتيقن المؤمن بأن الله ليس قوة
روحانية خفية فحسب، بل له وجود مستقل وله اسم مستقل، وهو
بمختلف الصفات.متصف
الرحمن..هو المبدأ الجميع أصناف الرقي، وعنده كافة الوسائل التي تتوسل
بها الدنيا إلى التقدم والنهوض.
Page 25
التفسير
كبير
١٤
سورة الفاتحة
التي
الرحيم..خلق الإنسان لغاية سامية فإذا اعتمد الإنسان على الذرائع
خلقها الله لأجله اعتمادا كاملا..أتت له بنتائج حسنة يستحق معها المزيد
من النعم باستمرار وبدون انقطاع.الحمد لله..تمتاز أعماله عز وجل بالجامعية والكمال، ولا يعوزه نوع من
أنواع الحسن.فهو الأحق بالحمد كله، لأنه خالق لكل ما عداه.طبائع
رب العالمين..وهو رب العالمين..ما من شيء إلا وهو الذي بدأه ورباه
ليرتقي إلى نهايته في مراحل عديدة، وليس هناك شيء وُجد بنفسه.فهذه
الدنيا تتنوع فيها المخلوقات التي لا تعد ولا تحصر، وكل نوع له أفراد ولهم
مختلفة، وكل طبيعة لها عادات..وهذا الاختلاف والتنوع يستمر ولا
نهاية له.فلا بد لفهم حقيقة شيء أن نفكر في نوعه، لا فيما يخالفه نوعا..فيجب أن لا ينخدع أحد برؤية اختلاف في عادة الله في الكون، لأنه
إلى اختلاف الأحوال لا إلى الإهمال أو الجور والظلم.تعالى الله عما يقول
الظالمون علوا كبيرا.يرجع
خالق
الرحمن..وكما أنه خالق الإنسان وغيره من الكائنات كذلك هو
لكل ما يحتاج إليه الإنسان من الأسباب.فكل شيء محتاج إليه عز وجل في
كافة الظروف والأحوال.الرحيم..وكما أنه خالق الأشياء وما تحتاج إليه من أسباب، كذلك هو
الذي يملك النتائج التي تؤدي إليها هذه الأسباب.فمثلا إنه خلق الإنسان
وخلق له ما يتغذى به لاستمرار حياته وكذلك ما يترتب عليه ويتولد منه،
صالحاً كان أو فاسداً، كله من أمره عز وجل.
Page 26
التفسير
كبير
مالك
يوم
١٥
سورة الفاتحة
الدين..سنَّ للجزاء قاعدة أن الإنسان سوف يتمتع بحسنات
ما كسب، ويتعذب بسيئات ما اكتسب والأعمال على قسمين: قسم يأتي
بثمرات عاجلة، وقسم آخر يتأخر ثماره إلى أجل مسمى.وهذا القسم الأخير
يأتي بنتيجة شاملة لجميع الأعمال، في حين أن القسم الأول يختص بكل
عمل على حدة.فالله تعالى لم يكتف بجزاء كل عمل، بل جعل للأعمال
كلها جزاء جامعا بصفة مالك يوم الدين.إياك نعبد وإياك نستعين..هذا هو الذات الجدير بالعبادة والحب.وتقدم
الإنسان يتوقف على أمرين: الأول: الحركات البدنية، والثاني: الميول
القلبية..وهذا الأخير يَعُمّ الفكرة والعقيدة والإرادة.فلا بد من إصلاح
القسمين كليهما، وهذا الإصلاح لا يمكن تحققه إلى بعونه تعالى.اهدِنا..هنا صرح عز وجل أنه يحب أن يتصل بعباده ويقوم بإصلاحهم..ومن ثم ينبغي على العبد أن يلتفت نحوه ويجتهد للتقرب إليه.الصراط المستقيم..يرى الإنسان أمامه طرقا متعددة تؤدي إلى الله فيما
يبدو، ولكن معرفة الطرق فقط لا يجدي نفعا حتى يعرف الإنسان أولا
أقصرها وأقربها، لئلا يقضي عليه السعي المضني قبل الوصول إلى غايته.صراط الذين أنعمت عليهم..كما عليه أن يسعى إلى طريق معروف عند
الصالحين من عباد الله، مسلوك لديهم موصل إليه عز وجل..وذلك كي
يطلع على الأخطار التي تعترض سبيله، ويقدر على معالجتها قبل الوقوع
فيها، ويطمئن قلبه، ولا يأخذه اليأس، ولكي يتمتع بصحبة رفاق صادقين
جادين.وهذا هو الطريق الجدير بالطلب من الله عز وجل.
Page 27
التفسير الكبير
١٦
سورة الفاتحة
غير المغضوب عليهم..عندما بتقدم الإنسان في التقرب قد تنهار به
ميول الكبرياء والإعجاب.فلا يجدر بالإنسان أن
يستبيح الظلم والاضطهاد
نتيجة التقدم الذي أحرزه بفضل الله وعونه، بل عليه أن يتوسل به إلى خدمة
الإنسانية والسلام العام، وينبغي أن يستعين بالدعاء للحصول على هذا
الغرض.ولا الضالين..وكما قد يطغى الإنسان بسبب التقدم كذلك يفرط
أحيانا في حب شيء حقير وضيع، فيرفعه إلى ما لا ينبغي بسبب الغلو
والإطراء، وهذا الأمر أيضا يجب تجنبه مع الاستعانة بالله عز وجل.شرح الكلمات:
بسم الله الرحمن الرحيم (1)
ب: الباء في "بسم الله حرف جار ، ورد بمعنى المصاحبة والاستعانة، أي
الله
أقرأ متمسكا باسم ومستعينا به.اسم معنى الاسم: الصفة أو العَلَم، وهو إما من الوسم أي العلامة أو
من السمو أي الرفعة وقد قال بعض العلماء إن هناك محذوفا متعلقا بالباء في
الله الرحمن الرحيم، ودليلهم قوله تعالى في
هو: اقْرَأْ واشْرَع بسم
سورة العلق: (اقرأ باسم ربك الذي خلق).بسم
الله
أما الزمخشري فيرى أن المحذوف هو : أقْرَأُ أو أَشْرَعُ، والمعنى هكذا:
بسم
الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أَشْرَعُ.ودليل الزمخشري أن التأكيد هنا هو على
Page 28
التفسير
كبير
اسم
۱۷
سورة الفاتحة
الله، لذلك يقدم، وأما في سورة العلق فكان التأكيد على القراءة، لأن
الرسول كان مترددا في القراءة، لذلك قدم لفظ "اقرأ" هنالك.ورأي الزمخشري لطيف للغاية ومؤيد لما ذكرتُ من أسباب تكرار
البسملة قبل كل سورة في القرآن الكريم.الله: اسم للذات الأزلي الأبدي الحي القيوم الخالق المالك الرب لكل
شيء.هذا الاسم ذاتي، وليس وصفيا.ولا يوجد اسم ذاتي لله عز وجل في
أي لغة سوى العربية.وهذا الاسم لا يدل إلا على ذات الله تعالى.وهو اسم
جامد وليس بمشتق.الرحمن: فَعْلان من رحم وهذا الوزن يدل على الامتلاء والغلبة.(تفسير
البحر المحيط).فمعنى الرحمن الواسع الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء.ولا بد أن تكون هذه الرحمة عن غير استحقاق أو عمل، لأن كل إنسان لا
يستحق أن يطلب الرحمة كحق له.قال الإمام اللغوي أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع
الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، وقال تعالى:
(وكان بالمؤمنين رحيما) (تفسير فتح البيان).وفي الحديث: عن ابن مسعود
وأبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ : "الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم
الآخرة." (تفسير البحر المحيط).الرحيم: فعيل من رحم، ويدل على التكرار والجزاء على قدر الاستحقاق
(تفسير البحر المحيط فمعناه أنه يجزي المستحق بالرحمة جزاء حسنا وافيا،
ويواصل هذا الفعل.
Page 29
التفسير الكبير
التفسير :
١٨
سورة الفاتحة
تبدأ سور القرآن كلها بالبسملة، ما عدا سورة "براءة".والأصح أن
البراءة ليست سورة مستقلة، بل هي جزء من سورة الأنفال، ولأجل ذلك
ما بدأت بالبسملة.ودليل ذلك ما رُوي عن ابن عباس قال: كان النبي
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم".(أبو
داود، كتاب الصلاة).وذكره الحاكم في مستدركه.ويشير الحديث إلى أن
البسملة تدل على انفصال سورة وابتداء أخرى، ومن ثم فالبراءة جزء
للأنفال.كما يدل هذا الحديث على أن البسملة من وحي الله تعالى ومن القرآن
الكريم بلا مراء.وقد زعمت طائفة من العلماء أنها ليست جزءا لأي سورة
من سور القرآن الكريم سوى الفاتحة، وبعضهم لم يستثن الفاتحة أيضا.وهذا
الرأي غير صحيح..أولا: بشهادة الحديث السالف ذكره، وثانيا: لأن هناك
عدة أحاديث أخرى تذكر بأن رسول الله ﷺ قال بأنها جزء لكل سورة،
منها مثلا: روى الدار قطني عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : "إذا
قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم.إنها أم القرآن وأم الكتاب
والسبع المثاني، وبسم الرحمن الرحيم إحدى أيها".هذا الحديث أيضا يشير إلى أن البسملة جزء لسائر السور، لأن الرسول
لم يخص الفاتحة بالبسملة، بل استدل بكونها أم القرآن وأم الكتاب
والسبع المثاني على أن البسملة كما هي جزء لسائر السور كذلك هي جزء
لهذه السورة، بل هي أحق بها لكونها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني.الله
Page 30
التفسير
بير
۱۹
سورة الفاتحة
كما روي عن أنس قال قال رسول الله : "أنزلت على سورة آنفا،
الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر." (صحيح مسلم، كتاب
فقرأ:
بسم
الصلاة، باب من قال البسملة آية من أول كل سورة).وأمثال هذه الرواية
قد وردت عن سور أخرى.فضيلة البسملة
أكد
فيه بسم
رسول الله فضيلة البسملة حيث قال: "كل أمر ذي بال لا يُبدأ
الله الرحمن الرحيم أقطَعُ".(الدار المنثور للسيوطي).وقال: "أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل، فإن الشيطان لا يفتح بابا
مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه
واذكر اسم
الله، وأَوْكِ سقاءك واذكر اسم الله عز وجل".وجل".(مسند أحمد
بن
حنبل ج ۳، باقي مسند المكثرين).وكذلك أمرنا بالبسملة عند
بالبسملة عند اجتماع الزوجين، وقبل الوضوء والطعام
واللباس، وقبل دخول المرحاض.وذُكر في القرآن أن سليمان بدأ كتابه إلى
ملكة سبأ بالبسملة حيث قال: إنه من سليمان وإنه بسم
الرحيم) (سورة النمل: (۳۱).وأيضا ذكر القرآن أن نوحا سمى
دخول السفينة فقال: (اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها) (سورة هود
الله الرحمن
الله قبل.(٤٢
Page 31
سورة الفاتحة
التفسير الكبير
حكمة وضع البسملة أول كل سورة
كي
من
جاءت البسملة قبل كل سورة لأن القرآن الكريم كخزينة لا تنفتح إلا
بإذن الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)(سورة
الواقعة ، أي لا يمكن أن يطلع على أسرار القرآن إلامن اصطفاه الله لهذا
الغرض.وكذلك يقول الله تعالى: (يُضل به كثيرا ويهدي به كثيرا)(سورة
البقرة (۲) ومعنى ذلك أن اللفظ ،واحد لكن كل إنسان يستفيد منه
بحسب تقواه.ولكن ما هي الوسيلة إلى هذه الاستفادة الصحيحة؟ يعلمنا الله
الوسيلة في قوله: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله..)(سورة النحل: ٩٩).وقد أَمَرَنا بالبدء بالتعوذ بالله ثم بالبسملة قبل كل سورة نصان
نزوات الشيطان ونتعوذ بالله ثم نستعين به متضرعين بالرحمانية والرحيمية،
وذلك هو الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة القرآن والاهتداء به.والأمر الثاني الذي لأجله جاءت البسملة أول كل سورة هو نبأ التوراة
بأن النبي الذي سوف يُبعث مثيلا لموسى ستكون سنته المتبعة في تعاليمه أنه
يبدأ كل ما يكلم به الناس باسم الله تعالى كما جاء في العهد القديم:
"ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي
أطالبه".(سفر التثنية.۱۸ (۱۹ فطبقًا لهذا النبأ العظيم كان لابد لمثيل
موسى عليهما السلام أن الله قبل أن يدعو الناس إلى رسالته، ويقول
لهم إن كل ما أقوله لكم هو باسم الله ومن لدنه ، وليس من عند نفسي.لقد
اقتضى تحقيق هذا النبأ أن توضع البسملة قبل كل سورة في القرآن المجيد،
يسمي
أنا
Page 32
التفسير
ـبير
۲۱
سورة الفاتحة
وأيضًا كي ينتبه اليهود والنصارى ويستجيبوا له..لئلا يستحقوا العذاب إذا
رفضوا ما يقوله هذا النبي..حسب ما أوحي به إلى موسى.الأمر الثالث الذي دعا إلى تقديم البسملة هو شهادة التوراة: "وأما النبي
الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أُوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم
آلهة أخرى..فيموت ذلك النبي".(تثنية ٢٠: ١٨).تصرح هذه الشهادة بأن الذي يفتري على الله الكذب مصيره الهلاك.ولذلك وإتماما للحجة على جميع الأمم، وخاصة على اليهود والنصارى..تبدأ كل سورة باسم الله.وهكذا يتجلى صدق النبي ﷺ لكل محقق يبصر
نجاحه وازدهاره، إذ لو لم يكن رسولا صادقا فلماذا لم يهلكه الله؟ فكأن
البسملة في أول كل سورة حجة دامغة على اليهود خاصة..أقامها الله
أكثر من مائة مرة، ولو كانت في أول القرآن فقط لما كان هذا الدليل
عليهم
بهذه الدرجة من القوة.الأمر الرابع الذي يقتضي تقديم البسملة في كل سورة هو أن قارئ
القرآن لا يخلو عن أحوال ثلاث: إما أن يكون مفلسا، أو مغضوبا عليه
بسبب معصيته وتماديه في الكفر، ولم تبق لديه أية وسيلة يستحق بها فضل
عز وجل، أو مؤمنا مضحيا في سبيل الله.ومن البين أن الحالة القلبية لكل
واحد من هؤلاء الثلاثة تختلف عن الآخر، فيمكن أن يكون الأول متحيرا،
والثاني يائسا، والثالث مستكبرا الأول متحير في إيجاد الوسيلة التي يتوسل
بها إلى الله، والثاني يائس بسبب استغراقه في المعاصي وامتناعه عن طلب
الله
Page 33
التفسير
ـبير
۲۲
سورة الفاتحة
الهداية، والثالث مستكبر لأجل توهمه بأنه حصل على كل ما لا بد منه.ونتيجة لهذه الأحوال الثلاث يُحرم الإنسان من الانتفاع بهدي الله.فوضعُ البسملة في أول كل سورة دواء لهذه الأمراض الثلاثة..فالأول
المتحير تخبره البسملة بأن هناك إلها يُنعم على الإنسان حتى بلا استحقاق،
والثاني اليائس تبشره البسملة بأن الذي أنزل هذه السورة قادر على أن يغفر
الذنوب، والثالث المستكبر تنبهه البسملة أن خزائن رحمة الله لا تنفد،
وتدعوه أن لا يكتفي بما قدمت يداه من تضحيات، بل يبذل الجهد الذي
يستحق به ما هو أعلى من هذه الدرجة وأسمى والظاهر أن الإنسان إذا
صلح قلبه بهذه الدرجة انكشفت له المعارف القرآنية التي لا عهد له بها قبل
هذا الإصلاح.فإيراد البسملة قبل كل سورة قد هيأ الله تعالى وسيلةً رائعة
لفهم معارف القرآن الكريم.والسبب الخامس لتقديم البسملة هو أنها تعمل عمل المفتاح لكل سورة،
جميع مسائل الدين تتعلق بصفتي الرحمن الرحيم.فقارئ أية سورة إذا
الخطأ
أخطأ في فهم شيء منها أمكن تصحيح بوجهين: إذا فكر الإنسان في
معاني السورة ووجد رأيه موافقا للرحمانية والرحيمية فرأيه صحيح، وإن
وجده مخالفا لهما فليعلم أن رأيه هو الخاطئ.وعلى هذا المنهج يكون كلٌّ
من البسملة والسورة تفسر إحداهما الأخرى.فاجتماعهما في موضع ما
لأن
يساعد الإنسان على فهم القرآن فهما صحيحا.
Page 34
التفسير الكبير
۲۳
سورة الفاتحة
ذكر البسملة في الكتب السابقة
قال بعض الطاعنين في الإسلام إن البسملة التي تفاخرون بها توجد أيضا
في الكتب القديمة مثل ما جاء في كتب زردشت: بنام یزدان بخشائش
كروداوار).وتُرجمت هذه العبارة باللغة الفارسة الحديثة كالآتي: "بنام
خداوند بخشائنده بخشائش کر".(تفسير المستشرق ويرى).كما قالوا إن استعمال (بسم الله كان عادة في كتب اليهود، وتعلّم
العرب ذلك منهم، وأول من أجرى هذا الاستعمال من العرب أمير من
الطائف.(ترجمة القرآن لـ رُدول).وهذا الادعاء الأخير لا يوجد له أصل في التاريخ، بل كان العرب لا
يحبون استعمال لفظ الرحمن بهذه الصورة.فلا بد لهم من تقديم شاهد
تاريخي على هذا الاستعمال، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا.وأما ما قيل عن عادة اليهود بهذا الاستعمال، فإن أُريد به أن البسملة
كانت متداولة بينهم في زمن متصل بعهد النبي أو في نفس العهد
النبوي، أو أن تاريخهم يشهد به..فهذا كله قول يعاكس الحقيقة بتاتا.وإن
ید به ما ورد في القرآن على لسان سليمان عليه السلام فهذا اعتداء عظيم
على القرآن من قبل هؤلاء المعترضين، إذ يطعنون فيه بما لا نجد له أي أساس
سوى القرآن ويحاولون نسبته إلى الآخرين فما دام القرآن ذكر بنفسه أن
سلیمان اختار هذا الأسلوب عندما كتب إلى ملكة سبأ: (إنه من سليمان
الله الرحمن الرحيم)..فكيف يصح إذا القول بأن المسلمين ينفون
وإنه بسم
وجود أي نظير لهذا المفهوم في كتب الأولين؟ إن الإسلام لا يقول بأن
Page 35
التفسير
كبير
٢٤
سورة الفاتحة
مفهوم هذه الآية جديد، إذ كانت أجزاء منها مستعملة قبل القرآن أيضا،
إنما يتحدى الإسلام بأن الأسلوب الذي اختاره في استعمال هذه الكلمات
لم يسبق له مثيل.ولأن جاء أحد بشاهد على زعمه فعندئذ يمكن أن يؤخذ
الله
في الاعتبار.لكن إيجاد هذا الشاهد أمر مستحيل، لأنه لا يوجد في الدنيا أي
كتاب يدعي بأن كل كلمة من كلماته وحي عز وجل.فليس سوى
القرآن كتاب يمكن أن تدوّن هذه الآية قبل كل فصل منه، لأنها جاءت في
الله
القرآن بوحي عز وجل.الله
التبرك والتفاؤل في المكاتيب وغيرها فأمر
وأما ذكر اسم على وجع
عادي لا ينكره أهل الإسلام، فإن شاركهم غيرهم في هذا فلا غرابة في هذه
المشاركة ولو تكررت ألف مرة.وأما ما قاله القسيس "ويري" فجوابه الأول ما ذكرناه آنفا، والجواب
الثاني أن بين المعنيين الفارسي والعربي بونا شاسعا، ولا يمكن أن يقارنهما إلا
الذي يجهل اللغة العربية جهلا شديد.إذ لا يُفهم من عبارة "بخشاش
گردادار عُشْرَ مِعشار ما يُفهم من الرحمن الرحيم)، كما سيظهر من
تفسيرها مفصلا.ذلك مع اعترافنا بما في تركيب العبارة الفارسية من مزية
معنوية، والإسلام يعلن: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)(سورة فاطر: ٢٥).وإذا فنحن لا نستنكر وجود أية كلمة جامعة في كتب زرادشت، وإنما
يستنكره القسيس نفسه لأن عقيدته المسيحية هي التي تحجر على جميع
الإنسانية فضل الله، ولا تقبل أي أثر من آثار النبوة والوحي خارج بني
إسرائيل.إن زرادشت نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا من وجهة نظر
Page 36
التفسير
بير
۲۵
سورة الفاتحة
الإسلام، ولأجل ذلك فهو عندنا حقيق بالاحترام، لأن منبع كلامه هو نفس
منبع ،القرآن فإن وافقنا على أمر فلا مجال للاستغراب.سبب زيادة الاسم في (بسم الله)
رُبَّ متسائل يقول : يمكن أن نستعين بالله ولكن لا نستعين باسم الله،
فلماذا زيادة كلمة اسم؟
وجوابنا له:
أولا: الباء يُستعمل للقسم كما يستعمل للاستعانة، فلو قيل: (بالله)
لاشتبه بالقسم مع أنه للاستعانة والتبرك، ولذلك أضيف لفظ الاسم منعا
للاشتباه.ثانيا: إن الذات الإلهية في خفاء تام ولا تُعرف إلا بالصفات، لذلك زيد
الاسم، وتلاه الرحمن والرحيم لنفس الغرض، والمعنى أني أستعين به عز وجل
متوسلا بهاتين الصفتين.ثالثا: أريد بوضع الاسم الإشارة إلى أن أسماء الله تعالى مباركة، وعلى
الإنسان أن يهتم بها لينال بركاتها.رابعا: القرآن خزينة محروسة.حينما يدخل الإنسان بيتا له حرمته فلا بد
أن يستأذن صاحبه أو يتقدم لحارسه أو لمن يسكنه حتى يسمح له بالدخول.فالشرطة حينما تدخل البيوت أو تصادر الأموال تقول: نحن نفعل ذلك
باسم الحكومة.كذلك إذا أقدم الإنسان على قراءة القرآن تقدم باسم
الله
للملائكة المأمورين بتعليم معارف القرآن وكأنه يقول: إن الله تعالى قد سمح
Page 37
التفسير
كبير
٢٦
ة الفاتحة
سورة
رفة
لي بقراءة القرآن فافتحوا لي أبواب معانيه، ويختصر طلبه قائلا: إني أسألكم
الله الرحمن الرحيم فتح الخزائن القرآنية.ومن الجلي أن من يهتم بمعرف
القرآن بهذه الصورة سوف ينال من علومه نصيبا وافرا، ومن لا يعتني بإذن
باسم
الله
وباسمه، ويقصد الشر ويكتم البغض..تُسَدّ في وجهه الأبواب.خامسا وسادسا: إن في هذا الاستعمال لإشارة إلى نَبَأَي العهد القديم
6
المذكورين في الإصحاح ۱۸ ، والفقرتين ۱۸ و ٢٠ من سفر التثنية، وقد
ذكرتهما في بحث التسمية قبل كل سورة بأن الرسول المعهود بهذين النبأين
ف يلقي على الناس كلام الله تعالى باسمه فللفت النظر إلى هذين النبأين
سو
كان لا بد من زيادة الاسم
شرح الكلمات:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳)
الثناء
الحمد: هو الثناء والمدح والشكر جميعا، ولكنه أشمل معنى من
والمدح والشكر، فهو يعني الاعتراف بالإحسان والشعور بالفضل، وتكرار
المدح وإذاعته الدلالة على الرابطة بين العبد وربه.كما
يعني المدح
الصادق؛ ويعني المدح على العمل الاختياري دون مقابل.فالحمد أجدر بالله
وأنسب، لأنه يدل على كل أنواع الثناء.مع
رب: هو المنشئ للشيء حالا بعد حال حتى تمامه، وهو المربي، والمالك
والسيد والمطاع، والمصلح (الأقرب).وقيل: الخالق (البحر المحيط).ولا يُطلق
الرب مجردا عن الإضافة إلا على الله تعالى (المفردات).
Page 38
التفسير الكبير
۲۷
سورة الفاتحة
العالمين: جمع عالم وهو كل نوع من أنواع المخلوقات عاقلة وغير عاقلة.وقد يستعمل للأخص كقوله تعالى : (..وأني فضلتكم على العالمين)(البقرة:
٤٨)، أي أهل ذلك الزمن.ولكن الكلمة تعم جميع أنواع الكائنات.وقيل:
العالم يُطلق على المخلوق لأنه يساعدك على معرفة الله (الأقرب).التفسير :
الله تعالى،
الحمد لله ما قال هنا أحمد أو نحمد بل قال الحمد لله، بهذا التركيب
أبدع معاني عديدة منها:
أولا : استعمال المصدر أفاد الشمول أي جميع أنواع الحمد التي تصدر عن
الإنسان أو يمكن أن تصدر عنه.فما من حمد إلا هو موجود في
وما من ذم إلا هو منزه عنه.ثانيا: أن الله تعالى هو الذي يستطيع أن يحمد مخلوقه حمدا صحيحا لأنه
عالم الغيب الإنسان يحمد ،الإنسان ولكنه قد يخطئ، أو يقصر، أو يغالي
فيه، ويمدح بما ليس في الممدوح.فالحمد الحقيقي هو الذي يحمده الله،
والإنسان لا يستطيع أن يتجنب الخطأ في الرأي حتى عن نفسه فضلا عما
يرى في غيره، لكن الرأي الذي يبديه عالم الغيب عن عبده لا يكون فيه
تقصير ولا مغالاة.أما استخدام الفعل (أحمد أو نحمد) فلا يؤدي إلى إبداع
هذه المعاني الرائعة.وثالثا: قد يحسب الإنسان أن باستطاعته الإحاطة بكنه صفات الله كلها،
وهذا خطأ، لأن حمد الإنسان الله محدود، فهو يحمده على قدر ما أُعطي م
من
Page 39
التفسير
كبير
۲۸
سورة الفاتحة
علم فقط، وليس بمقدوره معرفة الدواعي اللانهائية للحمد التي توجد في ذات
الله.وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى فهم الحمد
الكامل لله عز وجل.واستعمال لفظ الجلالة (الله) أزال الالتباس من أن الإنسان أيضا يملك
الثناء.فإن قيل: كيف أن الحمد كله لله فقط؟ فالجواب أن اللام في قوله
(الحمد لله) تفيد أن الملكية الحقيقية للحمد الله وحده، والإنسان إنما
هي
يستمد الحمد مما أنعم الله عليه من المحاسن.وهذه المواهب ليست لشخصيته،
بل هي ثمرة رحمة الله الواسعة، فعندما يُمدَح الإنسان فإنما هو حمد لله تعالى
حقيقة.معاني الآية ومطالبها
ومن معاني هذه الآية ما يلي:
الله تعالى خالق هذا الكون، منزه عن جميع
المعائب، وجامع
لكافة
الفضائل..۲
هو عليم بحقائق الكون، وليس أحد سواه يدرك هذه الحقائق على
وجهها الصحيح.والدليل القاطع على ذلك ما نرى للعلوم الطبيعية من
ازدهار ،وتقدم، ولكن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من إدراك كامل لأدنى
كائن من خلقه ، وما تزال الاكتشافات مستمرة والبحث جاريا في كل
جزء من الكون.
Page 40
التفسير
بير
۲۹
سورة الفاتحة
والله تعالى يحوز الحمد كله لكونه رب العالمين، فلا بد إذن أن يعمّ
نظامه الروحاني العالم كله ، كما هيأ الأسباب المادية للعالم كله، ويجب أن لا
تُحرم أمة من الأمم من وسائل الارتقاء الروحي.ولو كان الله قد أنزل لقوم
وحيا خاصا للزم أن ينزل الوحي أيضا مختصا بالأقوام الأخرى.ولكن إن
لم يكن ثمة وحي خاص فينبغي أن ينزل الوحي الشامل لإرشاد الأمم
كلها.فالأديان التي تقول بتخصيص الروح، أو تدعي أن النجاة منوطة
بأهلها فحسب..أديان غير عادلة في اعتقادها هذا..{
مواهب الإنسان كلها من فضل الله عز وجل.ومهما اكتسب
الإنسان من فضائل فالفضل كله يرجع إلى الله تعالى.ه.اتصال الحمد بالربوبية يدل على أن الإنسان لا يستحق السرور
الحقيقي إلا إذا كان مظهرا للربوبية.فالذي يفرح بمنفعته الشخصية ولا
يلتفت إلى خسران الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، لأن الراحة الحقيقية هي
أن ترتاح الدنيا كلها.٦.وبذكر الربوبية للعالمين أشار الله عز وجل إلى أن كل ما عداه ترقى
ويتغير خاضعا لقانون التطور، وصرح أنه ليس هناك شيء استوت بدايته
ونهايته، بل شيء سواه معرض للتغير والارتقاء من حالة إلى أخرى.وهذا
المبدأ يؤدي إلى تأكيد أمرين أولهما أن ما سوى الله مخلوق، لأن الذي يجري
عليه التغير والتطور من المستحيل أن يكون وجوده بنفسه، وثانيهما أن مبدأ
التطور والارتقاء متحقق، وكل من الإنسان والحيوان والجماد ينقلب من
Page 41
التفسير
بير
سورة الفاتحة
حالة إلى حالة أرقى لأن معنى الرب أنه لا يربي الأشياء بالتدريج حتى
يوصلها إلى الكمال فالارتقاء جار في جميع أنواع الكائنات...ويتضح
أن الارتقاء يتم بمراحل مختلفة وأزمان عديدة، لأن الربوبية
معناها إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام، وليس المعنى أن
تتم
الحلقة الواحدة فقط سلسلته الممتدة.من
ثبت أيضا أن الارتقاء لا ينافي وجود
الله
عز وجل، لأنه يقول:
(الحمد لله رب العالمين)، فهو يستحق الحمد بهذا النوع من التربية، ولذلك
قرن (رب العالمين) مع (الحمد الله).(الحمد لله
لأنها
٩ هذه الآية تدل أيضا على أن الإنسان مخلوق لأجل تقدم لانهائي،
تقول: الحمد لله الذي يربي الإنسان من درجة إلى أخرى أرقى منها، ولا
تتأكد صحة هذا القول ما لم نسلم بوجود درجة فوق كل درجة.١٠.وافتتاح سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن بقوله تعالى:
رب العالمين) يشير كذلك أنه حان أن يُحمد الله
عز وجل حمدا
كاملا، لأن الإسلام الذي هو أتم مظهر لصفة الربوبية العالمية قد ظهر
لإرشاد الناس أجمعين، واتحد بظهوره العالم الروحي مثل اتحاد العالم المادي.عندما كانت الرسل قبل الإسلام تأتي إلى أمة دون أمة، كان بعض
الجهلاء يكذبون سائر الديانات الأخرى التي جاء بها الأنبياء.كان الهندوس
يقولون : إنهم لا يعرفون "يهوه" إله اليهود، بل إن الإله الحق هو إلههم
بر میشور"، وكان اليهود يستهزئون بإله الهندوس "برميشور".ولكن بظهور
الإسلام توحد العالم في الدين، وأخذ الهنود والصينيون والمصريون والفرس
"
Page 42
التفسير
بير
۳۱
سورة الفاتحة
والشعوب جميعا في حمد الله تعالى، وتحقق أنه ليس لكل قوم إله خاص، بل
إن الجميع إله واحد.التفسير:.الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ (۳)
(رب
مع
أنهما قد
ولقد تساءل البعض عن سبب تكرار هاتين الصفتين هنا
ذكرتا في البسملة.والجواب أن البسملة تحمل معنى مستقلا، وهي مفتاح
لكل سورة أيضا، وإذا وردت ضمن موضوع السورة فلا بأس بها وليس هذا
من التكرار في شيء.وقد أعيدت هاتان الصفتان لنفس الحكمة، فذُكر
رب العالمين أن الله عز وجل يربي شيئا فشيئا إلى درجة الكمال، وصرح
هنا أن ربوبيته تظهر دوما بالرحمانية والرحيمية فهو أولا رحمن..أي خلق
لكل شيء وسائل تساعده على الارتقاء، وبالأسباب اللطيفة جدا وضع في
الإنسان وغيره من أنواع الحيوان والنبات والجماد قوى خفية، وهذه الأشياء
كلها تتأثر مما حولها وتستمد لبقائها واكتمالها من العوامل المختلفة.وثانيا
هو رحيم..أي إذا قام أحد من خلقه بواجبه حق القيام قدر الله له هذا
العمل حق ،قدره وتفضل على صاحبه ،برحمته وزوده بميل عظيم إلى
الارتقاء، وهكذا يستمر هذا التسلسل إلى ما لا نهاية له ولا ينقطع أبدا.والرحمن صفة لا تُطلق على غير الله عز وجل إلا بالإضافة، كما فعل
مسيلمة الكذاب إذا سمى نفسه "رحمن اليمامة".
Page 43
التفسير
بير
۳۲
سورة الفاتحة
ومعنى الرحمن من يرحم بلا عوض ويعطي بلا عمل.وهذا المفهوم يبطل
عقيدة الكفارة التي يزعمها النصارى، لأنها تقوم على فكرة أن الله تعالى لا
يرحم بلا عوض.وقد بلغت بهم شدة الشعور بهذا الاعتقاد أن نصارى
العرب عندما يكتبون في كتاباتهم (بسم الله) يذكرون معه الصفات الأخرى،
ولا يذكرون لتعصبهم صفة الرحمن ويكتبون مثلا: بسم الله الرحيم الكريم،
لأن قلوبهم تشهد بأن الله عز وجل إذا كان الرحمن أيضا..فلا يصعب عليه
أن يغفر للناس ذنوبهم بلا كفارة المسيح.ومن جانب آخر تلغي صفة الرحيم عقيدة تناسخ الأرواح الهندوسية
المبنية على فكرة أن أعمال الإنسان في هذه الحياة محدودة، ومن ثم لا يمكن
أن يترتب عليها خلاص أبدي.وصفة الرحيم الدالة على تكرار مظاهر صفة
الرحمة، تبين أن الله تعالى عندما يجازي الإنسان على أعماله بسخاء.يخلق
فيه الرغبة لتكرار أعماله الطيبة، ونتيجة لهذا التكرار، أو على الأقل لإظهار
الرغبة فيه يتكرر له الجزاء من الله..وهكذا بلا نهاية.وهذا الفهم الخاطئ لدى القائلين بالتناسخ راجع إلى اعتقادهم بأن الجنة
مكان للجمود وعدم العمل.فالخلاص عندهم يعني ما
بالهندية
يسمى
"النرفانا" أي توقف كل الرغبات والأعمال وترفض صفة (رب العالمين)
هذا المفهوم تماما، لأن الحياة الآخرة أيضا من خلق الله وعالم من العالمين، لا
تنفك صفة الربوبية تعمل فيه، ويمضى الإنسان في ارتقاء روحي لا يتوقف
بعد الموت، بل يستمر في عمل الصالحات، ويجزيه عليها الله الرحيم.والفرق
بين العمل في الدنيا والعمل في الآخرة أن الأول قابل للارتقاء ومعرض أيضا
Page 44
التفسير
كبير
۳۳
سورة الفاتحة
للهبوط، والثاني يهدف دائما إلى السمو والارتقاء بلا انحطاط أبدا.فالرقي
الروحي هو غاية الأعمال في الآخرة ولا نهاية له ولذلك ليس لنا أن نفكر
في تحديد العمل في الدنيا وتقييد جزائه في الآخرة.مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)
شرح الكلمات:
يوم: الوقت مطلقا كقوله تعالى: (وإن يوماعند ربك كألف سنة مما
تعدون) (سورة الحج: (٤٨).تقول العرب: يوماه يومُ نُعم ويومُ بُؤس.واليوم: الوقت الحاضر، تقول العرب: أفعل اليوم كذا..ولا يريدون يوما
بعينه ولكنهم يريدون الوقت الحاضر، الدهر (اللسان).الدين الجزاء؛ المكافأة؛ القضاء الملك السلطان؛ الحكم؛ التدبير؛ القهر؛
الغلبة؛ الورع؛ المعصية؛ السيرة؛ العادة؛ الشأن؛ اسم لجميع ما يُتعبد به الله..أي الشريعة؛ الملة ؛ الطاعة؛ الحساب؛ الحال؛ العادة (الأقرب).التفسير :
أولا: اعتمد المفسرون على كون الدين جزاء فقط، وأن الجزاء يختص
بيوم القيامة.ومن هذه الوجهة تدل الآية على أن الله مالك يوم الجزاء،
وليس لأحد أن يتدخل في ملكه.وبذلك ميز بين عاقبة الأعمال في الدنيا
وبين جزائها في الآخرة.يستطيع الإنسان أن يجزئ غيره خيرا وشرا، غير أن
حكم الإنسان قد يحمل الخطأ، ولكن الله تعالى سيتولى بنفسه الجزاء
Page 45
التفسير
كبير
٣٤
سورة الفاتحة
والعقاب يوم القيامة، ومن المستحيل أن يعذب أحدا لما لم يفعل، ويرهقه
ظلما بغير حق، كما من المحال لمحرم أن ينجو من العقاب بالكذب أو
الخداع.وتلفت هذه الآية نظرنا إلى أن الله لا يحكم يوم القيامة كملك فقط، بل
يصدر حكمه كمالك.فحكم الملك يكون خاضعا لنواميس الحكومة
وتقاليدها، ولا يمكن أن يتجاوز بحكمه العدل الرسمي في القضايا، لأنه
يقضي في الحقوق ولا يستطيع أن يتصرف فيها.ولكن الله تعالى (مالك)،
وليس ملكا فقط، ولذلك يمكن أن يعفو عن حقه على الناس كما يريد.وكما
و كما يتيح لنا هذا التصريح القيم اغتنام الرجاء واجتناب اليأس، فكذلك
ينبهنا إلى عدم التفكير في استغلال رحمة الله، لأن المالك كما وسعت رحمته
كل شيء، كذلك فإنه لا يرضى أن يرى خلقه متمرغا في حمأة الإثم.فالله
تعالى بمالكيته شجع الإنسان على التقدم والنشاط، وجعل مسلكه بين
الخوف والرجاء.والنصرانية، على عكس ذلك، تدفع الإنسان إلى أعماق
اليأس باصطناعها مقياسا خاطئا للعدل، كما تحرض على الإثم بالكفارة
المطلقة.فبهذين المبدأين الهدّامين لم تساعد النصرانية الإنسان على مجابهة
الإثم، بل شجعته على ارتكابه فزيادة اليأس بسبب العدل المزعوم أدّته إلى
زيادة المعصية، وإطلاق الرجاء في الكفارة دفعه أيضا إلى الانطلاق في الإثم.ثانيا: ثم إن الآية تدل على أن الله تعالى مالك زمن الشريعة والدين.وهذا
المعنى يرشدنا إلى بحث لطيف في نواميس القدرة.إن الله عز وجل ينفذ
حكمه في الدنيا بالعموم طبقا لسنته العادية، لكنه عندما يقيم دينا أو ينـــزل
Page 46
التفسير
كبير
٣٥
سورة الفاتحة
شريعة فإنه يظهر بمظهر المالكية، ولا يكتفي بمظهر الملوكية التي تتعلق بسنته
العامة، وإنما يتحلى بمظهر المالكية التي تدل على سنته الخاصة بعباده
الصالحين.والذين لا يعرفون حقيقة صفات الله عز وجل يجدون هذا
التصرف خرقًا لسنته..إذ يقوم بأمر الله إنسان يبدو ضعيفا مخذولا ويتحدّى
الدنيا بنبوته، ويقوم الناس ضده، ولكنه مع كونه ضعيفا عديم الوسائل
ينجح، وكذلك يتحقق ما يطلب من الله بالدعاء، وتتم على يده أنواع
المعجزات التي يتحدى بها الناس والسر في ذلك أن الله تعالى عندما يريد أن
ينفذ حكمه السماوي في الأرض يظهر بمظهر المالكية بدلا من الملوكية، كأنه
الله
يغير سنته العادية ويقرر قوانينه الخاصة لعباده المقربين، ويُحدث الخوارق
لإظهار صدقهم.وهذه سنة
هي التي مضت في الأنبياء أجمعين.وهذه الآية تخبر أيضا بأن صفة المالكية سوف تتجلى في زمن رسول الله
وفي هذا دليل على أن عهده عهد شريعة، وأن الله سوف ينصره
بالآيات المعجزات، وأنه لصادق مصدوق من الله العلي العزيز.ثالثا: ومن معاني هذه الآية أن الله تعالى مالك زمن الخير والشر، والمراد
أن الدنيا تواجه طورين طورا ينتشر فيه الخير والشر على السواء، وحينئذ
ينفذ الله سنته العادية في الأرض، وطورا يسود فيه الشر العالم كله، وعندئذ
ينزل الله تعالى حكمه الخاص في الأرض، ويغير مجرى الأمور فيها، ويهتم
بإصلاح جنته التي خلقها بغرس الإنسان ويبعث نبيا، ويؤسس على يديه
جماعة صالحة قائمة على الخير ، نابذة الشر، ويجعلها مثلا أعلى يُحتذى به،
وقدوة حسنة يُقتدى بها.ولا ينفك ينصر هذه الجماعة بسنته الخاصة،
Page 47
كبير
٣٦
سورة الفاتحة
التفسير
وتطول بها هذه النصرة.فإذا انقلبت على عقبيها ورجعت القهقرى إلى ما
الله
كانت عليه من الشر واستوت فيها حركتا الخير والشر فعندئذ يرفع
تعالى سنته الخاصة عنهم، ويعاملهم بسنته العامة الجارية في الناس، حتى تبلغ
سنته
هذه الجماعة أقصى مدى الشر، وعندئذ مرة أخرى يظهر الله لهم بحسب
المستمرة بمظهر المالكية، ويبعث نبيا يجتث الشر من الأرض، ويؤسس
جماعة طاهرة، ويستمر ظهور نصرته الخاصة بصورة المالكية حتى تزلّ هذه
من
الجماعة أيضًا عن مستوى الخير، ويجري معها مثل ما جرى في الأولين.رابعا: ومن معاني هذه الآية أنه مالك زمن الطاعة، بمعنى أن سنة الله
الخاصة التي يجريها سبحانه وتعالى للجماعات يجريها أيضا للشخصيات التي
تفنى في طاعته وتبذل حياتها في سبيل مرضاته.فلا يعاملهم
الله مثل غيرهم،
بل يسخر لهم القانون الإلهي الخاص.خامسا: ومن معاني هذه الآية أنه مالك زمن الأحوال الهامة الحاسمة في
تطورات الدنيا، والمراد أن كل عمل كحلقة حلقات السلسلة، وليس له
وجود منفرد، فمثلا عندما يمرض الإنسان فمرضه ليس بسبب خطأ طارئ
في ذلك اليوم فقط، وليست صحته بسبب رياضته أو غذائه في يوم معين..بل كل هذا نتيجة لحلقات من الأعمال المتكررة الكثيرة، فإن لأعمال
الإنسان نتيجتين: نتيجة بدائية ومؤقتة، ونتيجة نهائية دائمة، فمثلا هناك
رجل طائش يسيء استعمال عينه فيصيبها الرمد فتصح بالمداواة، ثم يتهاون
في أخذ الحيطة والحذر، فيعود الرمد إليها، وتصح بالعلاج مرة أخرى،
وهكذا يرمد ويبرأ إلى أن تزول بصارته ولا يجدي الدواء نفعا.والطالب
Page 48
۳۷
سورة الفاتحة
التفسير الكبير
الجاد يحفظ دروسه، ويُسر به أساتذته، ويتكرر له رضى الأستاذ، وهو نتيجة
فورية مؤقتة على عمله اليومي، لكن هناك نتيجة أخرى أوفى وأبقى من
الأولى، فهو لا يتقدم في دروسه اليومية فقط، بل يكتسب ملكة تزيده ذكاء
وخبرة في البحوث العلمية الدقيقة، وتجعله قبلة في العلوم.وهذه النتيجة
الأخيرة تكون من الخفاء بمكان إذ لا يشعر بها حتى أصدقاؤه وزملاؤه.وقد وجهنا الله تعالى بهذه الحقيقة إلى أن النجاح الأخير الدائم لا يتحقق
إلا بالتقرب إليه تعالى.لا شك أن الإنسان يعمل وينجح طبقا لسنة الله
المستمرة، ولكن النتيجة النهائية التي لا تتأتى إلا بعد اكتمال سلسلة من
أعمال متواصلة هي الجديرة بأن نقدرها ونهتم بها، وخاصة أن هذه النتيجة
سوف تبدو جليا عند الموت وتتأسس عليها الحياة الأخروية.وليس المراد من مالك) يوم (الدين أنه تعالى ليس مالكا للدنيا، كلا، وإنما
معناه أن المالكية المادية التي يحظى بها الناس في هذه الدنيا سوف تنقطع في
ذلك اليوم انقطاعا تاما كما يقول الله تعالى: (..ما أدراك ما يوم الدين يوم
لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ الله) (الانفطار : ۱۹ و ۲۰).هذه الصفات الإلهية الأربع المذكورة في مستهل الفاتحة وما جاءت عليه
من الترتيب..ترشدنا إلى نكتة طيبة من أدب السلوك وهي أن الله تعالى له
الدرجة العليا، والعبد له الدرجة السفلى بالنسبة إلى الله، ولأجل ذلك عندما
يلتفت الله تعالى إلى العبد فإنه يتنازل إليه درجة فدرجة، لكن إذا أراد العبد
أن يتقرب إلى الله تعالى فعليه أن يصعد إليه شيئا فشيئا حتى يتصل به.
Page 49
التفسير الكـ
كبير
٣٨
سورة الفاتحة
وبعدما أدركنا هذه الحقيقة ندرك أن الله تعالى يتنزل على عبده شيئا
فشيئا بهذا الصفات الأربع بحسب ترتيبها فأولا هو ينزل إليه بصفة رب
العالمين، ويهيئ
له محيطا يلائم النشوء والازدهار، ثم تأتى صفة الرحمن
فتسخر له أسبابا تمهد له طريق الرقي الروحي، ثم عندما يستفيد العبد من
هذه الأسباب ويحولها إلى نتائج عظيمة..تعمل صفة الرحيمية عملها وينال
العبد سلسلة من النعم، ثم يعطى الثمرة الأخيرة لكفاحه، أي الغلبة على
العالم، وهذه الغلبة مظهر للمالكية التي ذكرتُها في تفسير هذه الآية.والعبد،
على العكس، عندما يحاول أن يتصاعد ويتقرب إلى الله، فأولا لا بد أن
يكون مظهرا لصفة المالكية، بأن يقيم العدالة ويتجنب الظلم والاضطهاد،
ما
وأن تكون عدالته مرتبطة بالرحمة متصلة بالعفو غالبا.وهذه الدرجة هي
يسمى باجتناب الشر.ثم عندما يرتقي درجة يصبح مظهرا للرحيمية، فيقدر
أعمال الذين يتصلون ،به ويزيد لهم مما أنعم الله عليه من فضله ويغمرهم
بالخير، وهذا هو خُلق الإحسان.ثم يرتقي درجة ويصير مظهرا للرحمانية،
فضله وكرمه جميع الكون، ويشمل الأقارب والأباعد من الناس بلا
فيعم
تفريق أو أثرة، ويسع قلبه حبا للمؤمن والكافر على السواء.ولا يحفل بأن
يلقى الخير من الناس أم لم يلقه وهذه الدرجة هي ما يسمى بإيتاء ذي
القربى، وتشبه حالة الأم عندما تتفانى في خدمة طفلها، ولا تبالي بطاعته
إياها، ولا تعتمد على الخير المرجو منه..كذلك يكون العبد مظهرا
للرحمانية، كالأم لبني الإنسان كافة.ثم يتقدم خطوة ويصير مظهرا لصفة
رب العالمين، أي يتسع محيطه وينتقل مركزه من الفرد إلى المجتمع، ويشعر أنه
Page 50
التفسير
سورة الفاتحة
مسئول عن جميع العالم وراع له.فعندئذ يلتفت إلى إصلاح العالم بصورة
عامة، ويقلب المجتمع الفاسد رأسا على عقب.وهذه الطرق المتصاعدة المتنازلة في طيات هذه الصفات الأربع تعليمات
سامية لأهل السلوك، ورحمة منقطعة النظير للمتقين.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)
شرح الكلمات :
إياك : هذا أسلوب تخصيص معناه أخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة.نعبد عبد الله: أطاعه وخضع؛ وذل؛ وخدمه؛ والتزم شرائع دينه
ووحده (الأقرب).وعبد : قبل النقش، ومنه الطريق المعبد أي الموطأ لأنه
يقبل آثار الأقدام ولا تكون العبادة إلا لموجود كامل منفرد في صفاته بلا
شريك، وتكون طاعته ممكنة للإنسان.التفسير :
يبدو من قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين) وكأنه الا الله مستتر عن العبد ولذلك يحمده بصيغة الغائب، ولكنه
فجأة يناجيه بصيغة الحاضر ويقول : إياك نعبد وإياك نستعين).وقد زعم
بعض الجهلاء أن هذا الأسلوب يناقض الكلام البليغ؟ والحق أن هذا
الأسلوب قمة البلاغة، لأن وجود الله تعالى غيب الغيوب، ولا يستطيع العبد
أن ينظره بالعين المادية وإنما يعرفه بصفاته، ويتقرب إليه بذكره، حتى يشعر
Page 51
التفسير
كبير
سورة الفاتحة
به ويراه بقوته الروحية.ومن أسرار السلوك أن الإنسان عندما يفكر في هذه
الصفات ويتعمق فيها تتبين له الحقيقة ويندفع إلى الله اندفاعا لشدة الشوق،
وتتشرف روحه برؤية الله، ويغمره حب الله حتى تستغيث فطرته وتقول:
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.فتغيير الضمائر يدل على أن الإنسان إذا لم
يفكر في صفات الله يبقى غائبا عنه، لكنه عندما يطلب حقيقته في تلك
الصفات يتجلى الله له وكأنه يراه عيانا، وعندئذ يلتجي إلى مخاطبته.وعن أبى هريرة عن رسول الله أنه قال : قال الله تعالى: قسمتُ
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفُها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما
سأل.فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حَمَدَني عبدي.وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى : أثنى على عبدي.وإذا قال: مالك
يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة : فوَّض إلي عبدي، فإذا قال: إياك
نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.فإذا قال:
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل " (مسلم، كتاب الصلاة، باب
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة).ويُستنبط من هذا الحديث الشريف عدة أمور:
أولا: أن الحمد والثناء والتمجيد يختلف بعضها عن بعض في المعنى.ثانيا: أن الآية (مالك يوم الدين تدل على التوكل البالغ، وتشير إلى أن
العبد عندما يمجد الله كمالك يوم الدين، مع قوله (الحمد لله)..فكأنه
Page 52
التفسير
بير
٤١
سورة الفاتحة
يطمئن إلى ما يحكم به الله.وإذا تحلى العبد بهذا الإيمان والتوكل، أفلا يخصه
الله بالمغفرة والرحمة؟
ثالثا: أن النعم التي لأجلها كانت هذه الأدعية لا بد أن ينالها المسلمون في
وقت ما، لأن الحديث يبشر بأن لعبدي ما سأل أي أنه سوف يُعطى ما
طلب.وقد انتقد البعض تركيب الآية فقالوا: إن التوفيق للعبادة يكون من
الله
تعالى، فكان الأجدر تقديم الاستعانة على العبادة.والرد على ذلك بأن
العبادة بلا شك تتم بإعانة الله وتوفيقه ولكن تقديم العبادة هنا إشارة إلى أن
الإنسان الذي يفكر في عبادة الله هو الذي يستعين به، والذي لا يهتم
بعبادته كيف يطلب منه العون؟ فصدور فعل العبادة من الإنسان يكون
نتيجة تفكيره في العبادة بسبب إيمانه، فإذا شرع في عبادة الله طلب منه
المعونة، ولذلك قدمت العبادة على الاستعانة.ثم إن الإنسان عندما يقوم
بعمل فإنما يعمله بإرادته واختياره والنجاح والتوفيق لا يكون إلا باستعانة
عز وجل، ولو كانت إرادة العمل أيضًا بيد الله لكان الإنسان مجبرا في
أعماله.فمفهوم الآية أن العبد عندما يقدم على العبادة فإنه يدعو الله ويسأله
الله
النصرة والتوفيق كي لا يعبد أحدًا
سواه.والعبادة هي غاية التذلل والخضوع والمقصود منها اتصاف الإنسان
بصفات الله
عز وجل.والحركات الظاهرية في العبادة إنما تستهدف إحداث
تطورات للقلب، لأنه العبادة إنما هي عبارة عن كيفيات النفس وما يصدر
أعمال.وأما تعيين الوقت والتوجه إلى القبلة والوقوف والركوع
عنها من
Page 53
التفسير
ـبير
٤٢
سورة الفاتحة
والسجود فأعمال لا تتعلق بالعبادة مباشرة، وإنما هي حركات تستهدف
التفاعل بين الأوضاع الظاهرية والأحوال الباطنية للعبد، وهي تساعد في
توحيد الاتجاه، فهي كإناء يوضع فيه لبن المعرفة أو كقشر للب العبادة.وجاءت هذه الآية وما بعدها على صيغة الجمع: نعبد، نستعين، اهدنا..وهذا يدل على أن الإسلام دين اجتماعي، يهدف إلى ارتقاء الجميع وليس
الفرد وحده.ومن واجبات المسلم أن يكون راعيا لأخيه، فلا يكتفي بتوكله
وعبادته وحده، بل عليه أن يلقن الآخرين التوكل والعبادة بسعي دؤوب
حتى يكون الجميع من المتوكلين العابدين.وعليه أن لا يقتنع بالهداية لنفسه،
بل يجب عليه أن يدعو غيره للاهتداء، ولا يبرح ناصحا لهم يبث فيهم روح
الإيمان حتى يهتدوا ويسلكوا المسلك الذي سلكه، ويستعملوا جميعا في
دعائهم صيغة الجمع "نحن" مكان "أنا" بكل ما في الكلمة من معان.والواقع
أن مثل هذه الروح التبليغية والتربوية هي التي نهضت بالإسلام أيما نهوض في
سنين معدودة.وإذا أمكن اليوم ازدهار الإسلام فلن يمكن إلا بهذا الشعور
السامي، وليس لأهل الإسلام كرامة في الدنيا ولا شرف في الآخرة إلا إذا
تمسكوا بهذا المبدأ، قائلين بصورة جماعية: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا
الصراط المستقيم، واستفرغوا جهدهم لقول هذه الكلمات عن صدق
وعزيمة..لا عن مجرد عادة متكررة.والحق أن العبادة والاستهداء لا يكملان إلا بصورة اجتماعية، لأن الفرد
الوحيد لا يستطيع أن يعبد الله إلا إلى أجل مسمى، ولا أن يؤسس هذه
الفكرة إلا في محيط محدود.أما العابد الذي يجعل ولده وجاره أيضا يعبدان
Page 54
التفسير
كبير
٤٣
سورة الفاتحة
الله تعالى فإنه يوسع مجال العبادة ويمد أجلها.وأي شك في أن العبد الصادق
الوفي لسيده هو من يحول دون الأعداء ودون مساسهم بأملاك سيده؟ وأما
أيدي
العبد الذي يشهد تخريب بستان ،سيده، ولا يسعى جهده لإنقاذه من
الغاصبين فليس من العبودية في شيء.تصدر عن
تردّ هذه الآية على ما يراه بعض الناس في الجبر والقدر.هناك طائفتان من
أهل الآراء المتطرفة في حقيقة الأفعال الإنسانية، فالبعض يرى أنها
جبر وإكراه، ويقول بهذا الرأي بعض رجال الدين والفلاسفة وعلماء النفس،
وعلى رأسهم "فرويد" النمساوي.ومن يأخذ بهذا الرأي على أساس العقيدة الدينية يقول: إن الله مالك،
ومثله كمثل المهندس الذي يخصص بعض الأحجار للغرف وبعضها لدورة
المياه، كذلك الله تعالى يخلق من يشاء للخير ويُرغم من يشاء على الشر،
وليس الإنسان مختارا.والنصارى أسسوا الإكراه على فكرة الإثم الموروث
من آدم ويرون أن الذي لا يتحرر من قيود الإثم بالإيمان بالكفارة يبقى
مكرها عليه.والتناسخ عند الهندوس أيضا نتيجة لهذه الفكرة، لأن الخلقة التي
تستحق الروح أن تحل بها تبقى معذبة بها جزاء لما ارتكبته في خلقتها الغابرة.ولكن الدكتور "فرويد" تناول هذه المسألة على أنها بحث علمي، ويرى
أن الإنسان يبدأ عهده التعليمي في الطفولة، قبل بداية ظهور الإرادة فيه عند
البلوغ، فلا يمكن أن نقول إن الإنسان حر من ناحية الإرادة، لأن إرادته
ليست إلا امتدادا للنزعات التي تتولد عنده في مرحلة الطفولة الإنسان
يظن أن أعماله وليدة إرادته وتفكيره الحر، لكنها ثمرة مشاعر الطفولة، ولا
Page 55
التفسير
كبير
٤٤
سورة الفاتحة
شيء غيرها.وإن الإنسان إنما يحسبها الإرادة الشخصية لأنها قد اتحدت
بوجوده اتحادا.وآراء "فرويد" ليست مبتدعة، بل نجد الإشارة لها في الإسلام كما يقول
رسول الله ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو
ينصرانه."(صحيح البخاري، كتاب الجنائز).ومعنى الحديث أنهما يربيانه
على عقائدهما، فيقبلها قبل البلوغ نتيجة لتلك التربية، ويقلدهما في مسلكهما
بلا تفكير.وكذلك قد عقد الإسلام أهمية كبرى على عهد الطفولة عندما
أمرنا الرسول له بالأذان في أذن المولود ولكن رأي "فرويد" ليس صحيحا
بالكامل.ولقد رد القرآن على خطأ هذه المزاعم بقوله: (مالك يوم الدين، إياك
نعبد وإياك نستعين)، لأن الجزاء والعقاب تبطل حكمتهما باستخدام الجبر
والإكراه.فبقوله : إياك نعبد علّمنا أن الإنسان وإن كانت حريته بالإرادة
محدودة شيء ما، لكنه بلا مراء يتمتع بنصيب من الحرية يستطيع به أن يقرر
مصيره للاهتداء.مثلا : الإنسان، وإن كان متأثرا بعوامل سقيمة، إذا فكر في
صفات الله
وجد نفسه تهفو بالفعل لصوت (إياك نعبد)، ولا يستطيع أحد
أن يرفض هذه الحقيقة.ثم ماذا عساه أن يجيب الدكتور "فرويد" وتلامذته إذ
6
نرى أن الظروف تتطور، والآراء تتغير والدنيا لم تعد بحالة واحدة قط؟ فلو
كانت قوة الشعور في الطفولة شديدة التأثير إلى حد يستحيل معه التحرر من
قيودها، لوجب أن تبقى الدنيا من عهد آدم إلى يومنا هذا جامدة لا تتحول
خطوة عن الطريق القديم، ولكننا نرى بعين التاريخ أنها تطورت ولا تزال في
Page 56
التفسير
بير
٤٥
سورة الفاتحة
تطور دائم.وبذلك نتبين إمكان تطورات تحوّل مجرى التفكير الإنساني الذي
اندفع إليه في الطفولة إلى اتجاه آخر والقرآن يقوي جانبنا بأدلة محكمة
نتناولها في مناسبتها.وهناك فكرة أخرى تعاكس الجبر تماما، وهي أن الإنسان حر مطلقا في
تكوين اتجاهاته، والله تعالى لا يتدخل في أعماله أدنى تدخل.إن الإسلام
يرفض هذه الوجهة من الحرية المطلقة أيضا، ويقول: إنكم لا تستطيعون أن
تتحرروا تماما من عوامل البيئات التي تحيط بكم، فلا بد أن يكون عليكم
رقيب يسمو وجوده عن تأثير هذه العوامل، ويحفظكم من خطورتها عند
اشتدادها.ودعاء إياك نستعين يوجه الأنظار إلى أن خالقكم سبحانه
وتعالى لا يزال على مرأى ومسمع من تقصيركم وعجزكم.فادعوه
يستجب لكم، واقرعوا بابه يفتح لكم.شرح الكلمات :
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (1)
اهدنا: يقال : هداه إلى الطريق بينه له وهدَى العروس إلى بعلها: زفها
إليه.وهدى فلانا تقدمه مثل : جاءت الخيل يهديها فرس أشقر..أي يتقدمها
"الأقرب فللهدى ثلاثة معان الدلالة على الطريق؛ القيادة في الطريق؛
المصاحبة إلى نهاية الطريق.وفي القرآن أُطلقت هذه الكلمة على عدة معان
منها:
Page 57
التفسير الكبير
។
سورة الفاتحة
خلق القوى وتسخيرها للعمل كما في قوله تعالى: (أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى) (سورة طه (٥١) ومنها الدعوة للاهتداء كما في قول الله
تعالى: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) سورة السجدة: ٢٥".ومنها
القيادة الكاملة كما قال تعالى: (الحمد لله الذي هدانا لهذا)"سورة الأعراف:
٤٤.ومنها الترغيب والتحبيب، يقول عز وجل: (ومن يؤمن بالله يهد
قلبه)" سورة التغابن: ١٢" ومنها: النجاح كما جاء في قوله تعالى: (وإن
تطيعوه تهتدوا" سورة النور: ٥٥".والقرآن لا يضيق الهدى، بل يبين أن له مدارج كثيرة متصاعدة، وأن
الذين يستحقون بعملهم فضل الله ورحمته ينالون هذه الدرجات: (والذين
اهتدوا زادهم (هدى)"سورة محمد: ۱۸".خط
المستقيم من الاستقامة والاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على
مستو، وبه شبه طريق المحق نحو : اهدنا الصراط المستقيم " المفردات".التفسير :
في هذه الآية (اهدنا الصراط المستقيم يعلمنا الله دعاء لم يسبق له مثيل في
كماله وسموه.فهو دعاء لا يختص بأمر خاص، بل يعم جميع ضرورات الحياة
صغيرة وكبيرة دينية ودنيوية.فلكل عمل مهما كان طريق يوصل إليه، وإذا
اخترنا ذلك الطريق أدى بنا إلى النجاح.ثم أحيانا نجد طرقا شتى إلى عمل
واحد، وهذه الطرق..بعضها مشروعة وبعضها غير مشروعة، والمشروعة
منها ما يكون أسرع وأقرب للنجاح، ومنها ما يكون غير ذلك.وتعلمنا
Page 58
التفسير الكبير
٤٧
سورة الفاتحة
هذه الآية أن ندعو دائما بهذا الدعاء..كي يهدينا الله إلى الطريق المستقيم
وهو الأسرع إلى الفوز فما أيسر هذا الدعاء وما أكمله وما أشمله! لا هدف
أهداف الحياة إلا ويمكننا أن نستعمل له هذا الدعاء العظيم.والذي يعتاد
هذا الدعاء لن يدخر جهد في استثمار جهوده، لأنه يذكر مرة بعد أخرى إن
لكل عمل طرقًا مشروعة وغير مشروعة، وأنه يجب عليه البحث عن
من
فكرة
المشروع منها، وأن عليه اختيار الأقرب منها.وما أشد أن يستسيغ
هذا التعليم السامي.ومن البين أن الذي يدعو الله تعالى لأجل الطريق
المستقيم يتأثر فكره بهذا الدعاء.وتتجه جهوده كلها نحو البحث عن هذا
الطريق.وأي شك في سمو المقاصد وسداد الأعمال وتتابع الجهود لدى من
يهتم في أعماله بالمبادئ التالية المبنية على هذا الدعاء:
١.أن تكون جميع أعماله مشروعة.۲.أن لا يقنع بدرجة واحدة، بل يبقى مشوقا للدرجات العلى التي لا
نهاية لها.وينهي
كل
أشغاله
في..أن لا يضيع وقته سدى، بل ينتهز كل لحظة،
أقل وقت ممكن.إني على ثقة من أن المسلمين لو داوموا على هذا الدعاء في
إخلاص وصدق نية، مع فهم معانيه..لكان له تأثير ملموس في نفوسهم،
فضلا عما يعود عليهم من فوائد جمة لكونه دعاء صائبا.قال بعضهم: إن الله أمر المسلمين بهذا الدعاء (اهدنا الصراط المستقيم)
في كل صلاة، بل كان الرسول يدعو بهذا الدعاء دائما..أفلا يدل ذلك
على أنه لم يجد أيضا ذلك الصراط المستقيم حتى كان دائب الدعاء من أجل
Page 59
بير
ΕΛ
سورة الفاتحة
التفسير
الحصول عليه؟ وهذا تساؤل غريب يدعو إلى الضحك من عقول هؤلاء
المتعلمين من النصارى والهندوس الذين يوجهون مثل هذا الاعتراض بلا تأنٍ
أو ترو، ويتعجبون ويقولون: ماذا عسى أن يكون عند المسلمين من الرد
عليه؟ وإليكم الجواب:
أولا: الهداية، كما ذكرنا ليست الدلالة فقط بل هي الدلالة والقيادة
والإبلاغ إلى النهاية.فطلب الهدى إذن يختلف باختلاف الطالبين في
الدرجات، مثلا من لا يعرف حقيقة الهداية يطلب إدراك حقيقتها أو
موضعها من الأديان ومكانها.ومن يعرف الهداية ولكن يجد في سبيل القبول
موانع من ضعف الإرادة أو الأصحاب الذين يعرقلون طريقه، أو البعد عن
الهادي الكامل الذي يصعب الاتصال به، أو لم تتيسر له صحبة صالحة، فهذا
الشخص عندما يطلب الهداية يعني: قُدْني إلى الهداية، وأزل عن طريقي جميع
العقبات التي تواجهني.وإذا كان الطلب ممن تتيسر له الانقياد في هذا
الطريق، وزالت المشاكل عن طريقه فمعنى طلب الهداية بالنسبة إليه: اللهم
إن طرق الهدى واسعة جدا، ومسالك المعرفة لا تنتهي، فأطلب إليك أن
تساعدني على مواصلة التقدم في هذا الطريق وأن لا تتأخر قدمي عن السبق
فيها، وأن أقف على مزيد من أسرار الحق، وأن توفقني للعمل أكثر من ذي
قبل.فمَن مِن الناس يمكنه أن يستغني عن معنى من هذه المعاني الثلاثة للدعاء؟
إن رسولنا كان أكمل الأولين والآخرين، لكن إله الإسلام ذو قوى لا
نهائية، ومها تقدم الإنسان إلى قربه لا يمكن أن يحيط بها، بل يبقى له مجال
Page 60
التفسير
ـبير
٤٩
سورة الفاتحة
أوسع من أن يُحَدُّ، وهو دائم الاحتياج إلى الدعاء باهدنا الصراط
المستقيم، والاستزادة من علمه تبارك وتعالى في أمور الدين والدنيا كليهما.والحق أن هذا الدعاء لا يثير أي شبهه بل إنه يقدم نظرية شاملة لارتقاء
العلم في الإسلام وهي نظرية فيها دليل قاطع على أفضلية القرآن.نزل هذا
الكتاب القيم في جو حافل بالأديان، فنسخها كلها، وأسس مكانها دينا أقوم
وأكمل، لكنه لم يقل ما قالت به الملل أخرى من أن العلم قد انتهى
بوجودها، وانسدت أبوابه بمجيئها، بل بين أن العلم لم ينته بظهوره، وإنما
باب العلوم مفتوح على مصراعيه.ومن أجل هذا الغرض علم اتباعه أن لا
ينقطعوا عن طلب المزيد من العلم، وعليهم أن يقولوا في كل صلاة (اهدنا
الصراط المستقيم، وأن يكرروا هذا الدعاء في الصلوات أكثر من ثلاثين مرة
في اليوم والليلة.وبهذا المبدأ السامي وسع الإسلام للإنسان الطريق العلمي
أيما توسيع.وقد توهم البعض أن هذا الرأي يناقض كون القرآن آخر كتاب سماوي
للعالم، لأن العلم إذا كان دائم الارتقاء والازدهار فلماذا لا نسلم إذن في أن
القرآن سيأتي دوره لينسخ في وقت من الأوقات.ويحل محله كتاب آخر؟
ويمكن الرد على هذا الزعم بما يلي:
لو سلمنا بنزول كتاب من بعد القرآن ينسخه، فها قد مضى على
نزول القرآن أربعة عشر قرنا ولم ينزل هذا الكتاب الأكمل المزعوم.ولقد أجهد الفلاسفة وأتباع الممل الباطلة أن يأتوا بمثله فخابوا وخسروا في
جميع محاولاتهم.فإذا لم يكن ثمة كتاب كهذا فكيف نقيم لهذا الزعم وزنا.
Page 61
التفسير
كبير
0.سورة الفاتحة
منه
ثم إن القرآن عالم روحي، ولا يختلف في أحواله عن العالم المادي، فكما
يتقدم الإنسان كل يوم في مجال العلوم المادية، ويخطو خطوات واسعة في
طريق الارتقاء، ومع ذلك لا يُخلق له كل يوم عالم جديد حتى يكتشف فيه
أسرارا كامنة، بل يبذل تفكيره في نفس العالم القديم، ويستخرج
أسرارا
فيه وعلوم حديثة..كذلك القرآن العالم الروحي، لا يحتاج الإنسان بعده
إلى عالم روحي جديد حتى يفكر فيه.وما حظر القرآن على الناس التقدم في
العلوم.وكما أن الناس يكتشفون أمورا جديدة بمطالعة العالم المادي، كذلك
القرآن يقدم للإنسان المتدبر فيه علوما روحية واسعة غير منتهية نظرا لمدى
إمكانه وغاية استطاعته، والذين يفكرون فيه تنفتح عليهم معارف القرآن
حسب إخلاصهم وبقدر عزيمتهم في طلبهم اهدنا الصراط المستقيم)).فمع كون القرآن الكتاب الأخير لم يتوقف الارتقاء العلمي، بل قد ازداد
سرعة وسعة كما يصرح القرآن نفسه الذين اهتدوا زادهم هدى)" سورة
محمد: ۱۸ ".فالهدى الذي وصف به القرآن لا يطلق على رقي محدود، بل هو سلسلة
غير منقطعة من الحقائق، ولا تلبث الحلقة الواحدة حتى تبدو الأخرى.ولقد
جربت بنفسي أنه ما من مسألة دينية إلا ويقدم القرآن لنا علما متوفرا
لحلها.وعلى الرغم من وجود هذه الحقيقة الناصعة لم يُرد العالم أن يصغي
إلى رسالة القرآن بل يبحث عن دين آخر يطمئن إليه.ومثله إذن كمثل
الذي يجد المعين العذب يتدفق أمامه..ثم يتيه ويمضي بحثا عن غيره.
Page 62
التفسير
ـبير
۵۱
سورة الفاتحة
أني أتعجب للمسلمين الذين يدعون كل يوم (اهدنا الصراط
المستقيم)، ثم يظنون أنه لا يجوز لهم أن يجتازوا ما كتبه المفسرون، وأنه ليس
هناك علم في القرآن غير ما ذكروه.إن كان ما يزعمون حقا فلماذا يدعون
اهدنا الصراط المستقيم، والله تعالى لم يبق لديه شيء حسب زعمهم.فيجدر بهم أن لا يضيعوا وقتهم في هذا الدعاء، ويقتنوا تفاسير السلف
ويكتفوا بما فيها.إن هذا الدعاء دعاء جامع بصورة رائعة، ويمكن للإنسان أن ينتفع منه في
كل أمر من أمور الدين والدنيا.ولا يجد الباحث عن الحق مناصا من التوجه
إليه مهما كان دينه فهو دعاء لا يختص بدين دون آخر، بل يحتوي على
طلب الصراط المستقيم، أي طريق الحق الخالص الذي يمكن لكل إنسان أن
يدعو من
أجله
أن
من يمس باعتقاده.ولا يسع أحد..نصرانيا كان أم
غير
زردشتيا، بوذيا كان أو ملحدا، أن يعيب هذا الدعاء.إن الملحد لا يؤمن
بالله، لكنه يستطيع أن يقول : إذا كان الله موجودا فليدلني على الصراط
المستقيم.فهذا الدعاء لا ضرر فيه ويتسم بالحياد، إذ لا يختص بدين دون
دين.إنه جامع لكل أنواع الطرق، شامل لجميع العالم، بل يعم كل حالة من
الأحوال، وكل فرد من أفراد الأسرة العالمية.وقد ثبت من خلال تجاربي أنه
أحد غير مسلم نصحته بهذا الدعاء فدعا به، إلا وأظهر الله عليه
صدق الإسلام.لهذا فإنني على يقين..أن كل من يبتهل إلى الله بهذا الدعاء
بكل إخلاص وصدق سوف يكشف الله عليه الحقيقة، إذ لا يمكن أبدا أن
ما
من
يستغيث المخلوق على باب الخالق طالبا الهداية فيرده خائبا خاسرا.
Page 63
التفسير
۵۲
سورة
ة الفاتحة
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضالين (۷)
شرح الكلمات:
أنعمت : من الإنعام وهو الفضل والزيادة "الأقرب".المغضوب عليهم: الغضب هو ثوران دم القلب وإرادة الانتقام، وإذا
وصف الله تعالى به فالمراد الانتقام دون غيره "المفردات".الضالين الضلال : العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية.ويقال
الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا كان أم سهوا، يسيرا كان أو
كثيرا."المفردات".التفسير :
عندما أرشدنا الله تعالى إلى طلب الصراط المستقيم، علمنا أيضا أن يكون
هذا الصراط من أنعم عليهم، وأن لا يكون طريقا عاديا، بل يكون مسلكا
للأرواح السامية المرتقية.ما أعظم هذا الهدف الذي جعله الله
وجهة لكل
مسلم في أول سورة من سور القرآن فلا يليق بالمسلم أن يقنع بفعل الخير،
بل عليه أن يمضي فيه قدما حتى يصير من الذين نالوا حظا عظيما من نعم
الله تعالى.والحق أن الذي يتذوق حب الله لا يستطيع أن يكتفي بدرجة
ضئيلة، لأن حب الله تعالى يفسح قلب الإنسان، فلا يطمئن إلى ارتقاء
محدود، وبعدما يلتاع قلبه حبا للخالق عز وجل..فأنى لشيء آخر أن يحتل
قلبه ويطمئنه؟ الذي يريد وجه الله إنما يطلب الترقيات بأسرها، ومن عرف
Page 64
التفسير
ـبير
۵۳
سورة الفاتحة
أنه
مع
الله تعالى
ربه لا يعترف بنهاية التقدم.وأعظم من ذلك نصرة عند المؤمن..شعوره بهذا الطموح في سبيل مرضاة الله عز وجل..يجد من
التعليم والتشجيع بأن لا يرضى بسافل الدرجات، بل عليه أن يطلب ما
حصل عليه أولو النعم من عبادة الذين حازوا قصب السبق إلى الخيرات،
وعليه أن لا ينتظر ما نال أحد من هؤلاء المقربين من النعمة، بل يحق له أن
يسأل جميع ما تمتعوا به من أفضال.والإنعام في اللغة لا يحدد بمعنى خاص، بل يطلق على كل خير يعطي
إعرابا عن الرضا، دنيويا كان هذا الإنعام أم دينيا وقد وردت هذه الكلمة
بمعنى عام في قوله تعالى: (أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ)"
الإسراء: ٨٤".فالإنعام يشمل العلم والفن والكرامة الدنيوية وغيرها من
المفاخر، لأن هذه النعم لا توهب إلا من عند الله، ولكن كثيرا من الناس
بدلا من الشكر عليها ينسون المنعم وينصرفون عنه.كما أن القرآن يعد الإنقاذ من المصائب نعمة من النعم كما يقول عز
يبسطوا
وجل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هَمَّ قوم أن
إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله.وعلى الله فليتوكل
المؤمنون)" المائدة: ۱۲".فكل إحسان نعمة ولا شك، لكن هناك أنواع
من الإحسان هي أحق بأن تكون نعما وهي أسماها وأعلاها مكانة كما
يقول الله (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ) (المائدة:.(۲۱
Page 65
التفسير
ـبير
لقد ذكر الله
٥٤
سورة الفاتحة
في هذه الآية الأشياء الجديرة بكونها نعما، والتي أنعم الله بها
على بني إسرائيل.وفي أسلوب وجيز بليغ أشار القرآن هنا إلى النعمة
الدنيوية والنعمة الدينية ونعمة التفوق العام المترتبة على النعمتين السابقتين.وقد توسعت معاني الآية توسعا عظيما بذكر (صراط الذين أنعمت
عليهم) بعد (اهدنا الصراط المستقيم.فهذه الكلمات لم تجعل هدف المسلم
مجرد طلب الصراط المستقيم في مقاصده الشخصية بل وجهته إلى أهداف
أخرى هي أسمى منها.فعليه أن يطلب من الله الاهتداء إلى الطرق المستقيمة،
ثم يدخله في الطائفة المنعم عليها، وفوق ذلك يهديه إلى طرق العرفان،
ويعلمه التعاليم السامية التي وقف عليها عباده الذين أُنعم عليهم.الله
تعالى
ولقد من الله على أهل الإسلام إذ شجعهم بهذه الآمال الواسعة النطاق،
الحافلة بنتائج عظيمة.وإنا وإن كنا لسنا بحاجة إلى مزيد من الاستدلال على
أن أبواب التقدم مفتوحة على مصراعيها لأهل الإسلام، إلا أن اليأس قد عمَّ
المسلمين بهذا الصدد، لذلك نتوجه إلى القرآن المجيد مرة ثانية، ونبحث عن
المعاني التي أرادها الله بتعليم هذا الدعاء، وأيضا لنتبين هل وعد
بإجابة هذا الدعاء أم لا؟
قال عز من قائل:...وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
تَشْيتًا) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا (( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا) (النساء: ٦٧
إلى (٧٠).*
Page 66
٥٥
سورة الفاتحة
التفسير الكبير
لقد ذكرت هذه الآية النعم التي قدرها الله تعالى للمسلمين، وقد تكررت
فيها نفس الكلمات التي وردت في الفاتحة أي الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم.وهنا فسر القرآن الطائفة المنعم عليها وحددها بالنبيين
والصديقين والشهداء والصالحين، وقال إن المسلمين سوف ينالون هذه
النعم..أي ينالون هذه الدرجات العلى في الروحانية.قد يقال: إن (مع)
تعني المصاحبة ولا تعني هنا المشاركة أي أن المطيعين الله والرسول يكونون
مع هؤلاء ولن يكونوا منهم.لكن ضعف هذا القول واضح في نفس الآية،
لأن (مع) لو كانت متصلة بالنبيين فقط..لكان المراد من الآية أن بعض هذه
الأمة سيتشرف بمرافقة الأنبياء..من غير أن يكون منهم..لامتناع النبوة
المطلقة في هذه الأمة.لكن الله تعالى وضع (مع) قبل (الذين أنعم الله
عليهم).وإذا كان معنى (مع) هو المصاحبة دون أن يكون مثلهم..لكان
معنى ذلك أن المسلمين لن ينالوا شيئا مما أنعم الله به.نعم، إنهم سيُعطَوْن
مصاحبة ذوي تلك الدرجات الأربع ولكن من غير أن يشاركوهم فيها.وتُؤول الآية إذن إلى أن ليس في المسلمين من يستحق نعمة من هذه النعم،
وإن كان بعضهم سوف يرافقون المنعم عليهم من الأمم الأخرى.وهذا
المعنى لا يقبله القرآن والحديث ولا العقل السليم.فكلمة (مع) تتعلق بالطوائف الأربع من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين، فإن كانت (مع) بمعنى المعية والمصاحبة فقط..لكان معنى الآية
أن المسلمين لا يمكن لهم مطلقا أن ينالوا النبوة غير أنهم يصاحبون الأنبياء
الآخرين، ولا يستطيعون أن يكونوا من الصديقين غير أنهم يلازمون
Page 67
التفسير
كبير
سورة الفاتحة
الصديقين، ومن المستحيل أن يكونوا شهداء غير أنهم يصحبون الشهداء
الآخرين، ويمتنع عليهم أن يكونوا صالحين غير أنهم يصاحبون الصلحاء
الآخرين.وليس أذل ولا أشد إهانة لمقام النبي المصطفى وأمته من هذا
التأويل الركيك..بخلو أمته
منهم
من
الصالحين فضلا عن النبيين.الله
وقد قال البعض بأن النبوة هبة من عند الله فلا يجوز الدعاء لأجل
الحصول عليها؟ والجواب أن المسلم لا يدعو لأجل النبوة، بل الأمة المسلمة
تدعو أن تكون ممن أنعم الله عليهم، وهذا هو معنى الآية.ثم إذا شاء الله أن
يخلع على أحد
نعمة النبوة فلا راد لفضله (الله أعلم حيث يجعل
(رسالته الأنعام: ۱۲۰.والنبوة هبة من الله بلا مراء لكن لماذا اختص ١٢٥".بها محمد ا ، ولم يهبها لأبي جهل مثلا؟ لابد أن تكون في نبينا مؤهلات
لهذه النعمة من تضحية وإيثار في سبيل الله.ثم متى قلنا إن الآية تعلم المؤمن أن يسأل نعمة النبوة لنفسه، لأن هذا
النوع من الأدعية..التي يُصر فيها الإنسان أمر خاص لنفسه..مردودة
ومكروهة في الأمور الدنيوية فضلا عن أمور الدين، ومثل هذه الأدعية
كمثل الحداد الذي يدعو الله أن يجعله عميدا لكلية الطيب، أو الأعرج الذي
يدعو أن يكون بطلا للعالم في العدو.فهذه الأدعية عقيمة باطلة، لأن
الدعوات إنما تجاب حسب الظروف الروحية والمصالح السماوية.فلا يجدر
بالمؤمن أن يدعو ويلح على طلب شيء خاص من المراتب الروحية، ولو أنه
دعا أن يصبح صديقا أو شهيدا أو قطبا كان دعاؤه مكروها عند الله، فما
بالك بالإصرار على النبوة؟! لأجل ذلك تعلمنا الآية الدعاء بصيغة الجمع
Page 68
التفسير
كبير
٥٧
سورة الفاتحة
فنقول: (اهدنا) وليس (اهدني)، لأن صيغة الجمع تحفز للمصالح الاجتماعية
القومية.ولذا يصطفي الله من القوم من يراه حقيقا لدرجة روحية.ثم لا يغربن عن البال أيضا أن هذا الدعاء يراد به الحصول على الإنعام،
والنبوة أيضا إنعام وهبة فأي حرج لو اعتبرنا أن هذا الدعاء بقيام النبوة في
القوم؟ والقرآن يؤكد لنا أن جميع النعم، وعلى رأسها النبوة، سوف توهب
للمسلمين، فلا يحق لأحد أن يحرمها عليهم.وأما قولهم: كيف يمكن أن يبعث نبي ورسول الله ﷺ خاتم النبيين،
فجوابه موجود في قوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا)،
أي لا يستحق هذه النعمة إلا من أطاع الله ورسوله.ومن البين أن
المطيع بهذه الصفة لا يمكن أن يتعدى عمله عمل رسول الله ، ولا أن يأتي
بشرع جديد غير شرعه.فالنبي التابع لشريعة رسول الله ﷺ لا يكون
مخالفا ولا معارضا لخاتم النبيين بل يكون مكملا لمعناه.لقد كتب أحد المفسرين العصريين في تفسير له، ويكرر تقديمه للناس، أن
هذا الدعاء (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم..) لو كان
المراد منه الحصول على النبوة لكان تعليمه للنبي قبل بعثه نبيا، ولكن
وجوده في القرآن يدل على أن تعليمه كان بعد النبوة، وهذا ينفي كونه
دعاء للنبوة.وهذا القول غاية الحمق ودلالة على ضعف التفكير، لأن دعاء (اهدنا
الصراط المستقيم دعاء فطري، أما التلفظ بهذا الدعاء بكلمات القرآن فلأنها
Page 69
۵۸
سورة الفاتحة
التفسير
كبير
مباركة ومنزهة عن الخطأ.وإلا فكل محقق، مؤمنا بدين كان أو كافرا،
عندما يشعر بحاجة إلى البحث عن الحق يدعو بكلمات تشابه هذه الكلمات
معنى، ويقول اهدنا الطريق المستقيم طريق أحبابك وهل يمكن لمن كانت له
مسحة من العقل أن يظن أن رسول الله ﷺ ما كان يتمنى قبل بعثه إن
يهتدي إلى الصراط المستقيم ويسلك طريق المحبوبين لدى الله؟ إن مجرد
التفكير في هذا الأمر يؤدي بالإنسان إلى الكفر؟ والحق أن اضطراب قلب
محمد هو الذي تسبب في جذب الفضل الإلهي، وقد عبّر عن هذا
الاضطراب بقول: (اهدنا الصراط المستقيم).ولفظ القرآن في هذا الدعاء
يمتاز بعمومه وكماله وترفعه ونزاهته عن كل عيب.كما أنه يثير شعور
الاضطراب فيمن مات فيه هذا الشعور، ويبعث الناس على الأمل بأنهم إذا
دعوا بهذه الصورة فدعواتهم أقرب إلى القبول بل أمرهم الله بهذا الدعاء.بأن رسول الله كان خلوا من لوعة الاضطراب ومن دعاء كهذا
فالزعم
قبل بعثته نبيا..إهانة له ، بل هو استخفاف بكرامة
الله
عز وجل، لأنه
فرض النبوة فرضا على رسول الله عن غير جدارة ومن غير اشتياق عنده
للاهتداء.نعوذ بالله من هذه الخرافات!
ثم إذا كان هذا الزعم صحيحا..فلسائل أن يسأل: هل كان محمد ﷺ
صالحا محبا لله مقربا إليه قبل النبوة أم غير صالح؟ وإذا كان صالحا فليس بي
حاجة أن أصلي وأصوم كما يأمر ،القرآن وأن أجاهد كما يفرض علي،
وليس ثمة داع إلى القيام بشرائع القرآن إذ حصل رسول الله ﷺ على التقوى
وعلى هذه الصلة المفضلة بلا أي عمل كهذا، فلماذا إذا أبقى محتاجا إلى
Page 70
۵۹
سورة الفاتحة
التفسير الكبير
الدين وأحكامه؟ بل دعونا من الأمور الدينية وفكروا في الأشياء الدنيوية،
مثلا إذا قال قائل : لقد وجدَت الدجاجة أو البيضة في هذا الكون أول مرة
دون عمل بشري، فلماذا نحن بحاجة إلى إيجادها طبقا للقوانين الطبيعية؟
طبعا لا أحد يوافق على هذا القول، قائله
ويصبح عرضة للتفنيد والرمي
بالبلاهة، لأن سنة الله عند انعدام البذرة تختلف عن سنته بعد وجودها في
الأرض، وكذلك قبل بعثة النبي كانت التعاليم السماوية قد انمحت،
فاضطربت فطرته الطاهرة بشعور الحب الإلهي، فشرف الله تعالى هذه
العواطف الفطرية بالقبول وقدرها أحسن تقدير لكن بعدما نزل القرآن
وسن لكل أمر شرعة ومنهاجا..لا يمكن الحصول على النعم التي تمتع بها
الأولون إلا بشريعة القرآن التي نزلت على محمد ، ولن ينجح من
بعدها من يخرج على هذه الشريعة ويندد بأحكامها.وهناك وجهة أخرى للرد على هذا الزعم: هل درجة النبوة هذه مجرد
منصب من المناصب ولا حاجة إلى العمل للحصول عليها، أم هي منصب
ديني عظيم ذو أهمية كبرى، ويتطلب أن يكون النبي متصفا بالتقوى
والنزاهة قبل أن يصبح نبيا؟ وإذا كانت التقوى والنزاهة ضرورية للنبي
فسؤالنا: هل يمكن في رأيهم أن يكون غير النبي أتقى وأقرب إلى
النبي؟
؟ فإن أجاب المفسر العصري المذكور وأمثاله..بأنه يمكن أن يكون غير
النبي
الله
من
أتقى من النبي..فإذا تبقى المشكلة اللفظية فقط.أما إذا كان جوابهم أن
غير النبي لا يمكن أبدا أن يكون أتقى من النبي فان من يزعم أنه لا نبوة في
الأمة المحمدية، لا غير تشريعية ولا تابعة لدعوة الرسول محمد فكأنه يقرر
Page 71
التفسير الكبير
سورة الفاتحة
أن لا أحد من هذه الأمة بقادر أن يبلغ المكانة الروحية التي بلغها الناس من
الأمم الغابرة.وهذا القول يؤكد بحرمان الأمة المحمدية من النعم السماوية،
والعياذ بالله !
وتساءل المفسر المذكور فقال: ما هي العلة التي أدت إلى رفض أدعية
الأمة بأسرها خلال ألف أربع مائة سنة في هذا الشأن؟ والجواب أن إجابــة
الدعاء تتوقف على كيفية وكمية الدعاء ونوعه والسائل يسلم بإمكان نيل
مسلماته: كم صديقا في هذه الأمة؟ فإذا
الأمة
مرتبة الصديقية، فنسأله
من
قال : لم يوجد في هذه المدة إلا صديق واحد هو أبو بكر "رضي الله عنه"
فنسأله: لماذا لم يستجب الله لأحد آخر طوال هذه القرون؟ وإذا قال: كان
هناك صديق مع أبي بكر في الأمة، فنسأل هل كان أفضل من عمر وعثمان
الله
عنهم
وعلي "رضي
أن يصير صديقا وهؤلاء الأصحاب الثلاثة لم يتجاوزوا مقام الشهادة وهو لم
" أم لا؟ فإذا لم يكن أفضل منهم فإذن كيف أمكن
يرق إلى مقامهم في الشهداء بعد؟
وإجمال القول أن ما يرد على بقاء النبوة من الاعتراض يرد أيضا على بقاء
الصديقية وهو قول ناشئ عن قلة تدبر ولا يقوم على الحقيقة.وهنا أحب أن أضيف حكمة أخرى وهي أن الرسول سمى ســــورة
أن
الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب " سنن أبو داوود كتاب الصلاة".وعندي
هذه التسمية أخذت من هذه الآية والتى قبلها إن المرحلة الأخيرة للعبادة أن
يسأل العبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم.وإذا كان هذا الدعاء
ممكن الإجابة واطمأنت إليه قلوب القوم واضطربت به إلى الله، وتضرعت
Page 72
التفسير
كبير
༥ ད
سورة الفاتحة
بأنهم مندفعون نحو الهلاك، وأنهم يستحقون أن يفتح لهم طريق الهدى، وإذا
وافقت استغاثتهم استغاثة الشخصية الكاملة الطاهرة التي بعثها الله لتلك
الفترة، وجعلها بطل الأبطال في ساحة الدين، فعند اجتماع الاستغاثتين تنبثق
من
رحمة الله عز وجل وينزل فضله وحيا وهدى.وهكذا كانت سنة الله
قبل وهكذا ستبقى إلى الأبد.إن صريخ المظلومين في زمـــن نـــوح وافـق
تضرعات القلب الطاهر الصافي لنوح عليه السلام"، واستنـ
"عليه السلام"، واستنزل الكلام
الذي أنزل على نوح ، وإن صياح الأرواح الطيّعة في عهد إبراهيم عليـه
السلام اجتمع مع اضطراب القلب المطهر لإبراهيم..فاستدرّ نزو لصحف
إبراهيم، وتكرر ذلك في زمن موسى وعيسى عليهما السلام، وكذلك
حدث قبل بعثة النبي المصطفى.تخبرنا الأحاديث الصحيحة أن رسول
الله كان ينقطع للعبادة في غار حراء، ويبقى فيه داعيا متضرعا أيامــــا
والية.هكذا كان حال القلب الأطهر الذي يشعر بحقيقة ما يفكــــر فيـــه،
متوال
وكانت هناك تأوهات خفية من أهل الدنيا تطلب الهداية والصراط المستقيم.اتفقت كل تلك التضرعات واستثارت فضل الله تعالى، حتى نزل القرآن.والحق أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تنم عن
الظروف التي تعرضت للعالم قبل نزول الكلام الإلهي، خاصة تلــك
الظروف التي تأثرت بها القلوب الطاهرة السليمة.لقد أنتجت هذه الظروف
تضرعا وتخشعا في القلوب، وأدت إلى حماس واندفاع فكري، أسفرت كل
هذه الأوضاع عن نزول الهداية لذلك الزمن.فالحديث إشارة إلى أن هذا
Page 73
التفسير
الدعاء
٦٢
سورة الفاتحة
هو السبب لنزول القرآن ولذلك سماه رسول الله ﷺ " أم القرآن
وأم الكتاب" لأن العلة لوجود شيء تنزل منزلة الأم له.ومما يجدر بالذكر أن رسول الله وصف الفاتحة بأنها "القرآن العظيم"
ولإيراد بهذا القول أن سائر القرآن أصغر منها شأنا، فهذا بين البطلان..وإنما
سبب هذه التسمية أنه كان من الممكن أن يشتبه الأمر على المسلمين بسبب
اسم آخر لها (أم القرآن وأم الكتاب فيظنوا أنها غير القرآن..ولذلك
وصفها بأنها " القرآن العظيم " ليتبين للجميع أنها من القرآن.فالعرب تطلق
اسم الكل على الجزء فيقال مثلا..إن فلانا يقرأ القرآن، فلا
ذلك كل
القرآن وإنما جزء منه.يعني
ومن الحكم الروحانية التي يجب أن لا نغفل عنها حكمة تختص بأسمــاء
هذه السورة، أعني أم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظيم.؟ فكأن رسول الله
اعتبر الفاتحة الأم..أي سببا أدّى إلى نزول القرآن، وكذلك اعتبرها
في نفس الوقت الوليد أي القرآن نفسه، فاجتمع الأصل والفرع في شئ
واحد.هذا لأن الحالة الأولى في العالم الروحاني تولد الحالة الثانية، فكأن
الحالة الأولى هي ألام والحالة الثانية هي الوليد، مع أنهما تلحقـــان وجودا
الأم لأن الدعاء المذكور فيها هـو الــذي أدى
هي
واحدا.كذلك الفاتحة
لنزول القرآن، وهي القرآن العظيم لأنها جزء منه.والإنسان أيضا خاضع
لهذا القانون الروحاني الذي يعبر عنه بكلمات تشبيهية كما يقول عز وجل:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ
Page 74
التفسير
كبير
٦٣
سورة الفاتحة
وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) "التحريم ١٢،١٣"..أي الذين يتصفون بصفات مريم
ثم يتقدمون حتى يتلقون كلام الله ويصيرون مسيحي النفس.والخلاصة أن تسمية هذه السورة بأم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظيم
تفسر الاصطلاحات الإسلامية تفسيرا لطيفا وتبين للمرتابين حقيقة تسمية
الأمة
رجل من
باسم مريم وعيسى (وهو المهدي والمسيح المنتظر عليه
السلام لأنه إذا أمكن أن تكون السورة حسب قول رسول الله ﷺ أم
القرآن والقرآن نفسه فليس من الصعب أن يعرف المؤمن الصادق الإيمان
حقيقة مريمية رجل وعيسويته، لأن حالته وهو يتضرع لظهور المسيح كانت
حالة مريمية، ومن أجل ذلك سُمِّي هو "مريم" أم عيسى، كما سميت الفاتحة
أم القرآن لأنها تطلب الهدى بدعاء (اهدنا الصراط المستقيم) وكذلك عندما
سمع دعاء هذا الرجل وأجيب إلحاحه أعطى روحا عيسوية وسُمِّي عيسى.وبذا أصبح مثل دعاء (اهدنا الصراط المستقيم الذي استنزل القرآن وكان
أما، ثم صار جزءا منه وكان قرآنا عظيما.وهناك درس يجب أن نتلقنه كما تلقنه الصحابة من هذه الآيــة (اهـــدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم..هو أن لكـــل قـوم غايـــة
يسعون إليها ويستنفذون جهودهم لأجلها وكذلك جعل الله لهذا الكـــون
هدفا وغاية والأمة التي تحقق غاية الكون أحرى أن تكون غاية لهذه الدنيا.جاء آدم عليه السلام وعلم الناس مبادئ وتعاليم تلائم ذلك الزمن.وتقدم
الناس تقدما ملحوظا على ضوء هذه التعاليم وسبقت عقولهم عقـول
البدائيين إلى مدى بعيد.لكن الإنسان مع ذلك ما بلغ إلى الكمال الذي قدر
Page 75
التفسير الكبير
។
سورة الفاتحة
له أن يبلغه، لذلك استمر طموحه إلى التقدم حتى بعث نوح وبلغ بهم في
العلو مرحلة أخرى، ومع أن الإنسان تقدم في عهد نوح في كل ناحية مـــــن
النواحي الروحية والأخلاقية والعقلية إلا أنه ما حصل المقصد الذي خلق من
أجله، فتبع نوحا نبي آخر ثم آخر وتتابعت هذه السلسلة حتى ظهر الوجود
الكامل في شخصية محمد ، وظهرت بوجوده جميع الأسرار التي كانــت
مستورة مكنونة، وبين كل ما يتصل بالتقدم الروحي والنضوج العقلي
والسمو الأخلاقي فكأنه بلغ بالدين من الناحية العلمية إلى ذروته.ولذلك
أعلن الله تعالى بلسانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)
الذين
(المائدة: ٤).لكن الغاية المقصودة من هذه التعاليم الكاملة لن تتحقق ما لم يعمل بهــا
الإنسان ويتمسك بها تمسكا وثيقًا.ثم لكي تكون رسالة النبي ﷺ ناجحـــــة
حق النجاح، علم الله المسلمين أن يدعوا: (اهدنا الصراط المستقيم صراط
أنعمت عليهم)..أي أن هدفكم هو المقام المحمود الذي لأجله بدأت
الدنيا سفرها، وتقدم إليه الأنبياء بأممهم ، وقلّد رسول الله ﷺ المرحلة الأخيرة
منه.فمعنى (صراط الذين أنعمت عليهم..اللهم أعطنا حسنات أمة آدم، ثم
أبلغ عقليتنا إلى مبلغ أمة ،نوح، ثم ارفعنا إلى مستوى أمة إبراهيم، ثم هب لنا
فضائل قوم موسى، ثم اجعَلْ حظنا من نفح عيسى، وتقدم بنا يا ربنا مـــــن
رحلة إلى أخرى، واسْمُ بنا إلى المثل الأعلى لمحمد..كي تنجح رسالته
وتتحقق غايته، ويحل مركزه العظيم من المقام المحمود الذي وعدته.مرح
Page 76
التفسير الكـ
كبير
سورة الفاتحة
فالمراد من (صراط الذين أنعمت عليهم هو المرحلة الأخيرة من عبقريـــة
الإنسان التي تسابقت إليها القافلة الإنسانية التي قادها الأنبيـاء في فترات
عديدة ومراحل مختلفة، وفُوِّضت المرحلة الأخيرة منها إلى رسول الله ،
وكأن أمة المصطفى يطلبون بهذا الدعاء: اللهم أكملت الدين وأتممــــت
النعمة على رسولك الا
الله، فالآن نطلب إليك التوفيق والاستطاعة لأن نطبق
هذا الدين بأعمالنا وتظهر فينا القوى الجبارة الخفية التي نمت علــى يــد
الأنبياء، والتي هي المقصد الحقيقي لهذا الكون، اللهم لأجل هذا الهدف
العظيم فانصرنا، ووفقنا لأن نخطو بطريقة شاملة مراحل المعرفة التي خطتها
كل أمة خطوة خطوة، كي تتحقق الغاية المتوخاة من خلق الإنسان على يد
الأمة المحمدية.إن الصحابة رضي
تمسكوا بهذا المقصود، وجمعوا في
شخصياتهم أخلاق الأمم كلها وقدموا للعالم المثل العليا الخالدة.واليوم لو
اتخذت جماعتنا هذا الهدف نصب عينها لأوشكت أن تحل الساعة المباركة
التي يتشرف فيها رسول الله مقامه المحمود، وتهدأ فيهـا الـدنيـا مــن
اضطرابها المقعد.الله
عنهم
أما قوله تعالى : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)..فكل من يثير
بمعصية فهو من المغضوب عليهم، وكذلك من ضلوا في حب غير
الله
غضب
الله
ونسوه عز وجل، فهم من الضالين.وقد جدد رسول الله ﷺ معنى هاتين
الآيتين فيما رُوي عن عدي بن حاتم قال: إن المغضوب عليهم، قال:
اليهود.قلت: الضالين؟ قال النصارى).(مسند ابن حنبل، ج٤).ونقل
الترمذي الحديث بهذه الرواية وقال عنه : حسن غريب.ونقل ابن مردويـــه
Page 77
التفسير
كبير
سورة الفاتحة
عن أبي ذر الغفاري، قال: سألت رسول الله (ص) عن المغضوب عليهم،
كثير
قال اليهود :قلت الضالين؟ قال : النصارى.وقد ثبت هذا المعنى عن
من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال ابن أبي حاتم: (ولا أعلم
بين المفسرين في هذا (اختلافا)."تفسير ابن كثير".ويمكن أن نستدل بالقرآن أيضا على هذا المعنى، فقد ورد فيه عن اليهود:
(فباءوا بغضب على "غضب سورة البقرة : ۹۱.وجاء فيه عن النصارى:
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سورة الكهف ١٠٥".وقال عنهم بعد
أن ذكر منهم من يؤله المسيح وأمه : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير
الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء
السبيل" سورة المائدة: ۷۸".أخبر الله هنا أن عامة النصارى مـــا كـــانوا
مشركين بل كان بعضهم مؤمنين وبعضهم مشركين والمشركون منهم
كانوا ضالين ومضلين أيضا بسبب دعوتهم سائر النصارى الذين قبلوا
الدعوة، واستبدلوا الشرك بالتوحيد ومجمل القول: إن القرآن الكر
والأحاديث الصحيحة تدل على أن المراد بالمغضوب عليهم والضالين هــم
اليهود والنصارى.والعبارة بدل من "الذين" أو الضمير في (أنعمت عليهم ومعناها: اللهم
اهدنا الصراط، صراط المنعم عليهم، وليس صراط الذين أنعمت عليهم ثم
تولوا على أعقابهم وأصبحوا من المغضوب عليهم، ولا صراط من يغالي في
حب سواك فيضل.وقد توفرت في ذلك دواعي العبرة والإنذار للمؤمن.
Page 78
التفسير
كبير
٦٧
سورة الفاتحة
فليتذكر أن عليه أن لا يطمئن ما لم يبلغ إلى مأمن من الضلال.وليواصـــل
جهوده كي لا تزال قدم بعد ثبوتها لأقل ،غفلة، فتنهار به إلى الهلاك.وفي هذه الآية نبأ عظيم يمكن أن يحفز الرجل العاقل للتزود بالإيمان.فعند
نزول هذه السورة لم يكن اليهود ولا النصارى في اعتبار رسول الله ،
بل كان كفار مكة هم الذين يقفون ضده يومئذ، وكـــان عــدد اليهود
والنصارى في مكة ضئيلا جدا، وما كان لهم سلطان في حكومة مشركي
مكة.ولما جاء الدعاء (اهدنا الصراط المستقيم لم يرد بصيغة (غير
المشركين، بل ورد (غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اليهود
والنصارى..فكيف كان ذلك؟
يصبح
الجواب أن الله تعالى أومأ بذلك إلى أن ملة المشركين ستنمحي إلى غـــير
رجعة، فلا حاجة لكم إذن إلى طلب تجنب طريق المشركين.لكن اليهـود
والنصارى سيبقون..فدعت الحاجة إلى أن يدعو المسلمون ليتجنبوا عن
طريقهم.فنبه الله تعالى المسلمين وأمرهم أن يكفروا في كل احتمال، لأن
فتنة اليهود يمكن أن تفاجئهم من غير مأتاها.ثم من الممكن أن
المسلمون أنفسهم مثل اليهود، ولك بإنكار المسيح الموعود والإمام المهدي
كما أنكر اليهود المسيح ابن مريم وهذه الحالة تحدث عند استفحال فتنــــة
المسيحية الضالة.فكأنهم سيحرمون من نصر الله لتشبههم باليهود، ثم
تهاجمهم المسيحية الضالة فتنزع منهم الوفاء من أبنائهم.أليست هذه الآية
نبأ عظيم؟ أليس باستطاعة المسلمين أن يستفيدوا منها وينجوا مــن هـاتين
الفتنتين؟
Page 79
التفسير
كبير
٦٨
سورة الفاتحة
عند إمعان النظر نتبين حكمة لطيفة أودعها الله هذه السورة.فالصفات
الإلهية وصيغ الدعاء وقعت متناسبة تماما:
فصفة (الحمد الله) يقابلها من الدعاء إياك نعبد) وهذا إشارة إلى أن
الإنسان عندما يشعر بأن الله جامع لجميع أنواع الحمد..تدفعه الفطرة أن
يقول (إياك نعبد).وصفة رب العالمين يقابلها من الدعاء إياك نستعين)، وذلك لأن
الإنسان عندما يجد أن الله هو خالق كل ذرة من السماوات والأرض وهـــو
رب محسن..يلتجئ إليه ويقول: (إياك نستعين) وصفة (الرحمن) يقابلها من
الدعاء (اهدنا الصراط المستقيم)، لأن الإنسان عندما يشعر أنه أعطى جميـــع
حاجاته بلا مقابل..فإنه يصيح قائلا: اللهم إن أهم حاجة لي.هي أن أتصل
بك والتقرب إليك فاهدني إلى الصراط المستقيم.وصفة (الرحيم) يقابلها من الدعاء صراط الذين أنعمـــت علـيهم)،
والرحيم صفة الذات التي تقدر عمل الإنسان حق قدره.فكأن العبد يطلب
إلى الله تعالى أن تكون أعماله مؤدية إلى النعم التي أنعم الله بها على عبـــاده
المصطفين فالرحيمية تقضي ألا يضيع عمل عامل.ثم (مالك يوم الدين يقابلها من الدعاء (غير المغضوب عليهم ولا
الضالين)، لأن العيد عندما يتيقن أن الله سوف يحاسبه حسابا عادلا، يشعر
بالخوف من الخسران المقبل، ويدعو أن يكون من غير المغضوب عليهم ولا
الضالين..ليكون بمنجاة من غضب الله.
Page 80
التفسير
بير
٦٩
سورة الفاتحة
وإذا تدبرنا في آيات هذه السورة المباركة، وأمعنا النظر في ترتيبها، وجدنا
جليا أنها تتضمن تعليمات ارتقائية تدريجية لمراحل القرب.إن عبادة المعبود
تكون إما لحبه أو لخوفه..والله تعالى وجه الإنسان في هذه الصورة إلى كلتا
الناحيتين من صفاته.فالذين طُبعوا على الشكر لنعم الله يعبدونه لأجل هذا
الحب وهذا الإحسان ومن الناس من لا يبالون بالنعم، ولكن الخوف من
العقاب يحملهم على الطاعة والعبادة.فينبغي للحكيم أن يرغب أولا بالنعم،
فإذا لم ينفع ذلك عليه بالترهيب بالغضب.فالله تعالى..وهـو أحكــم
الحكماء..اختار هذا الأسلوب في هذه السورة، فذكر أولا الصفات التي
تغمر القلب حبا له عز وجل..فذكر اسمه..(الله)..معناه الجامع الجميع
المحامد، المنزه عن كل المعائب الخالق الرازق لكل شيء، تعــــم ربوبيتــــه
المؤمن والكافر، وهو الذي هيّأ لحياتنا مقدمات ووسائل دقيقة لا نستطيع
ندرك حقيقتها، وإذا عملنا عمل جزانا به الجزاء الأوفى.فالذين اعتادوا على
والخضوع للسماحة والكرم ، عندما يفكرون في هذه الصفات
أن
الطاعة والخضوع
يتطلعون له عز وجل بقولهم: إياك نعبد لكن الذين لم يجربوا تأثير الحب
والإحسان ولا يتأثرون إلا بالشدة، فهؤلاء عندما يفكرون في صفة (مالـــك
يوم الدين) ويرون يوم الحساب ماثلا أمامهم يوم يحاسبون على النعم
حسابا عسيرا، عندئذ يخضعون له خوفا من الحساب، ولا يلبثون إلا أن
يقولوا إياك نعبد).وبعد ذلك عندما يشعر بالضعف والعجز في نفسه، وعندما يدرس هـ
الآيات ويفكر في عظمة الله ،وجبروته يتضرع في طلبه ويضيف إليه (إياك
هــذه
Page 81
التفسير
بير
۷۰
سورة الفاتحة
نستعين)..أي إني أطيعك وأعبدك ، لكنني لا أستطيع أداء ما عليَّ من حـــــق
العبادة..من أجل ذلك فإني أستعين بك على هذا العمل، فوفقني أن أقوم
بواجب الطاعة حق القيام.فإذا كان الحب قد بلغ بالإنسان هذا المدى مـــن
شدة الشعور بعظمة الله وسلطانه، عندئذ لا يعتم أن يقول: (اهدنا الصراط
المستقيم).وهذا يدل على كمال الحب، لأن العبد يقول: اللهم لقد عرفتك
بهذه الصفات الجميلة، فالآن لا أستطيع البقاء بعيدا عنك، فاهدِني إلى أقصر
طريق مستقيم وسط خلو من الإفراط والتفريط.ثم يقول: (صراط الذين أنعمت عليهم، لأن المشرفين بالقرب تتفاوت
درجاتهم حسب أعمالهم، بعضهم من
أعمالهم بعضهم من الطائفة العامة، وبعضهم من
الخاصة، ولذلك يقول العبد: صراط الذين أنعمت عليهم)..أي اجعلني من
الطائفة الخاصة المنعم عليها.لا أحب أن أتخلف في العامة من عبادك، بـل
أريد أن أصبح محبا محبوبا لك وكما أنني أشتاق إليك كذلك أحب أن أراك
مشتاقا لي، لأن المنعم عليهم هم الطائفة المحبوبة.الطائفة
وهكذا يبلغ العبد إلى درجة الاتصال التام.وهناك تنكشف حجــب
المغايرة بين العبد وربه، ويتحقق له القرب الكامل بوصال المحب إلى المحبوب،
ويتمنى العبد أن يدوم هذا الاتصال ولا ينقطع أبدا.من أجل ذلك علمه الله
تعالى أن يدعوا لبقاء هذه العلاقة الطاهرة، وأن يسأل فضل الله وتوفيقــــه
لتعزيز هذه الصلة المقدسة.والانقطاع الذي يخل بهذه الرابطة يحدث بوجهين: إما أن يغضب المحبوب
ويطرد المحب من حضرته أو يضل المحب عن الطريق المستقيم ويبتعد عن
Page 82
التفسير الكبير
۷۱
سورة الفاتحة
المحبوب.لأجل ذلك علم الله العبد أن يقول: (غير المغضوب عليهم ولا
الضالين أي لا أريد أن أخطئ فتطردني من جنانك أو أن أضل بالمغالاة في
حب غيرك بعد إذ هديتني إلى الصراط المستقيم.هذا هو الدعاء الكامل الجامع الذي علّمه الله الناس رحمة بهم وفضلا
عليهم.إنه دعاء لا يمكن لدين من الأديان أن يأتي بمثله.ألم تروا كيـف
حللت الفطرة الإنسانية تحليلا دقيقا وكيف عولجت جميع النظريات المتطرفة
المتنوعة في هذه السورة القصيرة.ألا فليعقل العاقلون أن لا نجاة اليوم إلا
بالإسلام، ولا شفاء من الأمراض الروحية إلا بالقرآن.آمين: أي الهم استجب لنا.ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله
كان عندما ينتهي من قراءة الفاتحة يقول : آمين.وهذا هو العمل المطـــرد
الثابت عن الصحابة اقتداء بالنبي.
Page 83
سورة البقرة مدنية
وهي مع البسملة مائتان وسبع وثمانون
اسمها ورد هذا الاسم في عدة أحاديث على لسان الرسول ﷺ لا شك أنه لا يتضح من هذه
الأحاديث ما إذا كان النبي قد أطلق عليها هذه التسمية بنفسه أم بوحي من الله تعالى، ولكني على
يقين أن أسماء السور كانت بأمر الله تعالى.ومن الروايات التي تذكر هذا الاسم: عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله ﷺ: "لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن..هي
آية الكرسي." (الترمذي، أبوب فضائل القرآن)
نزلت هذه السورة في المدينة المنورة على فترات وعند البعض أن قوله تعالى: وَاتَّقوا يومًا تُرجَعون
فيه إلى الله (الآية ٢٨٢) ' نزل يوم النحر من حجة الوداع وأيضًا نزلت آيات الربا في الأيام الأخيرة من
البعثة النبوية.الترمذي، أبواب فضائل القرآن.وابن ماجة)
ومما جاء عن فضائل سورة البقرة:
عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله الله بعثا وهم ذو عددٍ فاستقر أهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني
معي
ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنًا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال كذا
وسورة البقرة.فقال : أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم.قال : اذْهَب فأنت أميرهم.منعني
وكذا
فقال رجل من
أشرافهم: والله ما أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها.فقال رسول الله
ﷺ: تعلموا القرآن
واقرءوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكًا يفوحُ ريحه في كل مكان،
ومَثل مَن تَعلّمه فيرقُدُ وهو في جوفه كمثل جراب أُوكِيَ على مسك." (الترمذي، أبواب فضائل القرآن،
سورة البقرة)
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت تقرأ البقرة فيه لا يدخله
الشيطان." (المرجع السابق)
عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه."
(المرجع السابق)
لقد وضعت أرقام الآيات في هذا التفسير باعتبار البسملة آية من كل سور القرآن، ما عدا سورة التوبة (الناشر).
Page 84
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ
آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ
شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حتى يُصْبحَ : أَرْبَعًا مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَهَا وَثَلَاثٌ حَوَاتِيمُهَا أَوَّلُهَا: وَلِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ....(سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن، سورة البقرة).هذه الفضائل الذاتية لسور القرآن تشق في الظاهر على بعض المتعلمين إذ لا يستسيغون وجود كل
هذا التأثير الخاص في سورة ما.ولكن لو أنهم نظروا من زاوية أن كل سورة تحتوي على موضوع
خاص، ولا بد لهذا الموضوع أن يترك أثراً على القلب لسهل عليهم فهم قضية الفضائل هذه.وفي تعيين الرسول ل لذلك الشاب أميرًا على الجيش حكم عديدة.:أولها أنه رغب الآخرين في حفظ القرآن وعدم نسيان ما حفظوه.كانت إمارة الجيش في ذلك
الوقت لا تمثل كسبًا ماديًا وإنما كانوا يسعون إلى اكتساب رضا أبيهم الروحي و بدافع حبهم الذي لا
يقدر قدره إلا من عرف لذة مثل هذا الحب.وثانيها: أنه جرت العادة في تلك الأيام أن يكون أمير الجيش أيضًا إمام الصلاة، ومرجع الناس في
المسائل الدينية وتحتوي سورة البقرة على مسائل دينية أكثر من أي سورة سواها..حتى قال حضرة ابن
العربي إني سمعت من بعض أساتذتي أن في هذه السورة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر
(تفسير القرطبي).وهذا القول فيه لمحة من الصوفية، ولكن لا يمكن إنكار أن سورة البقرة لا تجاريها
سورة أخرى من حيث تنوع المواضيع وسعة الأحكام.أما قوله بأن الشيطان لا يدخل بيتًا تُقرأ فيه سورة البقرة، فإنما يعني أنه إذا تدبر الإنسان ما تتضمنه
هذه السورة من وسائل لصد هجمات الشيطان ووساوسه لعجز الشيطان عن أن يدخل بيته.وأما قوله إن الشيطان لا يدخل البيت حتى الصباح..ففيه إشارة إلى أن التعليم، مهما كان
عظيماً، فلا يترك أثراً كاملاً إذا لم يُتعهد مرة بعد أخرى والتأثير الصالح مهما كان عظيماً، فإنه سرعان
ما يزول ما لم يُجدد.في
وأما قوله الله إن من قرأ الآيات العشر المذكورة في الحديث فرَّ الشيطان من بيته..فالمراد به أيضا أن
هذه الآيات خلاصة الإسلام.فالآيات الأربع الأولى من سورة البقرة ترسم صورة لحياة عملية طاهرة.أما آية الكر.والآيتان التاليتان لها والآيات الثلاث الأخيرة منها فتشتمل على دعوات تطهر القلب..وهذه الأمور الثلاثة، أي الأعمال الصالحة بحسب كلام الله تعالى، والتفكير في صفاته تعالى، والارتماء
على العتبة الربانية بالدعاء والابتهال..إذا اجتمعت تَطَهَّر قلب الإنسان وفرَّ عنه الشيطان.ترتيب السورة:
Page 85
هذه السورة هى أول سورة من المفصلات بدأ نزولها من السنة الرابعة عشرة للبعثة النبوية، ولم تزل
تتنزل لسنوات حتى اكتملت قبل وفاة الرسول
ﷺ بقليل.لماذا حدث ذلك؟ لماذا لم يدون المصحف
حسب نزول الوحي القرآني؟
لقد أجاب على السؤال بعض أعداء الإسلام، بل بعض المسلمين بقولهم أنه قد تم تدوين القرآن الكريم
حسب طول السور ،وقصرها، دون أن يلاحظ في ذلك أي ترتيب معنوي وهذا الزعم لغو بعيد عن
الحقيقية تماما وذلك للأسباب التالية:
سبع
أولاً : ترتيب السور في المصحف يبطل هذا الادعاء، فالسورة الأولى (الفاتحة) قصيرة حيث تشتمل
على
آيات فقط، والسورة الثانية (البقرة) طويلة جدا، والثالثة (آل عمران) هي أقل من ١١ ربعا،
والرابعة (النساء) هي ١٢ ربعًا، والسور التالية أيضًا تختلف من حيث الطول والقصر اختلافا كبيرًا.فالقول بأن السور مرتبة حسب طولها غير صحيح.إن
ثانياً: جمع القرآن الكريم ليس من عمل البشر، بل ولا من فعل الرسول ﷺ، لقول الله تعالى:
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) (القيامة): ۱۸)..أي أن جمع القرآن الكريم ونشره في أنحاء العالم هو من اختصاصي
أنا، وسوف يتم كلاهما بأمري وتحت إشرافي.فلا يمكن للمسلم أن يعتبر جمع القرآن وترتيبه من عمل
إنسان.أما غير المسلمين فلهم جوابنا الذي ذكرناه آنفا.ثالثا: إن لكل سورة من القرآن الكريم مضمونًا خاصا بها يتصل بمضمون السورتين السابقة واللاحقة
لها.ولو كان ترتيب السور حسب طولها وقصرها ما أمكن أن يتحقق هذا الربط والوصل بين
مواضيعها.ولسوف يتضح هذا الأمر جليا عند تناول الربط والوصل بين مواضيع سور القرآن..بما لا
يحتاج إلى مزيد من البيان.ولسائل أن يسأل إذا كان ترتيب سور القرآن في المصحف من وحي الله تعالى..فلماذا لم يتزل القرآن
بهذا الترتيب نفسه؟
وجوابًا على ذلك نقول من اللازم أن يكون ترتيب الكلام الحكيم مختلفا عن ترتيب نزوله، فكلما
:
يبعث نبي بشريعة جديدة فيها عقائد وتكاليف للناس وتتضمن منهجًا وهداية تامة..فلا بد أن يكون
بداية ما يتترل عليه من وحي مختلف عما يبدأ به تدوين ذلك الوحي..لأن الأمور التي يجب بيانها للناس
في بداية دعواه، عندما يكونون غير عارفين بدينه تماما..يجب ألا تُذكر في بداية التدوين..عندما
يكونون قد عرفوا كلام الله إلى حد ما.وبمقتضى هذه الحكمة كان ترتيب نزول سور القرآن مختلفا عن
ترتيب تدوينها في المصحف.
Page 86
كما أن كيفية نزول الآيات تحل مسألة نزول السور.فالثابت من الحديث أن الرسول ﷺ كلما نزلت
6
عليه آيات من القرآن كان يأمر كتاب الوحي أن يضعوا آية كذا في المكان الفلاني، والآية الأخرى في
مكان آخر أبو داود الترمذي، ابن حنبل والمشكاة.فإذا كان ترتيب الترول كافيا لوضعت كل آية
جديدة بجانب الآيات السابقة في التتريل.خذوا مثلاً سورة البقرة..نجد أن آيات الربا منها هي من
من آخر
أجزاء القرآن نزولاً، ولكنها لم توضع في آخر السورة.كذلك الحال في نزول قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا
صلے
تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ) (البقرة: ۲۸۲).فقد ورد في الحديث أنه نزل أيام حجة الوداع ومع ذلك لم يوضع أيضًا في آخر السورة.فتبين أن
الآيات لم تكن توضع من سور القرآن بحسب ترتيب نزولها وإنما بحسب مضامينها.وهكذا كان الحال
في ترتيب السور، فهى مرتبة في المصحف بحسب مضامينها لا بحسب نزولها.وجدير بالتذكر أن أول ما نزل من الوحي القرآني هو هذه الآيات من سورة العلق: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ : خَلَقَ الْإِنسَن مِنْ عَلَقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ :
عَلَّمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ).في هذه الآيات أمر بالتبليغ ودعوة الناس إلى الله.وقد أوجب الله على الإنسان القيام بهذا التبليغ لأن
له ربا خلقه وأودع قلبه فطرة الحب والتعلق ربًّا زوده بقوى الرقي والتقدم، ربًّا يحب لعبده الازدهار
فضلاً منه وكرماً..ولذلك وهبه ملكة التعلم والتحرير والتصنيف..كي لا ينتفع بعمله وحده، بل
يوصله للآخرين، فينتفعوا به ويحفظوه للأجيال القادمة.وفضلاً عن تزويد الإنسان بالمقدرة على التعلم
والترقي فيه، وتوصيل المعارف للآخرين، وطريقة حفظها من الضياع..فإنه عز وجل أوجد الوسائل التي
يترتب عليها الرقي العلمي في كل ،زمان ويكتشف بها الإنسان كل جديد لم يكن معلوما لدى آبائه.في هذه الآيات وجه القران الكريم نظر النبي الله إلى ضرورة التبليغ.وأخبر أن هناك خالقا للسماوات
والأرض وأخبر أيضا أن الإنسان في حاجة إلى الهداية، وأنه مزود بقوة تساعده على الاهتداء والازدهار،
ومن أجل تنبيه هذه القوى وصقلها ينزل الوحي السماوي.وما كان بُدّ من ذكر هذه الأمور قبل
التكليف بالنبوة؛ فأول ما يخاطب الإنسان يخاطب نفسه وما لم يمتلئ قلبه حماسًا وإخلاصا وإحساسا
بأهمية الأمر وضرورته فإنه لا يوطن نفسه أبدًا لأمور تتطلب منه تضحية براحته بل بحياته.
Page 87
هذا الموضوع تتضمنه هذه الآيات الأولى من الوحي القرآني، بل تناولته أيضا السور التي نزلت في
الفترة الأولى من الوحي.فمثلاً سورة المدثر تشير إلى ذلك الموضوع حيث تقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ
قُمْ فَأَنذِرٌ : وَرَبَّكَ فَكَبْر.أي يا من تدثّرت بخلعة النبوة..قم ونبه الناس وكبر ربك.ثم هناك سورة المزمل وهي من أوائل
السور
نزولاً..تبدأ بقوله تعالى: (يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (3) قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ( نِصْفَهُ أَوِ
انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْهَانَ تَرْتِيلاً : إِنَّا سَنُلْقِى
عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً...يا من تزمّلت برداء النبوة..قُمْ في الليالي لعبادة الله، واقضها في قراءة
القرآن، لأننا سنحملك مسؤولية لا يسهل حملها.يتبين من مضامين هذه السور الأوائل في التنريل أنها إلى جانب بيان صفات الله تعالى، والغاية من خلق
الإنسان، وضرورة عبادة الله وذكر انتشار الشرور والآثام، وغيرها من المواضيع..فإنها تحث النبي
على التبليغ والدعوة إلى الله، وتسعى لخلق الحماس في قلبه للقيام بذلك.أو بعبارة أخرى أعدت هذه
الآيات الرسول ﷺ المهمة جديدة..هي مهمة النبوة والظاهر أنه بدون هذا الإعداد لم يكن ليدرك
خطورة هذه المهمة التي سيعهد بها إليه، كما لم يكن ليؤديها حق الأداء.وإذا، كانت هناك في البداية
ضرورة لمثل هذا الوحي.ثم بعد هذا كانت هناك حاجة لبيان صفات الله تعالى، وضرورة النبوة،
ومواضيع التقوى والطهارة وأهمية الدعاء، ومسائل القضاء والقدر والبعث بعد الموت..إذ لم تكن هناك
جماعة قد تكونت بعد، ولم يكن الدين قد اكتمل، وكان من الضروري أن تبين للناس بإيجاز أمور
أساسية هامة..كي يعرفوا هذه المبادئ التي تميز الإسلام عن الديانات الأخرى.وعندما اكتمل نزول القرآن وازداد عدد المسلمين وعرف الذين كانوا يعيشون معهم من غير
المسلمين بهذه الأمور، ووجد جيل جديد من المسلمين الذين تعلموا هذه المبادئ الأساسية من آبائهم..ظهرت الحاجة إلى ترتيب القرآن للقارئ ترتيبا آخر يسد حاجات كل زمن إلى الأبد.ولم تكن عندئذ
حاجة ليقال للرسول ﷺ أن يا محمد، إن قومك قد فسدوا، وعندهم ملكات عطلوها ولا يستفيدون
أنت
منها، فقم وبلغهم كلام وادعهم إليه الآن يجب أن يكون أول المخاطبين بالقرآن الكريم هم
المؤمنون به، الذين تحقق في زمنهم انتصار الإسلام ويجب أن تكون للقرآن بداية تبين به الغرض من
الله
Page 88
نزوله، وما عليهم من مسؤوليات بوصفهم مسلمين.كما لا بد الآن أن يحاول غير المسلمين النظر إلى
القرآن نظراً فلسفيًا متسائلين ما الحاجة إلى دين الإسلام في وجود ديانات أخرى؟ وما هي الغاية التي
يحققها المسلم ولم يحققها أبناء الديانات الأخرى؟ كما سيقارنون تعليم الإسلام بتعاليم الكتب السابقة
مقارنة تفصيلية، ويبحثون فيما إذا كان الإسلام ونبيه مصداقا للنبوءات التي جاء بها الأنبياء السابقون
عن خاتم النبيين.وخلاصة القول إنه بعد اكتمال التزول..اختلف الأسلوب الذي يتوجه به المؤمنون وغير المؤمنين إلى
القرآن الكريم.والكتاب الكامل لا يمكن أن يبقي على كماله إلا إذا وضع في الاعتبار هذه الحالات
المتغيرة والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي سد هذه الحاجة، وراعى هذه الحكمة التي لم تراعها
التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهما من الكتب السابقة..بحيث كان ترتيب الكلام الإلهي في بداية نزوله مراعيا
المخاطبين الأول، ثم تغير ترتيبه بعد انتشار الدين ليراعي حاجات الناس في ذلك الوقت وما بعده..حتى
يكون لمواضيع الكتاب وقع أكبر بحسب الأحوال المتغيرة.فالفرق الموجود بين الترتيب القرآني من حيث
الترول، وترتيبه من حيث التدوين، ليس محل اعتراض..وإنما هو علامة امتياز وفضيلة.أما سورة البقرة فيتبين عند دراستها أنها تردّ على كل الأسئلة الطبيعية التي تثيرها الفطرة الإنسانية من
وجهة النظر الفلسفية إزاء الدين الكامل.وتدل مضامينها على أنها ما نزلت إلا لتأتي في بداية القرآن..بل إنها، كما سنبين، ترتبط بسورة الفاتحة ارتباطًا خاصا وتتمم مضامينها..مما يدل مرة أخرى أنها لم
توضع في بداية القرآن ،لطولها، وإنما بسبب ارتباطها العميق بمضامين سورة الفاتحة.هناك لطيفة أدبية جديرة بالذكر بصدد سورة البقرة لبيد بن ربيعة العامري شاعر جاهلي من شعراء
المعلقات أسلم في آخر أيامه وتأثر بفصاحة سورة البقرة وبلاغتها حتى هجر قرض الشعر.وسأله سيدنا
عمر رضي
الله عنه أن ينشده شيئًا جديدًا من شعره..فأخذ لبيد يتلو سورة البقرة.فقال له سيدنا عمر :
سألتك أن تنشدني بعض شعرك الجديد؟ فأجاب لبيد: ما كنت لأقرض بيتا من الشعر بعد أن علمني الله
البقرة وآل عمران فسُرِّ عمر من جوابه كثيرًا وأمر بزيادة راتبه السنوي من ألفي درهم إلى ألفين
وخمسمائة درهم.(أسد الغابة)
قد تبدو هذه الواقعة في ظاهرها عادية ولكننا إذا وضعنا في الاعتبار مقام لبيد بين العرب وقتئذ فلا
تبدو عادية.كان لبيد ذا مكانة مرموقة في الأوساط الأدبية العربية في زمن أوج الأدب العربي، وكلام
شعراء ذلك الوقت يعتبر حتى اليوم من أجمل الشعر.هذا الشاعر الكبير الذي كان يعد ملك البلاغة
والشعر يتأثر من بلاغة سورة البقرة وينبهر منها حتى يتخلى تماما عن قرض الشعر الذي كان غذاء روحه
و سبب عزه، والذي بوءه مكان الصدارة في مجالس الحكام العرب.وعندما طلب إنشاد بعض كلامه
Page 89
الجديد..قال في حيرة هل بقى هناك مجال لكلام آخر غير سورة البقرة؟ وهذا يجبرنا على الاعتراف بأن
هذا التأثير لا يمكن أن يكون إلا من كلام معجز.خلاصة سورة البقرة
قبل أن أشرع في تفسير السورة آية آية..أرى من المناسب هنا أن أجمل خلاصة مضامينها، وهذا
سوف ييسر على القارئ تفهم سبب وضع هذه السورة في مقدمة القرآن الكريم رغم تأخرها نزولاً،
وإدراك ترتيب مضامينها بصورة موجزة وهذا بدوره سوف يساعده على فهم معانيها.النكتة
التي
لقد ذكرت عند تفسير الفاتحة أن ملاكا علمني تفسيرها في الرؤيا.أما تفسير سورة البقرة فلم أتلقنه
بهذا الطريق، ولكن مما لا شك فيه أن الله تعالى قد علمني إياه عن طريق الإلقاء.وكل من تدبر يدرك أن
عُلّمتُها في هذا الصدد تحوّل هذه السورة كلها إلى موضوع مرتب ترتيبا محكما، وبالتالي لا بد
له من التسليم بأن هذا التفهيم لم يكن إلا بفضل وحده وبيان ذلك أنه قبل حوالي سبع وعشرين
سنة كنت أعلم القرآن لبعض أصدقائي، وكان الدرس في سورة البقرة.وعندما وصلت إلى قوله تعالى:
(رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَهُمْ وَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب
الله
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم)(١٣٠)..ألقي في روعي فجأة أن هذه
الآية هي مفتاح مضامين سورة البقرة، وأن مواضيعها هي نفس مواضيع السورة، ورتبت بنفس الترتيب.وعندما درست سورة البقرة على ضوئها لم يكن هناك حد لدهشتي وسعادتي وامتناني الله تعالى إذ
وجدت مضامين سورة البقرة مطابقة تماماً لمضامين هذه الآية.ليس هذا فحسب، بل رسخت هذه
المضامين في ذهني رغم تعددها حتى وجدت أنها منظومة كعقد من اللآلئ.إذا تدبرت هذه الآية وجدتها تذكر دعاء لسيدنا إبراهيم دعا به الله تعالى ليبعث نبيا في مكة.يقول
الدعاء: ابعث يا رب في هذا البلد وبين هذا القوم، نبيا يقوم بالمهام التالية:
الله
يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَتِكَ....أي يأتي بآيات ودلائل من تعالى تصحح الإيمان واليقين
وتقومهما، وتنشئ علاقة بالله تعالى وتكون معالم ومنارات على الطريق المؤدي إلى الله تعالى:
(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.....أي يقدم للناس كتابًا شاملاً كاملاً.
Page 90
وَالْحِكْمَة....أي يأتي بشريعة مصحوبة ببيان حكمة أحكامها والغرض من الدين والأمور
المتعلقة به والتي عليها مدار رقيه.ركيهم...أي يختار وسائل تهدف إلى ازدهار الأمة وطهارتها.وعندما درست سورة البقرة على ضوء هذه المواضيع وجدت مواضيعها تتطابق تماما مع مواضيع الآية
لفظًا لفظاً، بل وجدتها مرتبةً بنفس الترتيب المذكور في الآية.كما وجدت في كل عنصر من هذه
العناصر الأربعة إشارات إلى كلمات هذه الآية.بمعنى أن مضمون آيات سورة البقرة تشير إلى الآيات
والدلائل، ثم إلى الكتاب، ثم إلى الشريعة وحكمتها ، ثم إلى التزكية فقد ورد موضوع "تعليم الكتاب"
حتى الركوع٢ رقم ٢٠ عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ
قل
مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم
بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ) (البقرة : ١٦٨).ثم موضوع "حكمة الشريعة" بعد ذلك حتى الركوع رقم
٣١ عند قوله تعالى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) (آية:
٢٤٣).ثم موضوع "التزكية" يستمر إلى آخر السورة.ومن يدرس سورة البقرة من هذا المنظور يدرك
بشكل مدهش سعة وشمول معانيها، وما لترتيبها من حسن وتأثير.خلاصة الركوع الأول (الآيات من 1 إلى ٨)
في سورة الفاتحة دعاء علمنا الله إياه لطلب الهداية، وفي الآيات الأولى من سورة البقرة إشارة إلى هذا
هذا
الدعاء وقيل: إن الهداية التي التمستموها في سورة الفاتحة أي هداية المنعم عليهم في السابقين، هي
الكتاب..القرآن الكريم.وبترول هذا الكتاب لبى الله تعالى نداء الفطرة الذي كان يهز عرش الرحمن،
والذي ارتفع من قلوب الناس عند اندراس هداية الكتب السابقة.ثم يقول عز وجل إن القرآن الكريم لا يقدم للعالم منهجًا هاديًا فحسب بل منهجًا كاملاً شاملاً كل
الحقائق الموجودة في الأديان السابقة..ولذلك لا يبنى دعواه على الطعن والتشكيك في تلك الديانات.وهذا الكتاب لا يقتصر على تحسين أخلاق وتصحيح سلوك الإنسان فحسب، بل يسمو به إلى مقام
بالإضافة إلى تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع، فإنه ينقسم أيضًا إلى ركوعات..وهي أقسام صغيرة تناسب القراءة في ركعات الصلاة، وهي
مألوفة في المصاحف المطبوعة خارج الجزيرة العربية..وخاصة في القارة الهندية وإيران وأفغانستان وأندونيسيا وبعض بلاد المغرب العربي.
Page 91
توطيد علاقة حب خالص مع ربه تعالى.يذكر هذا الكتاب أمورا اعتقادية يجب أن يؤمن بها المؤمنون،
كما يبين لهم طرق العبادة التي ينبغي لهم السير فيها، ويوضح لهم حقوق بني جنسهم التي لا بد لهم من
أدائها.كما يذكر لهم هذا الكتاب أحوال مؤسسي الديانات السماوية السابقة، ويتناول كل الحقائق
المتعلقة بالماضي والمستقبل التي يجب عليهم الإيمان بها كلها.وينبغي ألا يكون هذا الإيمان شكلياً، بل لا
بد من تقديم التضحيات في سبيله..لأن الناس سوف يعارضونهم، ولكن يفشل المعارضون في النهاية.خلاصة الركوع الثاني الآيات من (٩ إلى (۲۱)
وسيكون هناك أناس منافقون يتظاهرون بالإيمان وقلوبهم فارغة منه.وسيكون هناك طائفة أخرى
مؤمنة، ولكنهم لجبنهم الشديد لا يترددون في إقامة علاقات سرية مع أعداء الإسلام.إلا أن عداوة
هؤلاء ومؤامرات أولئك..لن تضر الإسلام شيئا.خلاصة الركوع الثالث (الآيات من ٢٢ إلى ٣٠)
فعلى كل من يؤمن بالله تعالى أن يدخل في هذا الدين، ويشترك في عبادة الله وحده، وينال مقام
التقوى، ويصل بمعونة القرآن الكريم إلى ربه..فهذا هو الغرض من خلق العالم.وإذ قال قائل كيف نقبل
هذا الإدعاء القرآني؟ فقل لهم : لا بد وأنكم تتبعون دينًا من الأديان، فقيسوا القرآن بتعاليم دينكم.فإن لم
تجدوا تعاليمه أسمى مما عندكم فلكم الحق عندئذ في رفضه..وإلا فلا مناص لكم، بناء على مبادئ دينكم
من التسليم بكون هذا الكتاب سماويا متضمنًا تعليمًا أسمى مما في الكتب السابقة.كما يمكن لكم أن
تتباروا مع أتباع القرآن في مجال الإتيان بالآيات السماوية لتعرفوا من الذي يحظى بتأييد الله تعالى.فإن
أبيتم
إلا الرفض دون تفكير فلا مفر لكم من عذاب النار.ولا شك في أن المؤمنين بهذا التعليم سينالون
النعم الإلهية باستمرار، لكي لا يظن أحد أن هذه النعم جاءتهم صدفة وليست ثوابا من
لقد أشرنا إلى هذه النعم على وجه الإجمال، وإلا فسوف تتضح عظمة هذه البشارات في حينها..وعندها يزداد الكافرون كفرا والمؤمنون إيمانا ويقينا.وحرمان الكافرين من الإيمان نتيجة طبيعية، فالعين
المريضة لا تستطيع رؤية النور.الله تعالى.كيف لا تستطيعون رؤية صدق ،القرآن وهو ليس بدعا من الكلام الإلهي.فقد جاءت الهداية
السماوية في الماضي إلى أقوام كانوا موتى في الروحانية فبعثوا بها من جديد.فما الذي يقطع سلسة
الهداية هذه؟ لقد جاءكم الحق من الله تعالى طبقا لهذه السنة الإلهية المستمرة، وليأتين في المستقبل كذلك.وما المانع من قياس صدق القرآن بالمقاييس التي عُرف بها صدق الكتب السابقة؟
Page 92
ثم يقول : لم لا ينظر هؤلاء إلى نظام الكون الدال على سنة الارتقاء الذي تتجلى فيه يد القدرة الإلهية؟
ولماذا يختلقون الأعذار الواهية ليرفضوا الحلقة الأخيرة من سلسلة الارتقاء، مع
أن هذه الحلقة الأخيرة هي
الهدف النهائي لنظام الارتقاء، وبتركها يبقى ناقصا.خلاصة الركوع الرابع (الآيات من ٣١ إلى ٤٠)
ثم يذكر الحلقة الأولى من هذه السلسة..سيدنا آدم أول من تلقى الوحي..فقال: إنكم تؤمنون
بآدم، فما الدليل على صدقه عندكم؟ إن بوسعكم معرفة صدق محمد ﷺ بالمعيار الذي عرف به معاصرو
آدم صدقه.لقد أثيرت الاعتراضات على ،شخصه ولم تكن من أشخاص عاديين، بل من أناس هم
كالملائكة، ولكن هل نال هذا من صدقه؟ إن الله تعالى أيده حتى لم يبقَ على ملائكيته إلا من أطاعوا آدم
ووضعوا أيديهم في يده، وخروا بين يديه في تواضع أما الباقون فقد تحولوا إلى شياطين.خلاصة الركوعات من ٥ إلى ١٤) الآيات من ٤١ إلى ١٢٢)
ولا يظنن أحد أن كلام الله قد نزل على آدم عليه السلام فلا حاجة إلى نزول كلام آخر بعده.فمن
المعلوم أن الله لم يزل يتزل وحيه بعد آدم حسب حاجة البشر..إلى أن نزل كلام الله تعالى على موسى
عليه السلام، وما ذلك منكم ببعيد.لقد بعث لإصلاح قومه ني بعد نبي، ولكن قومه ما انفكوا يعصون
مرة بعد مرة.فقضى الله تعالى بتحويل مركز الوحي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل فبعث فيهم محمدا
بشريعة نهائية.والآن بدأ بنو إسرائيل يعادونه حسدا من عند أنفسهم، وسيكون مصير هذه العداوة
مثل مصير عداوة الأمم الغابرة لأنبيائهم.خلاصة الركوع الخامس عشر الآية من ١٢٣ إلى ١٣٠)
ثم يجب على بني إسرائيل أن يعرفوا أن أفضال الله التي نزلت عليهم كانت بسبب وعود قطعها الله
تعالى لإبراهيم عليه السلام، و لم تكن هذه الوعود خاصة ببني إسحاق ،وحدهم، وإنما تشمل بني إسماعيل
أيضًا.لذلك كان من الضروري أنه إذا قصر بنو إسحاق في
أن
أداء واجباتهم يتم الوفاء لبني إسماعيل
بوعودهم.ولتحقيق هذه الوعود قدر الله تعالى مجيء إسماعيل عليه السلام للعيش في واد غير ذي زرع
عند مكة المكرمة.وأخيرا حان أن ينال بنو إسماعيل ثمرة هذه التضحية.فبعث الله الآن فيهم نبيا، من
مهامه أن يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.خلاصة الركوع السادس عشر (الآيات ١٣١ إلى ١٤٢)
Page 93
الله
ولا حق لبني إسرائيل أن يمتعضوا من ذلك، بل عليهم أن يتذكروا أن آباءهم إبراهيم وإسحاق
ويعقوب عليهم السلام قد نصحوهم بأن العز الحقيقي هو في الطاعة الكاملة.فعليهم أن ينالوا نعم
تعالى عن طريق طاعته، ولا يثيروا غضبه بالعصيان.خلاصة الركوعين ۱۷ و ۱۸) الآيات من ١٤٣ إلى ١٥٣)
يعترض بنو إسرائيل على محمد رسول الله له لأنه ترك قبلة الأنبياء السابقين..ولكنهم ينسون أن
القبلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي عامل على الوحدة ثم عليهم أن يتذكروا أن إجابة دعاء إبراهيم
في حق بني إسماعيل تتضمن نبأ بأن الكعبة المشرفة ستكون قبلة للناس، وأن مكة المكرمة ستكون مركز
الحج.فإذا كان محمد ﷺ هو الذي تحقق فيه هذا النبأ..فحُقَّ له أن يعلن كون الكعبة قبلة الناس وإلا
استحال على قومه نيل نصيبهم من البركات التي صارت منوطة بهذه القبلة نتيجة لدعاء إبراهيم.لذلك
أمره الله تعالى بتطهير الكعبة تطهيرا ظاهريا..وذلك بفتحها وتحريرها وإزالة معدات الشرك منها،
وتطهيرها باطنيا..وذلك بتخليصها من أفكار الشرك والكفر، وجعلها قبلة للعالم كله.خلاصة الركوع التاسع عشر الآيات من ١٥٤ إلى ١٦٤)
ثم يقول إن هذه المهمة محفوفة بالصعاب وأن الكفار سيسعون لمنع المسلمين من ذلك بحد السيف.فلا تخافوهم، بل امضوا قدما مستعينين بالدعاء والسعي الحثيث، وتذكروا أن من يُقتل في سبيل الله يفز
بالحياة الأبدية، وأن الفوز محتم للمسلمين، ولا بد أن تفتح مكة ليجد المسلمون الفرصة لتطهيرها ظاهرا
وباطنا.خلاصة الركوع العشرين (الآيات من ١٦٥ إلى ١٦٨)
في هذا الركوع استخدم القرآن كلمة (آيات) ليشير إلى قوله تعالى: (يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَتِكَ )
وبين أن الأمور التي ذكرناها آنفا ليست من قبيل الادعاء الفارغ، بل إن خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار وسائر الظواهر الكونية تصدق ذلك فأولا : إن قانون الكون المادي واكتماله
بالارتقاء يقضي وجود قانون الكون الروحي الذي يكتمل أيضًا بالارتقاء.وثانيا: سوف ترون بأنفسكم
أن السماء والأرض والليل والنهار والسحاب والرياح ووسائل النقل في البر والبحر، لا تنفك تعمل في
تأييد محمد رسول الله له ، ونصرته ، لتعرفوا أن هذا الشخص محبوب عند الله تعالى، وهذا هو السبب في
أن الكون كله يعمل لنصرته..وإلا فإن الذي يسلك طريقا ينأى
عن الله تعالى يُذل ويُهان.ولقد انتهى إلى هذا الركوع معنى قوله تعالى: (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ ).
Page 94
خلاصة الركوع الواحد والعشرين (الآيات من ١٦٩ إلى ١٧٧)
بدأ
من
هذا الركوع العنصر الثاني من دعاء إبراهيم..أي الشريعة مع بيان حكمها.فشرع بالأمر
بأكل الحلال والطيب لأن أعمال الإنسان تابعة لحالته الذهنية، وهذه تتأثر بالغذاء الذي يتناوله الإنسان.والحلال ما رخصت به الشريعة، والطيب ما تجيزه مبادئ الصحة والعرف والذوق السليم.وبين أربعة
أصول تتعلق بالأطعمة المحرمة، فقال: لا تأكلوا الميتة التي بدأت تتغير طعما أو رائحة أو هيئة؛ ولا تأكلوا
الدم وما شابهه..أي المواد السامة، ولا تأكلوا لحم الخنزير لأنه سيئ الطباع، ومن أكل لحمه أخذ من
سوء طبعه، ولا تأكلوا ما يُفقد الإنسان الغيرة لله تعالى..كالأطعمة التي توزع في مناسبات الشرك
وغيرها.خلاصة الركوع الثاني والعشرين الآيات من ١٧٨ إلى ١٨٣)
يبين هذا الركوع خلاصة التعاليم الإسلامية من إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية
والنبيين..كي لا يقع الإنسان في إنكار أي حقيقة من الحقائق.ويؤكد بضرورة حسن المعاملة مع الناس،
وعبادة الله والإنفاق في سبيل الأهداف القومية، وحسن الخلق والصبر والوفاء بالعهد، وإقامة العدل،
ومساعدة الأقارب بالبر، ووضع القوانين للتمدن الاجتماعي التي من أهمها قانون الميراث.خلاصة الركوع الثالث والعشرين الآيات من ١٨٤ إلى ١٨٩)
لا بد لتحسين الأخلاق من تدريب ظاهري، ولهذا الغرض فرض الإسلام الصوم.فالصوم يصحح
الأخلاق، ويساعد على الدعاء ويزيده تأثيرا.خلاصة الركوعين ٢٤ و ٢٥) الآيات من ۱۹۰ إلى (۲۱۱)
يتناول هذا الركوع قواعد الحج الذي هو ذريعة لوحدة الأمة، ويبين أن من يعيث الفساد في الطرق
المؤدية إلى هذا البلد الآمن فالحرب ضده ليست فسادا، بل هي وسيلة لاستتباب الأمن، فعلى المسلمين
ألا يحجموا عن محاربة هؤلاء.كما يبين أنه لا يمكن أن يتمسك العالم كله بحبل واحد إلا إذا كان لهم
مركز واحد، ومن ثم فلا تحسبوا أمر الحج هينًا.خلاصة الركوع السادس والعشرين (الآيات من ٢١٢ إلى ٢١٧)
وردت في هذا الركوع الحكم وراء الأوامر الإلهية.فنبّه ألا تنظروا إلى الشريعة بعدم الاكتراث..فالظاهر يساعد على إصلاح الباطن.والسبب الحقيقي في مخالفة الشريعة هو حب الدنيا، لأن الإنسان لا
يريد أن يبذل أوقاته وأمواله في سبيل الله، وفرارا من حمل هذا العبء يختلق المعاذير..وهي السبب وراء
Page 95
كثرة الخلافات في العالم، فيشوه الناس تعاليم الأنبياء ويبدلونها إلى ما يخالفها تماما.مع أن تطهير النفس
لا يمكن أن يتم من دون بذل وتضحية.ثم ذكر الصدقات وعدّد مصارفها، وبيّن أن أعظم مصرف للصدقات أن تنفق في الجهاد في سبيل
الله..ضد من يعتدون على الآخرين بسبب عقيدتهم ويسلبونهم حرية الضمير.خلاصة الركوع السابع والعشرين (الآيات من ٢١٨ إلى ٢٢٢)
وإذا كان الوضع هكذا فلا مناص من القتال والتضحية بالمال والنفس، حتى وإن هاجمكم أعداء الحق
في أشهر الحج التي يحرم فيها القتال، فلكم الحق في قتالهم ويميل الناس في أوقات الحرب عادة إلى ممارسة
القمار وشرب الخمر طلبا لِلَّهو وجمعا للمال اللازم للحرب..فقال : إن حرب المسلمين حرب دينية
مقدسة، وإن سكينة قلوبهم لتكمن في رضا الله تعالى، لذلك ينبغي عليهم تجنب هذه المساوئ.ثم بين أنه لا حد للتضحية المالية.فعلى الإنسان أن يضحي بأكثر ما يستطيع دون الإضرار بحقوق
الآخرين عليه.ثم ذكر أن اليتامى يكثرون بسبب الحروب، فعاملوهم خير معاملة واحذروا من الزواج بالمشركين
والمشركات، لأن هذا إخلال بالنظام.خلاصة الركوعات ۲۸ إلى ۳۱ الآيات من ٢٢٣ إلى ٢٤٣)
ثم بين الأحكام الخاصة بالنساء فنهى عن مباشرتهن في المحيض، وأمر بحسن معاشرتهن.وقال إذا
اضطررتم لهجرهن فلا يطولن الهجر أكثر من أربعة أشهر.أما إذا لم تستطيعوا الاستمرار في العيش معهن
فطلقوهن.بعد ذلك بين أحكام الطلاق والرضاعة وأحكام الأرامل.وبذلك ينتهي موضوع تعليم الكتاب والحكمة.خلاصة الركوعين ۳۲ و ۳۳) الآيات من ٢٤٤ إلى ٢٥٤)
يبدأ هنا موضوع التزكية ومبادئها.فبين أن الرقي القومي غير ممكن من دون تضحية.فتذكروا دائما
أن الحياة لا تُكتب إلا لقوم مستعدين لاستقبال الموت.وبهذه الطريقة يحيي الله الموتى..بمعنى أنه تعالى
يصدر أوامر يحسبها القوم موتا ،لهم، ولكنهم إذا عملوا بها كتبت لهم الحياة.خلاصة الركوع الرابع والثلاثين (الآيات ٢٥٥ إلى ٢٥٨)
ذكر الله فيه أن الحياة الدنيا تنتهي على حين غرة، ولذلك يجب أن تسارعوا إلى فعل الخيرات وإنشاء
علاقة بالله جلّ وعلا قبل فوات الأوان.ثم هناك بيان موجز، ولكنه جامع للصفات الإلهية..ألا وهو آية
التي سماها الرسول
ﷺ سيدة آي القرآن.ثم بين أن الإنسان لا يحتاج إلى جبر وإكراه لإنشاء
الكرسي
Page 96
علاقة
مع هذا الرب المتصف بتلك الصفات الحسنى، ذلك لأن حُسنه خلاب للقلوب.ومثل هذه الصلة
بالله القائمة على المحبة هي التي تنفع الإنسان.لذلك إياكم واللجوء إلى الإكراه في أمور الدين..لأن
غرض الدين هو التزكية، وتزكية القلوب لا تتم بالإكراه.وإن اللذين ينعم الله عليهم بالقرب والولاية
يزيل عن قلوبهم الظلمات بالدلائل والبراهين ولا يرضى من أحد بظاهر الأقوال.خلاصة الركوع الخامس والثلاثين (الآيات من ٢٥٩ إلى ٢٦١)
والتزكية التي تمنح من الله تعالى على نوعين، الأولى التي يهبها الله للأفراد مباشرة، كتزكيته تعالى
للأنبياء، والثانية التزكية القومية التي توهب للأمم عن طريق الأنبياء.ثم ذكر أن الله تعالى قدر أن يمنح
هذه التزكية بنوعيها لذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام في أربعة أزمنة بوجه خاص.خلاصة الركوع السادس والثلاثين الآيات من ٢٦٢ إلى ٢٦٧)
ثم بين أن الحصول على التزكية القومية يقتضي سعيا وتعاونا جماعيا.وقد يعترض معترض بأن التعاون
الجماعي هو سبب ازدهار أي قوم سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.فالجواب أن غير المؤمنين بالله
تعالى إذا تعاونوا على فعل شيء كانت نتائج أعمالهم بقدر جهودهم..أما الذين يتعاونون لوجه الله
تعالى فتكون نتائج أعمالهم أعظم كثيرا من تضحياتهم.ومن علاماتهم أنهم (أولا) يقدمون تضحياتهم
امتثالا لأمر الله تعالى وإقامة لشريعته و(ثانيا) يبذلون تضحياتهم ابتغاء مرضاة الله، ولا يمنون على عباده
شيئا.خلاصة الركوع السابع والثلاثين (الآيات من ٢٦٨ إلى ٢٧٤)
والذين يضحون لوجه الله تعالى لا تضيع أعمالهم، وتطمئن قلوبهم بها، وتتطهر أعمالهم.ثم يبين أن
الإحسان إلى أي أحد أمر محمود، ولكن إذا كان إلى الذين يشتغلون في إصلاح الخلق فهذا أدعى لجزيل
ملاحظة أن يكون الإحسان بطريق مشروع.الثواب..مع
خلاصة الركوع الثامن والثلاثين (الآيات من ٢٧٥ إلى ٢٨٢)
ثم بين أن التعامل بالربا يتعارض مع الإحسان وروح التعاون الجماعي، ويجب على المؤمن تجنبه.إن
الأمم التي تتعامل بالربا جريئة على شن الحروب ولا تحفل بأمن الشعوب، فلا تخافوا الحرمان من
الازدهار إذ امتنعتم عن التعامل الربوي، لأننا سوف نهيئ الأسباب لتدمير الأمم المتعاملة بالربا.خلاصة الركوع التاسع والثلاثين (الآيات من ٢٣٣ إلى ٢٨٤)
والإقراض من طرق الإحسان والتعاون الجماعي.وإذا كان الإنسان غير قادر على أن يهب ماله
لأخيه المحتاج..فبوسعه أن يساعده بإقراضه إياه، ويجب عليه ألا يتردد في إسداء المعروف.ولما كان
Page 97
القرض سيُردُّ بعد فترة، لذلك تجب كتابته أمام شهود لتجنب الخصام وما يترتب عليه من فساد.وإذا
لم يكن هناك كاتب فيمكن الإقراض نظير رهن كشهادة على الدين.خلاصة الركوع الأربعين (الآيات من ٢٨٥ إلى ٢٨٧)
ولكن أفضل وسائل الطهارة هي (أولا) أخذ صفات الله تعالى في الاعتبار، و(ثانيا) الإيمان بكلام الله
تعالى والتفكير فيه، و(ثالثا) الدعاء مِن قِبَل الأنبياء والصلحاء ومن يتعلق بهم.هذه خلاصة سورة البقرة وفيها أقيمت الحجة مباشرة على اليهود والنصارى وقريش..حيث قيل
لهم: كان هناك دعاء لإبراهيم قَبلَهُ الله تعالى وكان تحقيقه منتظرا..وها هو محمد رسول الله ﷺ تحقيق
مجسد له، فإذا كذبتموه كذبتم إبراهيم لا محالة وتكذيبه يعني تكذيب السلسلتين من النبوة الموسوية
والمسيحية معا.كما أثبت الله تعالى بهذا الشكل صدق الإسلام للعالم كله إثباتًا غير مباشر..إذ من المحال أن يكون
خلق الإنسان بلا هدف.وإذا كان هناك كلام يحقق هذا الهدف فهو كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله محمد..لأننا
نتزود به بأمور هامة..من معرفة الله، والتشريع الصحيح وحكمته، وتزكية القلب.إذا قرأ أحد سورة البقرة على ضوء هذه الملاحظات..فإنه يجد في ذلك لذة جديدة وينفتح له باب
واسع على معانيها.علاقة سورة البقرة بالفاتحة
لسورة الفاتحة ارتباط بكل سورة من القرآن الكريم، لكونها خلاصة له ولكن ورود سورة البقرة بعد
الفاتحة مباشرة في ترتيب المصحف يدل على أنه لا بد أن يكون لها ارتباط بها أكثر من أي سورة أخرى.وأول صلة لها بالفاتحة أن الفاتحة خلاصة القرآن كله كذلك سورة البقرة هي خلاصة القرآن
أيضًا..لأنها تتضمن الدلائل والبراهين والشريعة وحكمتها وأساليب التزكية والطهارة.وهذه العناصر
من مجيء مبعوث أخير وعد به في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام.هي
الهدف
هي
وعلاقتها الثانية بالفاتحة أن هذه تعلمنا دعاء: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، وسورة البقرة
تعلن في بدايتها: (ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ...بمعنى أن هذه
السورة تحقق الهدف من السير في الصراط المستقيم، وبالتالي هي علامة ظاهرة لقبول دعاء الفاتحة.
Page 98
التفسير:
الم
الله الرحمن الرحيم
الم
: تسمى هذه الحروف مقطعات لتقطعها في النطق، ويتراوح عددها بين واحد وخمسة
حروف.ومن ناحية النوع هي أربعة عشر حرفًا: ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ي، ع، ط، س، ح، ق، ن،
والأخيران منها (ق، ن) يردان في بداية سورتين بشكل منفرد، والبقية منها ترد مثنى مثنى أو أكثر.وقد اختلف المفسرون في هذه الحروف..فقال بعضهم: إنها أسرار الله، وليس لنا أن نبحث عن
حقيقتها.وقال البعض: إنها للتحدي بأن القرآن رغم تألفه من هذه الحروف كلام معجز.وإذا كان
كلام الإنسان يؤلف من هذه الحروف فلم لم يستطع العرب أن يؤلفوا منها مثل القرآن؟ وقال بعضهم:
إنها أسماء السور.كما قيل إنها القسم الذي أقسم به الله على موضوع السورة.لكن هذه المعاني لا تصلح
لأن تكون دافعا لوضع المقطعات في بداية السور.وفسرها بعضهم بأنها ملخص لكلام ذي مغزى ومعنى يقولون مثلاً: إن الألف يدل على
الله ، واللام
على جبريل، والميم على محمد الا الله أي هذا الكلام أنزله الله على محمد بواسطة جبريل، هذا المعنى يصدق
على الم ولكنه لا يصدق على جميع المقطعات.وقال البعض إنها تدل على صفات الله التي تبينها السورة بعدها، وهي الحروف الأولى أو الأهم من
هذه الصفات الإلهية.وهذا المعنى الأخير أصح وأجدر بعظمة القرآن وأكثر اتفاقا مع ما يشهد به القرآن
نفسه بهذا الشأن.وقال البعض: إنها من ناحية قيمتها العددية تشير إلى آجال الحوادث التي وردت الأنباء بحدوثها في
السورة، أو أن السورة تخص بالذكر أحوال تلك الأيام.هذا المعنى أقرب إلى الصحة أيضًا، وعلى الأقل
الله
صلی
الله عليه
فإن سكوت رسول
وسلم عليه يصدقه كما سأذكر.وقد زعم بعض المستشرقين أنها تدل على أسماء الذين ألفوا هذه السورة بأمر محمد ﷺ (ترجمة سيل
نقلاً.عن غويليس).فالألف عندهم يدل على أبي بكر، والعين تدل على على أو عمر، والسين يدل على
سعد، والطاء على طلحة، والهاء تشير إلى أبي هريرة رضي
الله
عنهم.
Page 99
لكان
وهذا مما يشهد على جهل المستشرقين، ولكن بالرغم من هذا الجهل فإن كل واحد منهم يعد نفسه
نابغة في مسائل الإسلام والأغرب من ذلك أنهم أرادوا بالهاء أبا هريرة مع أنه أسلم قبل وفاة رسول الله
بثلاث سنوات فقط، بينما سورتا مريم وطه المبتدئتان بهذه الحروف ،مكيتان، وقد تم نزولهما قبل
إسلام أبي هريرة بخمس عشرة سنة.ومما يجب أن نأخذه في الاعتبار أن هذه السورة لو كانت من تأليف الصحابة رضي الله
يعني ذلك أن رسول الله ﷺ قد أشهد بنفسه هؤلاء الأشخاص على كذبه (نعوذ بالله من ذلك).فما دام
قد استطاع أن يكتب سائر القرآن من عنده فلماذا كلف الصحابة تأليف هذه السورة خاصة، وكيف
أشهدهم على هذا الافتراء..وإذا افترضنا أنه فعل ذلك فلِمَ أقام الحجة على نفسه بوضع
أسماء هؤلاء
الكتاب في أول السور؟! وهذا مما لا يفعله حتى من فقد عقله!
عنهم
ثم إن حديث رسول الله ﷺ أيضًا يشهد على كون هذه الحروف وحيًا.روى البخاري في كتاب
التاريخ ونقله الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ حرفا من
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.لا أقول الم ،حرف، ولكن ألف حرف، ولام
حرف، وميم حرف (الترمذي أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن).علما أن المراد من الحرف هنا الكلمة، لأن الحرف قبل تدوين النحو كان يستعمل للكلمة أيضًا،
ولكن بعد التدوين اختص استعماله بحروف الهجاء أو بالألفاظ التي ليس لها معنى مستقل.وإذن كيف
يمكن الظن بأن هذه الحروف للدلالة على أسماء الذين زعم أنهم قد ألفوا هذه السور.ثم الأغرب من ذلك أنهم يزعمون أن هذه الحروف كعلامات للأسماء، لكن أصحاب هذا الزعم
ترجموا الم أَمَرَ لي (محمد) ، الذي لا يدل على اسم ما.فكيف تكون هذه الحروف رمزا لما
يزعمون؟
وحديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي أيضا يشهد بأن رسول الله ﷺ بين أن الم من الوحي.* قولهم (أمر لي محمد) يدل أولاً على جهلهم المطبق باللغة العربية، وثانيًا على دجلهم وتلبيسهم في الدين..لان هذه الجملة غير صحيحة لغوياً،
(أمرني محمد).ولكنهم اختلقوها كذبًا وخطا ليتطابق (أمر) مع (أ)، و (لي) مع (ل)، و(محمد) مع (م).الناشر.وصوابها
Page 100
سبق أن ذكرت أن من معاني هذه الحروف دلالتها على آجال الحوادث التي تنبئ بها السورة.وصاحب هذا الرأي عالم يهودي..كان قد أبدى وكرر رأيه هذا عند رسول الله ﷺ فلم ينكره، وكأنه
صدقه إلى حد ما.ولذلك فإن هذا المعنى أيضًا جدير بالانتباه ويفتح آفاقا جديدة للمتدبرين.والحديث الذي يذكر هذا المعنى، رواه البخاري وابن إسحاق في تاريخهما كما رواه ابن جرير عن..وهو: "مرَّ أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله ﷺ وهو
ابن عباس عن جابر بن عبد
الله..يتلو فاتحة سورة البقرة (الم (٢) ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ) فأتى أخاه حبي بن
أخطب في رجال من اليهود، فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه الم )
ذَلِكَ الْكِتَابُ ؟ فقال: أنت سمعت؟ فقال: نعم.فمشى حُبَي في أولئك النفر إلى رسول الله
)
، فقالوا: يا محمد، ألم يُذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك الم ذَلِكَ الْكِتَبُ ؟ قال :
بلى، قالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم، قالوا: لقد بعث الله من قبلك الأنبياء، ما نعلمه
بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك ! فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه: الألف
واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة.أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه
وأجَلُ أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال : يا محمد، هل مع هذا غيره.قال:
نعم.قال : وما ذاك؟ قال : المص.قال : هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون
والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة.هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم.قال: وما ذاك؟
قال: الر.قال : هذا أثقل وأطول.الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون سنة
ومائتان.فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم.المر.قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم
أربعون والراء مائتان.فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتان.ثم قال لقد لَبسَ علينا أمرك يا محمد حتى ما
ندري أقليلاً أعطيت أم كثيرا.ثم قاموا، فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الأحبار : ما يدريكم
لعله قد جُمع هذا لمحمد كله: إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى
وسبعون ومائتان، فذلك سبع مائة وأربع وثلاثون سنة.فقالوا: لقد تشابه علينا أمره." (تفسير فتح
البيان)
يتبين من
هذا الحديث أن اليهود أرادوا بهذه الحروف الآجال أيضًا، وصرحوا بذلك لرسول الله ،
فلم ينكره.ولكن استدلالهم بهذه الحروف على أجل الأمة المحمدية صريح البطلان، لأن أجل هذه الأمة
Page 101
من
ممتد إلى يوم القيامة.ومع ذلك فإن
ذلك فإن سكوت ﷺ
ت رسول الله الله عند استدلالهم لا يخلو من حكمة.فبالنظر إلى
ذلك وإلى مواضيع السورة يمكن أن نقول بأن هذه الحروف من حيث قيمتها العددية تشير إلى ذلك
الزمن الذي أنبئ عن أحداثه في تلك السورة خاصة..وذلك بأن تقع تلك الحوادث بعد البعثة النبوية إما
خلال نهاية هذه المدة أو أنها تبدأ عندها.وإذا أقمنا وزنا لهذه الحقيقة فمن الواضح جدًا أن محتويات البقرة خلاصة لما جرى بعد البعثة خلال
إحدى وسبعين سنة..توفي حضرة معاوية في ستين للهجرة، وإذا زدنا على ذلك ثلاث عشرة سنة قبل
الهجرة تصير هذه المدة ثلاثا وسبعين سنة.وأعلن معاوية بيعة يزيد قبل وفاته بسنة أو سنتين.فبهذا تحدد
فترة بداية ازدهار الإسلام بإحدى وسبعين سنة، لأن تفاقم الفتنة كان في هذه السنة.وسورة مريم تبدأ بـ (كهيعص) التي مجموعها مائة وخمسة وتسعون.والسورة تتضمن
ازدهار النصرانية الثاني بعد رقي الإسلام والتاريخ يشهد أن المسيحية في هذه السنة، أي ١٩٥ بعد البعثة
النبوية، بدأت تسترد قوتها.وهذه في نفس السنة التي دبر فيها، لأول مرة في تاريخ الإسلام، عزل الملك
العباسي المعتصم بالله أثناء محاربته الروم، وجعل مكانه عباس بن المأمون ملكاً، وذلك كي يضعف
الإسلام ضد النصرانية، وفي هذه الأيام نفسها هاجم النصارى واستردوا بعض المناطق من الأندلس، وفي
الزمن ذاته بلغت الشقاوة بالمسلمين أن تآمر خلفاء الأندلس مع ملك الروم على الخلافة العباسية،
والعباسيون بدورهم عززوا علاقات الصداقة مع ملك الإفرنج على حساب الدولة الإسلامية الأندلسية،
وهكذا مهدوا الطريق لازدهار النصرانية بإدخال النصارى في سياسة المسلمين.وأرى أننا لو فكرنا بنفس
الأسلوب في سائر السور، تبينت لنا معانيها من الناحية الزمنية أيضًا.والآن أسرد بحث المقطعات الذي يتأسس على التفسير الذي فسر به سيدنا علي وابن عباس رضي
عنهم، وهو أن المقطعات تتضمن عدة ،أسرار منها ما يتعلق بأشخاص هُم على صلة بالقرآن بحيث لا بد
من ذكرهم فيه، ولكن المقطعات إلى جانب ذلك تعمل عمل القفل، فلا يمكن لرجل أن يدرك معاني
القرآن إلا بفتحها، وبقدر ما تنفتح له هذه الأقفال يتمكن من الإطلاع على معانيه.وبحثي
الله
بهذا الصدد يدل على أن معاني القرآن تتجدد بتجدد هذه الحروف.فإذا ابتدأت سورة بحروف
منها فاعلم أن السور التي تليها ولا تبدأ بمقطع جديد تابعة للسورة السابقة في الموضوع، وإن المتماثلة في
المقطَّعات متفقة في الموضوع ومنخرطة في سلك واحد وعندي طبقا للمبدأ المذكور، يستمر الموضوع
الواحد من البقرة إلى التوبة، فإن هذه السورة كلها مرتبطة بـ الم التي تبتدئ بها البقرة.ثم آل
Page 102
عمران تبدأ بنفس الحروف ثم النساء والمائدة والأنعام خالية من المقطعات فكأنها تابعة لما قبلها.بعد
ذلك تبدأ الأعراف بـ المص ، وفيها الما بحالها، لكن زيد في آخرها أص.بعد ذلك الأنفال
والبراءة خاليتان من المقطعات فيستمر الموضوع المتعلق بـ الم إلى براءة.أما الصاد الذي زيد في
آخر الأعراف فيشير إلى موضوع التصديق الأعراف والأنفال والتوبة تبحث في ازدهار الإسلام ورقيه،
لكن الأعراف تشير إلى موضوع التصديق بصورة مبدئية، والأنفال والتوبة تذكرانه مفصلاً ولذلك قد
زيد هنا الصاد.ثم سورة يونس تبدأ بـ (الر) بدلاً من الم ، وبقيت (الـ) بحالها، لكن الراء حلت محل الميم.فهنا تغير الموضوع..لأن البحث من سورة البقرة إلى التوبة كان من وجهة نظر علمية، فمعنى
أنا الله أعلم.لكن البحث من سورة يونس إلى الكهف يحمل طابع الحوادث التاريخية ويقتصر على
الاستنتاج من تلك الحوادث، لأجل ذلك قال الله عز وجل الر، أي أنا الله أرى وأعرض عليكم هذا
الكلام معتمدا على رؤيتي لتاريخ جميع أمم الأرض.فهذه السورة كلها تبحث في صفة الرؤية، والسور
التي قبلها تختص بصفة العلم.6
أرى من المناسب أن أذكر هنا بإيجاز ما يزعمه بعض المفسرين من أن المقطعات مهملة وأنها وضعت
قبل السور بدون جدوى.الحق أن المقطعات نفسها تبطل زعمهم، لأننا إذا تعمقنا في القرآن كله،
وجدنا المقطعات مرتبة ترتيبا وثيقا البقرة تبدأ بـ «الم، ثم آل عمران تبدأ ب الم، ثم النساء
والمائدة والأنعام بلا مقطعات ثم تبدأ الأعراف بـ المص ، ثم الأنفال والبراءة خاليتان.ثم سور يونس
وهود ويوسف تبدأ بــ (الر).ثم زيد الميم إليها في الرعد، لكن الزيادة تختلف عما مضى، إذ الصاد في
الأعراف بعد الميم، وهنا وضع الميم قبل الراء، فلو كانت الزيادة عن غير قصد لكن وضع الميم بعد الراء،
لكن توسط الميم بين اللام والراء يدل على أن هذه الحروف تؤدي معنى خاصا.كذلك عندما نجد أن السور المبتدئة ب الم متقدمة، وتليها السور المبتدئة بـ الر..يتضح
لنا تماما أن الميم متقدم على الراء من ناحية المعنى.وأيضًا في سورة الرعد اجتمع الميم والراء، وتقديم الميم
Page 103
على الراء أكد بأن هذه الحروف وضعت لمعان خاصة، وكذلك نجد أن المتقدمة منها معنى متقدمة في
الترتيب أيضًا.بعد الرعد استهلت إبراهيم والحجر بالراء، لكن النحل والكهف ما ابتدأتا بها، فكأنهما
تابعتان في الموضوع لما قبلهما.ثم سورة مريم تفتح بـ (كهيعص)، ثم سورة طه بـ "طه"، ثم
الأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان كلها خالية من المقطعات وكأنها تابعة لـ "طه".ثم الشعراء
تبدأ
طسم ، فبقي الطاء من "طه" بحاله وزيد عليه السين والميم مكان الهاء.وبعد ذلك سورة
النمل تبدأ بـ طسن ) الذي حذف منه الميم أبقى طين.ثم عادت سورة القصص مبتدئة
طس
بـ طسم ، كأن حرف الميم أضيف إلى موضوع السورة ، أو أعيد.بعد ذلك بدأت سورة
العنكبوت بـ الم وتكرر بحث علم الله من ناحية أخرى، ولأجل ضرورة جديدة.( إنني وإن لم
أكن هنا بصدد بحث الترتيب، لكن إذا سئلت عن تكرار الم، قلت: أن خطاب الم في السور
الأولى كان للكفار ، أما في العنكبوت فالخطاب موجه للمؤمنين.ثم بعد العنكبوت الروم ولقمان والسجدة تبدأ الم.ثم الأحزاب وسبأ وفاطر بلا مقطعات.وكأنها تابعة لما قبلها.بعد ذلك سورة يس تبدأ بالياء والسين.ثم الصافات بلا مقطعات.ثم سورة
ص تبدأ بالصاد والزمر خالية من المقطعات وهي تابعة لما قبلها ثم سورة غافر وحم والسجدة
، لكن زيد في الأخيرة حرف (عسق.وبعدها الزخرف تبدأ أيضا بـ
والشورى تبدأ بــ
حم ثم الدخان والجاثية والأحقاف كلها تبدأ بنفس الحروف، ثم سورة محمد ﷺ والفتح
ج
والحجرات بلا مقطعات وتابعة لما قبلها، ثم سورة ق ) تبدأ بالقاف، ثم يستمر موضوع واحد
إلى آخر القرآن.فكرَّر الحروف المتجانسة ثم حذف البعض.وتعويض البعض يدل على أن الذي وضعها لم يضعها إلا
لغاية.
Page 104
ولتحديد معاني المقطعات أرى من الأفضل أن نرجع للقرآن نفسه.فالسورة الأولى تستهل بـ
الم، وجاءت بعد هذا المقطع آية: ﴿ ذَالِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِينَ ).ثم في آل عمران جاء بعد هذا المقطع: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَنَةَ
وَالْإِنجِيلَ.ومما تجب ملاحظته هنا أن لَا رَيْبَ فِيهِ ) و ( بِالْحَق ) بمعنى واحد، فالكتاب الذي ذكر
بعد الم في البقرة هو نفس الكتاب الذي وصف بالحق في آل عمران.ثم الأعراف تبتدئ بــ المص)، وتلا هذه الحروف آية: ﴿ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا
يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ).هنا أيضا ذكر نفس الكتاب الموصوف بـ ( لَا رَيْبَ فِيهِ )، فقوله تعالى ﴿ فَلَا يَكُن فِي
وو
صَدْرِكَ حَرَجٌ ) يدل على نفس الميزة.ثم بعد عدة
سور
تبدأ العنكبوت بـ (الم) أيضا، ويليها قوله عز وجل: ( أَحَسِبَ النَّاسُ
صلى
أن يُتركوا أن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ).هذه الآيات أيضا تدل على
كتاب حق، لأن الاختبار أو الابتلاء لا يكون إلا لجلاء الشك وإبطال الريب.فهنا نفس البحث الذي
تشير إليه البقرة باختلاف بسيط وهو أن الخطاب في البقرة عام، وهنا خطاب خاص بالمؤمنين، حيث
قيل لهم كيف يستحقون معاملة المقربين ولا يزال الشك يخالط قلبهم.
Page 105
وفي سورة الروم نفس البحث وإن أصبح غاية في الدقة..يقول الله
عز وجل: الم
غُلِبَتِ
و
الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ )..أي أن كلام
الله
نزل بصدد الروم وسيتحقق بلا شك.كأن الله عز وجل تحدى هنا بجزء من كلامه واستغنى عن الكل
وأكد تحققه بحرفي (من) و (س) في قوله تعالى: مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ.ثم تبدأ لقمان أيضا بـ (الم) ويليها قول الله عز وجل: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
و
ن هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم
بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أَوْلَتَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ).وصفة الحكيم أيضا تدل على أمر يقيني فكأنه تكرار لموضوع البقرة.بعد ذلك سورة السجدة تبدأ بـ (الم) أيضًا، ويليها قول الله عز وجل: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ).هنا أيضا ذكر الكتاب الذي لا ريب فيه.فهذه الآيات كلها توضح جليا أنه أينما ذكر الم تبعها موضوع خاص يؤدي إلى علم يقيني لا
يساوره ريب.فمع هذه الحقيقة الناصعة كيف يمكن أن نتوهم ونقول أن هذه الحروف مهملة لا تهدف
إلى شيء؟ فالحق أن الم ترمز إلى إزالة الشك وتمكين اليقين.والشيء الذي يبطل الشك هو العلم
الكامل الذي يدل عليه معنى الم أي "أنا الله أعلم"..أي من أراد استئصال الشك واحتراز اليقين
فليتوجه إلى ما ألقيت إلى الرسول من الكلام وليدرس ما أنزلت إليه من الكتاب.
Page 106
الآن أتناول البحث عن الر.إذا أمعنا النظر في السورة المبتدئة بهذه الحروف وجدناها تبتدئ
ج
يبحث واحد..فقد استهلت سورة يونس بقوله عز وجل: ( الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَبِ
الحكيم ( أكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِر النَّاسَ
قلے
وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ
هَذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ( )
ثم يقول الله عز وجل في سورة هود: ( الر كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن
لدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَن (٤)
وو
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِعَكُم مِّتَبعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ
صلى
كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ.ثم ورد في سورة يوسف: ( الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانَّا
عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِينَ (٢).ج.قلے
ثم جاء في سورة الرعد: المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَبِ وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن
مِن رَّبِّكَ
الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ تَجرى
Page 107
لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ( ).هنا اجتمع موضوع الميم والراء.ج
ثم ورد في سورة إبراهيم: ( الر كِتَبُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( ).ثم في سورة الحجر: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ (٤) رُبَمَا يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ : ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُنْهِهِمُ الْأَمَلُ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٢) وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ : مَّا تَسْبِقُ
مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَكْخِرُونَ (٢ ).إذا أمعنا في هذه المواضع، تبين أن البحث يدور حول موضوعين اثنين، التاريخ القديم وخصوصا
عقاب المجرمين وخلق الكون والاستفهام الإنكاري في سورة يونس يدل على أن الأنبياء بين بشير ونذير
لن تنقطع بعثتهم قط.وبين في سورة هود أن كل قوم في تطور دائم وأنه لا بد أن يتطور في مدى
معين.ووضح بذكر الخلق أن تقدم العالم خاضع لقانون الارتقاء.بعد ذلك أشار في سورة يوسف إلى
تاريخ العالم بصورة واضحة ثم بإضافة (ميم) في سورة الرعد جمع موضوعي (الم) و(الر)، حيث
أشار بـ(ميم) إلى أن القرآن كلام يقيني، ثم دعا إلى النظر والتفكير في خلق الكون.ثم في سورة إبراهيم
كرّر التوجيه إلى التفكير في قوانين ،القدرة، مبينا أنكم لو فعلتم ذلك فستجدون فيه آثار يد الخالق
لحكيم.وفي سورة الحجر دعانا إلى التفكير في القانون القديم.ومن البين أن قانون الكون وحوادثه
المختلفة مرتبطة بالرؤية، والحق أنه لا يستطيع أحد التحري عن الحقيقة إلا إذا كانت ظواهر الكون
وقوانينه منكشفة أمامه فعلاقة هذه السور بالرؤية واضحة كما تشهد بها كلمتا الم
Page 108
اللتان قيل فيهما أنني أنا الله أعلم.وأرى فلا التاريخ القديم غائب عني ولا خلق الكون وقوانينه خافية.علي..فهدايتي هي التي يمكن أن تغنيكم عن كل شيء آخر في إدراك الحقائق المتعلقة بالعلم والرؤية.وجدير بالذكر أيضًا أن المقطعات، وإن كانت معانيها تتغير بتغير الأحرف، لكنها متفقة في أمر واحد
وهو أن السور التي تفتتح بالمقطعات يستهل موضوعها بالوحي، ومعظم هذه السور تصرح بكلمة
الكتاب و القرآن، وبعضها تشير إلى كتاب قديم مثل سورة مريم أو إلى كلام خاص مثل سورة الروم.هذان المعنيان المذكوران أي أن المقطعات (أولا) تدل على الصفات الإلهية وكل حرف يمثل الصفة
التي تبحث فيها السورة، وأنها (ثانيا) تدل على قيمتها العددية (الآجال)، ومجموع عدد هذه الحروف
يحدد الحوادث الواقعة إلى مدى المقدار من الزمن، كلاهما صحيح، وليس من اللازم أن يكون أحدهما
صحيحا دون الثاني.ويوافقني في هذا الرأي بعض العلماء من صدر الإسلام أيضا..كما روي ابن أبى
حاتم عن أبي جعفر الرازي عن أبي العالية يقول : "...ليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء
وليس فيها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم".أي أن
في هذه الحروف إشارة إلى كل الصفات الإلهية والحوادث من أزمنة مختلفة، والكلام الإلهي المعجز.ورأي أبي العالية في غاية الروعة والصواب والصدق.وقد نقله ابن جرير بلفظ آخر وصدقه.يمكن أن يقال عن المقطعات لماذا اختار القرآن الكريم هذا الأسلوب المبهم؟ ولماذا لم يبين هذه المعاني
بكلمات واضحة كي يفهمها العرب وغيرهم على حقيقتها؟ فالجواب أن هذا الأسلوب ليس غريبا عند
العرب، بل إن كبار الشعراء العرب كانوا يستعملونه..كما قال أحدهم: "قلنا قفي لنا فقالت قاف".ويعني قوله "قاف" وقفت.وقال آخر:
الله،
بالخير خيرات وإن شر فا ولا أريد الشر إلا أن تا
فالشاعر قد اكتفى هنا بـ "ف" بدل "فشر" و بـ "تا" بدل "تشاء".وفي حديث رسول الله : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل وكتب بين عينيه
آيس من رحمة الله.(ابن ماجة كتاب الديانات..أي أنه إذا قال: "أق" مكان أقتل، فجزاؤه بما ذكر
من اليأس والحرمان.فالعرب متمسكون بهذا الأسلوب المرتبط بالقرينة في النظم والنثر، ومن الأمثال الرائعة لهذا الأسلوب
ما اختاره القرآن من المقطعات والأمم الغربية قد بالغت اليوم في استعمال هذا الأسلوب.وهناك مئات بل آلاف من الحروف التي تتقدم مختلف الكلمات، والناس يفقهون معناها ولا
يستغربونها.
Page 109
ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ :
شرح
الكلمات:
ذلك: اسم إشارة للبعيد، أحيانا يستعمل للقريب بمعنى: هذا..نقل عن الزجاج: ﴿ ذَالِك
الْكِتَابُ ) أي هذا الكتاب (تاج العروس).ويمكن استعماله للقريب مع دلالته على البعيد..إذ إن
-
الإشارة إلى القريب بالبعيد إنما يراد منه البعد المعنوي دلالة على علوّ المرتبة (فتح البيان).الكتاب : "ال" تفيد التعريف علاوة على المعاني الأخرى.فإذا كانت للتعريف فهي إما عهدية وإما
جنسية، فالعهدية إما أن يكون معهودها ذكريًا أي قد سبق ذكره أو يكون ذهنيًا -أي يفهمه
المتحاوران - أو حضورياً -أي يكون حاضرا موجودا أمامهما.والجنسية إما استغراقية،
ما تَخْلُفُه
وهي
"كُلّ" حقيقةً أو مجازا، نحو "خُلق الإنسان ضعيفا، أي كلُّ إنسان، و"أنت الرجلُ"، أي الكامل في
الرجولية؛ وإما لتعريف الحقيقة، وهي لا تخلفها "كُلّ" حقيقةً ولا مجازاً نحو الإنسان أفضل من الحيوان.(الأقرب)
والكتاب: مصدر، وهو ما يُكتب فيه، وسمي به الجمعه مسائل مختلفة مع أبواب وفصول، ومنه سميت
التوراة كتابًا.وكل ما يُكتب فهو كتاب.والكتاب: الحكم؛ الفرضُ والقدر.ويطلق الكتاب على المترل
من الله تعالى، وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله من المكتوب.(الأقرب)
فهذه الكلمة يختلف معناها حسب اختلاف المواضع، فيطلق لفظ الكتاب على وحي التشريع
لاشتماله على فروض وأحكام ، وقد يطلق على كل وحي حق صادق لكونه ،إلهاما، وإن لم يدون بصورة
كتاب.ريب الريب: الظنة والتهمة الشك؛ والحاجة؛ وريب المنون (الأقرب).وقد وردت كلمة
رَيْبٍ مِّمَّا
ريب في عدة مواضع من القرآن الكريم.ففي سورة البقرة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي
نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ.فالريب هنا بمعنى الشك.وفي
سورة الحج: ( يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ..أي في شك من البعث.
Page 110
ثم في سورة الطور: ﴿ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ) أي نتربص به
دوائر الزمن والهلاك.ولم ترد هذه الكلمة في القرآن إلا للدلالة على معنى مذموم..كما جاء في قوله تعالى: ﴿ مناع
و
وو
رفُ
لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريب ) (ق: (٢٦).وقوله: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ هو مشرف
من هو
مُرْتَابُ ) (غافر: (٣٥).فالريب لا تدل على الشك الذي يزيد الإنسان بحثا وتدقيقا، بل هو الشك
الذي ينشأ عن سوء الظن والتعصب ويبعد الإنسان عن الحق، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَرْتَابَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ) (المدثر : ۳۲).وفي الحديث الشريف: "دع ما يريبك إلى ما (المدثر:٣٢).لا يريبك" (الترمذي، أبواب صفة القيامة.ويظهر من الحديث أيضًا أن الريب شك ناشئ عن الوهم أو
الوسوسة، وليس مما يساعد الإنسان على البحث والتدقيق.هدى الهدى هو الرشاد ،البيان الدلالة (الأقرب).والهداية الدلالة بلطف والهدى بالقرآن تدل على
معان أربعة:
١.الهداية التي عمت بجنسها كل مكلف..من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي وهب منها كل
شيء ما يناسب احتماله..قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ
(طه:٥١).وذلك ما ترى في الحيوانات التي لم تكتمل فيها قوة الإدراك، وليس لها منه إلا ما لا بد منه
من العلم الجزئي السطحي بالأمور البسيطة اللازمة لحياتها.وأرى أن هدى تعني إيجاد القوى المختلفة في الشيء وتسخيرها له، لأن مجرد وجود القوى لا
يجدي، بل إن دفعها للعمل لا بد منه لبث الحياة فيها فالوليد بولادته يكون مكتمل القوى النفسية، لكنه
لا يبدأ بحياته العملية إلا عندما تنتعش قواه بفعل الهواء والماء.ومثله في ذلك كالساعة التي تحتوي على
الآلات المهمة لتشغيلها، ولكنها لا تبدأ الحركة إلا بعد التدوير.والخلاصة أنه لا بد من الدافع الابتدائي لحركة الحياة، وهذا الدافع الابتدائي هو المراد من الهدى.وقد
جميع
صرحت هذه الآية أن الله عز وجل قد أعطى كل شيء قواه الضرورية، ثم دفعها للعمل المفوض لها.
Page 111
٢.الهداية التي جعلها الله تعالى للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال الكتب كالقرآن ونحو
ذلك، وهو المقصود من قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْتَهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا )..والهداية التوفيق، أي التمكن من القيام بالعمل الصالح، وسمو الفكر الذي يختص به من اهتدى.وهذا معنى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَنهُمْ تَقْوَلَهُمْ ).٤.الهداية في الآخرة، أي النهاية السعيدة ونيل الجنة قال تعالى: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَاهُمْ
أما قوله تعالى: ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ، أو قوله: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) فمعناها الدعوة إلى
الحق.أما الآيات المشتملة على عدم اهتداء الظالمين كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
).فالمراد منها النوع الثالث والرابع من الهداية أي التوفيق بالعمل والتمتع بنور الإيمان ودخول الجنة.ومن البين أن الذي لا يتمكن من النوع الثاني من الهداية سيحرم حتما من النوعين التاليين..لأنهما من
ثمرات النوع الثاني.المتقين: جمعُ مُتَّقِ، والمتقي اسم فاعل من اتقى، والاتقاء افتعال من وقى، ومعناه لغةً: أنقذ، صان،
حفظ.واتقى احتفظ الأقرب).وهو يدل في الشرع على الامتناع عن الشر، ولا يطلق على مجرد
الخوف.والوقاية: الترس أو كل ما يتخذه الإنسان من وسيلة للدفاع عن نفسه.وقال البعض: اتقاء الله
معناه اتخاذ الله عز وجل جنة للنجاة.والتقوى التي وردت في القرآن سأل عنها أبو هريرة فقال: "إذا
وجدتم شوكا في الطريق فماذا تفعلون عندئذ ؟ فقال السائل.أمر بها متجنبا أو أتحيز عنها حذرا.فقال أبو
هريرة: هذا هو التقوى، أي أن يتجنب عن المعصية ويتهرب منها بكل وسيلة.وقد أنشد أبو المعتز في
هذا المعنى أبياتًا رقيقة فقال:
خل الذنــــوب صغيرهـــــــا وكبيرها ذاك التُقَ
واصنَع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغـ
إن الجبال من
الحصـ
Page 112
التفسير: إن "ذلك" إشارة إلى البعيد، فلماذا استعملها الله تعالى للقريب فقال : ذلك الكتاب ؟
أجاب بعض العلماء أن "ذلك" يأتي للقريب أيضًا كما ذكرنا في معاني المفردات.وقال بعضهم إنه
للبعيد ولكن إذا انتهى ذكر شيء فهو بعيد بلا شك، كما لو ذكرنا شيئا في الكلام ثم أردنا إعادة
ذكره، جاز أن نشير إليه بذلك.والعرب عندما ينتهون من حكاية أمر ، يقولون: ذلك ما لا شك فيه.(الكشاف).وكذلك ورد في القرآن: ( لا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (البقرة:
٦٩).وذلك هنا إشارة إلى الفارض والبكر وهما قريبا الذكر.ويقول تعالى: ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي ) (يوسف: ۳۸).وهناك آيات أخرى كهذه مثل: ﴿ ذَالِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشُّهَدَة ) (السجدة: (٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا وَآتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ
ه (الأنعام: ٨٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ) (الأنعام: ٩٣).والخلاصة أن "ذلك" يستعمل في كلام العرب بمعنى هذا، وليس من الضروري أن يكون المشار إليه بعيدًا
في الواقع، بل إذا كان بعده ،ذهنيًّا، أي قد مر ذكره فمن الجائز أن يشار إليه بــ
إذًا يمكن أن نفسر قوله تعالى ذلك الكتاب بعدة معان: (۱) هذا هو الكتاب، (٢) هو هذا
الكتاب (۳) هذا..هو الكتاب الكامل ، (٤) هذا..ذلك الكتاب الكامل."ذلك".تصلح هذه المعاني الأربعة إذا كان "ذلك" مبتدأ و "الكتاب" خبرا، لكن هناك صورة أخرى وهي أن
يكون "الكتاب" عطف بيان و لَا رَيْبَ فِيهِ ( خبرا، فيكون المعنى هذا الكتاب الكامل لا
يتضمن ريب، أو ذلك الكتاب هداية الأنبياء..لا يحتوي على شك.لكن الأصح عندي والأوفق للفظ القرآن معنيان اثنان:
يعني
(الأول): هذا هو الكتاب الكامل، تقول العرب: زيد العادل، أي أن زيدا هو العادل، فقوله تعالى:
ذلك الكتاب أن هذا الكتاب وحده يستحق أن يتصف بصفة الكتاب.فيعتبر "ال" هنا
للاستغراق المجازي.والأخذ بهذا المعنى لا يضطرنا إلى تأويل بعيد خارج عن الكلام، ثم إن هذا المعنى
أكثر انسجاما مع السياق أيضًا، لأن الكتاب الذي يقدّم نفسه بأنه كتاب سماوي مع وجود كتب سماوية
Page 113
أخرى..لا بد أن يبدأ بادعاء مثله، لأن الناس سوف يتساءلون حتما: ما الحاجة إلى كتاب جديد
والكتب الأخرى موجودة؟ وفي هذا الأسلوب إجابة عن هذا السؤال الفطري، حيث قيل للسائلين بأن
الكتب الأخرى موجودة بلا مراء، لكن مجرد وجود كتاب لا يجعله محققا لجميع الضروريات الإنسانية.إن الغرض من الكتاب تأمين الوسائل الروحية للإنسان، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي يحقق هذه الغاية
العظمى، فلذا تمس بنا الحاجة إليه رغم وجود الكتب الأخرى.وهذا المعنى أنسب وأليق أيضًا بالنظر إلى معنى مقطعة الم التي سبق ذكر معناها، فعبارة
الم..أي "أنا الله اعلم، تدل على أنه مهما علم الناس من العلوم فإن علم الله هو الكامل من ناحية
ضرورة ذلك الزمن.كما إن عبارة "أنا الله أعلم، ادعاء يحتاج إلى الدليل، وأكبر دليل على ذلك أن
تقدم للناس مادة علمية لم يسبق لها نظير.فأجود معنى ممكن لقوله ذَلِكَ الْكِتَابُ )) بالنظر إلى
مفهوم الم هو أن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل.وإذا التفتنا إلى شهادة التاريخ وجدنا هذه الدعوى متحققة تماما.لا شك أن القرآن مسبوق زمنا
بالتوراة والإنجيل و "الفيدا" و "زند" وغيرها من الكتب..لكن إذا قارنا بينها وبين ما جاء به القرآن من
التعليم وجدناها عاطلة عن الشمول والجامعية التي نجدها في ثنايا القرآن المجيد.إذا كانت مزية الإنجيل أن
يؤكد على الحب الإلهي، فإن القرآن يتضمن ذلك وأكثر ، وإذا كانت التوراة تفتخر بشريعتها فهي أيضًا
تتضاءل أمام شريعة القرآن الجامعة، مع أن القرآن أصغر منها حجما.وقد بلغ القرآن من
والكمال مبلغًا جعل معنى الشريعة عن المسلمين متميزا، فالمسلم عندما ينطق بكلمة الشريعة، يقصد بها
معنى خاصا يشمل:.علاقة الوالدين والأولاد،.الروابط الزوجية،
٣.الزواج وأهدافه،
٤.حقوق الزوجين وواجباتهما،
ه.اختيار الرجل زوجته وبالعكس،
٦.مبادئ تربية الأولاد،.النظام العائلي
الجامعية
Page 114
.نظام الوراثة،
٩.نظام الوصية،
١٠.حقوق الجار القريب والبعيد
۱۱.مبادئ التجارة،
۱۲.مبادئ الزراعة،
١٣.واجبات الراعي والرعية وحقوقهما،
١٤.أنواع الحكم،
١٥.حقوق الأجير والمستأجر وواجباتهما،
١٦.العلاقات الدولية
١٧.أسس الاقتصاد،
۱۸.حقوق الإنسان بل الحيوان أيضًا،
۱۹.صلات الرسل وأتباعهم،
٢٠.وأخيرا وليس آخرا بل قبل الكل، علاقة الإنسان بخالقه.كل ذلك بصورة مفصلة وبأحكام شاملة كاملة محكمة بحكمتها، ويتضمن القرآن أيضا أمورا أخرى
بنفس الصفة، وليس ثمة كتاب يتضمن عشر معشار هذه الأمور.ولنأخذ مثلاً كتاب الفيدا (كتاب
الهندوس المقدس)..لنجد أن الأكثرية من الهندوس تجهله، والأقلية التي تعرفه لا تستعمله إلا للشعوذة
والألغاز، وأهم مزية له عندهم أنه يتضمن الأدعية المختلفة، وأنه يبين الغرض من خلق الإنسان.ولكن
فلسفة الدعاء وفلسفة خلق الإنسان التي فصلها القرآن يتضاءل أمامها تعليم الفيدا.فأدعية القرآن مشتملة
على دقائق الفطرة، وليست كلمات رنانة جوفاء.إنها تجعل الإنسان يشعر بضعفه، ويطلع على سيئاته،
ثم لا تهمله بل تشجعه على استمداد القوة من ربه، وتستره بستر القداسة والطهارة.ثم إن القرآن يبين
أسرار الخلق بأسلوب لا يشرد منه فكر الإنسان باستعارات بعيدة، بل يخرجه من ظلمات الحياة إلى نور
المشاهدة والتجربة، ويصقل عقله ويجلو تفكيره.والتفصيل الذي ذكر به القرآن قضية البعث بعد الموت لم يبق أمامه للكتب الأخرى إلا الاعتراف
بالهزيمة والفشل.التوراة ساكتة عنها كل السكوت والإنجيل يذكرها بصورة ناقصة جدا، والفيدا لا
يتناولها بتاتا، وكتاب "زرداشت" يذكرها باستعارات غامضة وبكلمات مادية بحتة، لكن القرآن بعكس
ذلك كله، يتناول هذه القضية بصورة مفصلة ويبين ما هو جزاء المحسن والمسيء، وكيف يتم ذلك، وما
Page 115
هي
كيفيته، وما هو الغرض منه، وما هو الهدف الحقيقي من الحياة الآخرة، وما هي الوسائل العلمية
لتحقيق هذا الهدف، وما هي مبادئ الجزاء والعقاب.ثم إن فلسفة الأخلاق التي يتأسس عليها الدين ويتوقف عليها الأمن والأمان في الأرض..بحث لم
تتناوله الكتب الأخرى قط، أو تناولت قشره وأهملت لبه فتعاليم بوذا ترتبط بالعواطف ولا شك، لكنها
لا تبلغ شأن تعليم القرآن.إذ إن القرآن لا يكتفي بذكر العواطف فقط، بل يبحث أسباب نشأتها،
ويؤكد ضرورتها، ويوضح الطرق المناسبة لإظهارها بأسلوب حسن، ويبين متى تكون صالحة وبأي
صورة ومتى تسوء وبأي طريق، وكيف يمكن تحويلها من السيئ إلى الأحسن، وكيف يمكن للإنسان أن
يتجنب العوامل التي تدفع العواطف إلى السيئات.جاء في تعاليم بوذا: "اقلعوا" عن الأهواء تتقوا الذنوب"، لكنه لم يذكر الدوافع المؤدية إليها، وسكت
عن العوامل التي تساعد على إزالتها.لكن القرآن المجيد يرشدنا إلى منبعها، ويوجهنا إلى التدابير التي تسد
ذلك المنبع.ورغم هذه التفاصيل الجامعة..فالقرآن الكريم أصغر حجمًا من جميع الكتب السماوية؛ مما يجعله سهل
القراءة، هين الفهم والحفظ حتى يبلغ عدد حفاظه مئات الألوف.فافتتاح القرآن بقول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ) لدليلٌ على أن هذا
الإعلان جاء طبقًا للضرورة وفي أنسب مقام حقًا.(الثاني): هناك معنى آخر لهذه الآية غير ما سبق، وأيضًا يساير السياق مسايرة تامة..وهو أن سورة
البقرة مسبوقة بسورة الفاتحة..التي تعلمنا منها دعاء يقول: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.وقد أجيب هذا الدعاء لهذه الآية حيث قال الله عز وجل:
ذَالِكَ الْكِتَابُ ، أي أن الهداية التي طلبتموها في الفاتحة هي في هذا الكتاب أي القرآن.وبهذا
يبقى ذالك ) بمعناه الحقيقي، أي إشارة إلى البعيد ولا يحتاج الأمر إلى تأويلات أخرى.عندما علمني ربي هذا المعنى شكرته على ذلك وشعرت بالانشراح، ولكن بعد فترة من الزمن اطلعت
على قول المفسر واحد..سبقني إلى هذا المعنى وهو ابن جعفر بن إبراهيم بن الزبير أستاذ ابن حيان، الذي
نقل عنه هذا المعنى في تفسيره.ولا شك أن هذا المعنى في غاية الروعة والدقة، وتتضح به العلاقة بين
Page 116
سورة الفاتحة وسورة البقرة ويتبين أن ترتيب سورة البقرة بعد الفاتحة ليس مصادفة، بل إن سورة البقرة
تقع موقع الجواب للفاتحة.وبذلك أيضًا لا نضطر إلى ترك المعنى المعروف بكلمة "ذَالِك ".والجزء الأخير من هذه الآية (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) هو أيضا يصدق هذا المعنى، فكأن الآية تدل.على أن الهداية التي سألتموها في دعاء الفاتحة هي في هذا الكتاب.وبما أنكم ما طلبتم هداية عادية..بل
سألتم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، فهذا الكتاب جاء حسب طلبكم.فهو لا يتضمن
مجرد هداية..بل هو ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، أَي يسمو بالتقي الكامل ليدخله في أعلى عليين من
يسمو
الطوائف المنعم عليها، كما أنه جمع ما أوتي النبيون من تعاليم وما تؤدي إليه هذه التعاليم من إنعامات.قوله تعالى لَا رَيْبَ فِيهِ ، ينفي عن القرآن الكريم المجيد كل معاني الريب من تهمة أو شك أو
من
حاجة أو آفة.وبذلك يكون التحدي من أربعة نواح أيضًا.إن هذا الكتاب لا يُنقص أحدا حقه، وليس
فيه تهمة لا ضد الله تعالى، ولا ضد نبي، ولا ضد ملك الملائكة، ولا ضد أحد من بني الإنسان، ولا
حتى ضد الفطرة الإنسانية، وهذه الدعوة من العظمة بحيث لا نجد لها نظيرا في أي كتاب آخر، وهذه
حقيقة ثابتة لم يسبق لها مثيل في الملل الأخرى.قد أثار الله تعالى في أول القرآن تساؤلا عن الحاجة إلى هذا الكتاب الجديد مع وجود الكتب
الأخرى.وكان من اليسير الرد على هذا التساؤل بذكر شيء من مزالق الكتب السابقة، وتعداد بعض
عيوبها التي تجعلها غير صالحة كمصدر للهداية، ومن أجل هذه العيوب أنزل الله تعالى القرآن المجيد؛
ولكان هذا الجواب صحيحا ،ومفحما، لأن القرآن وإن كان داعيا إلى التعاليم التي جاء بها الأنبياء
جميعا..وإلى أن بعثة النبيين استمرت قبل مجيء رسول الله..وإلى أن بعض الأنبياء جاءوا بشريعة من
السماء، إلا أنه لا يسلّم ببقاء هذه التعاليم مصونة إلى ذلك الوقت.لكن ابتداء هذه البشارة العظيمة، أي
قوله ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" ، بمثل هذا الأسلوب يشق على الطبائع النفسية، لأن
الاطلاع على مزالق الكتب السابقة، وإن كان من واجبات القرآن المجيد، لكن الخوض فيها عند بدء
الأمر لم يكن لائقا بكتاب في عظمة القرآن، كذلك لم يكن مجديا لإظهار العظمة الرائعة التي تتحق
بالأسلوب الوارد القائل: إننا لا نحط من قدر فرد أو كائن ما، بل نعترف بمترلته اللائقة به.فافتتاح
Page 117
القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) وتجنبه
الاعتراض في نفس الوقت على الكتب السابقة، لشاهد على عظمة القرآن.فهو يقدم البشارة للناس
بقداسته وخيراته وهو يحمي ذوي الطبائع الطاهرة من الاطلاع على مزالق الكتب السابقة.هذا يكشف
عن عظمته الذاتية إذ لا يبدأ بعيب الملل الأخرى ليفرض أهميته، بل يقدم كمالاته كدليل على صدقه،
دون أن
يمس بكرامة الديانات السابقة.وهذا موقف يدعو للإعجاب بشرفه وسموه، وقد اختاره القرآن
مع صعوبته وخطورته لإثبات صدقه، وحقق به أعظم نجاح.القرآن الكريم لا يدعم صدقه بإبطال الملل الأخرى، كلا، بل إنه يقرر: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا
خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ) (فاطر: (۲۵) وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد: ٨).فهو يعترف بصدق ٢٥)،
الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لإرشاد البشر، ويبرئ أصل الأديان التي تحمل طابع الوحي السماوي من
تهمة الكذب والزور..وذلك على عكس ما يقوله اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم، إذ كل واحد
منهم يصر على تكذيب غيره ويقول بأن كل ملة أخرى لهي مجرد ظلمة وضلال، وأن الله حرم سائر
العالم من الهداية.ولكن القرآن الكريم يقر بضرورة الهداية لكل زمان ولكل قوم، ويعلن بأن كل نبي
كامل لعهده محقق لضرورات الإنسان في دوره..وهكذا يمتاز القرآن عن الكتب الأخرى بترفعه عن
اتهام أحد.إن الذات الإلهية هي العنصر الأساس في كيان الدين وهي النقطة المركزية لكل الملل.وقد يندهش
البعض إذا قيل له : إن الكتب السابقة تتناول المقام الإلهي بما لا يليق به..ولكن ذلك حقيقة واقعة.فالكتب الدينية المقدسة والمتداولة بين أيدي الناس، مثل العهد القديم (التوراة والعهد الجديد (الإنجيل)،
وأسفار الفيدا (كتاب الهندوس)..والزندافستا كتاب الزر داشتين)..كلها تنسب النقائض إلى الذات
الإلهية بصورة أو بأخرى..وفي حين أن القرآن الكريم يزيل كل ريب، ويصف الله تعالى بكامل العزة
والجلال والقداسة.جاء في العهد القديم أن الله بعد أن خلق الكون شعر بالحاجة إلى الراحة فاستراح، وبمثل هذا القول
نسبوا إلى الخالق سبحانه ما لا يليق به : " وفرغ الله في اليوم السادس من جميع عمله الذي عمل فاستراح
في اليوم السابع.وبارك الله اليوم السابع ،وقدسه، لان فيه استراح من جميع عمله الذي عمل".(سفر
تکوین (۲)
Page 118
وقد عمدوا إلى حذف كلمة "استراح" من بعض الترجمات واستبدلوها بكلمة كما في النسخ
الأردية..تهربا من الاعتراض..لكن ما تزال الكلمة هي نفسها في النسخ العربية والإنجليزية.ولقد فند
القرآن الكريم هذه التهمة القبيحة فقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ لُغُوبِ ) (ق : (۳۹).وجاء في التوراة أيضًا أن الله تعالى تأسف وحزن على خلق الإنسان في الأرض.وكأن خلق الإنسان
كان خطأ ندم الخالق على فعله تعالى الله عن ذلك علو كبيرا.والذي يخطئ ولا يعرف نتيجة عمله غير
جدير بأن يكون إلها: فحزن" الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه " (تكوين (٦).ولكن القرآن الكريم يبين قدسية الله حيث يقول: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(البقرة)) (٣٤).ومن يعلم الغيب لا يخفى عليه شيء، ومن المستحيل أن يخطئ ويندم على خطئه.وإن
الندم دليل على ضعف الفاعل وقلة علمه ونقص بصره، ولكن القرآن يعلن أن الكون وكل ما فيه من
سماء وأرض وإنسان وملاك وحيوان ونبات وصغير وكبير..يشهد بأن الله تعالى متره عن كل عيب
وضعف: ( يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ
الحكيم ) (الجمعة: (٢).ثم إن أكبر التهم وأشنعها في حق الله تعالى هي الشرك.وقد تفنن الإنسان
في اصطناع شركاء مع الله تعالى.فمنهم من قال بالهين : إله النور وإله الظلام..ومنهم من اختلقوا ثلاثة
آلهة، فقالوا: الآب والابن وروح القدس وبعضهم افتروا عليه بالأزواج ومنهم من وزع صفات الله
على عدة شخصيات، واتخذوا كلا منها إلها.وبعضهم قالوا أن الله يتنازل عن حقوقه كليا أو جزئيا لعبد
يختاره من عباده.وبعضهم اعتبروا كل المظاهر العظيمة من الكون ذوات لها إرادة في إظهار صفات الله.أله الأشياء الضارة والحيوانات المخيفة.واعتبر بعضُهم مظاهر الحسن مظاهر لله تعالى ووصفوها
وبعضهم
بأوصاف الألوهية.ولقد تكفل الإسلام بتفنيد هذه الأقاويل والردّ عليها، وعرض الحجج الدامغة لدحض هذا البهتان
العظيم، وفصل صفات الله تعالى تفصيلا لا نجد له نظيرا في كتاب آخر.
Page 119
ثم إن الملائكة
هي
العلة الابتدائية والأساسية للكون بعد الله تعالى.ولقد برأهم القرآن أيضًا
من
العيوب والنقائض التي يُرمون بها فقال: لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(التحريم: ٧).وبذلك أبطل التهم التي قذف بها اليهود الملائكة من أنهم ارتكبوا معصية وأنهم أعرضوا عن أمر ربهم.ويقول الهندوس أن الآلهة أي الملائكة اكتسبوا ذنوبا فلا بد من تبرئة الملائكة من هذه التهمة ولأنهم المنبع
الرئيسي لحوافز الخير، ولا شك أن العين الصافية إذا أصبحت طهارتها عرضة للشك حرم الإنسان منها
وسد في وجهه باب الخير.والعماد الثالث لكمال صرح البناء الخُلقي والروحي للإنسان هو كلام الله، لأنه يورث الإنسان
المعرفة واليقين، لكن أصحاب الديانات والفلاسفة لم يرتدعوا عن اتهامه أيضًا.فبعضهم زعموا أن الوحي
أفكار صافية..مع أن تسمية الأفكار وحي، يشجع كل شخص على نسبة أفكاره إلى الوحي، وهذا
يحول دون اليقين الذي يتأتى عن طريق الوحي اللفظي.الله
والقرآن
يرد على كل ذلك بقوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ) (النساء: ١٦٥)، أي كلم
موسى شفويا وبالكلمات.وكذلك يقول: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (التوبة: (۷)..أي إذا التجأ إليك أحد من المشركين اللذين يحاربونك فأجب
يسمع ما أُنزل إليك من كتاب الله الذي كله كلام
الله
وليس
لفظًا
من صنع الإنسان.ثم إذا
طلبه كي يسمع
سمع
هذا الرجل ذلك الكلام أراد أن يعود إلى أهله فعليك أن توصله آمنا إلى قومه ومأمنه.فالقرآن الكريم قد برأ الكتب السماوية أيضًا من تهمة أنها ليست من كلام الله، وأنها من أفكار
العباقرة التي نسبوها إلى الله تعالى.والأساس الرابع لبناء الدين هو وجود الأنبياء، والتعاليم التي أوردها القرآن عنهم هي
أسمى من كل
بهتان.فأولا إن القرآن يصفهم بأنهم عباد مقربون مطهرون كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا
لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ) (الأنعام (۱۲۵).وقد شهدت هذه الآية بصورة مبدئية
على نزاهة حياة الأنبياء، وردَّت على جميع التهم التي تنسب إلى الأنبياء عموما سواء ورد ذكر هؤلاء في
القرآن أم لم يرد مثلا: يقول الهندوس عن نبيهم كرشنا انه كان يسرق الزبدة وينهمك في التمتع بالنساء
والعياذ بالله.وجاء عنه أن أمه قالت له: يا بني عندي تسعمائة ألف بقرة حلوب، فكل واعبث واسرق
Page 120
ما شئت من الزبدة، ولا تدخل بيوت الناس لأجل الحليب واختلاس الزبدة.كتاب شريمد بها غوت
بوران، الباب العاشر).أما الأنبياء الذين ذكرهم القرآن بأسمائهم لأسباب خاصة ومصالح جليلة..فإنه أبرز عظمتهم وشأنهم،
وبرأهم من التهم التي وجهت إليهم على وجه الخصوص.فمثلا: تقول التوراة إن آدم ارتكب معصية
متعمدة أورثها لبنيه من بعده، ولكن القرآن برأه وبين أنه نسي و لم يتعمد الخطأ..فقال: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا
إِلَى أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (طه: (١١٦).وزُعم في التوراة أن سيدنا إبراهيم كذب عدة
مرات، وهي فرية انخدع بها طائفة من المسلمين أيضا، ولكن القرآن قال فيه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
(النجم: ۳۸)..أي أنه أتم العهد مع الله تعالى إتماما كاملا فكان مثلا أعلى في طاعة الله والتمسك في
الخلق القويم كالعدل والإحسان والصدق وحسن المعاملة والرأفة والشفقة والستر على خلق الله والعفو.ولقد قالوا أن موسى عليه السلام خدع المصريين وسلبهم حليهم بأمر من الله (سفر خروج ۱۱: ۲)،
ولكن القرآن يقول على لسان قومه : وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى
السَّامِرِي (طه: ۸۸)..أي بعد ذهاب موسى إلى الطور وقعت طائفة من بني إسرائيل في الشرك بالله
تعالى، وعندما رجع وغضب عليهم قالوا له: لم نفعل هذا من تلقاء أنفسنا وإنما خدعنا السامري.والواقع
أننا لم ترد الاحتفاظ بحلي المصريين التي حملناها كرها، وسلمناها للسامري بحسب طلبه.فهذه العبارة
تبين أن المصريين هم الذين حملوهم هذه الحلي كي يرحل عنهم بنو إسرائيل الذين كانوا يظنونهم سبب
المصائب التي نزلت بهم.و نسبت هذه التوراة إلى سيدنا موسى أنه عندما أراهم المعجزة كانت يده مصابة بالبرص (سفر
الخروج ٤: (٦)، في حين أن التوراة تنجس المبروص اللاويين (۱۳ (۸) والبرص مرض مكروه.فيطهره
القرآن من هذه الوصمة ويقول: وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)) (طه: ٢٣).وتزعم التوراة أيضًا أن هارون عليه السلام صنع لبني إسرائيل عجلا ووجههم نحو الشرك.ولكن
القرآن الكريم يرفع عنهم هذا الريب فيقول: (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِتُمْ بِهِ وَإِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (طه: ٩١).وهكذا يكشف القرآن أن هارون لم يكن من
المشركين بل من المبطلين للشرك.وتقول التوراة الحالية أن سيدنا سليمان عندما تقدم به العمر أغرته زوجاته بعبادة غير الله (الملوك
الأول، ١١: (٤)، ولكن القرآن برأه من هذه التهمة فقال: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
(البقرة: ۱۰۳)، أي أن سليمان بريء من الكفر ولكن اللذين رموه بالكفر هم الشياطين الكافرون.
Page 121
وزعم اليهود أن سيدنا المسيح بن مريم عليه السلام كانت ثمرة بغاء والعياذ بالله، وانه جاء من نطفة
يوسف النجار من غير زواج.دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة جيسس، وكتاب حياة المسيح من
وجهة نظر اليهود).ورماه بعض اليهود بأنه ابن الجندي الروماني (بنثيرا) نتيجة علاقة أثيمة مع أمه(دائرة
المعارف اليهودية، ج ۷، ص۱۷۰).وطعن فيه اليهود بأنه كان مصابا بمس الشيطان، وأنه كان يتلقى
الشيطاني من بعلزبول (مرقس٢: ٢٢).الو-
لكن القرآن الكريم يطهرهما من هذه التهم كلها ويقول: (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِنْ
رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء (۹۲)..فهو يعلن طهارة الصديقة مريم التي حفظت كل
منافذها و لم تحمل من روح شريرة، وإنما من روح طاهرة من عند الله تعالى.وبرأ القرآن سيدنا عيسى من علاقة الشيطان فقال: وَآتينا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُس (البقرة : ٢٥٤)، فهو صاحب الآيات البينات، المؤيد بروح القدس، أي الملاك الطاهر المقدس.واتهم عيسى عليه السلام من قبل أتباعه بتهمة الصلب وهكذا وصموه باللعنة حسب ناموس التوراة
كما بينه بولس: "المسيح افتدانا من لعنة الناموس..إذ صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: معلون كل من
علق على خشبة".(رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۳ (۱۳)
وقد ورد عن موت المسيح على الصليب حسب زعم النصارى ومكثه في جهنم وموته ميتة اللعنة في
إنجيل نقوديمس ٢٠.وكذلك جاء في رسالة بطرس الأولى ما يلي: "فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من
أجل الخطايا، البار من أجلِ الأَثَمة، لكي يقربنا إلى الله مُمانًا في الجسد ولكن محيا في الروح الذي فيه
أيضًا ذهب فَكَرَزَ للأرواح التي في السجن، إذا عصت قديما حين كانت أَناةُ الله تنتظر مرة في أيام نوح،
إذ كان الفلك يُبنى، الذي فيه خَلَص "قليلون" (رسالة بطرس الأولى ۳ : ۱۸ - ۲۰)
وقد ورد في تفسير ماتيو" "بول" أن المراد بالسجن هو جهنم.ولكن القرآن الكريم يرفع هذه التهمة عن المسيح قائلا على لسانه وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (مريم) (٣٤) ، أي أن اللذين يرمونني بأنني من ولادة غير شرعية فإنهم كاذبون،
لأن ولادتي شملها سلام الله، واللذين يدعون بأني مت مصلوبا ملعونا هم أيضًا مخطئون..لأن موتي
يشمله سلام الله تعالى، وسوف أنجو من ميتة اللعنة.ومن يزعم أني سوف أتحمل ذنوب الآخرين وأبقى
في الجحيم ثلاثة أيام فهم أيضا مخطئون..لأنني سوف أبعث تحت ظل سلامة عز وجل.والأساس الخامس للدين هو الإنسان نفسه لأنه مهبط الوحي الإلهي.وقد حاولت بعض الأديان أن
تهدم هذا الأساس أيضًا؛ حيث تقول المسيحية بأن الروح الإنسانية أثمت بسبب ما ارتكب آدم من
الذنب، وأن الإنسان بطبعه ميّال إلى الإثم.رسالة بولس إلى أهل رومية، ٥: ١٢).
Page 122
والدين الهندوسي أيضًا يصرح بأن الإنسان رغم كفاحه لا يمكن أن يتطهر، بل لا بد له أن يخضع
*
للتناسخ المتكرر.ستيارث بركاش، لباندت دياندجي مؤسس ديانة آريا سماج: باب ٩).لكن القرآن الكريم، على عكس كل الأديان، يبرئ الفطرة الإنسانية ويقول : وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) (الشمس: ۸-۱۱).أي نحن
نقدم النفس الإنسانية كشهادة على أننا خلقناها مترهة من كل عيب، ووضعنا في فطرتها قوة التمييز بين
الخير والشر.فالذي يحفظ روحه من شوائب الشر يكون في منجاة، ومن يعكر صفاء الفطرة الإنسانية
بالشوائب الدنيوية ويحط من مكانتها العالية يلقى الخسران..بمعنى أن الروح الإنسانية تُخلق طاهرة نقية،
لكن الناس بعد ذلك يدنسونها، وليس صحيح أنها تنجست بذنب آدم أو غيره.وكذلك يبطل القرآن دور التناسخ ويقول : الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: ۳۳) فاستخدام الجملة الاسمية سَلامٌ عَلَيْكُمُ يفيد معنى
الدوام، أي تكونون في سلام دائم.وكذلك يقول : وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْذُودٍ (هود: (۱۰۹).فالسعداء سوف يبقون في الجنة
بحسب مشيئة الله ما دامت سماوات الجنة وأرضها باقية.ولقد قضى الله عز وجل أن
بنعمة غير مقطوعة وأن لا يخرجهم منها أبدا ولقد أقرّت هذه الآية الكريمة حق الفطرة الإنسانية المتعلق
بالنجاة الدائمة الذي أبطله الهندوس الآريون من خلال عقيدة التناسخ.فالإسلام قد أزال جميع التهم التي ادعاها أتباع الأديان المختلفة والفلاسفة على جميع دعائم الدين..إذ
عز وجل والملائكة والكتب والرسل والفطرة الإنسانية من كل ما نسب إليهم من افتراءات.وهذه مزية لا يملكها كتاب آخر في حالته الراهنة.برأ الله
يمتعهم في الجنة
ولو لم يكن للقرآن فضل سوى هذا الأمر لكفى بذلك وحده دليلا يُثبت ضرورته رغم وجود الكتب
الأخرى.فمن الجلي أن الذي يسيء الظن بالله تعالى ويرتاب في صفاته عز وجل..لا يمكنه أن يتصل به
ويتمتع برحمته الواسعة.والذي يسيء الظن بالملائكة لا يستطيع أن يعزز علاقته بهم، ويستفيد من
توجيهاتهم الظاهرة.والذي لا يؤمن بالأنبياء أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ليس بإمكانه أن
أسوتهم
الحسنة ومثلهم العليا.والذي يشك في كلام الله
تأثيره الطيب وثماره النافعة.ومن يظن
حتما
سیحرم
من
يتبع
بالفطرة الإنسانية الظنون سوف تضعف جهوده لتطهير النفس بالعزيمة الصادقة التي لا بد منها للحصول
على الطهارة الروحية.فوصف القرآن المجيد بأنه لا ريب فيه قد فتح طريقا للاستفادة من مصادر
الخير.والانتفاع بمثل هذا الهدى يكفل له النجاح، ويضمن له النجاة، ويمكن الأمل في القلوب.
Page 123
والذين يسارعون إلى الطعن في القرآن مع جهلهم الفاضح باللغة العربية، يفسرون عبارة لا
فيه على أنها تعبير عن القلق الذي شعر به الرسول ﷺ لما في القرآن من ريبة، وأنه ينفي عن نفسه
الريب لإحساسه بما فيه من ريب (القسيس) ،ويري نقلا عن الترجمة الرومية (للقرآن).وهذا الاعتراض
يكشف عن سخف ساذج للمعترض الذي ينسى أو يتناسى أن سورة البقرة ليست أول الوحي، وإنما
نزلت بالمدينة المنورة بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة تتابع فيها نزول القرآن وأبدى الكفار في هذه الفترة
كثيرا من الشبهات وحُقَّ للقرآن أن يرد التهمة بعد أن تلقى الطعن والتجديف مدة طويلة من الزمن.وهل من الخطأ أن يرد الكتاب عن نفسه التهمة بعد أن سددت إليه؟ وهل يقول أي عاقل بأن رد التهمة
إحساس بالذنب؟ أنها تهمة خرقاء، لا يتمسك بها إلا حاقد متعصب، يتعامى عن الحقائق الناصعة.من
أمثال صاحب الترجمة الرومية للقرآن والقسيس ويري whery ، الذي يصدقه فيما ذهب إليه.ومن المؤسف أن القسيسين لم يتعمقا في دراسة كتبهما المقدسة؛ إذ لو درساها حقا لما تجرأ على
الاعتراض على القرآن، لأنهما بهذا يعرضان كتبهما للطعن والتجريح..إذ إن الأسلوب الذي يعترضان
عليه نفسه يتكرر فيها، ونسوق بعض هذه العبارات:
"كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء" (أمثال : ٨).أنا الرب المتكلم بالصدق مخبر "بالاستقامة" (إشعياء ٤٥ : ١٩)."هذا حق وجدير بالقبول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول رسالة بوليس الأول ٤ : ٩)
يتضح من هذا أن الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد) قد اختار أسلوبا مماثلا لأسلوب القرآن.فمؤلفو العهدين إذن أولى بالتشكك! والحق أن هذه الشبهة لا تصح في القرآن أو الكتاب المقدس، لأن
دفع الاتهام لا يدل على الشك، وإنما يؤدي إلى اليقين والتأكد من صدق الدعوة.والرأي عندي انه لا
مجال للشك في الوحي السماوي إذا بدأ بهذا الأسلوب، لأن الإنسان لا يعرف بما سيلقاه قوله من رفض
أو قبول.ولكن الله تبارك وتعالى عليم بما سيكون عليه موقف الناس من الكتاب، ولذلك يناسب المقام
نفي الريب عنه، ومثل هذا الفعل يقوم دليلا على علمه تعالى بالغيب.ولما كان الريب يدل على الشك القائم على سوء الظن فقوله : لا ريب فيه يشير إلى أن القرآن لا
يحتوي شيئا تتكون عناصره من سوء الظن والعناد للحق، بل كل ما فيه يقيني محقق وليس ظنيا ملفقا.وليس مثل هذا التحدي بالأمر البسيط، بل إنه من أعظم الآيات على صدق القرآن المجيد.ونقول على
وجه الإجمال أن القرآن لم يأت بعقيدة إلا وعززها بالشواهد، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في مواضعه
عند تفسير الآيات.
Page 124
إن أفضلية القرآن تتأكد بهذا القول أيما تأكد، لأن ذكر أمر أو أمرين معلومين بالأدلة يكون يسيرا، أما
أن يكون كل ما في القرآن مدعما بالدليل الذي يزيح عنه ستار الظن والاضطراب، ويوقفه موقف اليقين
والثبوت..فلا يسع المنصف إلا أن يثق في مثل هذا الكتاب ولا يشك في صدقه أبدا.ذلك
ومن معاني لا ريب فيه أنه لا شك في كون القرآن محفوظا وورود هذا الكلمات بعد
الكتاب يدل على أنه لا كتاب بعد هذا الكتاب، وأنه صحيفة أخيرة أنزلت لهداية الناس..لأنه، كما
ذكر من معاني ذلك الكتاب أن هذا هو الكتاب الكامل الذي يتضمن ما يلبي جميع حاجات
الإنسان، فما دام كذلك لا يمكن أن يتزل كتاب آخر إلا إذا تطرق الضياع إليه، لأن القانون الجديد
يدعو إليه أمران اثنان إنما أن يكون القانون السابق ناقصًا، وظهر عليه القصور والعجز أمام مهمات زمن
ما، أو فقد كلُّه أو بعضه ومست الحاجة إلى إعادة تدوينه.لذلك
صرح عز وجل بهذا الأسلوب..أي قول لا ريب فيه بعد ذلك الكتاب أن هذا الكتاب الكامل لن يزال محفوظا من حوادث
الدهر، ولن يأتي زمن ينتاب فيه الناس ريب فيما إذا كان لفظه لا يزال كما نزل من عند الله تعالى أم أنه
قد تغير..وبما أنه لن يأتي على هذا الكتاب مثل هذا الزمن..فلن ينسخ أبدا، بل لا بد للناس إلى يوم
القيامة أن يطبقوه من أجل حياتهم الروحية.الله
أن هذا الإعلان العظيم ليدل على ميزة عظيمة للقرآن فاليوم وقد مرت على نزوله أكثر من أربعة
عشر قرنا..لا يزال الأعداء فضلا عن الأصدقاء يشهدون على صحته.وهناك من الشواهد الذاتية
والخارجية ما تدل على أصالته وسلامته من التحريف يشهد بذلك رجل مثل السير وليام موير، ويقول:
There is otherwise every security internal and external that we
posses that text Mohammad himself gave forth and used.(Life of Mohammad by Sir William Muir P.561)
أي أن لدينا كل ضمان داخلي وخارجي على أن الكتاب الذي بين أيدينا هو نفس نص الكتاب
الذي قدمه محمد للناس واستعمله بنفسه.والقرآن وحده يتمتع بهذه الفضيلة، التي تدل دلالة واضحة على ضرورته رغم وجود الكتب الأخرى،
لأن الكتاب الذي يتطرق إلى صحته الشك لا ينشرح الصدر للعمل به، في حين أنه لا بد من الانشراح
الكامل في الدين والعقيدة.وكتب العهد القديم والجديد والفيدا والزند أفستا كانت موجودة قبل القرآن،
ولكن لم يكن أي كتاب منها محفوظا بصورته المنزلة.فأتباع الزند أفستا يعترفون بأنفسهم أن معظمه قد
ضاع، والنسخة الحاضرة منه بحالة لا تدع مجالا للشك في ضياعه (دائرة معارف الأديان والأخلاق،
مجلد ۲).
Page 125
والفيدا أيضا غير مصون، ونسخه مختلفة عن بعضها اختلافا كبيرا مما يشكل دليلا واضحا على
التحريف.وقد بلغ هذا التحريف إلى حد اختفاء فقرات من نسخ ووجودها في أخرى.ولقد شهد
بتحريفه عالم هندوسي قبل عدة قرون، قال: "إنهم خلطوا الكلام الإلهي بالكلام الإنساني، وشوهوا
الأصل أنواعا وأشكالا (کورم بوران بورو ،ارده باب ٢٠، فقرة ٤٤، (٤٦).ولقد صدق جمهور
الهندوس وعلماؤهم في الزمن الحاضر بهذه الحقيقة أيضًا..الأمر الذي يكشف عن حالة الفيدا الراهنة.وتشهد التوراة الحالية على نفسها بالتحريف حيث جاء فيها: "فمات هناك موسى عبد الرب في
أرض موآب حسب قول الرب، ودفن في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان
قبره إلى هذا اليوم" (تثنية: ٣٤)."ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه" (عدد ١٠).ولا يقول عاقل بأن هذا الكلام نزل على موسى عليه السلام وإنما أضيفت هذه الفقرات إلى التوراة
بعد وفاة موسى بمدة طويلة.وعلاوة على ما ألحق بالتوراة من كلام البشر نجد فيها من التناقضات ما لا يمكن معها الادعاء بأن
هذا الكتاب هو نفس ما أنزل إلى موسى، لأن كلام الله تعالى متره عن الاختلاف..وهاك بعض
الشواهد:
جاء فيه أن الله خلق الحشرات والحيوانات أولاً، ثم بعد ذلك خلق الإنسان (تكوين١: ٢٤ إلى ٢٧)،
ولكنه في موضع لاحق يقول أن الله بعدما خلق آدم خلق أنواع الحيوان والطيور (تثنية ٢: ۱۸ و ۱۹).وجاء فيه أن الله تعالى أمر نوحا أن يضع في سفينته سبعة أزواج من كل نوع طاهر، فعمل نوح
أمر (تكوين : ١ - ٥)، لكنه في نفس الإصحاح يقول أن الزوجين، أي الذكرين والأنثيين، من كل
كما
نوع طاهر دخل السفينة حسب ما أمر الله !! (تكوين : (۹) فهل هي سبعة أزواج أم زوجان؟
وهناك عشرات من أمثال هذا التناقض الذي يكشف بوضوح أن هذا الكتاب لم يعد بالصورة التي
نزل بها على موسى عليه السلام.والأناجيل كذلك، لا نجد فيها ما نعتمد عليه في تمييز الوحي عن غيره..لأن الأناجيل كثيرة،
ورجحوا منها أربعة عن طريق الاقتراع بلا مرجح، وقيل أن هذه الأربعة هي أصحها وأوثقها.ولكن
هذه الأربعة أيضًا يندر فيها كلام المسيح، أما كلام
الله فلا
يوجد فيها مطلقا..نعم، هناك بضع
من کلام الله أو من كلام المسيح، يكاد ينعدم في
نسبها المسيح إلى الله، ولكن الوحي، سواء كان
كلمات
الأناجيل.أنها تضم أحداثا تاريخية لا تمت إلى الوحي بصلة، وما هي إلا وجهة نظر لبعض المؤرخين
وليس غير.
Page 126
ولا تنتهي
القضية عند هذا الحد لأن الأناجيل التي يتكون منها العهد الجديد متناقضة أشد التناقض،
وكذلك تراجمها في مختلف الأزمان متعارضة أشد التعارض، وإليك بعض الشواهد:
يقول متى في إنجيله إن المسيح أوصى تلاميذه قائلا: "لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم،
ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا "عصا (۱۰) ۹ - ۱۰ ).ولكن (مرقس) في إنجيله يقول: ١)."أوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا
مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين (٦: 7- ٩)
فأحدهم يقول لا تأخذوا حذاء ولا عصا والثاني نصحهم أن لا يأخذوا غير عصا وأن يكونوا
مشدودين بالنعال.وهذا تناقض بين.يقول (متى): "وأيضًا كان اللصان اللذان صُلبا معه يعيرانه" (٢٧: ٤٤).ويتفق مرقس (۱٥ : ۳۳ مع (متى) في ذلك، ولكن (لوقا) يخالفهما ويقول: "وكان واحد من المذنبين
المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا، فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا
أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه..ثم قال ليسوع: "اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس (٢٢: ٢٩، ٤٠ ، ٤٢ و ٤٣).ويقول (مرقس) أن المسيح انتهى من المحاكمة الساعة الثالثة (١٥: ٢٥).ولكن (يوحنا) يعارضه
ويقول إنه كان في محكمة بيلاطوس نحو الساعة السادسة.(١٩: ١٤).وفي (متى) أن يهوذا الاسخريوطي الذي ساعد على اعتقال المسيح خنق نفسه منتحرا (٢٧: ٥)، لكن
ذكر في (سفر (الأعمال أنه سقط على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها (۱: ۱۸).وهناك اختلاف غريب حول الحوادث التي وقعت في اليوم التالي ليوم الصليب.يقول (يوحنا): "وفي
أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعا" (٢٠: ١).فالزائرة
امرأة واحدة.ولكن (متى) يقول : " وبعد السبت" عند الفجر الأول للأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى
لتنظرا القبر" (۲۸:۱)، فالزائر امرأتان ولكن (مرقس) يخالف السابقين ويقول "وبعدما مضى السبت
اشترت مريم المحلية ومريم أم يعقوب وسالومة حانوطًا ليأتين ويدهنه.وباكرا جدا في أول الأسبوع أتين
إلى القبر إذ طلعت الشمس" (١٦: ١-٢).فالزائرات ثلاث نسوة.ولكن لوقا يخالف الجميع فيقول
"وكانت مريم المجلية ويوحنا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل" (٢٤ : ١٠).فكيف يمكن مع هذه التناقضات البينة أن نسلم بأن هذه الأناجيل هي كلام الله؟ إن هذا الشاهد وأمثاله
Page 127
كثيرة من تناقض الأناجيل تؤكد أنها ليست منزهة عن الريب والشك.أما النسخ المختلفة للعهد
الجديد ففيها من الاختلاف ما يزيد الأمر ريبة، واليكم بعض الشواهد:
الله
١- في إنجيل (متى) المطبوع قبل عام ۱۹۳۰، نجد الفقرة التالية وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا
بالصلاة والصوم (۱۷) (۲۱) ولكنها حذفت من النسخ المطبوعة عام ١٩٣٠ وما بعدها.٢- وفي (متى) قبل عام ١٩٣٠ "فقال له: لماذا تدعوني صالحا.ليس أحدا صالحا إلا واحد وهو
(۱۹ (۱۷) ، ولكنها حرّفت في الطبعات التالية إلى "لماذا تسألني عن الصلاح".٣- وجاء في (متى) أيضًا: ويل" لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل،
ولعلة تطيلون صلاتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم (۲۳) (١٤)..وهذه أيضا حذفت من طبعة ما بعد.۱۹۳۰
٤ - وتكرر هذا الحذف من إنجيل متى في (۲۷) (۳۵)..لما" صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي ٣٥).يتم ما قيل بالنبي..اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة".- وكذلك حذفت الفقرة (٥) (٤) من إنجيل يوحنا "لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك
الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه"
٦- وفي إنجيل يوحنا نجد في النسخة المطبوعة في (مرزابور، الهند حاشية تقول أن الفقرات من (۷:
٥٣) إلى (٨: (۱۱) ليست موجودة في أكثر النسخ المخطوطة.فعلماء النصرانية أنفسهم يعترفون أن بعض الفقرات التي في الإنجيل لم تكن في الواقع جزءا منه، وأن
النسخ القديمة يختلف بعضها عن بعض، إذ يوجد في بعضها طائفة من الفقرات التي لا توجد في البعض
الآخر.فهذه الأمور كلها لتنهض دليلا حاسما على أن الأناجيل الحالية ليست مترهة عن الشك
والشبهات، بل إنها لدليل قاطع على تحريف الإنجيل والزيادة فيه.فعلى الرغم من وجود هذه الكتب المحرفة المنسوبة إلى الله كان العالم بحاجة ماسة إلى كتاب تكون
كل كلمة منه محكمة متسمة باليقين، ويعترف الجميع معارضين ومؤيدين بصحته وصيانته من التحريف.فقوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب فيه يشير إلى هذا المعنى في حق القرآن الكريم ويؤكده.وخلاصة القول، أن نزول القرآن كان ضرورة لها كل المبررات لأن الكتب السماوية التي
موجودة قبل نزوله أصابها التحريف، وهذا مدعاة لكتاب جديد يمكن أن يعمل الناس وفق أحكامه
وتوجيهاته..وهم مطمئنون إلى أن كل كلمة فيه من عند الله تعالى.ولذلك يعلن القرآن بعد إثبات
كماله أنه سالم من أي ريب..حتى يبين الضرورة الداعية إليه بعد أن تطرق الشك والاضطراب إلى ما
سبقه من كتب.كانت
Page 128
أنه
ومن معاني الريب أيضًا الهلاك ،والدمار ومن هذه الناحية تدل عبارة لا ريب فيه على أن هذا
الكتاب..علاوة على أنه كامل جامع لكافة الفضائل..فهو أسمى من أن يكون فيه ضرر ما.إن بعض
وصفات العلاج قد تفيد في علاج مرض معين ولكنها قد تسبب أعراضا مرضية جانبية..ولذلك يطمئن
الإنسان علاج لا ينجم عنه ضرر قط لا في الأمور المادية ولا في الأمور الروحانية، فهو
خير محض.ويتأكد هذا المعنى من قوله تعالى: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)) (طه: ۳).فليس في
القرآن توجيه يعرقل التقدم الروحي أو المادي للإنسان بل هو خير صرف.وهذا ما يجعله ذا مكانة تسمو
فوق كل كتاب.القرآن
بني
ومن معاني الريب الحاجة..فيعني قوله تعالى: لا ريب فيه ، أنه كتاب جامع، لا يحتاج إلى شيء
من خارجه فما من حاجة إنسانية اعتقادية أو عملية أو خلقية أو اقتصادية أو حضارية إلا ويلبيها
القرآن.وهذه ميزة قد اعترف بها حتى الأعداء.فقد ورد في الحديث: "قال رجل من اليهود لعمر بن
الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا..لا تخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية،
أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة" (الترمذي، كتاب التفسير).فاجتمع في ذلك اليوم عيدان،
الجمعة عندنا عيد أيضًا.لأن
يوم
ويروى أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم..أمام يهودي فقال له لو نزلت علينا لاتخذنا
يوم نزولها عيدا.فقال ابن عباس : لقد نزلت في يوم اجتمع لنا فيه عيدان.(المرجع السابق).فالقرآن على صدقه وخلوه من كل شك، كتاب لا ينكر حقيقة بل يعترف بالحقائق، ويذب التهمة
والمظنة عن أسس الدين ويعتمد على اليقينيات لا الظنيات، وأنه محفوظ إلى يوم القيامة، وانه لا يعوق
تقدم البشرية ولا يؤذي العاملين به، وإنه لتوجيه كامل لكل ضرورات الحياة الإنسانية أفرادا وجماعات.قوله تعالى : هدى للمتقين.بعد أن بينت عبارة لا ريب فيه فضائل القرآن السلبية، أي ما تتره
عنه من سلبيات، تبين لنا عبارة هدى القرآن فضائله الإيجابية، أي ما اتصف به فعلا من إيجابيات.وتهدف هذه الصفة إلى أن القرآن غني بما يتوق إليه الإنسان للاتصال بخالقه إن الفطرة السليمة تتقدم
مندفعة بتلاوة القرآن نحو الله ولا يمكن بغير هذا الاندفاع أن تخطو الأرواح خطوات الشوق والمحبة بمجرد
الأفكار الفلسفية.لأن الفلسفة قد تثير الفكر، ولكنها لا تثير العاطفة الجياشة التي لابد منها لاندفاع
الفطرة الإنسانية نحو التطور المطرد لإنجاز العمل الذي اضطلعت به.يستطيع الفيلسوف إلقاء خطاب
رنان حول الإيثار وخدمة الغير، ولكن الأم الجاهلة التي لا تدرك ما يقوله الفيلسوف..تقدم في سبيل
طفلها مثالا عمليا للتضحية والتفاني ما لا يستطيع الفيلسوف أن يأتي بعشر معشاره.من أجل ذلك لا
Page 129
ينجح
الكتاب في رسالته الإصلاحية الشاملة إلا إذا كان هدى للمتقين، أي قادرا على
أن يلهب
عاطفة الحب في العاملين به بعد أن يطهر قلوبهم بآياته، ويزودهم بميل شديد للتقدم إلى
الله تعالى،
والعطف على المخلوق والقرآن بهذه الكلمات يهدف إلى تحقيق هذه الغاية، ويقول أن هذا الكتاب
الكامل الخالي من الريب والمضار يكسب الإنسان طاقة التقدم التي يسير بها نحو الحب الكامل
وجل.الله
عز
والهدى يعني
يُحرموا من إرشاد الله، ولا ينقطع عنهم توجيهه..سيجدون في هذا الكتاب ما يحقق رغبتهم.وأيا كان
نصيب المرء من التقوى فسيكون له بغيته من الاهتداء في تعاليم هذا الكتاب التريه الذي يطمئن إليه
القلب وتهدأ به الثائرة ويشعر أنه على هدى من ربه، وليس تابعا للعقل فقط، وانه إذا استعان بالله تعالى
استطاع أن يتقدم واثقا مطمئنا بعيدا عن الشك والاضطراب.والهدى أيضا التوفيق لمزيد من العمل ورفع المستوى الفكري للعامل..وبهذا المعنى تقول الآية: أن
القرآن الكريم يمتاز بقوة عجيبة، فإذا عمل الإنسان بحكم من أحكامه فإنه يتشوق بهذا العمل إلى مزيد
من التقدم في الخيرات، والله يوفقه لذلك توفيقا متواصلا..يجلو تفكيره، فيتقوى ويزداد إقداما وتنفتح له
الطرق الدقيقة للتقوى..وكأنه بذلك يسلك مسالك التقوى اللانهائية، ولا يمكن أن يتحدد مدى
تقدمه..كما يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۸).فالتقوى
والهداية ليس لهما حد أو نهاية بل لهما منازل والقرآن يهدي المؤمن حسب مرتبته من الإيمان إلى مرتبة
أخرى أعلى منها، وهذا الارتقاء التدريجي مستمر إلى مراتب غير متناهية.ويقول عز وجل: وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا )) (العنكبوت: ۷۰).فالذين يكافحون لأجل الاتصال بالله تعالى ويسلكون
الطرق التي حددناها لذلك..سنبين لهم الطرق المتتابعة الموصلة إلينا.وفي هذه الآية إشارة إلى أن سبلنا
متوالية غير منتهية وكذلك يقول: نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا
وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحريم: (۹) ففي الحياة الآخرة يأتي رسول الله ﷺ وأتباعه
المؤمنون إلى الجنة، ويتقدمهم ذلك النور المنبثق عن الإيمان والعمل..يسألون الله تمام النور والغفران.ومعنى ذلك أن التقدم الروحى لا يرتبط بالحياة الدنيا ،وحدها، بل يتعداها إلى الحياة الآخرة أيضًا،
فيها المؤمنون بهذا التقدم ويستزيدون من القوى المساعدة على التقدم المستمر.والخلاصة أن الهدى، كما فسرته الآيات المذكورة دليل على ارتقاء لا نهاية له، وان القرآن وسيلة
المتقين التي تمكنهم من التقدم المطرد.كذلك ما يُبعث به الأنبياء من هداية.ومن هذه الناحية تقول الآية: أن الذين يريدون ألا
ويتمتع
Page 130
والهدى أيضًا الخاتمة بالخير وبلوغ الغاية المنشودة، ألا وهي دخول الجنة.ومعنى ذلك أن الآية تهدف
إلى بيان أن القرآن يتضمن من التعاليم ما يستطيع به المتقي أن يبلغ هدفه النهائي.ونظرا إلى أن سائر
الملل تدعي بنفس الدعوة لذلك قد يبدو للقارئ أن دعوى القرآن هذه لا تقدم ما هو جديد وأفضل؛
ولكن إذا أمعنا النظر في المعنى الذي ذكره القرآن للجنة لتبين لنا ما يتصف به القرآن في هذا الموضوع
من جدة وطرافة.فالقرآن لا يذكر أن الجنة دار التمتع للنعم في الآخرة فقط، بل يقول أن دخول الجنة
الأخروية مرتبط بالجنة الدنيوية، فمن نال جنة الدنيا فاز بجنة الآخرة..كما يقول عز وجل: وَلِمَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (الرحمن: (٤٧).فالذي يتقي الله حق تقاته له جنتان.ويقول أيضًا: ﴿وَمَنْ كَانَ
فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا )) (الإسراء: (۷۳).ومن لم يتق الله حرم نور الدنيا
والآخرة، والمؤمن الذي يستنير بنور القرآن يتمتع في هذه الدنيا بتجلي الله، ويتحول إيمانه بالغيب إلى
إيمان الشهود، ولا يعتقد بأنه سيرث جنة الآخرة بعد موته فحسب..بل يكشف الله تعالى له صفاته في
أنه ليرى نفسه في الجنة قبل الممات.أما الموت الجسماني فيزيد شعوره الدنيوي جلاء بعد أن
الدنيا، حتى
يتيسر له تجلي الله في هذه الدنيا.ومن البين انه لا يبقى بعد هذا المقام اضطراب أو اشتباه، ومن ينل هذا المقام يصبح بمنجاة من
العثرات والعقبات فكأنه في حضانة الله تعالى في الحياة الدنيا.فلا يكون إذن- قول القرآن بأنه وسيلة
لدخول الجنة ادعاء بلا دليل بل إنه يقدم هذه الحقيقة كشاهد يكشف عن صدقه من كذبه في هذه
الدنيا.ولم تخلُ الأمة الإسلامية يوما من أناس كانوا دليلا على صدق هذه الحقيقة.فظلوا يتمتعون
الله تعالى وتجليه حتى دخلوا الجنة وهم في الدنيا..أي أصبحوا بمأمن من إغواء الشيطان،
وفي مرفق من النعم الروحية، وتشرفوا بكلام الله المتتابع، وأكرموا بمنجاة الله، واستشفوا آياته البينات في
أنفسهم، وجعلوها تتجلى في الآخرين.بالاتصال مع
ويقول بعض من لا يتدبر القرآن: إذا كان القرآن هدى للمتقين فقط، فلا بد من كتاب آخر
يُكسب الناس التقوى قبل الاهتداء بالقرآن فيقول القرآن :موضحا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ (الفتح: ٢٧)..أي أن التقوى الحقة لا
تحصل إلا بالقرآن والإيمان به بل هي التقوى الباقية الدائمة.إن الآية تقول بان أهل التقوى ذوي الصلة
الوثيقة بالله هم المؤمنون بالقرآن والآيات كثيرة تؤكد بأن القرآن هدى الجميع بني الإنسان على تفاوت
درجاتهم الروحانية، وهو لا يخص فريقا دون فريق، بل يعم البشرية جمعاء..فيقول تعالى: هَذَا بَيَانٌ
لِلنَّاسِ وَهُدًى (آل عمران (۱۳۹).ويقول: (هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة:
١٨٦).ويقول القرآن: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَل (الكهف: ٥٥).أي أن
Page 131
مفهوم
القرآن يتضمن مثلا أعلى لكل ما يتصل بمصلحة بني الإنسان جميعا متقين كانوا أو غير متقين، وكل يجد
فيه حسب وضعه من الروحانية ما يتقدم به إلى أعلى، ويسد حاجته من المهمات الدينية والدنيوية.ويقول عز وجل: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل (الروم: ٥٩).وهذه الآية تؤكد
الآية السابقة تقريبا، والفرق الوحيد أن الله تعالى قد قال في الأولى (صرَّفنا) وقال هنا (ضَرَبْنا).والتصريف إشارة إلى تنوُّع الأساليب التي اختارها القرآن لتعليم الهدى، أما ضرب المثل فهو إشارة إلى
بيان هدي القرآن بذكر أمثلة صحيحة وواضحة من الفطرة الإنسانية.ويقول أيضًا: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي
هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ﴾ (الإسراء: (٤٢).وهنا أيضا لا تخص الهداية المؤمنين وحدهم.ويقول: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: ۲۲).وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) (طه: (١١٤).فالقرآن يتوعد الكفار بهدف أن يصبحوا
متقين.وان كان الأمر كذلك فلماذا لم يقل القرآن أن أساسه التقوى الذي يقوم بناؤه عليه، بل قال إنه
هدى للمتقين ؟ والإجابة على هذا التساؤل ذات شقين:
:أولا أن الآية في محل الإعلان عن أفضلية القرآن وبيان الحاجة إليه رغم وجود كتب أخرى، لذلك
كان من الأنسب أن يذكر المراتب العليا التي يمتاز بها القرآن عن غيره من الكتب، والتي سكتت الديانات
الأخرى عنها ولو بالإشارة
وثانيا: أن التقوى تعني أيضًا الجانب الفطري منها..كما يقول تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
الشمس (۹) أي ألهمها قوة التمييز بين الخير والشر.فالتقوى هنا هي المحافظة على الفطرة، وهذا لا
يختص بدين أو عقيدة.إن مَن يُدنّس فطرته ولا ينأى بها من عوامل الفساد لا يمكن له أن يهتدي ما لم
يُرغم على ذلك إرغاما والقرآن لا يقبل الإكراه في مسألة العقيدة بتاتا.فالذين يستعدون لقبول الحق
ويطهرون فطرتهم هم الذين يهتدون بالقرآن ويبلغون الدرجات العلى، وأما الذين يأبون إلا البقاء على
غيّهم وضلالتهم فأولئك قد حكموا على أنفسهم بالهلاك، وليسو مهتدين إلا أن يُساقوا إلى ذلك سوقا،
وليس هذا من الهداية النافعة.الله
وإذن فقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين برهان على أهمية القرآن وضرورته مع
وجود كتب أخرى، وبيان أنه
وحي من تعالى الذي لا ينفع الهداية الروحانية سواه، ولا تجدي
الكتب غير الإلهية نفعا مع وجوده وهو الهداية الحقة التي لا بديل لها من الكتب السماوية السابقة
للأسباب التالية :
١.القرآن كتاب كامل وغيره ينقصه الكمال.
Page 132
.القرآن محفوظ من التحريف، وغيره لم يسلم من التحريف والاختلال.٣.القرآن شامل لكل العالم والأمم، وغيره خاص بقومه.جاء ليحفظ كرامة الشخصيات الدينية.{
المحترمة لدى الأمم جميعا، وجاء لإحياء كل ما ضاع من التعاليم السماوية السابقة.القرآن يقدم الفرص لمن أراد الاتصال بالله والتشرف بمكالمته، وغيره من الكتب لم يعد صالحا
لذلك بسبب نقائصه الداخلية والخارجية.كل ذلك من
المعارف الدقيقة لرائعة التي تشع من هذه الآية الصغيرة في عدد ألفاظها..العظيمة في
محتواها وأهدافها..وهذا مثل من إعجاز القرآن الكريم.قدمت هذا البحث بفضل الله تعالى على ضوء المعاني والتعاليم التي بينها مؤسس الجماعة الإسلامية
الأحمدية، وأود أن أضيف هنا حكمة لطيفة من الحكم الكثيرة التي بينها لنا حضرته بصدد تفسير هذه
الآية..أنقلها لكم بنصها كي يتعرف القراء كيف أنه غاص في بحر هذه الآية العميق، وأتى بفرائد نادرة
من لآلئ المعرفة الروحانية.قال عليه السلام:
" لتكميل أي شيء لا بد من توافر أربع علل:
أولا: أن يكون صانعه كاملا،
ثانيا: أن تكون المادة التي صُنع منها عالية الجودة،
ثالثا: أن تكون صورته في ذروة الجمال،
رابعا: أن تكون نتيجته محققة للغاية منه تماما.أي علته الفاعلة، وعلته المادية، وعلته الصورية، وعلته الغائية: وبكمال هذه العلل الأربع يكون الشيء
كاملا.من
هو
ولقد أعلن الله تعالى في مستهل القرآن المجيد بتوافر هذه العلل الأربع في حقه حيث يقول: الم..أنا
لله أعلم، إشارة إلى كمال العلة الفاعلة.فالكتاب الذي يصدر عن العليم يكون أفضل وأكمل الكتب
التي تؤلفها شخصيات هي أقل منها علما وأنقص قدرة.ثم يقول عز وجل: ذلك الكتاب..هذا
الكتاب الكامل، ولذلك فإن مادته فضلى المواد.ثم يقول لا ريب فيه..وهذا يدل على كمال العلة
الصورية، لأن القرآن بلغته الفصيحة منقطعة النظير، وشكله المصون المحكم الفذ يمتاز بصورة رائعة
متناسبة بريئة من كل عيب فعلته الصورية أكمل وأتم من أمثالها في الكتب الأخرى.ثم يقول: هدى
للمتقين..فعِلته الغائية أيضا أكمل، لأن الكتب السابقة تصل بالإنسان إلى درجة التقوى، أما القرآن
فيبلغ بالإنسان أعلى مراتب التقوى ويشرفه بكلام الله، ويمكنه من الاتصال الكامل بخالقه.
Page 133
هذا ملخص ما كتبه مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية ( عليه السلام)..ومن يتدبر في كتابه من أهل
البصيرة يجد فيها هذه المعارف الكثيرة، بل وما هو أكثر وأروع.الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)
شرح
الكلمات :
يؤمنون آمنَه إيمانا أمَّنه أي هيّأ له السلامة آمن به صدقه ووثق به آمن له: خضع له وانقاد.والإيمان يتعدى نفسه كصدق، وباللام..باعتبار معنى الإذعان، وبالباء..باعتبار معنى الاعتراف، إشارةً
إلى أن التصديق لا يُعتبر بدون اعتراف (الأقرب).فكلمة يؤمنون تدل على ثلاثة معان: التصديق والاعتراف واليقين الراسخ (تاج العروس).الغيب: غابت الشمس وغيرها إذا استترت من العين، واستعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما
يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب والغيب في قوله تعالى: (يؤمنون بالغيب ما لا يقع تحت الحواس،
ولا تقتضيه بداهة العقول (المفردات).وقوله تعالى : يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم.والغيب ما غاب عن العيون وإن كان مُحصلا في القلوب أو غير مُحصل، بل كل مكان لا يدرى بما فيه
هو غيب، وكذلك الموضع الذي لا يدرى ما وراءه غاب الرجل غيبا: سافر أو بان (اللسان).فالغيب كل شيء لا تراه العيون ،الباصرة ولا تدركه الحواس الظاهرة، رغم وجوده، وهو من
الإيمانيات فمعنى يؤمنون بالغيب:
أنهم يعتقدون بكونه حقا يقينا كاملا ويعترفون به، ويصدقونه.وأنهم يعتقدون اعتقادا جازما بما سيحدث بعد هذه الحياة.يؤمنون في حالة الغياب أي وقت انفرادهم أيضًا، فليسوا ذوي وجهين كالمنافقين.يقيمون: قام قياما ضدُّ قعد.قام الأمر : اعتدل قام الأمر : دام وثبت.قام الحق: ظهر وثبت.وقامت
السوق: نفقت.وأقام الصلاة : أدام فِعْلَها ؛ نادى لها وأقام الله السوق: جعلها نافقة (الأقرب)."قوله تعالى: يقيمون الصلاة..أي يديمون فعلها ويحافظون عليها.ولم يأمر تعالى بالصلاة حيثما
أمر ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان
بهيئاتها." (المفردات)
القيام العزم، قام للأمر: عقد العزم لإتمامه (اللسان).و
Page 134
وتعني
الصلاة: فَعْلَةٌ مِن (صَلَّى)، والألف منقلبة عن الواو الصلاة في الشرع عبادة فيها ركوع وسجود،
أيضا الدعاء؛ الدين؛ الرحمة؛ الاستغفار والصلاة من الله الرحمةُ، ومن الملائكة الاستغفار، ومن
المؤمنين الدعاء، ومن الطير والهوام والتسبيح، وهي لا تكون إلا في الخير بخلاف الدعاء...فإنه يكون في
الخير والشر.والصلاة حسنُ الثناء من الله على الرسول ﷺ (الأقرب)
والصلاة التعظيم والبركة.(التاج)
ويسمى موضع العبادة الصلاة.(المفردات)
فيعني قوله تعالى يقيمون الصلوة أنهم:
١.يصلون جماعة،
٢.يؤدون الصلاة وفقا لشروطها ومواقيتها،
٣.يعمرون المساجد بتوجيه الناس إلى الصلاة،
٤.يشوقون الناس للصلاة،
ه.يداومون عليها دون انقطاع،
٦.يحافظون عليها كشيء عزيز، فلا يهملونها فتنهار.رزقنا الرزق : العطاء.رُزقت علمًا أعطيتُه.والرزق : النصيب والحصة قال تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
أَنَّكُمْ تُكَذِّبون ) (سورة الواقعة (۸۳).والرزق ما يتغذى به (المفردات).والرزق ما ينتفع به ورزقه الله أي أوصله إليه (الأقرب).الأدلة
ينفقون: أنفق ماله صرفه وأنفَدَه.أنفق التاجر : نفقت تجارته.وأنفق السلعة: رَوَّجَها.ونفقت المرأة أو
السلعة: كثر طلابها وخطابها.النافق من المال : ما يبيعه الناس فور وصوله إلى السوق (الأقرب).فالإنفاق
يدل على إخرج الشيء وترويجه بدون انقطاع.التفسير تؤكد آيات عديدة في القرآن الكريم وجوب كون الإيمان ثابتا على قواعد من
والبراهين، لا على مناكب الوهم والاضطراب.وإذا كان الإيمان بالغيب هو الصفة الأولى في المؤمن وتأتي
المقدمة، فإن ذلك لا يعني التصديق الأعمى بما لا يُرى، أو الاعتقاد بأمور لا تحس أو لا تدرك عقلا،
فليس أبعد عن روح القرآن من مثل هذا الاعتقاد المفتقر إلى ما يؤيده من تعليل وإدراك.والحق أن القرآن
يستنكر ذلك بشدة.تأمل الآيات القرآنية التالية:
في
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اثْتُونِي
بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ) (الأحقاف: ٥).
Page 135
أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ) (الروم: ٣٦).قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَحْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ (الأنعام: ١٤٩ - ١٥٠).إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا
تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (النجم: ٢٤).وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) (البقرة: ٩).وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (النمل: ١٥).وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا) (الفرقان : ٧٤).قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)) (يوسف: ١٠٩).الأشياء
فالقرآن الكريم يلح على الدليل العقلي والعلمي، ويرفض الوهم والظن والاعتقاد الأعمى.كما أن لفظة الغيب في القرآن الكريم لا تعني الأمور الخيالية غير الحقيقية، ولكنها تعني
الحقيقية المؤكدة، وإن كانت مستورة عن العين.ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحجرات: ١٩).ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (السجدة: ٧).وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ..)) (الأنعام: ٦٠).فعلم الله تعالى يشمل أمورا يشهدها الإنسان وأمورا تغيب عن حواسه، وكلها حقائق يقوم على
وجودها الدليل العملي والعقلي.كتب القسيس "ويري" في تفسيره لهذه الآية أن المسلمين إذا كانوا قد آمنوا بأسرار كتابهم..فلماذا
إذن ينكرون أسرار الكتب السابقة مثل الكفارة والتثليث؟ لكن من البيّن أن وسوسته هذه ناشئة عن
جهله بمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب.فالقرآن لا يأمر بالتمسك بشيء لا يدعمه دليل، بل هو يندد
بما في الأديان الأخرى من معتقدات لا تستند إلى دليل، ويشهد أن أتباع محمد ﷺ لا يعتمدون في إيمانهم
إلا على البرهان.ولم يكن سبب إنكار المسلمين أسرار الكتب الأخرى، كالكفارة والتثليث، أنها سر، كما يزعم
القسيس (ويري)، بل لأنها أمور لا ينهض عليها دليل، بل هي مخالفة للعقل.ولو كان ثمة إثبات عقلي أو
نقلي لها لما أنكرها المسلمون.والمعنى الصحيح للغيب، كما أسلفنا، هو ما خرج عن نطاق الحس الظاهري، ويحتاج إدراكه إلى
الأدلة العقلية والتجريبية وفي حياة الإنسان الكثير من الأشياء التي لا يحسها بالحواس الظاهرة مثل:.
Page 136
الذاكرة الإنسانية، الحياء، الجرأة، الحب، الكراهية، العقل، الفكر..فهل من المعقول أن ننكر وجودها
لأنها لا تحس.وهناك مبادئ أخلاقية معروفة كالعفو الذي يزيل الغضب، وحين المعاملة التي تؤلف بين
القلوب..يعترف بها العالم أجمع، ولكنها أمور غير ملموسة.الأم تتفانى في سبيل وليدها وهي لا تعرف
فيما إذا كانت هذه التضحية ستأتيها بالمسرة والخير أم تسفر عن الألم والشقاء.والمعلم الذي يُدرّس
الطلاب لا يعرف ما إذا كان جهده سيؤدي إلى نتائج جيدة أم إلى فشل ذريع، ولكنه يواصل عمله ولا
يتوقف عنه.والدول تنفق الملايين على مشروعات طويلة الأمد، ولا تدري هل تؤدي إلى نجاح أم
تلحقها خسارة فادحة ولكنها تستمر في محاولتها معتمدة على أمل مقبل أو تجربة سابقة.والجنود
يدخلون الحرب وهم لا يعرفون عاقبتها، ومع ذلك يضحون بحياتهم دفاعا عن أرض الوطن.أليست هذه
الأمور كلها دليلا واضحا على الإيمان بالغيب؟
فالإيمان بالغيب يعني الإيمان بالحقائق الروحية التي لا تدرك بالحس الظاهري، ولكنها تحتاج إلى وسائل
أخرى.فوجود الله تعالى لا يقع تحت إدراك الحواس، ولكنه محقق بالأدلة الأخرى..وهي
أدلة لا تقل
وثوقا عن الإدراك بالحس الخارجي، بل هي أوثق
الله
وأقوى..منها ما يتلقاه المؤمنون من كلام
ويسمعونه، ومنها الأنباء الغيبية التي يرونها تتحقق بكل وضوح، ومنها قواه سبحانه وتعالى الجبارة
العظيمة التي يجدونها في نفوسهم وفي سائر الكون.إن أدلة وجود الله تعالى أسمى من أدلة الحواس.والإيمان بالملائكة أيضًا من الإيمان بالغيب فهي لا تُرى بالبصر الظاهري، ولكن لها وجود متحقق
بشواهد قاطعة.والحياة الآخرة، وصدق الأنبياء والكتب..كل ذلك لم يتركه القرآن بلا دليل..بل يُثبته
بأدلة قوية سنعرضها في مواضعها من السياق القرآني بإذن الله تعالى.منه
ومن الإيمان بالغيب أيضًا أن المؤمنين لا يكتفون بالأعمال ذات النتائج العاجلة..شأن التاجر الذي لا
يتعامل إلا نقدا، ولكنهم يزاولون حياة أخلاقية الطابع.فهم يؤمنون بقوة الأخلاق وثمراتها الطيبة وإن
تأخر عائدها.إنهم لا يتصرفون بالعقلية التجارية الفورية، وإنما يقومون بتضحيات تعود على قومهم
وعلى سائر الكون بالخير العميم.ومن أمثلة هذا الإيمان ما يقوم به الجندي الذي يجاهد للمحافظة على
أمن وطنه..فهو يقتحم الأخطار لهدف نبيل، ولا يدري ما إذا كانت ستكتب له الحياة لينعم بالأمن أم
يموت في المعركة..ولكنه لإيمانه بالغيب يضع البذرة وهو واثق من أن الثمرة مباركة.فإما أن يعيش
كريما في وطن كريم، وإما أن يتشرف بأداء واجبه ويأمل في جزاء الآخرة.والواقع أن المنجزات العظمى والأعمال الرائعة لا تتأتى إلا بالإيمان بالغيب.فالجهود التعليمية،
وأعمال البر، ومساعدة الفقراء، والتضحيات لأجل بناء الوطن..كلها أنواع مختلفة من الإيمان بالغيب..ولو لم يؤمن الإنسان بالنتائج المقبلة لأعماله ما استطاع أن يُقدِم عليها ويتجشم عناءها.فوصف القرآن
Page 137
للمتقين بأنهم يؤمنون بالغيب يشير إلى أن المتقي مع إيمانه بالمهمات الدينية..فانه يتمتع بجرأة عظيمة
لتقديم التضحيات الأخلاقية، ويترفع عن العقلية التجارية، ولا يتشبث بالثمرات العاجلة..بل يُقدم على
العمل الشاق إذا عرف أنه يعود بالمصلحة العامة والخير الشامل، ولا يهتم بما إذا كان سيذوق الثمار
بنفسه، ولا يتردد إذا تطلب العمل جهدا كبيرا.ومن رزقه الله البعد عن التعصب، وأوتي التفكر في حقائق الإيمان القرآنية بعقل نزيه..لا يجد مندوحة
يرسي
عن الإقرار بعظمة هذا المضمون..والاعتراف بأن القرآن للتقدم والرقي العالمي أساسا يقوم على
التضحية..وهي العنصر الحيوي في بناء التقدم إن الإيمان بالغيب هو الذي جعل أصحاب رسول الله ﷺ
يقومون بالتضحيات الجسيمة التي غيرت وجه الجزيرة العربية، وحولت مجرى التاريخ العالمي.ولولا
الإيمان بالغيب ما قاموا بتلك الأعمال الخالدة.وإذا كانت المراتب العالية للإيمان بالغيب تقوم على الإدراك العقلي والخبرة الذاتية، فان الإيمان بالغيب
لا يشترط هذا المستوى السامي، وبوسع الإنسان العادي أن يؤمن بالغيب، مكتفيا بالأدلة العقلية التي
ترشده إلى الإيمان بالله وملائكته والبعث بعد الموت..أما التمتع بالشهود والعيان فهي مرتبة لاحقة.والمتقي الذي يتفكر في الأدلة والشواهد التي تدله على الإيمانيات..هو في نظر القرآن في طريق الهدى،
صحيح الإيمان ولا يكلف إلا بقدر طاقته.وهذه الدرجة من الإيمان بالغيب تكفي الإنسان للنجاة.فإذا
ما اجتهد وتقدم تيسرت له الدرجات العليا من الإيمان بالغيب..الذي يقوم على مشاهدة الأمور الغيبية
على حقيقتها، مصداقا لقول النبي.."الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
(مسلم، كتاب الإيمان).وهو حديث يتضمن درجتي الإيمان كلتيهما..وهكذا يقدم لنا القرآن الكريم
وحديث الرسول
ﷺ أروع التعليم وأكمله..شاملا جميع مراتب التقدم..لينال المؤمن حسب موهبته
وكفاءته ما يوفي حاجته، ويفوز بالفلاح حسب درجته من الإيمان..ولا أن مثل هذه التعاليم
جديرة بأن تكون من الله سبحانه وتعالى.ومن معاني الإيمان بالغيب أيضا أن سلوك المؤمن يتسم بالتقوى وهو غائب عن الناس.فالمتقي يراعي
تعاليم دينه و آداب عقيدته أمام الناس ويستمسك بها وهو بعيد عن عيونهم..فهو لا يتظاهر بالإيمان أمام
قومه، وينسى إيمانه في غيبته عنهم والقرآن يشيد بالمؤمن بالغيب فيقول: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بالغيب (الأنبياء: ٥٠).ويقول أيضًا: وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْب (الحديد: ٢٦).وكذلك
يقول بلسان يوسف: أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْب (يوسف:٥٣).فالمؤمن يراقب الله تعالى وهو في خلوته،
ويحافظ على إيمانه وهو في ستره.ريب
00
Page 138
وينبه
الله هنا أولئك الذين ينتابهم الحماس الإيماني في الاجتماعات العامة وعند سماع الخطب
والمحاضرات، بينما يهدأ حماسهم ويتطرق الضعف إلى إيمانهم بمجرد أن يعودوا إلى أنفسهم.والحق أن
مثل هذا الإيمان السطحي تقليد على غير هدى..إنهم يتحمسون مع المتحمسين..من غير أن يكون لهم
دافع شخصي وميل قلبي إلى التقدم هذا الإيمان ليس بشيء..فقد عرض به القرآن في قوله: وإذا لقوا
الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ (البقرة: ١٥).فعلى المؤمن الصادق في إيمانه أن يؤمن بالغيب.فإذا غادر بلده أو ابتعد عن قومه ووطنه الإسلامي
ليدرس أو يعمل في بلاد الغرب وغيرها لا ينسى نفسه، بل يتفقد إيمانه حتى لا يفتر أو يضعف أو
يضيع..بل يحفظ إيمانه في غيبته عن المجتمع الإسلامي، وإلا كان من ذوي الإيمان السطحي..المقلد لبيئته
من دون معرفة أو يقين.وإيمان كهذا لا ثمرة له في تقوى أو تقدم نحو الله تعالى.ومجمل القول أن الله عز وجل وعد بقوله يؤمنون بالغيب أن القرآن يسمو بالمتقين المتصفين
بالصفات التالية إلى الدرجات العلى من القرب:
أولا: الذين يؤمنون بالعقائد الدينية المتعلقة بالعالم الروحاني بعد انكشاف صدقها عن طريق الأدلة
والبراهين إيمانا كاملا..وإن لم يصلوا بعد إلى مقام تغنيهم فيه التجربة الشخصية عن مجرد الدليل العقلي
في توطيد إيمانهم.ثانيا: والذين يخلصون إيمانهم من النفاق، وتكون قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم في توافق تام.ثالثا: والذين يكون إيمانهم ذاتيا وليس مستمدا من المحيط..بأن يتظاهروا بين المؤمنين بالإيمان وبين
الكفار بالكفر، وإنما لا يضطرب إيمانهم ولا يفتر عملهم مهما كان موقف المجتمع أو القوم منهم.رابعا: والذين يمتازون بإيمانهم بالحقائق التي لا تدرك بالحس الظاهري، لكنها معلومة بأدلة أخرى،
ويبلغون به إلى الكمال بتجارب شخصية.خامسا: الذين يتسامون عن التعامل بعقلية تجارية، ويؤمنون بأهداف أخلاقية، ويتمسكون بغايات
دينية، ويطمئنون إلى نتائج التضحيات وإن بدت غير مقبولة ببادئ النظر، لكنها عنصر حيوي في كيان
التقدم القومي والديني، ولا يزالون يضحون بالمصالح الشخصية في سبيل المصلحة القومية.والمتقون الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من هذه الصفات هم الذين يستحقون ما وعد به القرآن
أتباعه من هدى ويُعطونه حسب استحقاقهم.قوله:
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.إقامة الصلاة تعني المثابرة عليها بلا انقطاع.فالقيام على الأمر هو المداومة عليه والتمسك به.فالذين عناهم القرآن بقوله يقيمون الصلاة
الذين يستمرون في الصلاة لا يتركونها ولا مرة واحدة والصلاة التي يتخللها انقطاع أو إهمال لا يعتبرها
هم
Page 139
الإسلام عبادة، لأن الصلاة ليست من الأعمال المؤقتة، بل هي لا تكتمل إلا إذا تواصلت..مبتدئة من
أول صلاة بعد البلوغ أو التوبة..إلى آخر صلاة قبل الموت بلا انقطاع والذين يدعون الصلاة تفلت
حينا بعد حين يضيعون صلاتهم، لأن الصلاة لقاء الله..ومن يتهرب من هذا اللقاء يكذب نفسه بنفسه
في ادعاء حب الله تعالى.وإقامة الصلاة تعني أيضا أداءها..فالمتقون يراعون جميع الشروط التي لا بد منها للمحافظة على
مظهرها، ويتقيدون بالمبادئ التي بينتها السنة النبوية كصحة الوضوء، والمواقيت، وتمام القيام والركوع
والسجود، والخشوع في التلاوة القرآنية والتسابيح والأدعية المسنونة حسب مواقعها.والشريعة وان أكدت على الالتزام بالشروط الظاهرية للصلاة، إلا أنها لا تبيح ترك الصلاة لنقص
شرط من شروطها مثل عدم تيسر اللباس الطاهر وما إلى ذلك..بل إن أداء الصلاة مقدم على كل
الشروط.وإذن فلا يجوز أن تترك بعض النساء الصلاة من أجل الاشتباه في الطهارة بسبب ملازمة
الأطفال، كما لا يجوز أن يعتذر بعض المسافرين عن الصلاة لعدم الاطمئنان إلى الطهارة الكاملة أثناء
السفر.فهذه كلها وساوس شيطانية، لأن الله تعالى يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا
(البقرة : ۲۸۷)
والشروط واجبة، وتركها معصية عند استطاعة تحقيقها، لكن ترك الصلاة لأجل تحقق الشروط
معصية بلا شك، ومن يلجأ إلى هذه الأعذار يُعدّ تاركا للصلاة.فعلى المؤمنين أن ينتبهوا إلى هذا المترلق.وإقامة الصلاة تعني جعلها قائمة ومحاولة أدائها بجميع شروطها.وفي هذا إشارة إلى المشاكل التي تحول
دون أداء الصلاة بصورة كاملة والتي يتعرض لها بعض المصلين وكثير من المبتدئين.وهذه المشاكل تنتج عن العوامل الظاهرية والباطنية التي تلهي الإنسان عن صلاته وتجعله نهبا
للوساوس.ومن عادة الإنسان أن ينتقل بتفكيره من أمر إلى أمر والفكر الإنساني دائم التردد هنا وهناك، وقد
يبتعد عما بدأ به، ويتيه في الفوضى المتواصلة من الوساوس، إلا إذا تعلق بحادث مهم أو حماس زائد أو
عاطفة حب أو مثل ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الاستقرار الفكري المؤقت.وإذا لم تكن للمرء سيطرة
على أفكاره شغلته الأصوات الخارجية والحركات الجهرية والخافتة، وخشونة مكان الصلاة ونعومته،
وطيب الرائحة وخبثها..وما إلى ذلك.فقوله يقيمون الصلاة تشير إلى هذه المشكلة، وتشجع
المؤمنين على مواصلة صلاتهم..فلا يتزعجوا من هذه المشاكل، لأن الله يفتح لكل إنسان طريق التقدم
حسب مستواه من الإيمان ويجب على من يتعرض لمثل هذه المشاكل أن لا ييأس ولا يظن أن صلاته
ضائعة..فالله تعالى يطالب عباده بالتضحية حسب مقدرتهم.والمصلون الذين تتشتت أفكارهم أثناء
Page 140
الصلاة..إذا استمروا وبذلوا جهدهم لأجل الاستغراق والاستقرار..فصلاتهم مقبولة عند الله ولن يضيع
أجرهم، لأنهم حاولوا وجاهدوا في إقامة الصلاة، وهم أيضًا من المتقين.كما أن عبارة يقيمون الصلاة تشير إلى المتقين الذين يحضون الناس على الصلاة، لأن الحض على
الصلاة وترغيب الناس فيها هو أيضًا من إقامة للصلاة.فالمتقون المتصفون بهذه الصفة لا يكتفون بإقامة
الصلاة بأنفسهم، بل يستمرون في حث الناس عليها..تنشيطا للكسالى وتذكيرا للساهين.والذين
يتطوعون لإيقاظ الناس لصلاة التهجد في شهر رمضان هم أيضًا من الذين يقيمون الصلاة.وإقامة الصلاة أيضًا هي الإقامة المعروفة التي يُعلن بها بدء الصلاة وهي إشارة إلى صلاة الجماعة.ولكن المسلمين عامة، وللأسف الشديد، قد أغفلوا ضرورة صلاة الجماعة.وهذا من أعظم ما دفعهم إلى
الانشقاق والتفرقة مع أن الله تعالى قد جعل لهذه العبادة منافع فردية وبركات اجتماعية.فقوله:
ويقيمون الصلاة يعني أن المتقين يحافظون على صلاة الجماعة، ويدعون الناس إليها.وليكن معلوما أنه
ورد في القرآن الأمر بالصلاة كان بصيغة أقيموا الصلاة ، و لم يكن بصيغة "صلوا"..وهذا دلالة
على أن الأصل في الصلاة أن تكون جماعة وأنها أهم أركان الإسلام فالذي لا يصلي مع الجماعة بدون
عذر من مرض أو بعد عن القرية أو سهو أو عدم وجود مصل آخر..فإنه وان أدى صلاته في بيته فلا
تعتبر صلاته صلاة، بل يعتبر تاركا لها.أما الصلاة الفردية فهي عند الاضطرار، كمثل الذي يصلي قاعدا
إذا لم يستطع القيام.ومن يمكنه أداء الصلاة في جماعة، ثم يتركها فذنبه مثل ذنب الذي يصلي قاعدا وهو
قادر على القيام.فالذين يتهاونون في صلاة الجماعة جدير بهم أن ينتبهوا لهذا، لان التهاون يحرمهم من
أينما
أجر عظيم.ومن معاني يقيمون الصلاة أيضًا أنهم يؤدونها بنشاط وانتباه لأن التكاسل والتغافل يؤديان إلى
تشتت الأفكار والحرمان من لُبِّ الصلاة ومن أجل ذلك أمر الرسول الله بالوضوء قبل الصلاة، ونهى عن
الاتكاء على شيء فيها.(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة).ونهى عن
وضع المرفق على الأرض عند السجود، وأمر بإقامة الصلب في الركوع، وأمر بإقامة الرجلين في القيام
والركوع، وأمر بالسجود المعتمد على سبعة أعضاء الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال
في السجود، وباب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه، وباب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء).وأمر
بأبعاد البطن والظهر عن الرجلين (النسائي، كتاب افتتاح الصلاة، باب صفة السجود والتجافي في
السجود والاعتدال في السجود).وأمر بنصب القدم اليمنى أثناء التشهد بحيث تكون أصابعها متجهة نحو
القبلة (الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد).٥٨
Page 141
هذه المعاني الستة التي ذكرناها لقوله يقيمون الصلاة استنادًا إلى اللغة يصدقها القرآن الكريم
وحديث الرسول ، وإليك بيانه:
١ - عن المداومة على الصلاة يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) (المعارج: ٢٤).- وعن مراعاة الشروط الظاهرية والمعنوية لها يقول تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
(المؤمنون:۳).٣- وعن المحافظة على أدائها بلا إهمال ولا نسيان يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ) (المؤمنون: ١٠).٤ - وعن الدعوة إلى الصلاة يقول تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طه:۱۳۳).-
ه - وعن صلاة الجماعة يقول تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (النساء: ١٠٣).٦- وعن النشاط والانتباه في الصلاة يقول تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ
يُرَاعُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * ﴾ (الماعون (٦ ، (٧)، ويقول: وَلا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى
(التوبة:٥٤)، ويقول: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف:٣٢).والزينة
تشمل ما يلزم الإنسان من وضوء وما إلى ذلك مما يجدد النشاط.ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (النساء : ٤٤)..فإذا كانت الأفكار مبلبلة
تُرجَأ الصلاة إلى أن يكون المصلي واعيًا لما يقول، لأنه في حالة الاضطراب لا يدرك حقيقة
كلمات الصلاة والصلاة في مثل هذه الظروف لا تحقق النفع المطلوب.ولكن لا يعني ذلك أن
يتخذ الإنسان من اضطرابه عذرا يبعده عن الصلاة وإنما المراد أن يحاول المرء جهده للابتعاد عن
ما يسبب له الاضطراب الفكري ويوطن نفسه على النشاط والاستعداد للصلاة.وتحقيقا لهذا
الهدف شرع الإسلام أن يؤذن للصلاة كي يتفرغ المسلمون من أعمالهم ويستعدوا للصلاة،
وشرع الوضوء تنشيطا للبدن واستحضارا للنية، وحث على صلاة النفل في البيت قبل الذهاب إلى
المسجد، تسكينا للاضطراب وتمهيدا للاجتماع مع المصلين بالمسجد، ووصى بذكر
يخرج الإمام للصلاة، وذلك لحصر الفكر في الصلاة ونبذ المشاغل الدنيوية، كل هذه الأمور
تساعد على نفض الكسل والاضطراب، وتشتت الفكر في عدة أمور لأن المسلم إذا سمع الآذان،
وانقطع عن جميع
أشغاله الدنيوية، واندفع فكره نحو العبادة، ثم ذهب إلى المسجد وصلاة الجماعة
والذكر..كان في ذلك استقرار لذهنه نحو الصلاة، وتوفرت له جميع الوسائل التي تساعده على
تركيز فكره.ومن أجل هذا الغرض العظيم أمر النبي الله الحاقن أن يقضي حاجته من بول أو غيره
الله
حتى
Page 142
قبل الصلاة.(أبو داود، كتاب الطهارة، باب أي يصلي الرجل وهو حاقن).وأمر بالأكل إذا
وضع أمام المصلي الجائع حتى لا يشغله أو يبلبل فكره، فقال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة
فا بدءوا بالعشاء.(البخاري، كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام أقيمت الصلاة).وقد خص
العشاء بالذكر لأنه يوافق وقت صلاة العشاء، فلا يؤخر الطعام بل يتناوله المصلي قبل موعد النوم
بوقت كاف..كي لا تختل معدته، ويضطرب نومه..كما يحدث عادة لمن يأكل قبل النوم
مباشرة.والنوم الهادئ للمؤمن أن
يتيح
يقوم لصلاة التهجد نشيطا ومخالفة هذا التوجيه المبارك
يحول بين المسلم وصلاة الليل فيضيع منه الخير الكثير.عرفنا لكلمة (الصلاة)) معاني عديدة في اللغة، وقد استخدم القرآن العديد من هذه المعاني، بالإضافة
إلى المعنى الاصطلاحي الدال على العبادة العامة المعروفة بصلاة المسلمين.يأمرنا القرآن بالصلاة على النبي
ومعناها طلب الرحمة والبركة والتعظيم..والمقصود بها أن يدعو المسلمون لأجل رفعة درجاته،
إظهارا لاحترامهم وتعظيمهم له..فيقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب: ٥٧).وصلاة الله تعالى على الرسول تعني حسن الثناء وصلاة الملائكة تعني الدعاء والاستغفار، وقد وردت
الصلاة بمعنى الاستغفار في قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنْ لَهُمْ (التوبة: ١٠٣).وبمعنى
الدعاء في قوله تعالى: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُول أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ)) (التوبة: ٩٩).والصلاة تلك العبادة الإسلامية المعروفة، تتضمن عدة أمور أخرى؛ منها أنها دعاء يتحقق به هدف
الدين، وأنها استغفار وطلب للرحمة والبركة.وقد كشف القرآن عن الغرض الرئيس من الصلاة في قوله
تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(العنكبوت : ٤٦).فقراءة القرآن وصلاة الجماعة تبعدان المرء عن المساوئ الذاتية، كما أنها تردعه عن
المساوئ الاجتماعية فالصلاة لم تُفرض لتكون طقوسا وتقاليد، ولكنها عبادة تتكون من العناصر التي
يترتب على أدائها الانتهاء عن المنكرات وتطهير الباطن.وأسلوب الآية يشير إلى طبيعة الصلاة من
تنهى المصلي عن المنكرات، فمن يداوم على الصلاة من دون أن يشعر بالنفور من السيئات، فلا شك في
أن صلاته ناقصة.أنها
كما أن وصف المتقين بأنهم يقيمون الصلاة يدل على أنهم لا يصلون صلاة شكلية أو لمجرد
التقليد، ولكنهم يحاولون جهدهم إقامتها بصورة صحيحة..لتكون دعامة ثابتة من دعائم البناء
الروحاني.وإذا كانت الدعائم لا تحمل البناء إلا ما دامت ثابتة..كذلك الصلاة لا تدعم الكيان الروحي
Page 143
للمؤمن إلا ما دامت كاملة قائمة على أساسها.فينبغي على المؤمن ألا يكتفي بمجرد أداء الصلاة، بل
عليه أن يجعلها قائمة كي تكون عمادا لتقواه.الصلاة الإسلامية
والصلاة الإسلامية تتميز بكيفية خاصة، فقد فرض على المسلم أن يتوضأ لها، أو يتمم عند الضرورة
مقاصد
فيقوم مقام الوضوء.(المائدة: ٦، والبخاري، كتاب الوضوء، والنسائي، كتاب الوضوء).ومن
الوضوء توجيه فكر المصلي نحو العبادة، وهو يفيد في النظافة الظاهرة، لأن الأعضاء التي تغسل هي التي
تتعرض عادة للغبار والأوساخ والوضوء، كما تشهد بذلك التجربة، يخفف عن الأعضاء التي تغسل ما
أصابها من إجهاد، ويزيل ما بها من توتر، ويعيد إليها نشاطها بعد خمول، ويخفف حرارتها، ويهدئ
اضطرابها.وكل ذلك تجديد للحيوية، وجمع لشتات الفكر، وتركيز للعقل حول الصلاة..فيتحقق بذلك
للمصلي الطمأنينة والانشراح.الحكمة في هيئات الصلاة:
وهيئة الصلاة وأوضاعها من ركوع وسجود ليست من قبيل الطقوس الغامضة التي وضعت كيفما
اتفق، بل الحق أنها أريدت لمغزى عميق وحكمة بالغة لا بد من توفرها لكمال الصلاة.إن التكوين
البشري يقتضي تفاعل الروح والجسد، فيتأثر كل منهما بالآخر ويؤثر فيه.فمن تباكى تدمع عيناه، ومن
يتضاحك تنفرج كآبته، والمحزون يظهر أثر حزنه على وجهه وعينه، والمرعوب ترتبك أمعاؤه ويسيل
عرقه.فمشاعر الإنسان تؤثر في بدنه، وحالات البدن تنعكس على المشاعر.وقد جرت الشعوب جميعها، المتمدن منها والبدائي، في القديم والحديث على التعبير الجسدي عن
مشاعرها من حب وكراهية واحترام وطاعة وما إلى ذلك.وقديما كان الفرس يقفون رابطين أيديهم على
صدورهم أمام ملوكهم الذين كانوا يعتقدون بمظاهر الألوهية في الأرض، وكانوا يكتفون أحيانا بمجرد
الوقوف.والأمم الغربية تعدّ القعود على الركبة منتهى الاحترام والتذلل والهنود يتخذون الركوع وسيلة
للتأدب والخضوع، كما أنهم يسجدون لعظمائهم وآلهتهم.و بما أنّ الإسلام للأمم كافة..فلذلك جمع في عبادته كلّ تلك الأوضاع المتفرقة، كي يجد فيها كلّ
قوم طريقه الخاص الذي يؤدي به إلى الخشية التي تلزم العبادة، لأنهم (أولا) سيتأثرون بهذه الهيئة الخاصة
بسبب عادتهم القومية، و(ثانيا) سيستفيدون بهذا الأوضاع المختلفة حسب حالتهم القلبية، لأنّ التغيير
الذي يحصل في قلب الإنسان قد يجعله يركع من شدة الحب، أو مبالغة في التأدب، وقد يقعد على ركبته
لنفس السبب، وقد يمثل مثولا، وقد يخر ساجدا.فمهما يحصل في قلبه من التغير الروحي يجد له الوضع
المناسب الذي يساعده على التحمس والاستفادة من العبادة حق الاستفادة وثالثا) يتأثر الإنسان بهذه
Page 144
الأوضاع حسب ظروفه الجسمانية من المرض وغيره.مثلا يعاني المزكوم أثناء السجود، ولكن القيام
والقعود يساعدانه على التحمس للدعاء، لأن هاتين الهيئتين تتفقان وحالة مرضه.والذي يشكو ضعفا في
رجله يطمئن في السجود ويستعيد حماسه.وجملة القول أن الإسلام جعل من العبادة عملا اجتماعيا، واضطلع بمسؤولية إصلاح الشعوب كلها،
ولذلك جمع في هذه العبادة كل الأوضاع التي مارستها الشعوب في إظهار عاطفة التأدب والحب التي
تنطوي عليها قلوبهم.وهكذا بلغت الصلاة من الشمول والكمال حدًّا لم تبلغه صلاة أي أمة أخرى.ونظراً لما لصلاة الفرد من مزية فريدة أمر الإسلام بأدائها في جماعة، لأنّ اجتماع الناس، على اختلاف
استعدادهم، يجعل قلوبهم تتفاعل مع بعضها، فيتأثر ضعيف الإيمان بقوي الإيمان ويستمد منه القوة.وبما
أنّ الإنسان قد يشعر بميل نحو العبادة منفردًا فلذلك أمر الله بالنوافل كصلاة التهجد، إلى جانب الفروض
أيضا، وبذلك أتاح له الفرصة لتحقيق هذه الرغبة الخاصة.فخلاصة القول أنّ الصلاة الإسلامية جامعة لجميع الطرق المعروفة لدى مختلف الأمم لإيجاد حالة
خاصة ضرورية للعبادة، وفيها قوة عظيمة لإصلاح الحالة القلبية لكل فرد وشعب، ولإيجاد حماس صادق
للعبادة فيهم والتزام مختلف الأوضاع في الصلاة لا يقلل من عظمتها، وإنما تكتمل بها، وتتفوق بها على
العبادات الأخرى.وعلاوة على ما تقدّم من أثر للمظاهر والأوضاع، فإنّ الصلاة تتضمّن التسبيح والتحميد والتعظيم،
وهي معان سامية تذيب قسوة القلوب وتضم أدعية تعلو بالتفكير الإنساني، وتزيد أهدافه سموا ورفعة،
وتثير عواطفه للتقوى والعمل الصالح، وتُلهب في قلبه جذوة الحب الإلهي.وهذه الأدعية هي العنصر
الروحاني للصلاة.والفرق بين الصلاة الإسلامية وبين عبادة أية أمة أخرى، عند المقارنة كالفرق بين الشمس وسراج
الزيت.ولقد عزل الإسلام صلاته عن جميع مظاهر اللهو..كالغناء والموسيقى والرقص..التي نراها في
العبادات الاجتماعية للأمم الأخرى، ولكنّه زيّنها بالبساطة والحب الذي يقدم به المؤمنون تحيات
إخلاصهم للحضرة الإلهية ويلتمسون حبّه عزّ وجلّ.وتؤدّى الصلاة الإسلامية خمس مرات في اليوم، نهاره وليله وليس مرة واحدة في الأسبوع..كما هو
الحال عند بعض الديانات.ومع أنّ هذا العصر تكتنفه الاتجاهات اللادينية، وتتمكن منه المادية الطاغية..فإن صلاة المسلمين في اليوم الواحد تزيد عن صلاة غيرهم في أسبوع وهذا خير شاهد على ما في
الصلاة من قوة روحانية جاذبة.
Page 145
ويعترض بعض الناس: ما هي مصلحة الله في أمره الناس بالعباد، وهل هو بحاجة إلى عبادتنا، في حين
أن التعظيم والتكريم لا يسر إلا الجاهل من الناس؟
والجواب على هذا الزعم أنّ العبادة لا تهدف إلى إعلاء شأن الله تعالى، بل هي ترمي إلى إيجاد الصلة
بين العبد وربه، حتى يتمكن من استمداد النور الإلهي.ومما لا يمكن إنكاره أن مجرد التفكير لا يُولّد في
الإنسان حماسا لمحو ذاته في ذات الله تعالى، بل يحصل هذا عن طريق حب كامل شديد مندفع.وهذا
الحب لا يحصل إلا بانكشاف تام لنعم المنعم الكامل.والصلاة تحقق هذا الغرض لأنها تقدّم الوسائل
الكاشفة لشأن الله الحقيقي عزّ وجلّ.وإن قيل: إن الإنسان إذا أراد الاتصال بالله لأمكنه ذلك في أي وقت شاء، فإذن لماذا حدّدت المواقيت
الخمسة للصلاة؟
هذا الاعتراض ناشئ عن قلة تدبّر، لأنّ الطبيعة الإنسانية إذا لم توجّه إلى أهدافها باستمرار أخلدت
إلى الكسل.فالله تعالى، نظرا إلى تفاوت المصلين في القوة الإيمانية، أمرهم بالصلاة الجماعية..كي يتمكن
مع الأقوياء من الفرص التي تجلو قلوبهم وتطهر نفوسهم..وهذا بتغلغل العوامل الخفية التي
الضعفاء
تتسرب إليهم من أقوياء الإيمان.ويعترض البعض قائلين: لماذا أمرنا بأداء الصلاة خمس مرات يوميا؟ فإنّ توفير هذا القدر من الوقت
صعب جدا بسبب كثرة الأشغال في هذه الأيام.والرد على هذا الزعم أنّ الصلاة إذا كان هدفها إتاحة الفرص لانعكاس الصفات الإلهية بإذكاء الحب
الإلهي..فمن البديهي أنّ الحاجة إلى الصلاة تشتد كلّما كثرت الشواغل عنها، لأنه من كثرة الملهيات
وجب التذكير.فهذا العصر الذي كثرت فيه الأعمال وتنوعت فيه هو أحوج ما يكون إلى الصلاة.ولو
كانت الصلاة مجرد مظهر للعقيدة لأقمنا لهذا الزعم ،وزنا، ولكنها ليست كذلك، بل إنها تهدف إلى أن
تستعد النفس الإنسانية استعدادا يُمكّن الإنسان من التحليق السريع عن العالم المادي إلى العالم الروحي،
وأن لا يتخبط تفكيره في العلائق المادية فقط، بل يقدم على تحصيل المثل العليا، كما يقول الله عزّ وجلّ:
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر (العنكبوت: ٤٦)..أي أنّ الصلاة ليست مجرد اعتراف
بالعبودية، بل هي صقل القلوب ووقايتها من السيئات والمنكرات ليصير صاحبها نافعا لبني الإنسان،
وعنصرًا صالحا في المجتمع.فالعمل الذي يتضمن هذه المزايا كلّها تقل أهميته في العصر المادي الصاخب
بل تتضاعف.
Page 146
والحق أن انتشار القلق والاضطراب واعتداء الأمم بعضها على بعض في العصر الحاضر..كل أولئك
ترجع إلى عامل هام خطير..وهو إهمال الناس العبادة الخالصة لله تعالى، ولو تمسكوا بها لأدى اتصالهم
بخالق هذا الكون وربهم الكريم إلى استبدال المحبة والإيثار والتضحية بالتباغض والتنافر.والصفة العملية الثانية للمتقين الذين يجدون الهدى في القرآن أنهم يكونون كما قالت عنهم الآية ومما
رزقناهم ينفقون.والرزق هو كل عطاء
من بصفة عامة وليس الطعام وحده كما يظن بعض
الناس والأصل في الرزق الإمداد بالوسائل حسب الضرورة والطعام واحد من الضرورات الحيوية
للإنسان، وليس هو الأصل في المعنى، ولذلك يخطئ من يفسر الرزق بالطعام وحده.الله
وصفة ومما رزقناهم ينفقون لم تحدد الإنفاق كما أو نوعًا أو مادة وليس لنا أن نحدد ما لم يحدده
الله فالمتقون يبذلون في سبيل الله نصيبا من كل ما أعطاهم الله..علما كان أو عقلا أو شرفا أو مالا.إن
كل ما يسد ضرورة فهو نعمة من الله تعالى، وقد أمر الله بإنفاق كل هذه الوسائل.إن من يساعد الناس
بالمال ويبخل عليهم بجاهه أو من يكسوهم ولكنه يحرمهم المأوى، أو من يخدمهم ولكن يضن عليهم
بعلمه..مثل هذا الإنسان لا يكون من العاملين بهذه الميزة التي تصف بها الآية المتقين المنتفعين بهدي
القرآن.الآية تدل على أن المساعدة بالمال وحده جانب من الإنفاق، وليست كل الإنفاق.فمن الإنفاق
في سبيل الله تعليم الناس وخدمة اليتامى والأرامل والمحتاجين والدفاع عن الوطن وبذل النفس في سبيله
وعلاج المرضى، وكشفُ المخترعات بالعمل ليلا ونهارا للصالح العامة..وكثير غيرها من نعم
الله التي لا
تعد ولا تحصى.والذين يتدبرون هذه الآية يسعون دائما أن تكون كل طاقة ونعمة لديهم في المنفعة العامة.ولقد أدرك
الفقهاء حقيقة الإسلام الكبرى إذ استثنوا من الزكاة ذلك الحلي الذي تستعمله صاحبته أو تعيره
للفقيرات من النساء أحيانا.وهذه حقيقة كبرى، لأن الزكاة فرضت لتزكية المال وطهارته.والمال
كالماء..إذا جرى لا يفسده شيء وإذا وقف أسِن المال الذي يُصرف وينتقل نفعه من يد إلى يد فهو
كماء مبارك يخرج من عين متدفقة فينتفع الجميع، ولذلك يشجّع الإسلام على التجارة والزراعة
والأعمال التي تعود بالفائدة على العاملين بها وعلى غيرهم، ولكنه يحرّم كتر المال وحجره عن التداول،
لأن هذا يحرم الناس من نفعها.وقد شدّد الإسلام في هذا الأمر فقال: وَالَّذِينَ يَكْترُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ (التوبة: ٣٤،٣٥)
منه
Page 147
كما أن الآية تدل على أن المنفق على الفقراء والمنفق على أولاده وزوجه والأم التي ترضع وليدها،
والابن الذي يعتني بخدمة والديه..كل هؤلاء وغيرهم منفقون في سبيل الله، بل المنفق على نفسه يعتبر
منهم.وكل من يبخل على نفسه ولا ينال من الطعام ما يضمن صحته فإنه يعصي هذا الأمر، لأن الآية لا
تقول "ينفقون على الفقراء" وإنما تركت الإنفاق بلا تعيين، وبذلك شملت إنفاق الإنسان على نفسه
وزوجه وأولاده وأصدقائه.وقد أوضح الرسول الله الله هذا المعنى حيث نصح رجلا كان يصوم النهار ويقوم
الليل، ولا يهتم بزوجته وأولاده، فقال له: "إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك
حقا، وان لأهلك عليك حقا.فأعط كل ذي حق حقه".(الترمذي، أبواب الزهد)
ولقد أبطلت هذه الآية جميع أنواع الرهبانية التي يرونها من الحسنات..مثل عدم الاهتمام بالنظافة
والطعام وإهمال حقوق ذوي القربى.فالمتقي عند الإسلام هو الذي ينفق من كل ما أعطاه الله على
نفسه وذويه وجيرانه وأصدقائه وعلى الفقراء والأغنياء والمعارف ،والأجانب على المواطنين والمسافرين
والغرباء، على بني الإنسان بل الحيوانات أيضًا..لأن الإسلام يأمر بالإنفاق من كل نعمة، ولكل مصلحة
ضرورية..فمن ترهب وقعد عن السعي فقد أعجز نفسه عن الإنفاق وخالف الآية.وتدل هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون على أن الإنفاق محدود بجزء من الرزق وليس كله.وتقرر
آيات أخرى من القرآن أن الإنفاق المفرط الذي يؤدي إلى الفقر محرم كذلك.يقول تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (الإسراء:٣٠).والمحسور هو من
ضاعت قوته وبدا عجزه..فحُرم من التقدم.وإذا كان الإفراط في إنفاق المال مكروها حتى لا يورث
الحسرة فإن الأمر لا يسري على الإنفاق العلمي والفكري.فالمال معرض للنفاد..أما العلم والفكر فلا
ينفدان بالأنفاق.ولكن الاعتدال يكون مطلوبا أيضًا في هذه الحالة، بمعنى تجنب إرهاق النفس إرهاقا
يعطل قوى الإنسان ويحول بينه وبين المداومة على التقدم إن من يجهد نفسه فيمرض ويتوقف عن
يعد مخالفا لهذه الآية.ويدل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون على أن المتقي ينفق في سبيل من الحلال، فليس من
البر إنفاق مال جاء من حرام ومن ينفق مالا جمعه من رشوة أو سرقة لا يفعل خيرا، لأنه ينفق من
حقوق غيره وليس من رزق الله له..والشر لا يلد إلا شرا.ولما كان معنى الرزق هو العطاء المتواصل حسب الحاجة..فإن الآية تعني أن الخوف من الإنفاق
مخالف للعقل السليم.فكلمة رزقناهم تدل على أن الله تعالى لن ينقطع عن العطاء، فلا داعي
للخوف.إن الذي ينفق حسب أمر الله تعالى لا يخسر أبدا.بل يربو ماله وتزدهر ثروته، لأن الله لن يقطع
الله
العطاء
70
Page 148
عنه رزقه.أما ازدهار العلم والعقل والجاه ،بالإنفاق ونمو القوى باستعمالها فظاهر معروف..لأن من
يفيد الناس بعلمه يزداد علما ومعرفة.وبالمثل فإن المنفق من جاهه يزداد جاهه بين الناس.وكذلك المنفق
من ماله تتضاعف ثروته..لأن نفقته على نفسه تزيده قوة ونشاطا لكسب المال، ونفقته على زوجته
وأولاده تزيد عدد الأيدي العاملة له، ونفقته على جيرانه وأصدقائه تزيد عدد مساعديه، ونفقته على
الفقراء ترفع مستوى معيشة قومه..وبكل ذلك تزدهر ثروته بلا شك.:
وعلى العموم فإن الإنفاق الصحيح للمال يمنعه من الضياع، بل يضاعفه إضعافا كثيرة، وعلاوة على
أن فضل الله ينزل على المنفق نزولا ،روحانيا، فإن السنن الإلهية الكونية تساعد على زيادة المال وبسطه،
ولا يتسبب عن الإنفاق نقص أو انقباض، ولا يخالف الإنفاق إلا الجهلاء الذين لا يدرون أنهم بإمساكهم
عنه يدفعون بأموالهم نحو الخسارة لا الربح.وقد تساءل بعضهم : لماذا يجعل الله الناس وسيلة للإنفاق على سائر خلقه، ولا يعطي كل واحد نصيبه
مباشرة؟ هذا التساؤل ناشئ عن قلة التدبر، فالواقع أن الناس جميعا ينفقون بعضهم على بعض، وليس
الإنفاق وقفًا على الأغنياء وحدهم، كما قد يبدو في الظاهر.إن الغني يثري من التجارة أو الزراعة أو
الصناعة بتعاون الأيدي العاملة والمتعاملين معه من الفقراء.كما أنهم يحافظون على ماله ويكفلون له
الأمن والاستقرار، ولولا أنهم معه وحوله ما أمكن له أن يجمع مالا، أو يحميه وحده من الضياع والهلاك
بأيدي السارقين وقطاع الطرق.فالفقير يعين الغني قبل أن يعين الغني الفقير.من هذا يتبين كيف أن الله
عز وجل قدر نظاما ماليا رائعا، وجعل لكل إنسان سهما في مال غيره كي تعم المواساة وتتقوى وشائج
المحبة والتعارف ويزدهر العلم والتمدن والتكافل الاجتماعي بين بني البشر، وقد فصل القرآن هذا النظام
المالي كما يلي:
١ - الزكاة: وهي فريضة من فرائض الإسلام بما شرع الله تعالى للمجتمع البشري كله حقا مفروضا
في المال، لأن المال مكتسب بجهود تعاونية من قبل سائر البشر.وهذا الحق لا يسقط بأداء الحقوق
الفردية..فمثلا إذا كان لرجل منجم يستخرج منه معدنا، فإنه يدفع أجور العمال نظير عملهم، ولكن
القرآن يشرع بأن لهؤلاء العمال نصيبا في ملكية ذلك المعدن..لأن خزائن الأرض كلها مخلوقة لأجل
جميع نوع الإنسان، ولا تختص بشخص دون آخر، وكذلك لسائر الناس نصيب في هذا المعدن، ولذلك
فرض الإسلام على مالك هذا المنجم أن يدفع للحكومة قسما من ماله كي تنفق منه على كل رعاياها بما
فيهم عمال منجمه.
Page 149
والفلاح الذي يرتزق من أرض يزرعها..ليس المالك الوحيد لهذه الأرض وما يؤثر فيها من شمس
وهواء وماء لإنتاج ثمرات الأرض..ولكنها شرك بينه وبين سائر البشر، ولذلك عليه أن يؤدي نصيبا من
محصول الأرض لصالح الرعية كلها.والتاجر لا يمكن له أن يجمع ماله ويربح إلا في بيئة آمنة.وبين قوم يتعاونون معه، ولذلك فرض
الإسلام على هؤلاء التجار أن يؤدوا الزكاة.ومن فاض معه مال وادخره، فلا يجوز له أن يحرم الناس من
منافعه، ولذلك عليه أن يدفع زكاة ماله كل عام، لأن الادخار المستمر يحرم غيره من حقه في المال وقد
أمر الله تعالى بالزكاة في قوله
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة: ۱۰۳).والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة
تأخذها وتنفقها الحكومة، أو إذا لم تكن الحكومة فالنظام الإسلامي يقوم بجمعها وإنفاقها، كما يظهر
من قوله تعالى: خُذ.٢ - الصدقة: وهي تطوع، خاضعة لمقتضى التقوى القلبية..تُعطى لمن يسألها لسد حاجته، ولمن لا
يسألها حياء أو عجزا، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون)) (البقرة : ٢٧٥).وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ٢٠).لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (البقرة:٢٧٤).يُوفُونَ بِالنَّذْرِ...(الدهر : ٨).والنذر هو الصدقة التي يعد بها الإنسان قائلا: إذا وفقني الله في عمل كذا، أو أزال عني مصيبة كذا..فسوف أنفق من المال كذا، أو أؤدي عبادة كذا والفرق بين الصدقة العامة والنذر..أن الصدقة تنفق
قبل زوال المشكلة، أما النذر فيؤدى بعد زوالها.الله
ومن
بعض صلحاء الأمة لم يحبذوا النذر ، بل حبذوا الصدقة، لأن النذر نوع من الاشتراط والمساومة مع
تعالى.فالأفضل أن يتصدق الإنسان أولا، ثم يتوكل على الله وأنا أيضًا أوافقهم في هذا الرأي، لأن
الإمام البخاري روى عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ : "من نذر أن يطيع الله فليطعه،
نذر أن يعصيه فلا يعصه البخاري، كتاب النذور، باب النذر في الطاعة)
-النفقات التي يضطلع بها الإنسان لأجل الأهداف القومية أو الشعبية والتي حثّ عليها القرآن في
قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ (التوبة: ٤١).2801
Page 150
هذا النوع من النفقات ليس بزكاة ولا صدقة.وهو هام جدًّا، بحيث استحق فاعله أجرا عظيما.وأيامنا هذه ليست أيام الجهاد بالسيف، وإنما ينبغي بذل الأموال لنشر الإسلام، أو تزويد المسلمين بتعاليم
الإسلام، أو لتوحيد شمل جماعتهم، وما إلى ذلك من أمور لرفع شأن الإسلام في العالم.بهذا يتحقق
القسم الأول "وهو الجهاد بالمال" من قوله تعالى : جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ويتحقق القسم الثاني
بالجهاد بالنفس بأن يقف الإنسان بعض وقته لأجل الدعوة إلى الإسلام مضحيا بمصالحه الشخصية،
ويسهم في أعمال التربية والتعليم بما فيه المصلحة العامة للمجتمع.٤ - الأموال التي تنفق تعبيرا عن الشكر الله تعالى على نعمه..كما قال عز وجل: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)) (الأنعام: ١٤٢).ه - الفدية: ويتضح الغرض منها في قوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (البقرة: ١٩٧).فهي إنفاق
ليجبر نقصا في العبادة لا حيلة للمرء فيه.٦ - الكفارة: ويراد بها جبر نقص ناتج عن تقصير بشري، كما في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
باللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (المائدة: ٩٠).والفرق بين الكفارة والفدية هو أن الفدية يؤديها الإنسان حينما يقوم بعمل بإذن الله تاركا عملا آخر
أهم من
منه، أو حينما يرى أنه قصر بعض الشيء في أداء واجب عليه فيزيل هذا القصور بأداء الصدقة.أما
الكفارة فيؤديها الإنسان لارتكاب معصية، أو عند اقترابه منها ليزيل عنه وبال هذه المعصية، ويعبر عن
توبته بالعمل.جدير بالانتباه أن مفهوم الكفارة في القرآن الكريم هو أن يعبر التائب عن توبته بالعمل، وذلك بإنفاق
شيء من المال أو تضحية جسمانية، علاوة على ندامته بالقلب واللسان.ولكن الكفارة المسيحية تعنى أن
كائنا عظيما ضحى بحياته لأجل الآثمين الذين لم يولدوا بعد والواضح أنه لا علاقة لهذه الكفارة بالتوبة
على الإطلاق، لأن الكفارة المسيحية تضحية مزعومة تمت قبل وجود الإثم والآثمين.٧- الإنفاق للتعاون في سبيل النهوض بالمستوى الاجتماعي والحضاري..مثل إنفاق المرء على
أهله،
وإنفاق الوالد على أولاده فهذه النفقات أيضًا فرضها القرآن واعتبرها ضرورية ومن يرفض أداءها كان
آئما عند الله، وعلى الحكومة الإسلامية أو النظام الإسلامي إكراهه على أدائها لهم.- حق الخدمة أو الأجر، وهو المكافأة نظير منفعة كما في قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ
فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوف..(البقرة: ٢٣٤).فالشريعة تحث الوالد على أن يؤدي
أجر الرضاعة لمن تُرضع ولده وأن ينفق على هذه الخدمة بما يحقق العدل والكفاية.٦٨
Page 151
- الإحسان وهو الإنفاق على من لهم حق الشكر لما أسدوا من جميل سابق من الوالدين والأهل
وذوي القربى..إنفاقا يتسم بالحسن والوفاء ورد الجميل واسترضاء القلوب، كما قال تعالى: ﴿وَوَ
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
(لقمان: ١٥) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (البقرة : ٨٤).ولا ينبغي أن أحد فهم كلمة الإحسان هنا، فيظن أن البر بالوالدين إحسان إليهما، لأن
يسيء
الإحسان هنا لم يرد بمعناه المعروف، وإنما يعني المجازاة على فعل بمثله كما قال القرآن: فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥).١٠ - الهدايا وهو الإنفاق على ما يُهدى للأصدقاء في مختلف المناسبات لنشر المحبة والمودة بين الناس..وفي الحديث النبوي: تهادوا تحابوا"..وقال: مازال" جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"
(الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار).وأفضل طريق لإهداء الهدية هو الضيافة،
كما ذكره القرآن عند الحديث عن ضيوف إبراهيم ولوط عليهما السلام فالأسف أن المسلمين قد
تغافلوا عن هذا الأمر الرباني أيضًا، وخاصة في المدن، مع أن الرسول ﷺ قد حث على ذلك لدرجة أن
اعتبر إكرام الضيف حقا له، وقال إنه إذا قصر أهل قرية في أداء هذا الحق فيمكن إجبارهم على
بأن الهدية ليست من أنواع الصدقة، وإنما هي رمز للإخوة الإسلامية، وأساس هام لرقي الحضارة
العلم
والمدنية.أدائه.مع
والخلاصة أن قوله تعالى : مما رزقناهم ينفقون لا يشمل الأمر بالتصدق فحسب، وإنما يدخل فيه
كل النفقات المذكورة فيما سبق.وهذا أمر أساسي حيوي لخلق التقوى في أفراد المجتمع.نظرة شاملة على مواضيع الآية
وتدل النظرة الشاملة على هذه الآية الكريمة أنها تتضمن ثلاثة أحكام:
۱ - الإيمان بالحقائق الخفية عن أنظار الإنسان ونستدل بذلك على أن الإيمان بالمحسوسات وحدها
ليس من الفضيلة في شيء، فالمحسوس يسلم به الناس ولا ينكره إلا أحمق أو معاند، ولكن المتقي أسمى من
ذلك وأجل، فهو لا يدخر وسعا بالإيمان بالحقائق المكنونة، وتلك هي ميزة الكمال في الروحانية.إن
الاعتراف بوجود النهر مثلا لا يمت إلى كمال العلم بصلة، لكن العالم الجدير بوصف عالم هو من يمعن
النظر فيما وراء النهر من حيث منافعه المحتملة والممكنة وتتبع منابعه ومصابه والتطورات التي تؤثر فيه،
وأثره
ه في البيئة التي يمر فيها، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الآثار.فالشخص الجاهل لا يعلم عن النهر
إلا ما يراه بعينه من وجود ظاهري حاضر فقط، أما العالم فإنه يدرك ما يغيب عن نظر الجاهل، ويستطيع
Page 152
أن يستفيد ويفيد علمًا وعملاً بما يعرفه.وهكذا الحال في المجال الروحاني.فالعالم العامل أي المتقي لا
يقتنع في الدنيا بما يشهده بعينيه فحسب وإنما يعكف على التحقيق في بدايتها ونهايتها والبحث عن
كنوزها ودفائنها الكامنة.وهذا هو الإيمان بالغيب.ومن البيّن أن العلم والعمل لا يكتملان من دون هذا
البحث العميق، فالإيمان بالغيب عنصر أساس هام لاكتمال الإنسانية، ولا يجرؤ على صرف النظر عنه إلا
الجاهل الغافل.٢ - وبعد أن أكدت الآية أهمية الإيمان بالغيب لفتت أنظارنا إلى ما يترتب عليه من نتائج لازمة..وهي إذا أمعن الإنسان النظر في مبدأ هذا العالم واستبان له بالأدلة البينة وجود الخالق جل وعلا..عندئذ يندفع نحو توطيد علاقته بخالقه وربه سبحانه.وهذا هو ما يسمى بالعبادة وإقامة الصلاة.٣- وإذا تقوت صلته بالله خالق كل شيء فإنه بعد ذلك يهتم بالمخلوقات التي أوجدها هذا الخالق
العظيم، فيبذل جهوده من أجل كل ما له صلة ،بربه لأن حب الخلق يسري إلى قلبه من حبه
للخالق، كما نرى أن حب الإنسان لوالديه لا يلبث أن يقوده إلى حب أشقائه.ولذلك بعد الإيمان
بالغيب تأتي إقامة الصلاة، ثم الواجب الثاني وهو مما رزقناهم ينفقون).ويتبين مما أن
سبق
مع
الله
ورود إقامة الصلاة والإنفاق بعد الإيمان بالغيب ليس مصادفة، وإنما هو ترتيب
محكم.وتقديم إقامة الصلاة في الآية على الإنفاق هو الترتيب الصحيح المنطقي، فإقامة العلاقة
تعالى أولى بالتقديم، لأن حب المخلوق يأتي من حب الخالق جل وعلا.ويختلف الإسلام في ذلك عن نظرية الفلاسفة ومن على شاكلتهم ممن ينقصهم التعلق بالله تعالى، إذ
يزعمون أن تقوية الصلة بالمخلوق تؤدي تلقائيا إلى التعلق بالخالق، وإذن فالأمر الأجدر بالاهتمام عندهم
هو التعلق بالمخلوق.ولكن إذا تأملنا في هذه النظرية تبين لنا بطلانها.إن الإحسان إلى المخلوق، ولا
شك، قسم من عبادة الله تعالى، ولكنه لا يوجب التقرب إلى الله، والعكس صحيح..فإن التقرب إلى الله
الإحسان إلى المخلوق، ومن أحب الله أحب خلقه..والتاريخ يحكي لنا عن مئات بل آلاف
الناس الذين خدموا البشرية أجل الخدمات، وتحملوا من أجل ذلك كل المشقات، وما فعلوا ذلك إلا حبا
لله تعالى.إن إبراهيم وموسى وعيسى وكرشنا ورام شندر وزرداشت و بودا وكنفوشيوس، وسيد الجميع
وسيدنا محمد المصطفى..كل هؤلاء أمثلة رائعة لمن أحبوا الله وتعلقوا به، وخدموا بني الإنسان نتيجة
هذا الحب.ولا يقدم لنا التاريخ مثالا واحدا لإنسان أحب البشر ومن ثم أحب الله.يو.هذا
من الواقع العملي.أما الدليل فإنه أيضًا يرفض زعم الفلاسفة إن حب المخلوق إما أن يكون ثمرة
حب الوطن أو بسبب عاطفة طبيعية.ومَن أحب بني وطنه فيمكن أن يعادي غير مواطنيه حسب
مقتضى الوطنية، وبدلا من أن يتوجه إلى الله تعالى يبقى مقيدا بأحابيل السياسة، وينساق وراء أهدافها.
Page 153
وصاحب العاطفة الودودة لن يندفع إلى حب الناس بدافع عقلي، وإنما يكون مسوقا بعاطفة.ومن قادته
من
عاطفته لا يدرك الخالق تمام الإدراك.أما من استعمل قواه الفطرية في محلها، فإنه يتفكر فيما بدا أمامه
خلق الله
وبالتالي يمكن له أن يهتدي إلى الصانع جل وعلا وإن اختفى عن نظره، فهذه الصلة بالخلق
ليست إلا وسيلة للتعرف على الخالق والتعلق به، ثم يترتب على هذا التعلق الرجوع على الخلق بالمحبة.مثل هذا الإنسان الذي يُعمل عقله فيما أدرك، ويصل بهذا إلى معرفة الخالق ومحبته، ثم يحب غيره بسبب
محبته الله، فإنه يكون قد سلك الطريق السليم.وقد أشار الرسول الله إلى هذا المعنى عندما سئل عن
الأعمال الحسنة التي يعملها المرء قبل إسلامه فقال : "أسلمت على ما أسلفت" (مسلم، باب بيان حكم
عمل الكافر إذا أسلم بعده كتاب الإيمان فعمله الصالح مقبول محفوظ له ما دام قد عرف الله وأسلم
له..إن حب المخلوق بسبب حب الله هو الطريق الطبيعي، وغيره استثناء لا يصلح إلا إذا كان الإنسان
عليم العلم بذات الله عز وجل.والذي يحظى بمعرفة الله لا يلبث أن يندفع إلى عبادته، ومن ثم يشغف
بحب مخلوقاته، لأن لقاء الله تعالى يعني العلم الكامل بصفاته عز وجل.ومن كان على بينة من أن الله
تعالى رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فمن الطبيعي أن يصطبغ بهذه الصفات، ويحسن
إلى عباده حسب مقتضاها وإن لم يفعل كان قلبه خلوا من آثار تلك الصفات وإلى هذه الحقيقة أشار
القرآن الحكيم بتقديم إقامة الصلاة على الإنفاق من الرزق.وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
شرح
الكلمات
أنزل أنزل الله الكلام: إذا أوحى به.الآخرة: مذكرها آخر، وضدُّها الأولى (الأقرب).وقد وردت هنا صفة لموصوف محذوف ويكون
معناها: القادمة أو الواقعة فيما بعد.يوقنون: أيقن الأمر وأيقن به علمه وتَحقَّقه.واليقين إزاحة الشك وتحقيق الأمر (الأقرب).التفسير : تذكر هذه الآية ثلاث صفات أخرى للمتقين.فهم يؤمنون بالكلام الإلهي المنزل على محمد.وقد ذكرت هذه الصفة لحكمة هامة وهي أن العمل المقبول لا بد له من حسن النية والاتجاه
الصحيح نحو العمل.وحسن النية وحده غير كاف إلا كان أسلوب العمل الصحيح مجهولا تماما.ولكن
Page 154
إذا عرف أسلوب العمل الصحيح أو كان من الممكن معرفته ثم يصرف المرء نظره عن الاتجاه العملي
الصحيح أو يتغاضى عنه مدعيا حُسن النية..فلن يكون ذلك مقبولا أو معقولا..فمن أهمل الصحيح
متعمدا فقد شهد على نفسه بفساد النية بالدليل العقلي.ثم إن الاتجاه العملي الصحيح في الأمور الروحانية هو ما يأتي من عند الله، ولذلك فحسن النية هو لمن
لا يدخر وسعا في معرفة ذلك الطريق والتمسك به عمليا.وبما أن القرآن الحكيم يعلن بأن الطريق
الصحيح بعد البعثة المحمدية هو ما تجلى به الله على النبي الله ، لذلك لا يبلغ الغايات الروحانية العليا إلا
من آمن بالكلام المنزل عليه.فبعد أن يؤمن المتقي إيمانا إجماليا، عليه أن يبذل جهده لتدعيم إيمانه
بالعمل..والعمل الصحيح المدعم للإيمان والتقوى هو ما أوحى به الله إلى سيدنا ومولانا.وإذن فلا
بد من الإيمان بالوحي المنزل عليه لاستيعاب عناصر التقوى.6
ويزعم البعض أن الله يأمر بالإيمان بالقرآن وحده، ولم يأمر بالإيمان بالرسول ، فالطاعة إذن لأوامر
القرآن، وليس للرسول طاعة عليهم، وإلا كان ذلك شركا.وقد ظهر أصحاب هذا القول في الهند منذ
فترة، وأصلهم من الخوارج القائلين بأن الحكم لله وحده والأمر شورى بينهم".لقد انخدع هؤلاء بسبب عدم تدبرهم في معاني القرآن الحكيم.وقد بنوا وهمهم هذا على الآيات التي
يعلن فيها القرآن أنه كتاب كامل لا ينقصه شيء، وقالوا بأنه لا داعي لهداية هاد أو تفسير مفسر.وتغالوا في ذلك حتى أوّلوا الآيات التي تأمر بطاعة الرسول، بقولهم أن المراد بالرسول هو القرآن نفسه.ولكنهم لا ينتبهون إلى أن القرآن الكريم نَسَب نزول الكتاب إلى الرسول وإلى الأمة حيث يقول:
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ (البقرة : ٥).ويقول أيضًا: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا
(الأنعام: ١١٥).وهذا الأسلوب لا يختص بالنبي ﷺ فحسب، بل يعم سائر الأنبياء.قال الله تعالى عن
موسى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب) (البقرة: (۸۸).وقال أيضًا: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ)) (آل عمران: ٢٠٠).وهنا تساؤل: لماذا نسب الله نزول الكتاب إلى الرسول مرة وإلى الناس مرة أخرى، ولم يكتف
بذكر إنزاله إلى القوم فقط؟ السر في ذلك أن نسبة الكتاب إلى القوم يعني أن الكتاب أنزل للناس،
وهذا تنبيه لهم بأن تعاليمه مناسبة لهم وتصلح لأحوالهم، وترمي إلى ما يعود بالخير عليهم.أما نسبة نزول
الكتاب إلى الرسول فتشير إلى وجود موافقة تامة بين فطرة الرسول وبين ما يشتمل عليه الكتاب من
تعاليم، وأنه تفسير عملي حي للكتاب.ولولا ذلك لما قيل أنزل إليك مرة، وأنزل إليكم
مرة أخرى، أو آتينا موسى الكتاب مرة ثالثة، ولاكتفى بقول : آمنوا بالقرآن، أو آمنوا بالتوراة.فما
دام القرآن الحكيم لم يستخدم هذا الأسلوب فلا بد من الاعتراف بأن هذا الأسلوب البياني فيه حكمة
Page 155
هامة، وهذه الحكمة
أيضًا.هي
الإشارة إلى أن الكتاب ليس هاديا وحده وإنما الرسول الذي أنزله الله إليه هادٍ
وقد جاءت هذه الإشارة أكثر وضوحًا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى
مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الإنعام (۱۲۵).فهذه الآية توضح بكل جلاء أن
حامل الكلام الإلهي ليس ساعي بريد، بل يتزل الله كلامه على رجل يستطيع فهم الرسالة جيدا،
وتفهيمها للناس تماما، وأنه أولى بالاطلاع على دقائق كلام الله من الآخرين، وأنه لا يعطى كلمات
الكتاب فحسب، بل يوهب أيضًا فهما كاملا لها، لأن فطرته توافق الكلام الإلهي موافقة تامة.وما دام الأمر كذلك فمن السخافة القول: "إن الكلام موجود، فما الفرق بيننا وبين من جاء به؟ نحن
نكتفي بالإيمان بهذا الكلام ونفهمه بأنفسنا!" هذا القول السخيف يشابه قول الكفار الذين قالوا:
وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)) (الزخرف:٣٢).فلا الكفار كانوا محقين
في قولهم هذا، ولا هؤلاء المتظاهرون بالإيمان مصيبون في اعتراضهم هذا، وإنما الحق أن كلام
الله يشمل
الإيمان بالذي أنزل إليه، وبكلماته التي يفسره بها، لأن الكلام الإلهي ألفاظ والرسول صورة تطبيقية
لها، وقد وقع الاختيار عليه لتبيين ما نزل إليهم بعمله وأسوته ويفسره بكلماته.بهذه المناسبة يجدر بنا إلقاء مزيد من الضوء على معنى (الترول) عندما ينسب إلى القرآن والوحي
الإلهي وغيره من الأمور يظن بعض المسلمين ،وغيرهم ممن يجهلون حقيقة التعاليم الإسلامية، عند قراءة
مثل هذه الآيات أن الكتاب شيء مادي يكتبه الله جل وعلا ،بيده ويناوله لملك الوحي، ليترل من
السماء إلى الأرض، فيسلمه إلى الرسول.الواقع أن هذا التصور المادي لما يتزل من السماء إلى الأرض
ناشئ عن فهم خاطئ لعدة أسباب هي:
١.تعريف حقيقة السماء
٢.ماهية الملائكة وكيفية صدور أعمالهم.وسائل توصيل أحكام الله إلى الناس
٤.معنى النزول
وقد سعى بعض المستشرقين مستندين إلى بعض الروايات المتداولة بين المسلمين، إلى تفسير آيات
النزول تفسيرا ماديا ومنهم سيل (sale) في مقدمة ترجمته للقرآن وكان من الممكن لهذا المستشرق
أن يؤول الآيات القرآنية كما أول روايات التوراة التي تذكر نزول الله إلى الأرض لتعذيب أهل سدوم
وعمورة (تكوين:١٨).ونزول روح الله على داود (صمويل:١٦)، ونزول روح القدس على المسيح
Page 156
بصورة حمامة (يوحنا: ٣٢).والذي صدقه المسيح عيسى نفسه (متى).ولكن المستشرق أخذ بالمعنى
الحرفي الظاهري.الشأن
والحق أن القرآن الكريم استعمل كلمة السماء في معان مختلفة.فهي حينا تأتى بمعنى السحاب،
وحينا بمعنى العلو، وحينا آخر بمعنى علو المقام والمنزلة.وهي إذا استعملت الله عز وجل فهي تعبير عن
المرتبة فحسب، ولا تعني العلو الظاهري المكاني الذي قد يتصوره البعض.وكيف يكون
ذلك والله تعالى يقول: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ (ق: (۷۱).وعدم مراعاة هذا الفرق أوقع
في فهم معاني السماء.علو
المسلمين في
وسمو
الخطأ
ثم أوضح القرآن أن الملائكة ليسوا كائنات مادية، وإنما هم العلة الثانية في هذا الكون بعد الله تعالى.الله
وهم الواسطة الأولى لتنفيذ أحكام الله تعالى في هذا النظام الكوني.فمنهم من هو مأمور بتبليغ كلام
إلى عباده ومنهم من هو مسئول عن نظام المواليد ومنهم من هو مسخر لتنفيذ أحكام الموت وهلم
جرا.فكأنهم الأسلاك الحساسة التي يحرك بها الله تعالى هذا النظام العالمي، كما وصفهم القرآن: ﴿وَمَا مِنَّا
لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم (الصافات: ١٦٥).أي أن كلا منهم يقوم بما هو مكلف به وهو مقيم لا يفارق
مقامه، وهو في ذلك كالشمس تضيء ما حولها من الكواكب وهي تلازم مقامها.فترول الملائكة مجرد
استعارة، ونزول الكلام بهم استعارة أيضًا.إلا
والخطأ الثالث في فهم معنى النزول ناشئ عن تصور بعض الناس أن الله تعالى يحتاج في أعماله إلى
وسائل مادية مثل الإنسان، فينزل كلامه مكتوبا ويرسل به رسولا إلى عبد اختاره من عباده.مع أن
القرآن يوضح هذا الأمر في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (البقرة: ١١٨).أما
*
عن كلمة الترول فقد قال الله تعالى عن رسوله : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولاً يَتْلُو
عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله (الطلاق: ۱۱ و ۱۲).والرسول الله لم ينزل السماء، فمعنى الترول هنا مجازي، وأن
الكلمة تستعمل الخلق، وإيجاد شيء عظيم يُعَدّ من المنن الكبرى كقوله:
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نُعاساً)) (آل عمران: ١٥٥).وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ (الزمر: ٧).وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى)) (البقرة: ٨٥)
أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً (الأعراف: ۲۷).وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الحديد: ٢٦).فمعنى نزول كلام
الله
هو التعبير عن كون هذا الكلام نعمة عظمى يؤدي جحودها بالإنسان إلى
الدرك الأسفل من الهوان.وهذا كلام لا يحتاج إلى نزول مادي، بل إنه علم إلهي خاص يحظى به المقربون
Page 157
من عباده بآذانهم وعيونهم وقلوبهم، مترها عن الوساوس، نقيًّا من الشوائب، وتوهَب له من الله صورة
اللفظ
وصوته.وهو ليس من قبيل الأخيلة أو الأوهام كما تتوهم بعض فرق الهندوس وأتباع البابية.ويجب أن لا ينخدع أحد هنا فيظن أن المتقين هم فقط أولئك الذين آمنوا بالنبي ، بل يقول القرآن
إن المتقين قد مضوا أيضًا قبل النبي ، وآمنوا بالوحي الذي أنزل من قبله.قال الله تعالى: وَلَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ) (الأنبياء: ٤٩).وهذا لأن صحيح، من لا يؤمن
بكلام الله الذي يترل في زمنه كيف يعتبر متقيا!
الله
وقوله تعالى: وما أُنْزِلَ مِن قَبْلِك هو العلامة الثانية للمتقين في هذه الآية، فهم يؤمنون بما نزل قبل
رسول الله ﷺ من الوحي أيضًا.الله أكبر ! ما أعظم هذه المعجزة القرآنية رجل أمي لا يعرف القراءة
والكتابة حتى بلسان قومه، رجل عربي من قوم هم أشد الشعوب تعصبا وعنادا..يتلقى الأمر من
تعالى بأن النجاة من الضلال لن تحصل بالإيمان بما جاءه من وحي، وإنما لا بد لها من الإيمان بما جاء قبله
كذلك.ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر: ٢٥).﴿وَلِكُلِّ من وحي
قَوْمِ هَادٍ (الرعد: ۸).فكأن محمدا لله مجمع البحرين حقا، بل كان مجمع البحار الروحية كلها.فمن يؤمن به فهو ملتزم
بالإيمان تلقائيا بالأنبياء السابقين كآدم ونوح وإبراهيم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه"، ويؤمن أيضًا
بأنبياء بني إسرائيل كموسى وداود وإدريس وإلياس وزكريا ويحى، ويؤمن بمؤسس المسيحية أيضا عيسى
العلمية، ويؤمن بأنبياء ظهروا في الهند ككرشنا ورام شندر وأنبياء جاءوا إلى الفرس كزرادشت..فهل
هناك أدل على السماحة والصدق في طلب الحق من هذا التعليم الإسلامي؟ وأنه منهج متره عن العصبية
القومية والتفريق العنصري، بل هو السعي الحثيث إلى الحق والاعتراف به حيثما كان، وإظهاره أينما
كان خفيا.آه! ما أجحد الدنيا التي تعادي مثل هذا الكتاب العظيم ليتهم يميلون إلى الإنصاف، وليتهم يُصدرون
حكمهم بعد تفكير، وليتهم يتدبرون الآيات الأولى من القرآن!؟
إن مسلك القرآن الكريم لا يقر بمنهج المسيحيين الذين لا يرتدعون عن اتهام الأنبياء بارتكاب الكبائر
مع إيمانهم بهم.فالقرآن ينزه جميع الأنبياء ويصدقهم، ويطالب المسلمين المؤمنين به أن يؤمنوا إيمانا
إجماليا بالأنبياء الصادقين ويصدقوهم.وبذلك يفتح الإسلام باب السلام العالمي، لأن المسلم لن يسيء
إلى نبي من الأنبياء، بل سوف ينظر إليهم باحترام وتقدير وتنزيه عما رماهم به أعداؤهم وأتباعهم على
حد سواء.Vo
Page 158
والعلامة الثالثة في هذه الآية هي قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون.والآخرة هي الأمر المتأخر،
ولذلك سميت الحياة بعد الموت بالحياة الآخرة، ووصف يوم القيامة باليوم الآخر، وسميت العاقبة بالآخرة
لأنها تتأخر، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (الضحى: ٥).ومعنى قوله : وبالآخرة هم يوقنون أنهم على إيقان بأمر متأخر.أما ما هو هذا الأمر؟ فيمكن أن
يكون المراد به القيامة أو الحياة بعد الموت، فهو المعنى الأكثر استعمالا في القرآن الحكيم كما في قوله
تعالى: مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاق) (البقرة : ۱۰۳)، بَل ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ)) (النمل: ٦٧)،
فيكون المعنى أن المتقين موقنون بالحياة بعد الموت.ويمكن أن يكون المراد بالآخرة البعثة الآخرة للرسول الله، كما جاء في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ
الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلالٍ مُبِينٍ * وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الجمعة:٣ و ٤).فالمتقون يؤمنون ببعثة إحيائية آخرة لرسالة المصطفى الله الله في آخر الزمن ، ويعود بها الإسلام إلى ما كان
عليه في عهد النبي الكريم.وفي تلك البعثة الآخرة يتتزل الوحي دون تشريع حسب قوله تعالى: إن
الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ (فصلت: ۳۱).ومن يتشرف بتلقي الوحي الإلهي لهذه المهمة سيتصف بمقام النبوة التابعة من
معين النبوة المحمدية.وذلك المقام متوقف على إطاعة الله تعالى ورسوله محمد المصطفى كما يقول
تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً)) (النساء: ٧٠).في
وذكر الإيقان بالآخرة تشجيع للمسلمين كي يضاعفوا مساعيهم في المجالات الروحانية، لأن من يؤمن
بها سيندفع نحو بذل جهوده لنيل تلك الحياة كما سعى لها صحابة النبي والتابعون ورجالات الإسلام
الصالحون من بعدهم في كل عصر.ومما يلفت النظر في الآيتين السابقتين من سورة البقرة أن كل آية منهما تبدأ بشيء ويتلوه أمران.فكأن الآية الأولى منهما تشير إلى أن إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله تابعان للإيمان بالغيب، والآية
الثانية تدل على أن الإيمان بالوحي السابق والإيقان بالآخرة تابعان للإيمان بالوحي المحمدي.ومما لا شك
فيه أن الوحي السماوي السابق للإيقان بالآخرة..لا يحصلان في هذا العصر إلا عن طريق القرآن المجيد.فلقد أمست أحوال الأنبياء السابقين مبهمة؛ بحيث لا يمكن أن يتبين صدقهم وعظمتهم إلا في ضوء
القرآن.وكذلك لا يتيسر اليقين بالوحي في المستقبل إلا بالإيمان بتعاليم القرآن، لأن كل دين آخر قد
Page 159
أغلق باب الوح فلا
يدعي
أي من هذه الأديان أن الإيمان به يُشَرِّف الإنسان بكلام
بكلام الله عز وجل اليوم
أيضًا.أُوْلَتبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
شرح
الكلمات:
المفلحون: أفلح.فاز وظفر بما طلب، نجح في سعيه وأصاب في عمله (الأقرب).والفلاح: الظفر
وإدراك بغية (المفردات).ويقال لكل من أصاب خيرا مفلح.والفلاح نجاح يغبط به الآخرون (تاج
العروس).وقد اتفق أئمة العربية أنه ليس هناك كلمة أكثر شمولا للخيرات الدنيوية والدينية من الفلاح.التفسير: تشير جملة أولئك على هدى من ربهم إلى ثلاثة أمور:
أولا: أن الهدى من رب المتقين.فمن حظي بالتقرب إلى الله تعالى تقدم بخطوات متتابعة حتى يبلغ
منتهى الكمال في رقيه لأن الرب هو من يتدرج بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة أعلى حتى يصل به إلى
الكمال.ثانيا: أن رب المتقين هو ربهم.وإضافة كلمة (رب) إلى (هم تعني أن الغاية من خلق الإنسان
الهداية لا الضلال، ولما كان الله تعالى هو الرب الذي تكفل في هذه الغاية فسيتيح لهم كل وسائل
الاهتداء إن هم اهتموا بطلبه.هي
ثالثا: إن كون المتقين على هدى يعني أن الهدى مطيتهم.والمعروف أن العظيم إذا دعا أحدا إلى
لقائه أرسل له مركبا يوصله إليه تكريما له وترحيبا به وإعانة له وهكذا سيكون الهدي الإلهى مطية
للمتقين توصلهم إلى ربهم جل وعلا وهذا التعبير مألوف في اللغة العربية، فيقولون "جعل الغواية مركبا"
أو "امتطى الجهل" بمعنى أنه حيثما يتوجه اتجه إلى الضلال.فالعبارة تعني أن الهدى مطية للمتقي المتحلي
بالصفات المذكورة في الآيات السابقة، وأنه يقوم بكل أعماله خاضعا لهدي الله تعالى، فتسمو أعماله عن
الجهل والضلال ولا ينال هذه الميزة إلا الذي يتلقى الهدى عن طريق الوحى من الله تعالى كل حين،
وإلا فالذي يستخدم العقل فقط، فإنه كثيرًا ما يقع في الخطأ.كما يشير قوله تعالى على هدى أيضًا أنهم لا يجدون صعوبة في الاهتداء إلى الله، لأن الهدى يسهل
سفرهم
كالمطية.وقد وردت كلمة "هدى" نكرة دلالة على عظمة هدايته.
Page 160
وقوله تعالى أولئك هم المفلحون يعني أن من كان الهدي الرباني ذريعته في حياته فلا بد أن يظفر
بما سعى ،له ويصلح حاله وينجو من الشرور ويبقى ذكره وثمار عمله.ورب قائل يستدرك: ولكننا نرى بعض المقربين يقاسون ،الشدائد وبعضهم يقتل، فكيف يتحتم
نجاحهم؟
فالجواب: أن المفلح من نال بغيته، وليس المراد بفلاح المتقي أنه ينال المتع المادية والراحات الجسمانية.إن المقربين ينالون، ولا شك، فلاح الدنيا ونعيمها أيضًا، ولكن هذا النوع من الفلاح أمر عارض وليس
غاية مقصودة، بل أن بغية المتقين النهائية هي التقرب إلى الله تعالى ونشر رسالته الحقة، ولم يخب في ذلك
أحد المتقين.لقد سعى اليهود للقضاء على المسيح الناصري عليه السلام وعلقوه على خشبة الصليب
لقتله، فهل نجحوا في ذلك أو قضوا على رسالته؟ كلا، بل إن المسيح نجح رغم قوة معارضيه وكثرة
مخالفيه.لقد استشهد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما أمام جيوش يزيد.فهل أفلح يزيد أو خاب
الحسين؟ كلا، كان الحسين صاحب الغاية الشريفة من المفلحين، واعترف العالم بصحة ذلك الشرح
للنظام الإسلامي الذي جاد الإمام الحسين بحياته من أجله و لم يجد يزيد من علماء المسلمين وعامتهم من
يؤيده.إن الموت أو القتل في هذه الحياة العاجلة لا يمنع الفلاح ما دام إدراك البغية متحققا حسب وعد
الله تعالى.ولولا صمود واستشهاد الحسين ورجاله في كربلاء ما هب علماء الإسلام بحماس وقوة لإحياء
تعاليم الإسلام وبيان حقائقه الناصعة.فزادها إشراقا أبديا.وفي هذه الآية إشارة أيضًا إلى أن دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يستجاب باتباع القرآن،
وأن الإنسان ينال فعلا وصال الله بطريق التقوى الذي يمهده القرآن فلا تبقى جهوده منحصرة في الدعاء
فقط.إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
شرح الكلمات:
كفروا كفر الرجل ضد آمن كفر نعمة الله وبها جحدها وسترها (الأقرب).الكفر في اللغة ستر
الشيء.وكفر بنعمة وكفرانها: سترها بترك أداء الشكر.ولما كان الكفر يقتضي جحود النعمة صار
يستعمل في الجحود.والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحدون الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو
ثلاثها (المفردات).VA
Page 161
أنذرتهم أنذره بالأمر : اعلمه وحذره من عواقبه قبل حلوله وأنذره: خوَّفه في إبلاغه.ويقال: أنذرت
القومَ سير العدو إليهم فنذروا أي أعلمتهم وخوفتهم فحذروا واستعدوا (الأقرب).والهمزة في
(أأنذرتهم) تفيد التسوية أي يستوي إنذارك لهم أو عدم إنذارك.التفسير بعد أن جرى الحديث عن أهل التقوى والإيمان الصادق تتحدث هذه الآية عن صنف من
الناس..إذا سمعوا القرآن الكريم أعرضوا عنه ولا يتدبرونه، ولا يبرحون متمسكين بكفرهم على الرغم
الأدلة الناصعة.وقد أشارت آيات أخرى إلى هؤلاء الكافرين وبينت مسلكهم الذي يحجبهم عن
الإيمان.فمثلا يقول تعالى: كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
(يونس: ٣٤).ويقول: فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ) ( الأعراف : (۳۱).وقد ورد نفس المضمون في سورة النحل (آية ٣٨) وسورة
من
يس (الآيات (۱۲۹).الله
ولا يراد من هذه الآية أن الكفار لن يؤمنوا في المستقبل، فهذا عكس الواقع؛ إذ آمن كثير من الكفار
بعد نزول هذه الآية، بل نزلت بعدها سورة النصر التي تصرح بأنه: إذا جاء نصر
والفتح * ورأيت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا..إذن فالآية لا تنفي إسلام الكفار أصلا.الكافر هو المنكر، فمن قدّم
له الحق وتثبت منه وقبله فسوف يؤمن به.أما الكافر الذي يبقى على إنكاره ويتشبث بالباطل بعد أن
عرف أدلة الحق..فهذا لن يؤمن أبدا ما دام يعتمد الإنكار، ويسد طريق الاهتداء على نفسه.والواقع أن
القرآن جاء لهداية الكفار والآية تدعوهم إلى ذلك بعدم التمسك بالإنكار إذا ما تجلت لهم دلائل صدق
القرآن وتعاليمه.ولعل القائلين بهذا المعنى الخاطئ لم يدروا أن الهمزة في مثل هذه المواضع لا تكون للاستفهام، بل هي
تشابه المصدر معنى.فمعنى الجملة: إن إنذارك إياهم وعدم إنذارك سواء فهي جملة معترضة للتأكيد أو
للاستدراك، ويمكن أن تكون حالا أو صفة أيضًا، ومعناها:
١- أن الكفار الذين وصل بهم الحال من العناد بحيث يستوي إنذارك إياهم أو عدم إنذارك..لا
يؤمنون.فإن تركوا العناد، وهو مخالفة الحق وردّه مع معرفته، أمكن لهم أن يؤمنوا.٢- والكفار الذين يستوي فيهم إنذارك أو عدم إنذارك لا يؤمنون لأنهم ليسوا محلا للإنذار فلا
جدوى من تخويفهم من
فالكفار على نوعين : نوع يؤمن بدين من الأديان، فيؤمن بالله والحشر والنشر، فإذا قدمت لهم حقيقة
من الحقائق الروحانية ونبهتهم إلى خشية الله اتقوه ومالوا إلى تدبرها، وإذا عرفوا صدقها آمنوا بها، ونوع
آخر لا يؤمن بدين ولا يؤمن بالله والحشر والنشر
والحشر والنشر..فلا فائدة
من تخويفهم من
الله.إنهم يستهزئون باسم
الله تعالى.
Page 162
الله جل وعلا فهؤلاء بحاجة أولا إلى تقديم الأدلة على وجود الله والحشر والنشر، ثم بعد ذلك يوجهون
إلى ما جاء به النبي من حق، لأن خشية الله لا تتأتى إلا بعد الإيمان به، وعندئذ يمكن أن يؤدي الإنذار
إلى الإيمان.٣- إن إنذارك الكفار الذين يعرضون حتى عن مجرد السماع أو عدم إنذارك سواء عليهم.إنهم لا
يؤمنون ولن يؤمنوا.خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ
شرح
الكلمات
منه،
ختَم حَتَم حَتْما وختامًا إذا طبعه ووضع عليه الخاتم ختَمَ الصَّكَ وغيره: إذا وضع عليه نقش خاتمه
حتى لا يجري عليه التزوير.(الأقرب).وختم الله على قلبه : جعله بحيث لا يفهم شيئا، ولا يخرج عنه
التزوير.(الأقرب).شيء كليات أبي البقاء).والختم والطبع على وجهين مصدر ختمتُ وطبعتُ وهو تأثير الشيء كنقش
الخاتم والطابع، والثاني : الأثر الحاصل على النقش، ويُتجوز بذلك تارة في الاشتياق من الشيء والمنع
اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب.وقوله : ختم الله على قلوبهم إشارة إلى ما
أجرى الله به العادة أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور، ولا يكون منه تلفت بوجه
إلى الحق، يورثه ذلك هيئة تُمرنه على استحسان المعاصي، وكأنما يُختمُ بذلك على قلبه (المفردات).به
والختم والطبع واحد في اللغة، وهو التغطية على الشيء، والاستيثاقُ من أن لا يدخله شيء (التاج).قلوب : جمع قلب أي الفؤاد، وقد يطلق على العقل (الأقرب).ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص
من العلم والروح والشجاعة.وجائز في العربية أن تقول : ما لَكَ قلب، وما قلبك معك، أي: ما عقلك
معك.وأين ذهب قلبك أين ذهب عقلك وكان له قلب أي تفهم وتدبر (لسان العرب).فمعنى ختم الله أن الله جعل قلوبهم بحيث لا تفهم شيئا، ولم تبق في عقولهم مادة التفكر والتدبر.السمع سمع الصوت أدركه بحاسة الأذن والسمع حِسُّ الأذن والأذنُ؛ وما ولج فيها من شيء
تسمعه.والسمع: الذكر المسموع، وجمعه أسماع (الأقرب).والسمع قوة في الأذن به يُدرك الأصوات،
وفعله يقال له السمع أيضًا.ويعبر تارة بالسمع عن الأذن، وتارة عن فعله كقوله تعالى: إنهم عن السمع
لمعزولون، وتارة عن الفهم كما يقال: لم تسمع ما قلت، وتارة عن الطاعة (المفردات).
Page 163
أصله
أبصار: جمعُ بَصَر وهو حاسة الرؤية؛ العين؛ العلم (الأقرب).عذاب كل ما شق على الإنسان ومنعه عن مراده وكل عذاب في القرآن فهو التعذيب إلا قوله
وليشهد عذابهما طائفة فإن المراد الضرب الكليات).والعذاب: الإيجاعُ الشديد.فالتعذيب في
الأصل هو حمل الإنسان أن يَعْذَب أي يجوع ويسهر.يُقال: عذَبَ الرجل: ترك الأكل والشرب.وقيل
من العذاب أي الماء الحلو.وعذَّبْتُه : أزلتُ عذب حياته أي حلاوتها (المفردات).فمعنى العذاب:
الإيذاء؛ حرمان الإنسان مما يُسعد حياته؛ إفشال هدف حياته.التفسير : هذه الآية تبين مصير أولئك الكفار الذين يتصفون بالعادات السيئة المذكورة في الآية، وليس
جميع
الكفار.فمن السنن الطبيعية أن العضو الذي يعطله الإنسان عن العمل يفقد المقدرة على أداء عمله
شيئا فشيئا إلى أن يتعطل..فالعين يزول عنها إبصارها إذا عُطّلت والأذن تُصمّ إذا لم تستعمل لمدة
طويلة، واللسان يتعطل عن الكلام إذا لم تستخدمه لزمن طويل، والذراع تفقد قوتها إذا توقفت عن
العمل.وقد نرى بعض الهندوس يفلجون أيديهم بمنعها عن الحركة مدة طويلة.وكذلك الحواس الباطنة..إذا تركها الإنسان و لم يستعملها مدة من الزمن تعطلت.يشير الله تعالى في الآية الكريمة إلى أن تلك الحواس الثلاث وسائل للاهتداء، وأن عناد الكفار يجعلهم
يهملون قلوبهم وآذانهم وأعينهم.فالقلب للتفكير، ومن يعود نفسه على استعماله يُصب الحقائق الكثيرة.والأذن للسمع، وبه يمكن للمرء أن يتعرف على الحقائق التي قد لا يدركها بفكره.والعين للنظر، وبها
يمكن إدراك ما فات السمع والفكر.والشقي من يحرم نفسه من هذه الأمور كلها، فلا يمكن له أن
يتعرف على حقيقة، أو أن يُسَلّم بأمر بتاتا..ولسوف يتأذى ويتألم من جراء ذلك، لأن أحكامه وقراراته
كلها ستكون مجانبة للصواب.ويزعم الزاعمون أن
ختم
الله على قلوب الكفار وسمعهم يعني إكراههم على الكفر.وهذا من الظلم
الذي ينفيه القرآن عن ا الله تعالى إذ يقول:
إنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (النساء: ٤١).إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (يونس: ٤٥ ).وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (الزمر: (٨).وَكَرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ) (الحجرات: ۸).والقرآن ينفي الإكراه في مواضع عديدة.فلو جاز لكان الإكراه على الإيمان وليس على الكفر، كما
قال عز وجل: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (الكهف: ٣٠).فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأنعام: ١٥٠).
Page 164
ويتبين من القرآن أن الإيمان والكفر من أعمال الإنسان فقد قال تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ ومنهم من
كَفَرَ (البقرة: ٢٥٤).مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ (الروم: ٤٥).والحق أن الختم والغشاوة ليسا إلا من ثمرات أعمال الإنسان نفسه كما وضح ذلك القرآن في قوله:..طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ..) (النساء: ١٥٦)...آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ)) (المنافقون: ٤).كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (يونس: ٧٥).يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (غافر: (٣٦).كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (المطففين: ١٥).فالختم والطبع والتغطية كلها بسبب كفرهم واعتدائهم وتكبرهم وتجبرهم.وقد نسب الختم والطبع إلى الله في هذه الآية وغيرها من الآيات، لأن النتائج المترتبة على أعمال
الإنسان هي من عند الله تعالى طبق مشيئته وقانونه، فالكفر والعناد من عمل الإنسان، أما النتيجة وهي
الطبع فهي من قانون الله تعالى، ولذلك نسب إلى الله.وفي آية أخرى نسب النتيجة إلى الكفار أنفسهم
لأنهم تسببوا في تطبيق القانون الإلهي عليهم نتيجة عدم تدبرهم.قال الله تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ
عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا (محمد:٢٥).فالذين يسدون أبواب الهداية في وجوههم ويعطلون قلوبهم وآذانهم..يعقب الله تعالى على أعمالهم
بنتيجة توافقها تماما.وهذا ما يصدقه قول الرسول :
"إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد
زادت حتى يُغلف قلبه، فذلك الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"
(تفسير ابن جرير).ولقد شرح ابن جرير ذلك بقوله:
قبل
الله
عز
فأخبر أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من
وجل، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم.ولا يغيبنّ عنكم أن الختم والحجاب ليسا ماديين، ويتضح ذلك من قوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ (فصلت:(٦)، وقوله تعالى ﴿وَلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (الأعراف: ۱۸۰)، وقوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا
Page 165
فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج: ٤٧).هذا، ولم تنسب الغشاوة على الأعين إلى الله تعالى كما نُسب إليه الطبع على القلوب والآذان..وذلك للإشارة إلى أن الكفار قد يعتذرون بأنهم لم يؤتوا العقل الراجح لفهم دقائق أحكام الله تعالى، أو
لم تتح لهم فرصة سماعها، ولكن آيات الله في تأييد رسوله ونصرته كانت تتنزل عليه أمام أعينهم وعن
أيمانهم وعن شمائلهم..فكيف يمكن لهم أن يتنصلوا من رؤيتها؟ وهذا يؤكد أيضا أن نسبة الختم إلى الله
تعالى كانت نتيجة فعلهم أنفسهم..فكما تعاموا عن رؤية آيات التأييد الإلهية لرسوله كذلك تغابوا عن
فهم حكم الله تعالى وتصاموا عن سماعها.وجدير بالملاحظة هنا أن السمع قد قدم على البصر بعد ذكر القلب، وهذا ترتيب مطرد في القرآن
الكريم، ولهذا النسق حكمتان الأولى ما ذكرناه آنفا من أن العقل الواعي له السبق في إدراك الحقائق، ثم
إذا لم يدركها وحده استعان بما يسمعه من أدلة ثم إذا لم تكفه تلك استفاد بما يراه بعينه.والحكمة الثانية
أن قوة السمع في الكائنات الحيوانية تبدأ عملها قبل البصر، وهناك كائنات تبقى صغارها عمياء لفترة
تقصر أو تمتد، وتدرك ما حولها بحاسة السمع.ويلاحظ أيضًا أن الآية الكريمة ذكرت القلوب والأبصار بصيغة الجمع، أما السمع فبالإفراد.والحكمة
في ذلك أن أفعال القلب تختلف في كل إنسان عن غيره اختلافا كبيرا ويصل هذا التفاوت بين القلوب
لدرجة أن بعض الناس يترل تحت الثرى وبعضهم يصل إلى الثريا وكذلك تختلف القدرة على إبصار
الحقائق من آيات ومعجزات من فرد إلى آخر، وهكذا تختلف القلوب والأبصار فتتعدد.أما بالنسبة
لسماع القرآن الكريم، فلا يتفاوت السمع وإنما هو نوع واحد، فهو كتاب وحيد من نوعه، لذلك
يسمعون جميعا بسمع واحد.هناك سؤال يقول : لماذا استعمل الله الختم للقلوب والأسماع وهو أشد من الغشاوة التي
استعملت للأبصار، والتي يمكن أن تزول، ولكنه في موضع آخر يقول: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) (النحل: ١٠٩).السبب في اختلاف هذا الاستعمال أن الإنسان يفكر أولا في قلبه، ثم يهتدي بسماع الدليل، وإذا لم
يتمكن بعد هذا من الهداية يرى الآيات والمعجزات، وهذه تظهر شيئا فشيئا بعد نزول الكلام الإلهي..فكأن الحجة عن هذا الطريق تقدم على مهل، لذلك يختم الله تعالى الأبصار في نهاية الأمر.الغشاوة توضع
أولا ثم يأتي الختم.أما سورة البقرة فهي تذكر حالهم قبل الختم الذي لم يكن قد جاء أوانه بعد.وأما
Page 166
سورة النحل فهي تذكر حالهم بعد ظهور المعجزات عندما لم يؤمنوا بالحق رغم مشاهدتها، فكأنه قد
ختم على هذه الحواس كلها.ولا يعني العذاب هنا عقوبة النار بعد الموت فقط، بل يعني أيضا الحرمان من قُرب الله تعالى، لأن من
معاني العذاب المنع والحرمان.فالمؤمنون سيصلون إلى ربهم على مطية الهدي الرباني، ولكن الكفار سوف
يُمنعون من رؤية الله ووصاله وأي عذاب أشد هذا ؟!
من
وتشير الآية أيضًا إلى أن الذين يتهاونون في استعمال القلب "أي العقل" والسمع والبصر يتأذون
ويذلون في كل شأن من حياتهم، وهكذا لا يبرحون في العذاب دائما.وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ )
شرح الكلمات:
آمنا آمن صدق.وقد سبق أن ذكرنا ثلاثة معانٍ للإيمان تحت آية الذين يؤمنون بالغيب،
ونُضيف إليها قول الإمام الراغب: "الإيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد ﷺ، ويوصف به
كل من دخل في شريعته، مقرا بالله وبنبوته؛ وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس
للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل بحسب
ذلك بالجوارح".وقد بين القرآن الكريم هذا المعنى في قوله: قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ١٥، وقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ)) (النمل: ١٥).التفسير: كان الحديث من قوله تعالى أهدى للمتقين إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون عن
طائفة تؤمن إيمانا راسخا وتنال ما يترتب على إيمانها من خير أيما نَيل ثم قوله إن الذين كفروا إلى
قوله ولهم عذاب عظيم يذكر طائفةً لا يبرحون على كفرهم وعصيانهم عنادا فيلقون ء نتائجه.سوء
وقد أشير في هذه الآيات -ضمنيا - إلى الذين هم كفار من حيث العقيدة ولكن قلوبهم خالية من
التعصب، وإذا عُرض عليهم الحق حاولوا فهمه فإذا تبين لهم قبلوا به وصدقوه.ومن هنا يبدأ ذكر طائفة أخرى من الناس هم المنافقون والمنافقون على نوعين: نوع ينضم إلى
المؤمنين ظاهرا، ولكنهم ينكرون عقائد الإسلام في باطنهم وهم يتظاهرون بالإيمان من أجل المصالح
الدنيوية أو العصبية القومية.ونوع آخر يصدق مبادئ الإيمان بالأدلة العقلية، ولكنهم لا يملكون من قوة
الإيمان ما يمكنهم من الصمود وتقديم التضحيات.وهذا النوع يبدو عليه التكاسل والتهاون، ولا يكون
Page 167
السبب وراءه اختلافا في العقيدة، بل ضعف القوة الإيمانية التي تجعلهم يلتزمون بما يؤمنون به.فإن
اشتدت عليهم وطأة الكفار أظهروا ميلهم إليهم وأخذوا يذكرونهم بعلاقاتهم الودية، ولا يرون بأسا في
مداهنتهم، قائلين في أنفسهم: إن الحق غالب بفضل الله، ولا يضيره أن ندفع عن أنفسنا الأذى بالتودد
لأعدائه.هذه الآية إشارة إلى القسم الأول من المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وإن كانت قلوبهم
منكرة له.وهنا اقتصرت الآية على ذكر الإيمان بالله والإيمان بالآخرة..اكتفاء بذكر الحلقة الأولى
والحلقة الأخيرة من حلقات الإيمان على سبيل الإيجاز المعبر عن المقصود.تماما.والواقع أن هذا الأسلوب
القرآني سمة إعجازية.فالقرآن كتاب جامع للعلوم كلها..روحانية ومادية..يتضمن الإلهيات، وعلم
الأفلاك، والضرورات المعيشية، ومبادئ الاقتصاد، وأساسيات الاجتماع، والأحكام المدنية والأخلاقية،
وأحكام العبادات، وما يتصل بالعباد من حقوق، وواجبات الحاكم والرعية والأغنياء والفقراء وأصحاب
المصانع والعمال، وفيه حقوق الزوجين وأفراد الأسرة وواجباتهم، وفيه أحكام الحرب والسلم، ومبادئ
القضاء وآداب الأكل والشرب..عشرات ومئات من الأحكام والتوجيهات..ذكرا وشرحا مع بيان
الحكمة وضرب الأمثلة وكان عليه أيضًا أن يبصر الناس بآيات الله المتجددة، ويطلعهم على أعمال
الأنبياء السابقين ومعاملة الله تعالى لهم، ويخبرهم بأنباء المستقبل..ليزداد المؤمنون في كل زمن إيمانا، ويجد
الكافرون فيه عبرة وهدى.فكيف لكتاب أن يتناول كل هذه الأمور..لولا هذا الإيجاز اللطيف المعجز.ومع أن الكتاب المقدس
(العهد القديم والعهد الجديد)، وكذلك كتب الفيدا..أضخم حجما من القرآن بكثير، إلا أن المقارنة
بينها تكشف عن المكانة السامية التي يتمتع بها القرآن مادة وموضوعا كلمة وأسلوبا، فالقرآن المجيد مع
ما فيه من حقائق وافرة وموضوعات متنوعة ومنهج متكامل..نجد أنه يتناول كل ذلك بأسلوب موجز
بليغ، مع سهولة لفظه وسلاسة أسلوبه، ووضوحه وخلوه من الألغاز والمعميات.ومثل هذا الإيجاز لا يأتي إلا باتباع مثل هذه الأساليب اللطيفة.فإذا أريد مثلا أن يذكر تقسيما طبيعيا
لشيء ما اكتفى من حلقاته بالحلقتين الأولى والأخيرة.وإذا قصد إلى العبرة من إحدى قصصه، حذف
ما لا ضرورة له، وذكر ما لا بد منه للاستنباط وأتى من الكلمات ما يدل على أوسع المعاني.ثم ساق
الجمل على نسق بحيث يعبر كل لفظ عن معناه المستقل..مقترنا بسائر الكلمات.ثم رتب الآيات ترتيبا
كل آية عن موضعها لدلت على معنى خاص يغاير معناها وهي مرتبطة بسائر الآيات.ثم
نسق مجموعات الآيات بحيث يدل كل حرف على معنى مستقل بجانب دلالته الخاصة من جهة اتصاله بما
لو فصلت
معه
Page 168
قبله وما بعده.وقد اختار القرآن الكريم هذه الأساليب لكي تحتوي كلماته القليلة على معاني غير
محدودة.ولقد ذكرت ما سبق بشيء من التفصيل..لأن بعض الجهلة يستدلون بمثل هذه الآيات على أن مجرد
الإيمان بالله واليوم الآخر يغني عن لوازم الإيمان، إذ إن الإيمان، بزعمهم، يتوقف في هذه الآية على هذين
الأمرين.ولعل هؤلاء الناس يجهلون أو يتناسون تلك المبادئ القوية المحكمة التي استعملها القرآن الكريم
لأجل الإعجاز والجامعية..وهي سمة عامة في جميع القرآن الكريم وتدليل على ما سبق وتصديق لما
أوردنا..نسوق مثالا من القرآن :
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (الأنعام: ٩٣).فمن هذه الآية يتبين أن الإيمان بالآخرة يستلزم الإيمان بالقرآن ومن يؤمن بالقرآن فعليه أن يؤمن
محمد له ولأن الإنسان تشرف بهذه النعمة الكبرى - نعمة القرآن المجيد عن طريقه ، وكذلك عليه
أن يؤمن بالملائكة، لأن القرآن يذكرهم كثيرا.بل تبين هذه الآية أيضا أن فعل الأعمال الصالحة تدخل
في الإيمان باليوم الآخر لأن الله تعالى يقول هنا بأن الذين يؤمنون بالآخرة هم لا يؤمنون بالقرآن
فحسب، بل أيضًا يعملون حسب تعاليمه.وللآية الكريمة وجه آخر فهي تحكي ما قاله المنافقون من إيمانهم بالله واليوم الآخر، وتركهم ذكر
الرسول والقرآن والملائكة عمدا، لأنهم لم يؤمنوا بهم..فاكتفوا بما قالوا لخداع المؤمنين.وفي قوله تعالى: ومن الناس تعريض لطيف بالمنافقين، إذ تشير إلى واجبهم كأناس لهم عقل وفكر،
فكان عليهم ألا ينساقوا وراء من أسلم من قومهم دون أن يستخدموا عقلهم وفكرهم، فإنسانيتهم
كانت تقتضى أن يتدبروا ما جاء به الرسول..فإن تبين لهم صدقه آمنوا به واستمسكوا به، وإن كان
غير ذلك تمسكوا بما هم عليه من دين آبائهم أما أن يقلدوا أحدا كالأنعام التي يتبع بعضها بعضا دون
تدبر..فهذا فعل يتنافى وخصائص الإنسان.وهذه الآية وما سبقها من الآيات الكريمة ترد ردا حاسما على مزاعم من يقول بأن القرآن أمر بإكراه
الناس على الإسلام، ذلك الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين أيضًا.ولو فكر هؤلاء المتعنتون من أعداء
الإسلام ومن انخدع بقولهم من المسلمين في هذه الآية وحدها لعرفوا حق المعرفة أن الإسلام يرفض
الإكراه ويضاد الإكراه والإجبار.ذلك لأن الإكراه يسبب النفاق، وإكراه أحد على الإسلام يعني دعوته
إلى التفوه بالإسلام والتظاهر به، وإن كان قلبه غير مطمئن إليه.وهذا هو ما تستنكره الآية وتعرض به.إن الإسلام دين يرفض بشدة دخول المنافقين فيه، ولكنه يرحب بكل من هو مطمئن القلب صحيح
Page 169
أن
يتصور أبدا أن
العقيدة.ومن ثم فلا
يرغم الإسلام أحدا على دخوله بقوة السيف أو بالإكراه.لا يمكن
يسمح الإسلام بذلك، لأن الدين الذي يصف المؤمنين بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسهمْ فِي سَبيل اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(الحجرات : ١٦).فالإسلام يريد مؤمنين واثقين مطمئنين إلى عقيدتهم، يضحون في سبيلها بكل غال ورخيص..يريد
إيمانا صادقا وليس نفاقا..فكيف يُكره إنسان على ذلك؟
تُخَدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا تَخدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
شرح الكلمات:
يخادعون: خدع الشيءُ: فسد (التاج).خدعه: ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلمه (الأقرب).يقال: خادَعَ: إذا لم يبلغ مراده، وخدع إذا بلغ مراده خادعه إذا تركه خادع العين: شككها فيما
ترى.خادعه: إذا كاسده (الكليات).الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما
يخفيه (المفردات).الخدع: إظهار خلاف ما تخفيه.وجاز استعمال (يفاعل) لغير اثنين لأن المثال يقع
كثيرا في اللغة للواحد نحو عاقبتُ اللصَّ.والعرب تقول : خادعتُ فلانًا، إذا كنت تروم خدعه (اللسان).وخدعه منعه، يقال: كان فلان كريما ثم ،خدع أي أمسك ومنع.وسوق خادعة: أي مختلفة متلونة
تقوم تارة وتكسدُ أخرى (التاج).وخادع الحمد تركه (الأقرب).إذن فمعنى يخادعون الله أنهم:
أولا): يريدون خداع الله ولكن الله لا ينخدع منهم.ثانيا): يشككون غيرهم بإظهار خلاف ما في صدورهم.ثالثا: يفسدون في الدين
رابعا: يحاولون منع الله بمعنى أنهم يعرقلون نشر دينه.خامسا): يعاملون الله معاملة المتلونين، فأحيانا يطيعونه وأخرى يعصونه.يشعرون شعره وشعر به فطنه عقله؛ أحس به (الأقرب).والشّعر هو العلم بدقائق الأمور، وقيل
هو الإدراك بالحواس.ولا يجوز استخدام لا يعقلون مكان لا يشعرون، لأنه كثيرا ما يكون
Page 170
الشيء معقولا، ولكن لا يشعر به الإنسان فالفرق بين الشعور والعلم أن الشعور يكون بالحس الباطني
أما العلم فيحصل بالوسائل الظاهرة.وقد يؤثر العلم في القلب، أما الشعور فلا بد أن يؤثر فيه (التاج).التفسير : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الإيمان النافع يتأسس على النية الحسنة والإخلاص لله عز
وجل مع الصدق، والإيمان الذي ينقصه الإخلاص ليس بشيء، بل هو من باب الخداع، والله تعالى عالم
الغيب والشهادة فلا يمكن أن ينخدع.وقد كان لهذه الآية نصيبها من الاعتراضات، فقالوا:
أولاً - كيف يمكن لأحد أن يخدع الله؟ وثانيا - إذا كان المراد من يخادعون أنهم يحاولون أن يخدعوه،
فالسؤال: كيف يحاول أحد أن يخدع الله تعالى بعد الإيمان به؟ ثالثًا (ويخادعون) من باب المفاعلة التي
تدل على اشتراك الطرفين في العمل، وهذا يعني أن المنافقين يخدعون الله والله يخدعهم أيضا، فكيف يجوز
الله؟ أليس فيه انتقاص من قدره عز وجل؟
وردا على الاعتراض الأول نقول:
ذلك على
أ- إن فعل خادَعَ غيرُ خدَعَ، فخادَعَ يعني حاول خدع الآخر، سواء خُدع الآخر أم لم يُخدع، وقد
سبق تفصيل ذلك عند شرح الكلمات، فلا يصح هذا الاعتراض.ب- ولا يصح
هذا الاعتراض حتى لو فُسّرت ( يخادعون الله) بمعنى يخدعونه سبحانه وتعالى، لأن المعنى
أنهم يعاملون الله تعالى معاملة تشبه الخداع، إذ لا يكونون صادقين مخلصين فيها، والتجربة تؤكد ذلك؛
حيث نجد البعض غير مخلصين في إيمانهم.فما دامت التجربة تؤيد ذلك، فكيف يصح هذا الاعتراض؟
سواء أكان المنافق مؤمنًا في الظاهر ويكون مع الكفار في السرّ، أو يكون كافرا في الظاهر ويكون مع
المسلمين في السرّ، علينا أن نرى لماذا يتصرف هكذا.من الواضح أن غرضه أن يجني بعض المنافع بخداع
مع
الناس، ولكن حيث إن أمر الإيمان يخص الله تعالى في الحقيقة، فلا يعني تصرفه هذا إلا أنه ليس صادقًا
الله تعالى، وليس مخلصا كما ينبغي في علاقته مع الله تعالى.لا شك أنه ينوي خداع الناس، إلا أننا لو
قمنا بتحليل تصرفه، لظهر لنا أنه لا يريد إلا أن يخدع الله تعالى.وإذا فسد قلب المرء فلا يتعذر صدور
مثل هذه التصرفات المتناقضة عنه.ولكن لا ذلك أن الله تعالى ينخدع بهذه المعاملة؛ فهو سبحانه
العليم الخبير الذي يستحيل خدعه وانخداعه كما يقول وما يخدعون إلا أنفسهم.فمخادعة الله هنا
ليست بحقيقة وإنما هي مجاز، ومعناها مماطلة أحكام الله والتنصل عن الواجبات المفروضة منه، ومثله قول
الشاعر : "وخادعتُ المنية عنك سرًّا.وقد أراد به إزالة أسباب الموت.يعني
فإذا كان معنى الخداع هو قصد الخدع وإرادته فما وجه الاعتراض على ذلك؟ إن في هذه الدنيا
من العلماء والفلاسفة الذين لا يعتقدون بعلم عز وجل، ويظن بعضهم أن علمه سبحانه وتعالى
طائفة
الله
Page 171
يقتصر على الكليات ولا يحيط بالجزئيات، وأمثال هؤلاء كانوا موجودين وقت نزول القرآن أيضا كما
ذكرهم في قوله: وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (فصلت:٢٣ و ٢٤).ووصفهم في قوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا
يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (هود: ٦).ولا يعتقد هذه العقيدة إلا ضعفاء الإيمان ممن يجهلون صفات الله تعالى ولا يدكون كنهها حق
الإدراك، فيتخبطون في هذه العقائد والأعمال المنكرة، متشبثين بقشة الغريق..يقولون: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (الأنعام: ٢٤).عظمة
من
يظنون أن الله تعالى يغفر لهم لأنه رحيم غفار، بل إنهم هم مظاهر مغفرة الله، ولولاهم ما ظهرت
مغفرته.ولكن الآية الكريمة تقرر أنهم يخدعون أنفسهم بإيمانهم الفاسد وعقيدتهم الباطلة.أما من يقولون بأن المخادعة تعني المشاركة فيكون الخداع من الله تعالى أيضا، وهذا ينال
وعلو شأنه، فنرد على اعتراضهم بأن المفاعلة لا تستلزم المشاركة من الجانبين، بل قد تدل على
صدور الفعل من جهة واحدة كقولك: عاقبتُ اللصَّ.فهذا لا يعني أنك عاقبته وهو عاقبك.كذلك يعني
قوله : يخادعون الله أن محاولة الخدع حدثت من جانب المنافقين وحدهم.الله
هذا، وإن جزاء الجريمة يعبر عنه أحيانا بلفظ الجريمة كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا (الشورى: ٤١)، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة: ١٩٥).فالمعنى
أن المنافقين يخادعون الله، والله يخدعهم..أي يعاقبهم ويجازيهم على خداعهم.وهذا
الاستعمال شائع في اللغة العربية وهو من باب المشاكلة، يقولون : "حَسَدَني الله إن كنتُ أحسُدُك"، أي
عاقبني على الحسد (الأقرب).وقال عمر بن كلثوم في معلقته:
ومثله قول الطحوي
ألا لا يَجْهَلَنْ أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينــــا
فنگكب عنهُمُ درء الأعادي وداوى بالجنـــون من الجنون
وهذا المعنى يدعمه قول الله تعالى:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (النساء: ١٤٣).خلاصة القول: إن الآية لا تعني أبدا أن الله تعالى يمكن خداعه.فهذا الفهم الخاطئ يخالف نصوص
القرآن الصريحة، وهو افتراء جريء على العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية..كما قال عز وجل:
Page 172
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق: ۱۷).به
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (الأنفال: ٤٤).وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِين (سبأ: ٤).أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا
خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المجادلة: ۸).يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)) (غافر: ٢٠).نخلص من هذا البحث بالأمور التالية عن المنافقين وسلوكهم:
١.أنهم بسلوكهم يتعاملون مع الله تعالى معاملة الخادع.٢.أنهم يريدون خداع الله تعالى مع أنه يجل عن الانخداع.أن الله تعالى يعاقبهم على أعمالهم بما يوقعهم في مغبة خداعهم.٤.أنهم يتناءون عن الله بسلوكهم.."حيث خدع تعني هجر".أنهم لا يستقرون على حال بسبب عدم إخلاصهم فيما يدَّعونه من إيمان.فهم أحيانا يتصرفون
تصرف المؤمنين ويسايرونهم خوفا منهم، وأحيانا يخضعون لوطأة الكفار وينحازون إلى صفوف أعداء
الإسلام.."حيث خدع بمعنى اضطرب ولم يستقر على حال كقولهم: سوق خادعة".٦.أنهم يسلكون مسلك المفسدين.."حيث الخداع يعني الفساد"..أنهم يخادعون رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، ومن يسعى لخداع الرسول ﷺ فكأنما
يريد بذلك خداع الله تعالى.ويتبين هذا المعنى من قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ
اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: (۱۱) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام: (٣٤).فمبايعة الرسول ﷺ مبايعة الله، وتكذيب الرسول ﷺ
جحود بآيات الله
ولقد ورد نفس الأسلوب في الحديث القدسي: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضتُ فلم تَعُدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال:
أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلم تَعُده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم،
استطعمتُك و لم تُطعمني قال : يا ربّ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك
عبدي فلان، فلم تطعمه.أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتُك فلم
Page 173
تسقني.قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه.أما إنك
وعرفها حق
لو سقيته لوجدت ذلك عندي (مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض).وقوله تعالى : وما يخدعون إلا أنفسهم يدل على حقيقة ناصعة وهي أن أعمال المنافقين التي
يعوزها الإخلاص ستعود عليهم وبالا، لأن الخديعة لا تحل إلا بصاحبها..فيكون في الدنيا والآخرة من
الأذلاء السافلين.يظن أنه يخدع الله تعالى، ولكنه في الواقع يخدع نفسه ويدفعها نحو الهلاك.وقوله تعالى: وما يشعرون أي لا يفطنون إلى حقيقة الأمر.والشعور يختلف عن العلم والعرفان
والعقل والفكر.فالشعور هو العلم بالأمور الدقيقة والعلم هو ما يحصل عن طريق الحواس الظاهرة.أما
العرفان فهو العلم المتكرر للشيء، ولذلك تسمى العلوم الروحانية بالعرفان، لأنها تدرك أولا بكلام الله
تعالى أو بالفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها، وهذا هو العلم الابتدائي عندما تقترن به المشاهدة
يصير عرفانا، ويسمى صاحبه عارفا لأنه شاهد صفات الله
التي
كتاب الله
علمها من
المعرفة.والعقل هو قوة توجه الإنسان نحو العمل طبق علمه وفكره وشعوره والعاقل هو الذي يستعمل
في أعماله العلم الصحيح والفكر الصائب والشعور النافذ إلى دقائق الأمور، ويمنع نفسه من مخالفة هذه
القوى.أما الفكر فهو قوة تساعد على الاستنتاج من المعلومات الخارجية، والمفكر هو الذي يرتب
معلوماته البسيطة ترتيبا يؤدي به إلى نتائج جديدة لم يكن يعرفها أحد من قبل.الشعور هو إحساس المرء بقواه الباطنية التي جُبل عليها وبالتالي اهتداؤه بها إلى طريق الخير.ومنه سمي
الشعر لأنه يظهر من الداخل إلى الخارج.والشعار هو اللباس الداخلي الملتصق بجسم الإنسان.والشعار
الشجرة لأنها تنبت خارجة من الأرض والشعار أيضًا هو كلمة السر التي يُتفق عليها بين الحارس وغيره
من الخفر، وسمي كذلك لأنه من الأسرار الخفية والشعر سُمي كذلك لأنه يعبر عن المشاعر والعواطف
الباطنية والشعائر هي مظاهر إرادة الله عز وجل، وبها تتجلى مشيئته وصفاته.والمشاعر هي الحواس
الباطنية، فالشعور إذن حس خفي يطلع الإنسان على قواه الباطنية ولا علاقة له بالعلم الخارجي.وقوله تعالى: وما يشعرون يعني أن الفطرة السليمة تمج الخداع، ولكن المنافقين لا يعرفون حتى
قوى نفوسهم فضلا عن حقائق الدين وهم لا يدرون أن النفاق من الأفعال القبيحة التي ترفضها الفطرة
السليمة دون أن يوجهها أحد.وكما سبق أن ذكرنا أن هذه الآية تشير إلى جماعة من أهل المدينة كانوا يتظاهرون بالإسلام قولا
بأفواههم و لم يكونوا مسلمين في الحقيقة.فلما أسلم غالبية أهل المدينة دخل هؤلاء مع الداخلين في
الإسلام..دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير الجاد ولكنهم لما أمعنوا النظر في حقيقة الإسلام وجدوا
أن هناك تضحيات لا بد من تقديمها لأجل الإسلام..تراجعوا وابتعدوا عنه شيئا فشيئا.ولكنهم لم
Page 174
يجرءوا على إنكار الإسلام جهارا خشية قومهم والقرآن الكريم يذكر ذلك فيقول لهم: لا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ (التوبة: ٦٦و٦٧).في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
١١
شرح
الكلمات :
6
مرض كل ما خرج بالإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق وشك وظلمة ونقصان وتقصير في أمر
(الأقرب).هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان: الأول مرض جسماني وهو
المذكور في قوله: ولا على المريض حرج ، والثاني عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق
وغيرها من الرذائل الخلقية.ويشبه النفاق والكفر وغيرها من الرذائل بالمرض..إما لكونها مانعة
إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية،
وإما لميل النفس إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة.ولكون هذه الأشياء
متصورة بصورة المرض قيل : دُووِيَ صدر فلان ونغل قلبه (المفردات).أليم: موجع (الأقرب).عذاب أليم: أي مؤلم (المفردات).عن
يكذبون: كذب أي أخبر عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به، ضد صدق، وسواء فيه العمد والخطأ
(الأقرب).التفسير: يراد بالمرض في هذه الآية النفاق.وقد ذكرت السورة أولا أصحاء الروح وهم المتقون، ثم
ذكرت المصابين بمرض الكفر، ويليهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض.ولقد وصف النبي ﷺ علامات
هذا المرض في المنافق فقال: "إذا حدَّث كَذَبَ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان، وإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذا
خاصم فجر" (البخاري، كتاب المظالم وكتاب الشهادات).هذه العلامات لوازم النفاق، لأن المنافق يريد أن يخفي نفاقه ويدفع عن نفسه هذه التهمة، فيلجأ إلى
الكذب والشجار والسباب لكي يشغل الناس عن عيبه.ولا يستطيع المنافق أن
يرضي الجانبين دائما،
Page 175
فيلجأ إلى إخلاف الوعد ونقض العهد.ولا يكون المنافق مقبولا عند من ينافقهم إلا إذا خان قومه
وأفشى أسرارهم.وهكذا نجد تلك الصفات الذميمة مرتبطة بمرض النفاق ارتباطا وثيقا.وفي قوله: فزادهم الله مرضا..نُسبت زيادة المرض إلى الله، لأنها نتيجة لمخالفة أحكام الله
وقوانينه..يترتب عليها نتائج حسنة أو سيئة..قدرها الله تعالى، لأنه واضع القوانين ومسبب النتائج.وإلا..فما أنزل الله القرآن للناس ليزيدهم مرضًا، بل أنزله شفاء لهم من الأمراض حيث يقول: يا
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاء لِمَا فِي الصُّدُورِ) (يونس: ٥٨).والمرض المذكور في الآية هو فقدان قوة الحسم والجبن والنفاق كما يقول: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ﴾ (التوبة: ۷۷).ولزيادة المرض عند المنافقين معنى ثانٍ، ذلك أنه كلما زاد المسلمون تقدمًا ،وقوة، اضطر المنافقون إلى
زيادة نفاقهم استرضاء للمسلمين مع أنهم أشد استياء وغيظًا، وهكذا يزداد مرضهم.وقد عبر القرآن
هذا المعنى بقوله : (إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ)) (عمران: ۱۲۱).﴿وَإِنْ
عن
ولهم
وكلما نزل القرآن الكريم بأحكامه وأوامره وتوطدت الشريعة الإسلامية، ازداد مرض المنافقين
واشتد نفاقهم واضطرابهم وَوَجَلُهم وجبنهم.وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَأَوْلَى لَهُمْ (محمد : ۲۱).تقرر هذه الآية ثمرة النفاق بقوله : ولهم عذاب أليم ، ولكن ثمرة الكفر في الآية السابقة هي
عذاب عظيم.والسبب الفارق بين العذابين أن الكفار مهما تعرضوا للعذاب إلا أنهم يناوئون الإسلام،
ويحاولون بذل جهدهم للقضاء عليه، وهكذا يُخفون عن صدورهم أما المنافقون فإنهم يكتمون
عداوتهم، ولا يستطيعون التنفيس عن غيظهم والإفصاح عن سريرتهم، فيتجرعون المرارة ويحترقون من
الألم، ولذلك وصف عذابهم بأنه عذاب أليم.وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (3)
شرح
الكلمات:
۱۲
لا تفسدوا فسد ضد صلح.الفساد ضد الصلاح، وهو خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان
الخروج منه أو كثيرًا (المفردات).
Page 176
الأرض: النفضة والرعدة (التاج)؛ الكوكب الذي نعيش عليه؛ قطعة منه؛ وتعني البلاد، يقال: أرض
الشام وأرض مصر.والأرض في هذه الآية تعني البلاد؛ وكل ما سفل فهو أرض (الأقرب).مصلحون صلح ضد فسد أصلحه أقامه بعد فساده.وأصلح بين القوم.وفق (الأقرب).التفسير : ظهر فساد المنافقين في تصرفاتهم التالية:
1 - إثارة الشقاق بين المهاجرين والأنصار..متخذين الحمية القومية ذريعة لتحقيق أغراضهم الهدامة.مثال ذلك ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول يوم غزوة بني المصطلق، إذ أثار ضجة، وزعم أن الأغراب
(يريد (المهاجرين يتسلطون على الأنصار بسبب تهاون هؤلاء في حقوقهم.فحرَّضهم عن التخلي عنهم
وعدم مساعدتهم بالنفقة وتطاول في كلامه على مقام الرسول ﷺ، وقد حكى القرآن هذه الواقعة
كشفا لحقيقة المنافقين وأهدافهم فقال: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ حَتَّى
يَنْفَضُّوا (المنافقون: ۸).٢ - الطعن في سيرة الرسول ﷺ تحريضا للخونة، وسعيا لزعزعة إيمان الناس في أعماله.ومثال ذلك
تعريض بعضهم بعدالة النبي في توزيع الصدقات.وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ
يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) (التوبة: ٥٨).وتعريض بعضهم بأن الرسول الاستماع لكل ما يقال، كما ذكر
القرآن في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنْ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ (التوبة: ٦١).٣- الشماتة في المسلمين إذا أصابهم أمر ومحاولة إضعاف روحهم المعنوية.وقد عبر القرآن عن ذلك ،
في قوله: ﴿وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ )) (التوبة: ٥٠).٤- إطلاق الشائعات وتردديها سعيا إلى تثبيط عزيمة المسلمين، وقد ذكر القرآن ذلك في قوله:
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ (النساء: ٨٤).ه - تحريض غير المسلمين على محاربة المسلمين.قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَتَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (الحشر : ١٢).وتشير الآية إلى ما يسوقه المنافقون تبريرا لمسلكهم المتلوّن بأنهم يريدون الإصلاح والخير.وهذا دفاع
باطل لستر نواياهم الخبيثة، ولكن الأحداث تكشف ما يُبطنون من بغض للإسلام والمسلمين.ووجود المنافقين ظاهرة تلازم الجماعات التي يحكمها نظام دقيق محكم.أما المجتمعات التي تفتقر إلى
النظام فإن النفاق لا يتأصل فيها.فالنظام المحكم يخشاه الجبناء ولا يجرؤون على مناهضته جهرا، ولذلك
يوالون الأعداء سرًّا، ويدسون على النظام دسائسهم في الخفاء.
Page 177
والجماعة الإسلامية الأحمدية هيئة منظمة، فلذلك عليهم أن يتوقعوا وجود المنافقين الذين يندسون بين
صفوفهم بتحريض من أعدائهم.وإنَّ تواجد المنافقين فيها لدليل على نظامها المحكم وليس علامة ضعف
فيها.ولقد عرفنا القرآن الكريم علامات المنافقين وكشف الستار عن أعمالهم، فَلْنَحْذَرهم جيدا ولا نغفل
عنهم، ونعاملهم بالمعاملة التي رسمها القرآن الكريم، فلا نغتر بدعاواهم الخلابة، لأنهم يتلصصون
كالشيطان، ويدعون بأنهم من الناصحين.أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ)
۱۳
التفسير: إن عدم شعور المنافقين بفسادهم دليل على ضعف شعورهم، لأن النفاق مصدره القلب،
ولا يفطن إليه إلا بالشعور.ولو أن المنافقين تفقدوا ما في قلوبهم لأدركوا أن أعمالهم لا تهدف أبدا إلى
الإصلاح المزعوم، بل إنها راجعة إلى الجبن وعداء الجماعة، ولو فعلوا ذلك لأدركوا حقيقة مرضهم،
ولكنهم لا يحاولون النظر فيما تختلج به صدورهم من الأفكار.فهم بذلك يخدعون أنفسهم فضلا عن
خداعهم من سواهم من الناس.وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ )
شرح
الكلمات:
السفهاء: سفه الرجل: اتصف بالسفاهة؛ جهل.سفهت الطعنة: أسرع منها الدم وخف.وسفه
نصيبه : نَسيَه.السَفَهُ: خفة الحِلْم أو نقيضه؛ أو الجهل، وأصله الخفة والحركة والاضطراب (الأقرب).السفه: الخفّة في البدن، ومنه قيل: زمام سفيه: كثير الاضطراب؛ وثوب سفيه: رديء النسج.واستعمل
في
حقة النفس ونقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية (المفردات).وسافهتُ الشراب: إذا أسرفت
فيه (اللسان).فالسفيه هو خفيف العقل؛ الجاهل؛ المتقلب الرأي؛ قليل الذكاء في الدين والدنيا، من لا
وزن لرأيه ؛ عديم التفكير عند الإنفاق.يعلمون: علم تيقن وعرف أتقن أحاط.والعِلم : إدراك الشيء على حقيقته (الأقرب).قلے
۹۵
Page 178
التفسير: ينظر المنافقون إلى المؤمنين على أنهم يتصفون بالسفاهة، ذلك لأنهم ينفقون أموالهم بسخاء
في سبيل الله ويضحون بحياتهم من أجل دعوة الإسلام، ويتعرضون لمخاطر القتال وعداوة الكفار، وهم
على قلة عددهم يتحدون الدنيا كلها.ولذلك إذ دُعي المنافقون إلى إخلاص النية وصدق الإيمان قالوا: لا
يمكن أن نكون حمقى مثل هؤلاء المؤمنين، وإنما علينا أن نحفظ أرواحنا وأموالنا وجهودنا.وقد أشار
القرآن إلى هذه الأمور في مواضع عديدة مثل:
لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (المنافقون:۸)،
إذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ (الأنفال: ٥٠)،
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ
مِنْهُمْ (التوبة: ٧٩)،
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ)) (المائدة: ٥٣).والحق أن الفتح والانتصار لا يستحقهما إلا الشجعان البواسل والفدائيون المناضلون.والمؤمنون هم
أشجع من في الأرض، لأن أنظارهم تشخص إلى السماء دون الأرض.إن الشعوب التي تتهرب من
التضحيات وتتقاعس عن الفداء..مصيرها الهلاك والدمار والذين يضنون بأموالهم عن الإنفاق في سبيل
الذين يبددونها باطلا، أما الذين ينفقونها في مواضعها..فأولئك هم الذين ينمونها ويضاعفونها
الله
هم
أضعافا كثيرا.وترد الآية على المنافقين بأن جبنهم وبخلهم هما السفاهة بعينها، إذ يراهنون على الحصان الخاسر.فالكفار لن ينتصروا بتاتا، وإذن فلن يجديهم نفاقهم شيئا، بل إنهم سيخسرون أموالهم وحياتهم في عين
الذل والحسرة.ومن
كانت هذه حياته ونهايته فقد سفه سفها مبينا.وقد عاش رئيس المنافقين حتى رأى
بعينه انتصار الإسلام وتبين له من الحكيم ومن السفيه يقول تعالى مُبيّنًا هذه الحقيقة: وَلا تُعْجِبُكَ
أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة: ٨٥).نعم، إن الحرص الشديد على المال والولد يجعل حياة المنافق عذابا وقلقا وحرمانا، ثم يعقب ذلك
الهلاك والخسران.
Page 179
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَنطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا
معَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ )
شرح
الكلمات :
:
خلوا خلا به وإليه ومعه سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل خلا بالشيء: انفرد به و لم يخلط به
غيره.وقيل إن إلى هاهنا بمعنى "مع" كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله.يقال: خلاك ذم:
ابتعد عنك (الأقرب).شياطين: جمع شيطان، وهو إما من "شطن" أو "شاط".شَطَنه: خالفه عن نيته ووجهه؛ أبعده.شطن
من
هذا
عنه: بعد.شطنت الدار بعدت شطن الرجل بعد عن الحق.الشطن : الحبل الطويل.فالشيطان
الباب هو النائي عن الحق والذي يسعى لإبعاد غيره عنه، ويفكر دائما في الشر كأنه احتكر مخالفة الخير
(الأقرب).وشاط الشيء: احترق.واستشاط غضبا : إذا احتدَّ في غضبه والْتَهَب.شاط فلان: هلك.فالشيطان من هذا الباب من يحترق حسدا وتعصبا ويهلك.وتطلق كلمة شيطان أيضًا على روح شريرة؛
العاتي المتمرد من إنس أو جن أو دابة الحية الصغيرة والشيطان هو الهالك، وفي الحديث: "الراكب
شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب"..فقد سُمي راكب وراكبان بالشيطان لأنهما أكثر عرضة
للهلاك على يد السارقين وقطاع الطرق (الأقرب).مستهزئون هزأ به ومنه سخر منه.استهزأ هزأ (الأقرب).هزئ الرجل مات.وأهزأه البرد: قتله.المستهزئ بالشيء المستخف به (اللسان).التفسير : المراد من الشياطين في هذه الآية رؤساء الكفار والمنافقين اللذين ابتعدوا عن الإسلام كبرا
وصلافة، ونفروا عن الحضور عند رسول الله ﷺ وكانوا لا يدعون أتباعهم ومن يلونهم من الناس
ليتجهوا نحو الصراط المستقيم، فجعلوهم كما حكى القرآن عن لسانهم : وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا )) (الأحزاب: ٦٨).فلا يصح أن يُراد هنا بالشيطان إبليس.كما أن كلمة شياطينهم ليست سبا لرؤساء اليهود والمسيحيين، لأن الشيطان كما بينا في معاني
الكلمة، هو المخالف عن الوجه والذي يعرض نفسه للأخطار.وثانيا قد خاطب النبي أصحابه بقوله:
ﷺ
"الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب وثالثا جاء في الإنجيل "فالتفت وأبصر تلاميذه،
فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله، لكن بما للناس" (مرقس:۸،۳۳)، "أيها
الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم (متی ۲۳ ۳۳)، "فلما رأى كثيرين من
Page 180
الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من
الآتي؟ " (متى ٣:٧)
الغضب
والعجيب أن بعض الكتاب المسيحيين ينتقدون وصف هؤلاء الناس بالشياطين وينسون ما جاء في
كتابهم المقدس على لسان المسيح الناصري ال.فكلمة شياطين وردت طبقا للأسلوب العربي المبين،
وهي
ليست من قبيل الشتائم أبدا، وهذا المعنى الذي أوردناه عن كلمة شيطان واستعمالها ثابت عن
الصحابة وكبار العلماء أيضًا: نقل ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا خلوا إلى شياطينهم من
اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب.ونقل ابن جرير أيضًا عن قتادة أن المراد بقوله إذا خلوا إلى
شياطينهم إخوانهم من المشركين.ونقل عن مجاهد أنهم أصحابهم من المنافقين والمشركين.ونقل عن
بن مسعود: أنهم رؤوسهم في الكفر (تفسير بن جرير).عبد
الله
اللهُ يَسْتَهْزِئُ بهمْ وَيَمُدُهُم فى تغييهِمْ يَعْمَهُونَ )
طُغْيَنِهِمْ
شرح الكلمات :
يمدهم: مده في غيّه: طوَّل له وأمهله (الأقرب).די
طغيان طغى جاوز القدر والحد طغى الرجل أسرف في المعاصي والظلم.طغى الكافر: غلا في
الكفر.طغى الماء: ارتفع وزاد إلى حد الفيضان (الأقرب).يعمهون : عَمَة : تحير في منازعة أو طريق؛ تردد في الضلال.العمه أن لا يعرف الحجة.ويطلق العمى
على فقدان البصر أو البصيرة أما العمه فيطلق على أعمى البصيرة الأقرب).فمعنى يعمهون أنهم
يتخبطون في ممارساتهم الظالمة، أو عقولهم لا تعمل.التفسير : بينا في شرح كلمات الآية العاشرة أن الأسلوب العربي يعبر عن عقاب الجريمة بنفس لفظ
الجريمة، فعقاب المخادعة الخداع، وعقاب الاستهزاء الهزء، فكأن المجرم وقع في نفس جريمته.وإذن لا
وجه للاعتراض على عبارة الله يستهزئ بهم ، لأن معناها أن الله يعاقبهم بجريمة استهزائهم.إن روح
القرآن الكريم تتعارض مع الاستهزاء والسخرية، وترجمة هذه الآية في بعض التراجم على أساس هذا
المفهوم الخاطئ جهل بالأسلوب العربي.كما أن الاستهزاء يعني الكذب أيضًا، وقول الله تعالى بريء من ذلك وقد قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
قيلاً) (النساء: ١٢٣).۹۸
Page 181
مستهزئون
وفضلا عن ذلك فإن الكلمة التي تسند إلى الله تعالى وإلى الإنسان تفقد مدلولها المختص بالإنسان إذا
أسندت الله عز وجل.فإذا قلنا إن الله يتكلم فلا يراد بذلك أبدا أن الله تعالى يتكلم كالإنسان بلسان
وشفتين وحنجرة..وإنما المراد ظهور ألفاظ مسموعة للإنسان بقدرة الله وقد وصف الله تعالى نفسه
بقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری: ۱۲).وعلى ضوء هذا التفسير يكون معنى قوله الله يستهزئ بهم أنه يعاقبهم باستهزائهم ويخزيهم بين
أيدي الناس، ويجعلهم أضحوكة لهم.ومما يجدر بالانتباه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: إنما نحن مصلحون ، بينما قالوا للكفار : إنما نحن
هذه شهادة فطرية من المنافقين على حال المؤمنين وحال الكفار.فكانوا يدركون أن
المؤمنين لن يقبلوا منهم عذرا بأنهم كانوا يستهزئون بالكفار، وإنما يستاءون من هذا القول.أما
الكفار..فكان المنافقون يعلمون أنهم لخلو قلوبهم من التقوى، لن يستاءوا من قولهم: إنما نحن
مستهزئون، بل سوف يفرحون بهذا الجواب الساخر لعداوتهم للمؤمنين.فقول المنافقين هذا ينهض
شهادة تلقائية مؤثرة على ما ناله المسلمون من مكارم الأخلاق، وعلى خلو الكفار من التقوى.وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم أنه يمهلهم، لا ليزدادوا في الضلال..وإنما لإتاحة الفرصة أمامهم
للتوبة والإصلاح، كما قال عز وجل: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ
فِي.طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الأنعام: ۱۱۱) وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ)) (فاطر:۳۸).عن
ففساد أعمالهم، وعدم تذكرهم بآيات الله، وإصرارهم على الإعراض عن النذير، وإهمالهم التدبر فيما
أنزل إليهم من ربهم..يحرمهم معالم الطريق الصحيح، ويستمرون في ضلالهم الذي يسوقهم إلى
التخبط في مزيد من الضلال.وهذا هو معنى يعمهون أي يترددون في الضلال ويضربون في الأرض
من دون علامة تهديهم.أَوْلَتَبِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَيحَت تِجَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ
۱۷
Page 182
شرح الكلمات:
اشتروا اشترى وشرى: مَلِكَ بالبيع.ومن ترك شيئا وتمسك بغيره فكأنه اشتراه.واشترى بمعنى باع
أيضًا الأقرب والمفردات).الضلالة الضلالة ضد الهدى ضل عنه: لم يهتد إليه وضل الرجل في الدين ضلالة ضد اهتدى
ضل فلان الفرس: ضاع عنه ضل الماء في اللبن خفي ضل فلان فلانا نَسِيَه.ضل الناسي: غاب عنه
الشيء.ضل سعيه : عمل عملا لم يعد عليه نفعه (الأقرب).حفظ
التفسير : اشتروا الضلالة بالهدى تتضمن معنيين: الأول، أنهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى في
مقابلها.فالإنسان مخلوق على الفطرة السليمة التي وهبها الله تعالى إياه وزوده بالقوى التي يمكنه بها أن
يميز بين الخير والشر، ولكن التربية السيئة والرفقة الشريرة والأعمال الذميمة تفسد هذه الفطرة وتفقدها
القدرة الموهوبة.وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فقال : فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ (الروم: ۳۱)،
لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ أَحْسَنِ تَقويم )) (التين: ٥).وقد ذكرها الرسول
ﷺ في قوله : "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
يمجسانه" (مسلم) كتاب القدر.فمن خسر هذه النعمة الإلهية بسوء عمله واستمسك بالضلالة فقد
دخل هذه التجارة الكاسدة: شراء الضلالة بالهدى.والمعنى الثاني أن المنافقين فضَّلوا الضلالة على الهدى، ذلك أن الله تعالى قد وهب الإنسان القدرة على
التمييز بين الخير والشر ثم خيره من ناحية، ومن ناحية أخرى أرسل الرسل وأنزل معهم
الكتاب
يعرض فيه الهداية على الناس..في الوقت الذي كان الشيطان وأتباعه يروّجون للتعاليم الضارة.وقد أساء
المنافقون الاختيار وتقبلوا الضلالة الشيطانية المهلكة ورفضوا الهداية النافعة، فبئس الاختيار !
ويظن المنافقون أن سلوك النفاق ربح لهم، إذ يتجنبون به غضب الفريقين، ويكسبون موالاتهم،
ويهربون من مسئولياتهم وواجباتهم، ولكن الآية تقول: فما ربحت تجارتهم، أي أن الأمر بعكس ما
يتوقعون، فهم الخاسرون.وليت الأمر يقف عند الخسران والهوان الدنيوي، ولكن العقاب الأخروي
لأن من افتقر إلى الهداية من شأنه أن يضل عن الهدف فهم يخسرون الدنيا، وما كانوا
مهتدين فيخسرون الآخرة أيضًا.ينتظرهم،
وتعلمنا الآية الكريمة حقيقية هامة هي أن أي عمل للإنسان له نتيجتان؛ إحداهما عاجلة، والثانية
آجلة.فمن يُقبض عليه وهو يسرق مثلا يلق العقاب والمذلة في هذه الحياة الدنيا، وهذه هي
النتيجة
Page 183
العاجلة لفعلته و بسبب انقياده وراء هذا العمل تضعف فيه القدرة على رؤية الحق والهدى وقبوله، وهذه
هي النتيجة الآجلة.ومن يفعل الخير يجد نتيجته العاجلة في رضاه عن نفسه وارتفاع شأنه بين الناس؛
ونتيجته الآجلة أنه يزداد معرفة بالخير، وقدرة على فعله واتباع سبيل الهدى.مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَنتِ لا يُبْصِرُونَ )
:
شرح الكلمات:
مَثَلُهم: المَثَل هو الشبيه والنظير؛ الصفة؛ الحجة، يقال: أقام له مثلا أي حجة؛ القول السائر بين الناس؛
الحديث؛ العبرة؛ الآية (الأقرب).المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة
ليبين أحدهما الآخر ويصوره (المفردات).استوقد استوقد النار : أشعلها (الأقرب).أضاءت أضاءت النار : استنارت أضاءها: أشعلها (المفردات).ظلمات
جمع
ظلمة، والظلام والظلمة ذهاب النور، وقيل عدم الضوء عما من شأنه أن يكون
مضيئا.ويكنى بالظلمة عن الضلالة، وبالنور عن الهدى (الأقرب).ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق.وجاءت كلمة ظلمات إشارةً إلى أنه فضلا عن الظلمة الظاهرية فإن المكان أيضا محفوف بالأخطار
الأخرى العديدة.ولقد وردت الكلمة في القرآن دائما بصيغة الجمع إيماء إلى أمر أخلاقي أو روحاني..لأن المعاصي وسوء الأخلاق لا تبقى على حالها، بل تتفاقم ويترتب عليها مزيد من المعاصي والمصائب.يبصرون أبصره رآه أخبره بما وقعت عينه عليه أبصر فلانًا: جعله يبصر.أبصر الطريق: استبان
ووضح (الأقرب).التفسير: تبين هذه الآية التطورات التي واجهها المنافقون إذ إنهم أوقدوا النار، ثم إذا انتشرت
أضواؤها أصابتهم الغشاوة، فحرموا الرؤية، ولم ينتفعوا بها.والمراد من إيقاد النار هنا وصول الدعوة
الإسلامية إلى المدينة، لأن الرسول تلقى الدعوة للذهاب إلى هناك من أهل المدينة، وكان المنافقون من
بين الجماعة الداعية.ولكن عندما انتشر نور الإسلام أصابهم البغض والحسد، واتجهوا إلى أعداء
المسلمين، وفي النهاية عموا وفقدوا بصارتهم وبصيرتهم.ومن الحقائق الروحية أن من يضل بعد الاهتداء
يهوي إلى درك سحيق، ويفقد ما ناله من قبل.
Page 184
إن التعبير عن التعاليم الدينية والآيات السماوية بلفظ النار وارد في القرآن الكريم، فعندما كان
العليا عائدا من مدين رأى تجليا سماويا بصورة النار حكاها القرآن في قوله: آنَسَ مِنْ جَانب
موسی
الطُّورِ نَاراً (القصص:۳۰).فلما اقترب إليها ناداه الله تعالى: يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(القصص: ۳۱).وكذلك شبه الكلام السماوي بالنار في قوله تعالى: يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نار (النور: ٣٦)..مشيرا إلى أن الذين لهم فاعلية روحية قوية تكاد تتوقد روحانيتهم من تلقاء نفسها
قبل أن تتلقى الوحي الإلهي الذي عبر عنه بالنار.کلام
الله
فالمنافقون لما وجهوا الدعوة مع أهل المدينة إلى الرسول الله الله جاءهم مُظهرا للتجلي الإلهي، فأضاء
جوانب النفوس، عندئذ ثار الحسد في قلوب المنافقين فحرموا أنفسهم من الخيرات.وتشبيه التجلي السماوي والكلام الإلهي بالنار ليس عجيبا، فقد عبر العرب عن المحبة بالنار.وإذا كان
الحب ينير في نفس المحب تلك المشاعر التي تتملك قلبه وتغلب غيرها من الأحاسيس، فإن التجليات
الإلهية والوحي الرباني تقضي على الأهواء الفاسدة وتمحق الميول والنوازع إلى المعاصي، وتطهر القلب من
كل سوء فلا يبقى به إلا حب الله تعالى وحب ما يحب..فتشبيهها بالنار تشبيه صادق ولطيف.كما أنها
قد شُبهت أيضا بالماء في بعض الآيات لما لها من تأثيرات أخرى مناسبة.وفي الأسلوب العربي يعبر عن الحرب أيضًا بالنار.تقول العرب: خمدت ناره أي انهزم في الحرب.وقد
ربط العرب النار بالحرب حتى إنه إذا حمدت نار فريق أثناء المعركة تشاءموا.وقد فر أبو سفيان بجيش
المشركين في موقعة الأحزاب بسبب انطفاء نيرانهم بفعل الرياح الشديدة.وقد أشار الله تعالى إلى هذا
المعنى في قوله: كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْب أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (المائدة : ٦٥).وعلى ضوء هذا المعنى يكون مفهوم الآية أن المنافقين قد دسوا الدسائس وكادوا المكائد، متعاونين مع
الكفار، وألهبوا نار الحرب ضد المسلمين على أمل أنهم سيبيدون الإسلام، ولكن النتائج جاءت على
عكس ما تمنوا، فتضاعفت قوة الإسلام وتأصلت عظمته في القلوب، وبدلا من أن ينتفع المنافقون
بمكائدهم ذهب الله بنورهم أي فقدوا نور بصيرتهم وتخبطوا حتى وقعوا في الحفرة التي حفروها
للإيقاع بالمسلمين.وقوله أذهب الله بنورهم يعنى أيضًا أن العباءة النورانية للإسلام التي لبسها هؤلاء المنافقون نزعها
منهم، بمعنى أن الكفار لم ينتصروا في هذه الحرب التي أشعلوها ولكن انكشف نفاقهم بسببها..ذلك
أنه بعدم اشتراكهم في الحروب ظهر بطلان ادعائهم بالإيمان، وبالتالي تبين للمسلمين خطأ حسن ظنهم
الله
بأنهم مسلمون.
Page 185
والمعنى الثالث هو أن ازدهار الإسلام كشف عن حقيقة المنافقين.ذلك أنه كلما اكتمل الدين وازداد
النور الإلهي، كثرت أحكام الشريعة، وهذا يثقل على المنافقين أكثر فاكثر..مما يفضحهم فيسلب عنهم
لباس النور.وقوله تركهم في ظلمات لا يبصرون يدل على أن المنافقين أوقدوا نار الحرب ليحققوا بها أهواءهم
ويسترجعوا بها عظمتهم، ولكن أمرهم انقلب ضدهم بانكشاف نفاقهم وتراكم الظلمات عليهم،
فاستفحل نفاقهم وزاد غيظهم وكيدهم وفقدوا الرؤية للخروج منها.وباعتبار أن النار هي نور الإسلام..يكون المعنى أنهم استدعوا الإسلام بأنفسهم ثم أعرضوا عنه،
الله من نور الفطرة السليمة، وكذلك من نور الوحي الإلهي وبر
فحرمهم
ووم
م بكُمُ عُمّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ )
)
شرح
الكلمات:
وبركاته.صم صم الرجل : انسدت أذنه وثقل سمعه أو ذهب، فهو أصم والرجل الأصم من لا يُطمع فيه ولا
يُرَدُّ عن هواه (الأقرب )..كأنه يُنادى فلا يسمع.بكم: البُكم: الخُرس مع عيّ وبَلَهِ.وقيل هو الخرس أيا ما كان.وقال ثعلب: البكم أن يولد الإنسان
لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر.وقال الأزهري: بين الأخرس والأبكم فرق في كلام العرب، فالأخرس
الذي خُلق ولا نطق له كالبهيمة العجماء، والأبكم الذي ينطق بلسانه وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن
وجه الكلام (اللسان).عُمي: جمع أعمى.عَمِي الرجل: ذهب بصره كله؛ ذهب بصر قلبه وجهل؛ غَوِيَ (الأقرب).التفسير: تقدم الآية وصفا ملائما لحال المنافقين، فهم صم لأنهم لم يسمعوا لكلام الوحي الإلهي،
فحرموا الفائدة من القرآن الحكيم.وهم بكم لأنهم أغلقوا أفواههم استكبارا وغرورا، ولم يستفهموا
الرسول عما اشتبه عليهم من أمر ، وإنما أخذتهم العزة الكاذبة، ورفضوا أن يكونوا في موقف المتعلم
الله
6
بعد أن كانوا قادة معلمين.وهم عُمي لأنهم لم يبصروا ما طرأ على إخوانهم المسلمين من تغيرات رائعة.لقد كانت أمام المنافقين فرص عديدة للسمع والكلام والنظر في بيوتهم أيضًا.ألم يلحظ شيخ المنافقين
أبي بن سلول ما أصبح عليه سلوك ابنه عبد الله "رضي الله عنه"؟ ألم ير كيف تحول ابن
كذاب جبان إلى رجل صادق بر طاهر شجاع باسل، وكيف صار ابن عابد الدنيا عبدا لله تعالى لا
يكف عن السجود لذي العرش العظيم؟ ألم ير المنافقون أبناء عشيرتهم وما يجري في بيوتهم وفي أعمالهم
عبد
بن أبي
Page 186
و
وفي سلوكهم من عفة وطهر وأمانة وصدق؟ ألم يروا
يروا بني الأوس والخزرج الذين تخلصوا من كل عيب
أخلاقي، وفاضت قلوبهم بمحبة الله تعالى..كيف كانت تسيل أعينهم لذكر الله، وتتغنى ألسنتهم
ألسنتهم بحمد
الله، وكيف كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ إذا لم يروا ذلك كله وهو أمام أعينهم..فمن الأعمى إذن؟
أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ تَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي وَاذَاهِم
ج
مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ )
شرح الكلمات:
۲۰
أو: حرف عطف يفيد معاني عديدة منها: التقسيم والتخيير، والإباحة، والجمع المطلق أي بمعنى "و"،
والشك والاستثناء، والإبهام، والتقريب، والشرط، والغاية ،والإضراب والتبعيض.وهو هنا بمعنى الجمع
المطلق والتقسيم (المغني).صيب الصيب السحاب ذو الصوب (الأقرب).الصيب السحاب المختص بالصوب، وهو نزول
المطر بقدر ما ينفع (المفردات).السماء: كل ما علاك فأظلك؛ سقف كل شيء؛ ظهر الفرس ؛ السحاب ؛ المطر الجيد؛ العُشب؛ رواق
البيت( الأقرب).رعد الرعد صوت السحاب رعد السحاب صات وضجّ للأمطار (الأقرب).فيكون معنى الرعد
هنا الأوامر الإلهية الجسيمة والوعيد بأنباء الهلاك والدمار والأمر بالحرب.برق البرق وميض السحاب (الأقرب).والمراد من البرق هنا المشاهد الحربية، أو النكات العلمية
الواضحة، والآيات الدالة على الصدق والغنائم والانتصارات الإسلامية.الصواعق جمع صاعقة وتعني الموت؛ كل عذاب يهلك صيحة العذاب نار تسقط من السماء في
رعد شديد لا تمر على شيء إلا أحرقته (الأقرب).والصاعقة : هي الصوت الشديد من الجو، ثم يكون
منه نار فقط، أو عذاب أو موت.وهي في ذاتها شيء واحد، وهذه الأشياء تأثيرات منها.حذر الحذر: التحرزُ ومجانبة الشيء خوفا منه (الأقرب).الموت زوال الحياة عمن اتصف بها (الأقرب)، زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسم.وأنواع
الموت بخلاف ذلك هي:
Page 187
الأول ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنباتات: يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا (الروم : ٢٠).والثاني زوال القوة الحاسة: يَا لَيْتَني مِتُ قَبْلَ هَذَا (مريم : ٢٤).الثالث زوال القوة العاقلة : أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) (الأنعام: ۱۲۳).الرابع: الحزن المكدر للحياة: يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ (إبراهيم: ١٨).والخامس: المنام (المفردات).وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية (اللسان).محيط: أحاط بالأمر: أحدقه (الأقرب).التفسير : بدءًا من هذه الآية يتحدث القرآن عن فئة ثانية من المنافقين هم أولئك الذين آمنوا ولكن
إيمانهم ضعيف يخشون الناس أشد من خشيتهم الله تعالى، ويجبنون عن مواجهة تهديد الأعداء،
ويتقاعسون عن بذل التضحيات، ويحاولون أن يبقوا على صلتهم ومودتهم مع الكفار، ويراسلونهم
ويمدونهم ببعض أخبار المسلمين وكان هؤلاء النفر يعللون أنفسهم بأن الإسلام دين
الله الحق، وأنه لن
يتضرر بهذا الذي يفعلون وأنه منتصر حتما، وإذن فلا ضير عليهم إذا صانوا أنفسهم من إيذاء الكفار
ومن بذل تضحيات لا داعي لها!
ولكن القرآن يعلن منذ البداية أنه دين التضحية والفداء، وأن هذا التخاذل نفاق كريه، ومن يلجأ إلى
هذا الأسلوب منافق ضال وما الإسلام إلا أن يسلم المرء كل ما يملك الله رب العالمين، ومن لا يوطن
نفسه على هذا الإخلاص والفدائية فلا يرجُون ما قدر للإسلام من خيرات وازدهار.يضرب القرآن مثل هذا الفريق من المنافقين بالسحاب الممطر، وما المطر إلا فضل الله تعالى المبشر
بالخير.ولكن المطر يصحبه ظواهر طبيعية تدل عليه فهناك ظلمات ورعد وبرق..ولكنها لا تحول دون
نزول الخير، ولا تمنع الفلاح العاقل من أن يسارع إلى الانتفاع بالمطر ، فيخرج ليعد القنوات والمصارف
والحواجز للاستفادة من الغيث.وما من عاقل يترك المطر يتسرب من أرض خشية الرعد أو البرق فيضيع
سدى.وكذلك فإن ظهور الإسلام هو كغيث سماوي، يلزم أن تصطحبه الظلمات والرعود والبروق.لكن
المؤمنين لهم خبرة بمثل هذه الظروف والأوضاع، فبدل أن يضطربوا لها..يعدون لها عدتها من
التضحيات، فينتفعون بها حق الانتفاع وأما المنافقون ضعفاء العمل فيأخذهم الفزع، فيلزمون بيوتهم،
ويحرمون أنفسهم من المنافع المقرونة بازدهار الإسلام وانتصاره ويستحقون غضب الله تعالى أيضًا.
Page 188
الله
ثم يقول
عز وجل: والله محيط بالكافرين، أي أن هؤلاء المنافقين..مم يخافون؟ أيخافون إيذاء
الكفار الذين قد قضى الله تعالى بهلاكهم؟ لماذا الخوف من المقضي عليهم بالهلاك؟ وهل ينجو الجبان من
الصواعق إذا وضع أصابعه في أذنه؟ إن الرعود التي يسمعها تقع بعد أن يتزل البرق.فالحذر إذن لا مبرر
له، وكان الأولى به أن يسعى للانتفاع بالمطر والاستعداد له.وكلمة أو في قوله تعالى أو كصيب لا تعني الشك كما يظن البعض، فالله تعالى هو العليم
الخبير، وهو أسمى وأجل عن التشكك والتردد إن هذا المثل لا يتعلق بفرد واحد، ولكن يتصل بجماعة
تتكون من عناصر مختلفة الأوضاع والأحوال، وفي مثل هذه الحالة لا تدل كلمة أو على الشك.إذا
قلت عن زيد إنه قائم أو قاعد، فقد شككت لأنه فرد واحد.أما إذا قلت عن جماعة إنهم قائمون أو
قاعدون فالمراد أن بعضهم قائم والبعض الآخر قاعد؛ وعندئذ لا تفيد الشك.فالآية تدل على أن المنافقين فئتان : فئة سبق ذكرها وهي التي ضيعت فرصة الهداية، وعطلت مواهبها
وملكاتها، وأثارت الحرب في وجه دعوة الإسلام، فوقعوا في الضلالة، وما هم بخارجين منها ما لم يعودوا
إلى حواسهم وفئة أخرى يأخذهم الخوف كل مأخذ كلما رأوا ظلمات الصعاب ورعد الحرب وبرق
المحن والقتال، ويسدون آذانهم عندما يرون صواعق المعارضة تنقض عليهم ناسين أن من السنن الكونية
أن تكون الظلمات والرعود والبروق مصاحبة لنعمة المطر الذي هو من نعم الله الكبرى، وأن هذه الأمور
سرعان ما تختفي ويبقى الغيث ونفعه العميم.إن الآية الكريمة تخبرنا بمجريات الأمور عندما تتنزل رسالة سماوية وتتجلى في آفاق الدنيا..فدائما ما
تصحبها السحب الداكنة والرعود القاصفة والبروق الخاطفة..كناية عن ظلمات المصائب والابتلاءات
وقطع الصلات بين المؤمنين والكافرين والهجرة والتضحية بالأموال والأنفس.ثم يأتي الرعد..أي
المجاهرة بالتحدي للدنيا كلها.ثم يظهر البرق..أي النوازل التي تخطف الأبصار.وقد تتحول البروق إلى
صواعق..أي يتابع الأعداء الهجمات لاجتثاث شأفة المؤمنين، ويضطر المؤمنون إلى رد الهجوم، ويصاب
فيها بعض المؤمنين أحيانا.ويخاف ضعاف القلوب من المنافقين جميع أنواع المشاكل، ولكنهم على وجه
خاص..تكاد تزهق نفوسهم من هذا الخطر الأخير.ولقد رد
الله
تعالى على أولئك الذين يزعمون أن بعثة الأنبياء مدعاة إلى ظهور الفساد والشتات،
فأخبرهم
بأن المطر نعمة سماوية له منافع عديدة وتصحبه بعض الظواهر الشديدة.كذلك عند بعثة
الأنبياء..تثور العواصف، ولكن هذه ليست علامة شؤم.بل إنها تحمل البشرى بالبركات المقبلة.إن من
سنة الله عند المطر أن يخفي السحابُ قرص الشمس، ولكن بعد حين..تشرق الشمس على الأرض،
Page 189
وهي
أحلى ما تكون منظرا، وأشد ما تكون بركة.وهكذا بعثة الرسل فإنه بعد الشدائد والصعاب..تشرق الشمس الإلهية عقب الغيث الروحاني بأروع ما يكون الإشراق.وقوله تعالى والله محيط بالكافرين يلفت نظر هؤلاء المنافقين إلى تلك الحقيقة، ويقول لهم: من أي
شيء تخافون؟ هل تخافون الكفار وأذاهم؟ ألا تؤمنون بأن الله قضى بهلاك أعدائه؟ فكيف تخافون من هو
هالك لا محالة؟
يَكَادُ البَرْقُ تَخطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مِّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
ج
قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ )
شرح
۲۱
الكلمات:
يخطف خطف الشيء : استلبه بسر
استلبه بسرعة.وخطف البرقُ البصر : ذهب به (الأقرب).شاء: أراد.الشيء كل ما يصح أن يُعلم أو يخبر عنه ويستعمل المصدر مكان اسم المفعول، فالشيء ما يراد أو
يُبتغى أو يُقصد (الأقرب).قدير: قدر على الشيء: قوي عليه القدرة: القوة على الشيء والتمكن منه (الأقرب).والقدرة إذا
وصف بها الإنسان فاسمٌ لهيئة له، بها يتمكن من فعل شيء ما، وإذا وصف الله تعالى بها فهي نفي العجز
عنه.ومحال أن يُوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنًى وان أطلق عليه لفظًا.والقدير هو الفاعل لما يشاء
على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه (المفردات).التفسير: تشير الآية إلى أن هذه الفئة من المنافقين قاربوا أن يفقدوا بصرهم من شدة خوفهم كلما
تعرضوا للمواقف التي تتطلب منهم شجاعة وتضحية.وإذا كانوا لم يفقدوا بصرهم كلية فمن المحتمل أن
يفقدوه إذا استمروا على خوفهم ورعبهم.وفقدان البصر هنا كناية عن فقدان الإيمان.إن للبرق تأثيرين مختلفين على هؤلاء المنافقين : إذا أضاء لهم مشوا فيه، أما إذا صاحبته الصواعق المدمرة
أعمى عيونهم ووقفوا مكانهم لا يتحركون والمراد أنهم إذا أحسوا بالطمأنينة تعاونوا مع المسلمين في
أعمالهم؛ أما إذا اشتد البلاء وانقضت صواعق الحرب قاموا فزعين وتخلوا عن طريق المسلمين.
Page 190
الله تعالى
وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم تحذير لهذا الصنف من المنافقين: أن احتفظوا
بشجاعتكم واسلكوا مسلك المؤمنين.لقد وفقتم حتى الآن إلى المحافظة على إيمانكم بسماع آيات القرآن
الحكيم، ولكن إذا استمر حالكم هذا من النفاق..فمن الممكن جدا أن يضيع هذا الإيمان، ولا يفيدكم
سماع القرآن شيئا.وهناك أيضًا خطر فقدان بصركم؛ أي أنه بتواتر نزول صواعق المحن والمصائب تخذلون
المسلمين وتتخلون عنهم.إنكم تنضمون إليهم كلما ترون ومضات النور، ولكن يُخشى عليكم فقدان
هذه الفرصة فتضيع منكم بصيرتكم الروحانية تماما.وهذه من الآيات التي يصعب تفسيرها، ولقد فسرها الآخرون بطريقة مجملة.وبتوفيق من
تمكنت من تفسيرها جزءا جزءا، ثم الربط بين عناصرها من ناحية وبينها وبين الآيات السابقة والتالية لها
من ناحية أخرى..فلا يبقى في فهمها أي غموض.يظن بعض الناس أن القرآن الكريم لا يقول بوجود النفاق بالأعمال ويرون أن النفاق المذكور في
قوله تعالى: (أو كصيب...الآية هو أيضا عن المنافقين في عقيدتهم.أذكر عندما كنت أدرس القرآن
الحافظ روشن" علي"، وكان من العلماء الإجلاء الموهوبين بملكة خاصة في استنباط معاني القرآن
الكريم، على يد أستاذنا حضرة مولانا نور الدين قبل توليه منصب الخلافة كان الحافظ روشن يناقشه
كثيرا حول موضوع النفاق، وكان يقول بأن نفاق الأعمال محال عقلا وأن المنافق هو من فسدت
مع
عقيدته."
وأرى هذه الآيات تبين أحوال المنافقين بالعمل.وقد وجدت حديثا يذكر المنافقين بالعمل، فعن أبي
سعيد قال قال رسول الله ﷺ: "القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط
على أغلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره.وأما
القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر.وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه
كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرعة يمدها القيح والدم..فأي المادتين غلبت
على الأخرى غلبت عليه" (مسند أحمد بن حنبل).فهذا الحديث يبين أن هناك منافقا يعتبر مسلما من حيث الإيمان، ولكنه ضعيف من ناحية العمل.فإن
غلبت حالته الإيمانية أصبح مؤمنا صادقا، وإن غلبت حالة النفاق عليه صار منافقا كاملا..أي يضيع
إيمانه.هذا الموضوع يشرح هذه الآية لأنه يبين أن سمع وبصر هؤلاء لم يزولا بعد، ولكن لو استمروا على
هذا الحال فهناك خطر كبير لضياعهما.
Page 191
ومن نعمة الله تعالى أن البرق لا تصحبه الصواعق دائما، ومعنى ذلك أن الشدائد التي لا بد من
من
أذاها
مواجهتها لا تكون في معظم الأحوال مهلكة والخير الناجم عن هذه الشدائد أكبر بكثير
ومشاقها.فالعاقل من انتفع بها فواجهها بشجاعة، وبذل في سبيل الله تعالى غير هياب ولا وَجل.إن الآية الكريمة تحذر المؤمنين أيما تحذير.إنها تخبرهم بأن الله تعالى عندما يرسل رسالة يجعل طريقها
الدين
محفوفة بالمشاكل والشدائد، وإن سبيل الدين لا يُفرش بالأزهار والورود، بل ينال الإنسان بغيته من
باجتياز الغابات الشائكة ومن أراد الإيمان ،ولذته فعليه أن يتحمل المشقات، ويعرف الآلام، ويقدم
التضحيات بكل ما يلزم لبلوغ هذه الغاية.والذي يتنصل عن التضحية ثم يزعم بأنه يريد الإيمان إنما
يتصرف تصرف الحمقى، لأنه يريد التقرب إلى الله بالنفاق..ومن المستحيل أن ينجح ويبلغ غايته.إن
الباحث عن الحق إذا أدرك ذلك حق الإدراك ففلاحه أكيد وإذا لم يدرك هذه الحقيقة صار نهبة للأوهام
والأماني الكاذبة، وباء بغضب من الله بدل من أن ينال فضله..والعياذ بالله!
وقوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير يدل على أن الخوف الذي يتسلط على قلوب ضعاف
الإيمان ناتج عن نقص إيمانهم وجهلهم بحقيقة صفاته جلّ وعلا.لماذا يخافون التضحيات يا ترى؟ إنما سببه
خوفهم من أذى الكفار.والحق أنهم لو أيقنوا بقدرة الله تعالى حق اليقين، ما وقعوا في مثل هذه
الشبهات.لو أيقنوا أن الله قادر على ما يريد، لما خافوا الكفار.ألا فليعلم المنافقون أن الله تعالى قدير
على كل ما يقضي به من الأمور، لا مانع ولا حائل دون إرادته.فإذا كان تعالى قد قضى بانتصار
الإسلام وازدهاره فكيف يحول الكفار - مهما كثر عددهم وعدتهم دون ما يريد؟ تذكروا صفات الله
وقووا إيمانكم حتى يزول عنكم الخوف والتردد إلى الأبد.إنه مما لا شك فيه أن جميع أنواع الضعف والمعاصي ناشئة عن الجهل بالصفات الإلهية ونقص الإيمان
بها.ويجب على الخائف من غير الله أن يستيقن بأن ضعف الإيمان بصفات الله تعالى هو الذي يسبب
الخوف، ولولا ذلك الضعف لما كان الخوف أيضًا.وبمناسبة قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير سأل بعضهم : هل تعني هذه العبارة أن الله تعالى
قدير على أن يكذب أو يموت؟ مثل هذا التساؤل لا يصدر إلا عن قلة تدبر وضآلة فكر.فوصف القدير
صيغة مبالغة من قدر وتعني ذو القدرة الكاملة.وليس الكذب والموت من الكمال في شيء بل هما
من النقائص، وذو القدرة الكاملة متره عن النقص، ومن ثم فإن صفة القدرة لا تتعلق بهذه النقائص.وإنه
لمن السخف أن يقول قائل: إن فلانا عظيم الشجاعة حتى أنه ليفر من الفأر! إن الشجاعة والفرار لا
يجتمعان كذلك كمال القدرة والنقائص لا يتفقان.
Page 192
كما أن قوله كل شيء يعني كل ما يريد، لأن شيء مصدر بمعنى المشيئة والإرادة، فمعنى
العبارة أن الله تعالى قدير على كل ما يريده.وإرادة الله تعالى كاملة، والكذب والموت وما إلى ذلك بعيد
الكمال، والله جل وعلا لا يعلق إرادته ومشيئته ومقدرته على النقائص التي لا تليق بجلاله.عن
0 = 0
يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
شرح الكلمات:
اعبدوا العبادة غاية التذلل (المفردات).ربكم راجع شرح الكلمة في سورة الفاتحة.خلقكم خلق الأديم: قدَّره قبل أن يقطعه.خلق الشيء: أوجده وأبدعه على غير مثال سبق
(الأقرب).لعلكم ولعل حرف مشبه بالفعل يفيد التوقع والإشفاق، ويختص بالممكن المشكوك في حدوثه؛
وكذلك يفيد التعليل.وجاء في القرآن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، أي كي يتذكر أو
يخشى.فلعلّ في هذه الآية تعني: كي وحتى.التفسير: استهل القرآن بإعلان أن خير الدواء ما يصفه العليم الخبير..ألا وهو الله تبارك وتعالى، وأن
القرآن هو الدواء الناجع لتنشئة العالم من الناحية الروحانية؛ فإنه أولا: كتاب جامع للكلمات كلها؛
ثانيا: أنه مبرأ من كل ريب وعيب؛ ثالثا: يفتح باب الرقي بلا حدود، ويتدرج بالمتقي أعلى فأعلى
كفاءته.ثم بين الشروط التي لا بد منها للانتفاع الكامل بهذا المنهج الرباني.ثم انتقلت الآية إلى
بيان موقف الطائفة المنكرة للقرآن ثم ذكر طائفة ثانية تدعي الإيمان بلسانها ولكن القلوب من الإيمان
هواء، وطائفة ثالثة قلوبهم مؤمنة ولكنهم لا يجرؤون على العمل بما آمنوا به.وبين القرآن أن هذين
النوعين لا يستطيعون الاستفادة من القرآن لأنه منهج عملي..ما جاء لينتسب الناس إليه بالقول، بل
ليحدث تطورًا حاسما في حياة البشرية جمعاء، وليس للأدعياء نصيب في خيراته وإنما هي للعاملين به.ثم في هذه الآية يوجه القرآن الأنظار إلى الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقوى في الإنسان والتي بها يبلغ
المراتب العليا، ويهنأ بخيرات المنهج الإلهي من سعادة الدنيا والآخرة..ويقول: إن هذه الوسيلة
الله تعالى.هي
عبادة
Page 193
والعبادة تعني التذلل الكامل والاتباع الشامل، أي أن يجعل الإنسان نفسه خاضعة للتأثيرات الإلهية التي
تسري فيها بيسر وثبات إن الاكتفاء بالمظاهر التعبدية غير كاف إذا لم تكن النفس صافية صادقة في
تذللها واتباعها.ومن طبيعة النفس البشرية أن تنفعل للإحسان، وتكون أكمل انفعالا إذا شمله الإحسان هو وآباءه من
قبله.والآية تُذكر الإنسان بأن الله تعالى صاحب الفضل والإحسان إليه وإلى آبائه وأجداده..ذلك كي
تثير فيه أكمل شعور بالمحبة..فتقوم عليه العبادة الكاملة.فقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم يبين أن
المستحق للعبادة الحقة هو الخالق الذي أوجد الإنسان وآباءه، وهو الرب الذي ربى الإنسان وآباءه من
فضله وإحسانه.وإذا كان المرء يخلص المحبة لمن أسدى إليه جميلا، أو صنع لأبيه معروفا..فالله تعالى ينعم
عليه كل لحظة، وأنعم على آبائه السابقين نعما لا حصر لها، فهو سبحانه الجدير بالمحبة الكاملة
والإخلاص التام.وفي قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم حث الله على العبادة بأسلوب رائع جدا، يبين به حاجة
الإنسان إلى عبادة الله تعالى، فيقول: إن الصانع يعرف صنعته، فالمهندس الذي شيد بناء يعرف مقدار
الثقل الذي سوف يتحمله البناء، وكذلك الله تعالى..خالق الإنسان وآبائه، والعليم بما أودع الإنسان من
القوى والمواهب والكفاءات..هو وحده القادر على إصلاح الإنسان أما أن يسلم المرء عنانه لأي
معبود آخر..يجهل صلاحياته ولا يقف على حدود استطاعته فلا بد وأن يدفعه إلى هوة الهلاك.فالعبادة الحقة ليست مجرد تقاليد جوفاء.بل هي التمسك بالمنهج الروحاني..وهي
الله عز وعلا..لأنه
العليم بقوى الإنسان المكنونة، الخبير بأساليب إنمائها والبلوغ بها إلى غاية الكمال.ثم أتبعه تحديد غاية العبادة وأخبر بأن الهدف المنشود للعبادة ليس مجرد إقرار العبودية لله تعالى، ولو
كان كذلك، لكانت عبادة غير الله، رغم كونها ظلما لا ضرر فيها.ولكن العبادة لا تؤدي إلا لتكميل
الروحانية والتقوى، وهذا الكمال لا يمكن أن يتحقق بيد مخلوقات لم تخلق الإنسان ولا تعلم ما أودع فيه
من قوى خفية، وما هي خصائصها وحدودها..ومن ثم فإنها ستحطم هذه القوى الرائعة بدلا من أن
تبلغها الكمال.ولقد رأينا أن الإنسان إذا أسلم قياده لغير الله تعرض للخسارة الفادحة..فمن قائدٍ يفتح له أبواب
الحرية الحمقاء على مصارعها لينفلت بعيدا عن التقوى وطريق الكمال، وقائد آخر يصرف النظر عن
قوى الإنسان فيحمله من الأعباء الثقال ما ينوء به كاهله وتتعطل به قواه ومواهبه؛ ومنهم من يوجهه إلى
طريق الرهبانية وترك طيبات الدنيا؛ وآخر لم يميز بين النافع والضار، وسمى الشريعة لعنة، ومن ثم ألقاه في
هوة الدمار.فالله تعالى هو الذي أعطاه تعليما لا ينسى به ،مسئولياته كما لم يضعه تحت أعباء تدمر قواه
Page 194
الفطرية.وإلى هذه الأخطار يشير قوله تعالى : لعلكم تتقون.فالله تعالى الرب الخالق يدل المرء على
العبادة التي تتيح له التقدم المستمر في ضوء الفطرة الصحيحة..لأنه تعالى هو العليم بكل دقائق هذه
الفطرة..فهي من صنعه وحده.المتاهات
وبقوله لعلكم تتقون يشير الله إلى أن الأمر بالعبادة لا يهدف إلى منفعة أو مصلحة خاصة لله
سبحانه، بل إنما أريد به خير الإنسان نفسه.فالغاية المنشودة هي تكميل الإنسان بتحقيق المقتضيات
الفطرية كاملة غير منقوصة.فالتقوى المقصودة من قوله تتقون هي أن يتخذوا الله تعالى وقاية وجُنّة
تحميهم من أسباب الهلاك ،والدمار ويكون عز وجل مولى لهم..يرعاهم وينجيهم من
والهواجس ويهديهم في طرق الحياة المتشابكة.وفي قوله تعالى اعبدوا ربكم حكمة لطيفة جديرة بالالتفات فالرب كما عرفنا هو الخالق المربي
الذي يتدرج بمخلوقاته إلى كمال النشوء والرقي.وفي هذا النداء العام قد خُصت هذه الصفة بالذكر
للفت الانتباه إلى حقيقة هامة..وهي أن الاكتفاء بمجرد العمل وتطبيق أوامر الشريعة لا يجدي كثيرا ما
لم تدعمه العلاقة بين الإنسان وربه..علاقة المحبة والإخلاص له عز وجل فكل فرد من الناس قد زوده
الله عند خلقه بالقوى الأساسية التي لا بد منها للارتقاء إلى الكمال، ولكنهم مختلفون في مدى انتفاعهم
هذه القوى وأوامر الشريعة.وعلاقة المحبة مع الله تجتذب رضاه ومحبته فيهَب للإنسان هداية خاصة
تلائم ذاته وتناسب حالته ليمضي في طريق الرقي قدما والأمر بعبادة الرب حض على إخلاص المحبة الله
لينال الإنسان من نعمة ربوبيته تلك الهداية التي يهبها لأحبائه المخلصين.من
ومن معاني قوله تعالى لعلكم تتقون أن الذين يقومون بعبادة الرب بيقين وإخلاص ينجون من
التعادي والتظالم، ويسود بينهم الأمن والأمان.لقد شهد التاريخ بصدق هذه الحقيقة، فإن صحابة
الرسول ﷺ – بعد أن دخلوا في عباد الله المخلصين- كانوا دعاة سلام وحماة أمن وحَمَلة عدل، واستراح
الناس في ظل حكومتهم متمتعين بالأمن والعدالة واضطر الأعداء إلى الاعتراف بإحسانهم قبل الأصدقاء.والحق أن الأمن لا يستتب في هذا العالم إلا إذا أصبح الناس عباد الله المخلصين.ولو اصطبغ أهل الغرب
بصبغة عباد الله لما طغت عليهم الأهواء الاستعمارية.إن هذه الآية هامة جدا، لأنها تقدم أول أوامر القرآن الحكيم.لقد سبقها ذكر صفات المتقين بأنهم
كذا وكذا دون أن يأمر الله تعالى بذلك، والآن جاء الأمر الإلهي الأول فكان بالتوحيد، وذلك بأسلوب
لطيف كامل منقطع النظير..فمثلا: المأمور بالعبادة هو الناس..أي جميع أهل الأرض..وليس العرب
فقط، بما يدل على أن الإسلام كان منذ أول أمره ولا يزال ينادي بجمع العالم كله على كلمة التوحيد،
أن يخرج أمم الأرض كلها من العبادات القومية المتفرقة إلى حلقة جامعة لكل الأمم.ثم ذكر
ويريد
Page 195
المعبود عز وجل بأنه الرب..دون تعيينه بلفظ الجلالة "الله"، وبذلك أبطل وجود آلهة أخرى من
آلهة
من
الأحجار والأنهار والجبال والكواكب لأنه قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم.ثم نفى وجود
بين الآباء والأجداد بقوله: والذين من قبلكم.إن علامات العبادة في مختلف الأمم، كما أقرّ علماء المقارنة بين الأديان، تنشأ عن طريقين اثنين،
وهما: الحب أو الخوف.وهذه الآية تتضمنهما معًا؛ فقوله الذي خلقكم يشير إلى الحب، بينما قوله
لعلكم تتقون يحتوي على معاني الخوف.ثم إن الحب ينبع من عينين اثنتين: هما الحسن والإحسان.وهذه الآية على إيجازها..تقدم هذين الأساسين لإنشاء علاقة الحب
مع عز وجل.إنه تعالى ذو
حُسن أخاذ، لأنه ربِّ، وما أبرعه من صانع يخلق شيئا في هيئة بدائية منحطة، ثم يتدرج بارتقائه إلى
الكمال.ثم تعرض الآية الإحسان عرضا رائعًا، إذ تصرح عز وعلا هو المحسن إليكم وإلى
منتهى
آبائكم أيضًا، لأنه خالقهم جميعًا.بأن الله
الله
فبقوله تعالى العلكم تتقون أشار إلى الخوف من سخطه، كما نبه أيضا إلى إحسانه إليهم في
المستقبل.فما أبلغها وما أشدَّها إعجازا من آية حوت هذه المعاني الواسعة كلها في بضع كلمات! فتبارك
الله أحسن الخالقين!
ومن الغريب جدا حسبما جاء في العهد الجديد أن المسيح الناصري عليه السلام حينما سئل عن أعظم
وصايا في الشريعة، أجاب: "تُحبّ الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي
الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها؛ تُحب قريبك كنفسك" (متى ٣٧:٢٢ إلى ٣٩).مع
أن الوصية الأولى والعظمى التي كانت تجدر بالذكر هي التمسك بالتوحيد.والعهد القديم آخر
هذا الأمر الأهم، وكذلك سائر الكتب.أليس ذلك من فضل القرآن على سائر الكتب السماوية، أنه قدم الأمر الأول الأحق بالتقديم، بقوله
عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ، بينما سائر الكتب السماوية
أخرته إلى غير موضعه؟
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
۲۳
0 0
Page 196
شرح
الكلمات
فراشا: فرش الشيء بسطه ومده.الفرش: ما يفرش على الأرض للنوم أو الجلوس عليه (الأقرب).الفرش: بسط الثياب، ويقال للمفروش: فَرْش وفراش.وقوله: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا
ذلّلها بحيث يمكن الاستقرار عليها.والفراش ما يُفرش من الأنعام أي يُركب (الأقرب).بناء: جمعه أبنية بني عكس هدم بنى المنزل شيّده بنى الأرض: عمر فيها دارا (الأقرب).والبناء: اسم لما يُبنى؛ سطح البيت، السقف (المفردات).أي
السماء: السحاب.الثمرات: جمع ثمرة وهي حمل الشجر (الأقرب).الثمر: اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر
(المفردات).رزقا (راجع الشرح السابق في الآية رقم ٤).أندادا: الند هو المثل والنظير (الأقرب).وندُّ الشيء: مشاركه في الجوهر، ومثله: مشاركه في أي
شيء كان نِدُّ الشيء: ما يسدُّ مسدَّه.قال ابن الأثير : هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي
في
يخالفه (التاج).التفسير : أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خالق الكون المحيط بالإنسان من سماء وأرض.وبهذا يذكر
الإنسان بأثر البيئة الخارجية على عمل الإنسان وحياته.فكل أعمال الإنسان تدور حول الزراعة
والصناعة والتجارة والضرب في الأرض والسياحة فيها وهذه جميعها ترتبط بأجواء السماوات وأنحاء
الأرض، وتتأثر بتأثيراتها.ولا يمكن لأحد أن يوجه أعمال الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا من خلق
السماوات والأرض، والذي جعل فيها ما فيها من قوى فعالة في حياة الإنسان.نعم، إن الهداية الكاملة
هذا المجال في يد الخالق وحده.السماوات بأجرامها وأفلاكها وأجوائها..لها دخل كبير بما يجري على الأرض من رياح وأمطار
وفيضانات وعواصف، وهذه تؤثر تأثيرا مباشرا في الزراعة والنقل والاتصال وترتبط بها سلامة الإنسان
وأمنه وصحته ومرضه، ولها علاقة وثيقة بما يصيب الحياة الأرضية من حوادث وكوارث وأمراض.والرب الخالق المسيطر على هذه العوامل كلها..هو وحده القادر على أن يهدي الإنسان في خضم هذه
المؤثرات الجبارة..التي لا يملك زمام أمورها وأسرار عملها إلا الله تعالى؛ فهو القادر على أن يُسخّر كل
هذه الموجودات لخير الإنسان وليس أحد غيره يملك القدرة والعلم والسلطان..وعلى هذا فهو الجدير
بالعبادة الخالصة وحده.١١٤
Page 197
إن هذا الكون يضم عددا لا حصر له من خلق الله، وكلها تؤثر في حياة الإنسان تأثيرات متنوعة
مستمرة، وعلم الإنسان لا يحيط بكل هذه الموجودات، ولا يمكن للإنسان أن يدرك كل هذه الوسائل
الظاهرة ،والخفية ولا أن يعرف أثرها ضررا أو نفعا ومن ثم فالواجب عليه أن يلجأ إلى الرب الخالق
المسيطر على كل هذه الأكوان، يستمد منه الهدى، ويطلب منه التوفيق، ويسأله المعونة، ويدعوه ليصونه
من مضراتها الخفية أو الظاهرة، وينفعه بخيراتها المعروفة أو المجهولة.أفلا تنظرون إلى أنبياء الله تعالى، لم يدّخر أعداؤهم حيلة ولا وُسعًا لاستئصال شأفتهم، ولكن الله
ربهم المقتدر أحبط مكائد الأعداء وبددها.لقد دبر أعداء المصطفى الله مؤامرات عديدة للقضاء عليه،
وتعرض لهجماتهم العدوانية، فتارة حاولوا قتله بالسُّم الفتاك، ولكن الله عز وجل نجاه من هذه الدسيسة
الشيطانية، وهلك أحد صحابته الكرام في هذه المكيدة وتارة أخرى ترصدوا له ليفتكوا به في داره
وخلوته، لكن جهودهم باءت بالفشل الذريع وحدث أن احتال اليهود ليلقوا عليه صخرة، ولكن العليم
الخبير أنبأه بالوحي، فنجا من المؤامرة.ولنذكر كيف ألقى الله تعالى الغشاوة على أعين الكفار عند مغارة
ثور وهم يطلبون الرسول الله ليقتلوه.ولننظر إلى المسيح الناصري اللي كيف حاول أعداؤه قتله على الصليب، بل قتلوه حسب زعمهم،
وكيف أرسل الله تعالى ريحا عاصفة اضطرتهم ليتزلوه من الصليب قبل أن يهلك، وهكذا نجاه من ميتة
خزي وعار أرادها له اليهود.ولقد ظهرت في أيامنا هذه عشرات الخوارق على يد المهدي والمسيح الموعود الع..فعلى سبيل
المثال أخبره الله تعالى أن داره ستظل آمنة مصونة من الطاعون الجارف الذي اكتسح قاديان "بالهند" وما
حولها لسنين طويلة، وبشره بقوله : "إني أحافظ كلّ من في الدار..فلم تُصب داره بأي مكروه.وأيضًا
كان أيام شبابه مُقيما في أحد البيوت بمدينة سيالكوت، وكان معه ذات ليلة بعض الضيوف، ومنهم
رجل هندوسي اسمه "بيم سين"، وحدث أن سمع حضرته صوتا غريبا في سقف الغرفة التي كان ينام فيها
ومعه الضيوف، فأيقظ من
وأخبره أن الله تعالى أطلعه على أن السقف سيتداعى وينهار، ولذلك
عليهم جميعا أن يخرجوا من الغرفة على الفور.ولكن الضيوف لم يصدقوا قوله عن انهيار السقف
وسخروا منه ورفضوا مغادرة الغرفة قائلين إن ما أحس به وَهم.ولكنه ألح عليهم بالخروج وقال لهم:
يجب أن تخرجوا أنتم أولا، وسأكون آخر من يخرج..لأن السقف سيبقى قائما ما دمت تحته.فخرجوا
جميعًا ثم خرج حضرته، وما كاد يخرج حتى انهار السقف.معه
١١٥
Page 198
المحبة
كل هذه الأمور التي لم تزل تظهر منذ بدء الخلق ولن تزال تظهر، تدل على أن لهذا الكون خالقا،
وتبين رعاية الله تعالى وتسخيره قوى الكون لصالح عباده، وتكشف عن ضرورة إقامة علاقة من
والعبودية مع الله تعالى، لكي ينتفع الإنسان انتفاعا كاملا من هذه المخلوقات وينجو من أخطارها.وليكن معلوما أن المراد بالسماء هو العلو، أي كل الفضاء الذي يحيط بالأرض وتوجد فيه النجوم
والكواكب، وليس كما يتوهم عامة الناس من أن السماء دائرة ملموسة.ويعني قوله والسماء بناء أن
هذه السماء حماية ومنجاة، لأن البناء هو السقف، والسقف سبب من أسباب الحفظ.ومعنى ذلك أن ما
في ذلك العلو من طبقات هوائية وسحب ممطرة وأجرام سماوية كالشمس والقمر..كلها تدخل في
مقومات حياة الإنسان على الأرض.وأنتم تعلمون
يعني
أن حقائق الكون كلها تشير إلى الوحدة في نظام العالم، وأن كل العقلاء
يعلمون هذه الحقيقة، ويعترفون بأن الكون يسير وفقا لقانون واحد يربط بين كل مكوناته.ومن ثم فمن
الواجب على الجميع أن يتمسكوا بالتوحيد القائم على العلم اليقيني ولا يشركوا بالله وهم يعلمون.وتتضمن جملة وأنتم تعلمون بيان أن الجريمة لا تعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت على علم تام.وهذه
إحدى فضائل الإسلام العظيمة، لأنه لا يدين عاملا على عمله لمجرد صدور الفعل منه، بل إنه يراعي في
حكمه الظروف والأوضاع التي تم فيها العمل، ويتحرّى مدى علم الفاعل وإدراكه للخطأ الذي ارتكبه.والإشارة هنا إلى الأرض والسماء توجه الأنظار إلى أن حياة الإنسان تتوقف على وجود السماء
والأرض، وبذلك يشير إلى أهمية النظام الروحاني ودوره الأساس في حياة الإنسان.إن هذه الحياة المادية
لا تقوم ولا تكتمل إلا بما تعطيه الأرض وما تنزله السماء، وكذلك الحياة الروحية..فإنها لا يكفي لها
نور العقل ودليل الفطرة وحدها، وإنما يلزم لها مع هذا هداية السماء في كل حين.فإذا كانت الحياة
الأرضية تكتمل بما يأتيها من السماء، فإن الفكر الإنساني كذلك بحاجة إلى التعاليم والهداية الإلهية من
السماء، ويتوقفان جميعا على تكميل العالم الروحاني للإنسان، ولولاهما لكان هذا العالم ناقصا باطلا.فكما أن الأرض فراش للإنسان والسماء سقف له، كذلك الحال في العالم الروحاني.لا شك أن الإنسان
مزود بالعقل، ولكن مَثَل العقل كمثل العين التي لا ترى إلا بنور الشمس؛ فما لم يتلق العقل النور من
الشمس الروحانية، أي الوحي السماوي، لا يمكن أن يعمل بصورة صحيحة كاملة.ولا شك أيضا أن
الحاجات الفطرية طاهرة جدًّا، ولكن الأهواء الدنيوية تدنسها ولا يمكن أن تتطهر إلا بماء السماء..ألا
وهو الوحي.كذلك لا يمكن أن يحيا الإنسان حياة ناجحة إلا بعلاقة مع الله تعالى.ألا ما أجهل أولئك الذين زعموا رغم كل هذه الأيادي الإلهية والنعم الربانية أن الله لم يخلق الإنسان،
بل إن الإنسان هو الذي خلق الله ! وما أعماهم يريدون القول بأن الله تعالى ليس موجودا في الحقيقة،
Page 199
وإنما اختلقه الإنسان بخياله وللأسف الشديد أن أولئك الضالين يُدْعَوْن فلاسفة وعلماء، والحق
أهم
أجهل من على وجه البسيطة.وفي قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم مزيد من الشرح لما سبق، وبين أن الأرض فيها
قوة الإنماء بلا شك، ولكن هل تستطيع هي أن تعطي ثمارا بدون ماء السماء؟ فكيف يمكن لعقولكم
مهما كانت من الخصب والنمو، أن تعطي ثمرة طيبة بدون معونة الله؟ إن ماء الأرض يفسد إذا انقطع
عنه ماء السماء، فلا تستطيع أن تعطي ثمارا طيبة..كذلك إذا لم تتلق العقول البشرية مددا من وحي
السماء، وذلك عن طريق العبادة، فلا تستطيع أن تأتي بأفكار روحانية طاهرة.فلا تدعوا أن عقولكم
قادرة على أن تقرر لكم مناهج الحياة..فنحن القادرون على فعل ذلك.وفي الآية أيضًا إشارة إلى أن الله تعالى قد ربّاكم ورفعكم من حالة أدنى إلى حالة أعلى، وتردون على
هذا الصنيع بمحاولة إسقاطه تعالى من مكانته الأسمى، فتدعون له أندادا من مخلوقات حقيرة..كأنكم
بذلك تحقرونه جل وعلا! لقد جعلناكم مخلوقا لا ند له في الشرف بين المخلوقات، وسخرنا لخدمتكم
الأرض والسماء، وأنتم تجعلون لنا شركاء..ونحن في الحقيقة لا شريك لنا؟!
أما كيف كان موقف رسول الإسلام من توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الأنداد..فأضرب لكم
مثالا واحدا؛ فقد قال له أحد الصحابة ذات مرة في أمر ما ما شاء الله وشئت.فقال له أجعلتني لله
ندا؟ قل: ما شاء الله وحده (ابن كثير).الله
والآن أتناول البحث عن تساؤل أثاره بعض العلماء الغربيين، في ضوء الآيتين الأخيرتين، ومن أبرزهم
الفيلسوفان المعروفان: هربرت سبنسر وفريزر وأشاعه بعدهما الدكتور روبرتصن وسمث ولورنس جوم
وجرانت أيلن وغيرهم.وهؤلاء الفلاسفة فريقان فريق يزعم بأن عقيدة وجود تطورت عن الاعتقاد
بالجن والجنيات.ويزعم الفريق الثاني أن الإنسان الأول خاف السباع والزواحف والحيوانات المؤذية
فعبدها، ثم تطور الأمر بالتدريج إلى نشأة الاعتقاد بوجود الله.ويتفق الفريقان في القول بأن عقيدة وجود
الله بدأت أولا بالتعدد أي الإيمان بوجود آلهة كثيرة، ثم حل الاعتقاد بوحدانية الله محله شيئا فشيئا.وقد
بنوا مزاعمهم هذه على تاريخ الإنسان البدائي الذي يدل في رأيهم على الاعتقاد
بوجود آلهة متعددة،
ولذلك قالوا بأن الشرك سبق الوحدانية ،وجودا، وأن التوحيد ليس في الحقيقة سوى صورة متطورة عن
الشرك.وقال بعض هؤلاء خوفا من رجال الدين بأن نظرياتهم هذه لا تمثل طعنا في الدين، بل من الممكن أن
الإله العاقل قد تدرج في إظهار نفسه كما تدرج في كشف القوانين الكونية للناس.وأغلب الظن أنهم لم
Page 200
يقولوا هذا بعد تفكير وترو.بل أرى أنهم ما قالوه إلا عداء للدين أو أنهم لم يَرَوْا حاجة للتدبر في
ذلك..ولجئوا إلى مثل هذا القول تخفيفا من حدة غضب رجال الدين.فيها..هي
لا تقوم هذه النظريات على دليل مقنع أو على تفكير صائب، بل إن الحقيقة الناصعة التي لا شك
أن الأديان الهامة تؤكد على أنها نشأت بالوحي السماوي وهكذا تنهار الفلسفة القائلة بأن
الله أظهر نفسه شيئا فشيئا.إنه لَمِمّا يخالف العقل السليم أن يكون الله قد وجه الناس أولا إلى عبادة
الأرواح الميتة، أو دَلّهم على اتخاذ الأفاعي والضواري والأحجار والأنهار أربابا من دونه..ثم بعد ذلك
كله أظهر نفسه.مع أنه لو بدأ بوحدانيته لما كان ذلك مستبعدا عند العقل.ثم إن ديانات العالم كلها
تعلن بوجود الوحي منذ بداية الخلق، ولو صدق الفلاسفة في زعمهم بتأخر الوحي الإلهي لكانت كتب
الديانات السماوية باطلة مفتراة فالهندوسية واليهودية والمسيحية والزرداشتية المجوسية) والإسلام كلها
تتمسك بعقيدة وجود الوحي الإلهي منذ البداية.تقول التوراة بوضوح إن الإنسان تشرف بالوحي الإلهي بمجرد أن ظهر على الأرض، وتعلم
وحدانية الخالق والإنجيل يصدق ذلك كل التصديق فلولا الوحي الإلهي وتعاليمه في بداية الخلق لكان
قول التوراة باطلا ولا أساس له حيث تروي ما أمر الله تعالى به آدم قائلا: "أثمروا واكثروا واملئوا
الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض"
(تكوين ۱ : ۲۸).تؤكد هذه الفقرة على أن آدم أول الناس قد أخبر منذ البداية أن ما في السماوات
وما في الأرض من مخلوق إلا وهو مسخر لخدمة الإنسان، فبعد هذا التعليم الإلهي كيف يمكن لآدم أن
بألوهية الشمس والقمر والحيوانات وغيرها من المخلوقات؟ كما لم يكن قبل آدم آباء حتى يعتبرهم
يؤمن
آلهة، كما يزعمون.منه
كذلك الإسلام قدم نفس النظرية، وقال إن الإنسان قد تشرف بكلام الله ومعرفة وجوده، بمجرد أن
خُلق على الأرض، وسيأتي تفصيل ذلك في موضوع خلق آدم في هذه السورة.وفي وجود هذه
التعليمات لا يمكن أن تجتمع دعاوى الدين وأفكار هؤلاء الفلاسفة بأي حال من الأحوال.ولا بد إذن
تكذيب الكتب السماوية أو رفض نظريات الفلاسفة.لقد تأسست نظرية الفلاسفة عن وجود الله على أمرين هما :أولا إنكار الوحي السماوي، ثانيا:
المفهوم الخاطئ للارتقاء.من
أما إنكارهم للوحي فقد نجم عن حرمانهم من هذه النعمة، لأنهم تربوا في البلاد المسيحية التي لم تحظ
بهذه النعمة منذ أمد بعيد..فلأنهم لم يتلقوا الوحي..لا بأنفسهم مباشرة، ولا بواسطة غيرهم ممن تلقاه..توهموا عدم وجود الوحي السماوي بتاتا.ودفعهم ذلك الوهم إلى البحث عن دواع عقلية لوجود الله،
۱۸
Page 201
فأرادوا حل هذه المسألة على ضوء نظرية التطور التي كانت تسترعي أنظارهم في تلك الأيام، فوقعوا في
هذه العقيدة المنحرفة عن الحق.الله
أما مفهوم الارتقاء الذي مفاده أن الإنسان في أول الأمر عبد آباءه أو مظاهر الطبيعة أو حيواناتها..فهو باطل ومرفوض عقلا وتاريخا.والحق أن مفهوم الارتقاء بالنسبة للعقل الإنساني إنما هو مقصور على
أن الأمور الدقيقة انكشفت على الناس شيئًا فشيئًا، وتم إظهارها بحسب نشوء العقل الإنساني.ولجهل
الفلاسفة بأن التخلف الحضاري لا يرتبط بالضرورة مع النشوء والابتداء..ظنوا أن عقيدة الأمم البدائية
عن وجود ناشئ عن عقائد الشرك الأولى التي كانوا يؤمنون بها.ولو أنهم أنعموا النظر في التاريخ
لعرفوا أن الأمم المختلفة تناوبت عليها أدوار متنوعة من الحضارة، فهناك أمم كانت متحضرة ذات باع
كبير في العلوم والفنون ثم باتت محرومة منها.ألم يدرسوا حضارة اليونان والفرس والعراق ومصر؟ وهل
غاب عنهم تاريخ الهند والصين؟ ألم يعرفوا الاكتشافات التاريخية القديمة التي تدلهم على أن بلاد الشرق
كانت في الماضي ذات حضارات عظيمة ثم تلاشت اليوم، وأن هذه البلاد كانت في سالف الأيام منابع
العلوم ثم صارت اليوم مصادر الجهل؟ فإذا كانت أدوار الحضارة والمدنية تسبق أدوار الجهل والتخلف..فلا يستبعد إذن أن يكون دور التوحيد سابقا على دور الشرك.والشواهد على هذه الحقيقة موجودة في الأديان المعاصرة..كالهندوسية مثلا، فإن "كشرنا" نبي
الهندوس كان موحدا قبل ألفي سنة، وكان كتابه "جيتا" يتضمن عقائد التوحيد.وإذا قارنا ذلك الكتاب
بعقائد الهندوس قبل اليوم بخمسمائة عام لوجدناهما على طرفي نقيض، وهذا يدل على أن التوحيد كان
سابقا وأن الشرك كان تابعا.وكذلك اليهودية والمسيحية..تختلفان اليوم عما كانتا عليه من التوحيد كما يتبين ذلك من التوراة
والإنجيل.حتى
ثم انظروا في تاريخ الإسلام الذي هو آخر الأديان والذي تأسس بنيانه على التوحيد، والذي كان
مؤسسه حربا على كل ألوان الشرك طول حياته، ولم يغفل قط عن تنبيه صحابته إلى فخاخ الشرك
لحظة وفاته، ولقد حذرهم قائلا: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (ص
(صحيح
البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة..ومع ذلك نرى كيف انحرف الناس من أمته عن طريق
التوحيد واتخذوا قبور الأولياء مساجد، ونسبوا إليهم ما هو من صفات الله تعالى، وتوسلوا إلى الأموات
لقضاء حاجاتهم.فهل يصح لنا بالنظر إلى انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك أن ندعي بأن ابتداء الإسلام
كان من الشرك؟ هذه الشواهد كلها تدل على أن زعم الفلاسفة بأسبقية الشرك على التوحيد ليس إلا
اختلاقا وافتراء.
Page 202
وهناك دليل آخر يبطل زعمهم هذا فقدت دلت البحوث العلمية على أن أقدم القبائل في العالم اليوم
تتمسك بعقائد الشرك أشد التمسك، ولكن لا يزال عندها تصور عن الإله الواحد رغم عقائدها الموغلة
في الشرك، مما يدل على قِدَم عقيدة التوحيد فيها وهم لا يعبدون ذلك الإله الأكبر مع إيمانهم به..ويعبدون آلهتهم الشعبية.ويعترف علماء المقارنة بين الأديان بوجود فكرة الإله الواحد الأكبر في قبائل
استراليا وأفريقيا والمكسيك، وأنه إله غير مرئي، مقامه في السماء.وإذا نظرنا في عادات الإنسان نجد أنه
دائما يميل إلى الجديد ويعمل به، ولما كانت تلك القبائل تعبد الإله المتعددة وتدعي الإله الواحد..فذلك
دليل على أن التعدد هو العقيدة الجديدة التي يأخذون بها، وينسون معها التوحيد لأنه العقيدة القديمة..وذلك جريا على عادة البشر من هجران القديم والاتجاه إلى الجديد المبتكر.ومن الدلائل أيضًا على وجود الاعتقاد بين القبائل المتوحشة بإله واحد غير مرئي خالق للكل أن
سكان "المكسيك"، وهم من أقدم الشعوب..يعتقدون بإله واحد اسمه "إيوانا ويلونا" خالق كل
الأكوان، المحيط بها، أبو الآباء.في بدء الخليقة..عندما لم يكن شيء ولم يوجد كائن..فكر "ويلونا"،
وعن فكره نشأت قوة النمو، فتحولت تلك القوة المتزايدة إلى صورة فضاء واسع، ومنها تجلى نور الإله،
ثم أخذ الفضاء يتقلص فنشأ منه الشمس والقمر وما أشبه هذه الأفكار بمعتقدات الأديان الحاضرة عن
خلق هذا الكون.•
وهناك بعض القبائل الأفريقية البدائية الموغلة في التوحش، ولديها اعتقاد مماثل بإله واحد يسمى
"نينكو".ووجدت على آثار بابل وهي من أقدم مراكز الحضارة الإنسانية عبارات التضرع إلى الإله
الواحد..وهاك ترجمتها:
"يا أيها الملك الأزلي الأبدي، مالك جميع المخلوقات؛ أنت خالقي.يا أيها الملك، ليكن
رحمتك، يا مولانا أنت ترحم الجميع لتكن مملكتك الواسعة ذات رحمة اغرس في قلبي حب عبادة
ألوهيتك، وهب لي كل ما ترضى، لأنك أنت الذي صيرت حياتي بهذه الصورة".ولكن بعد ذلك الدور
التوحيدي تحولت بابل إلى مركز للعقيدة الشركية.وكذلك كانت قبائل كندا وأستراليا البدائية تعتقد بإله واحد يدعى هنا وهناك بأسماء مختلفة.ويتبين مما سبق من الشواهد الدينية والتاريخية أن عقيدة التوحيد كانت سابقة في الوجود على عقائد
الشرك.وأريد هنا أن أكشف الغطاء عن خطأ آخر..أوقع هؤلاء الفلاسفة في ظنهم الباطل هذا، وهو أنهم لما
قرءوا في التوراة وغيرها من الكتب عن إله قبيلة كذا وإله شعب كذا استدلوا بهذه الكلمات على
أن
فكرة الآلهة المتعددة الأصل الذي تطورت عنه عقيدة الإله الواحد، وقد وقع الفلاسفة في هذا الخطأ
هي
Page 203
لأنهم لم ينتبهوا إلى أن الديانات السابقة على الإسلام كانت غير عالمية، أي أن كل دين كان يخص قوما
بعينهم أو قبيلة بذاتها.وهكذا كان أتباع هذه الديانات يحسبون أن الإله الواحد إلههم وحدهم دون
غيرهم.وهذه الرسالات وإن كانت سماوية صادرة عن إله واحد إلا أن اختلاف أحوال القبائل والأمم
اقتضی
أن تكون هناك اختلافات في تفاصيل الديانات وقد نشأ عن تلك الاختلافات ذلك الظن الخاطئ
لدى من يجهل هذه الحقيقة بأن لكل دين منها إلها خاصا به.والحقيقة أن الإله الذي شرف البشرية بالرسالات السماوية إله ،واحد أعطى كل شعب طبق حاجته.وقد أبان القرآن الكريم وجه الحقيقة في هذه القضية قائلا: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
(فاطر: ٢٥).ومما يثير العجب أن الذين يظنون بأن الاعتقاد بالإله الواحد "يهوه" إله بني إسرائيل قد ظهر فيهم بعد
موسى..لم يروا بأن إبراهيم سبق موسى بزمن طويل، وكان من ذريته قوم يسكنون مكة، وكانت
عقيدتهم تخالف عقيدة اليهود..إذ إنهم أسرفوا في الشرك، وجمعوا في الكعبة عددا كبيرا من الأصنام،
وكانوا بعيدين عن عوامل الحضارات الخارجية بعدًا تامًا..ثم جاء نبي الإسلام محمد ﷺ ونادى في قومه
الذين عادوه أشد العداء..بأن جدهم إبراهيم كان موحدا ولم يكن من المشركين.يقول القرآن المجيد...بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٦).ورغم الخلاف الشديد بين النبي وبين قومه من أحفاد إبراهيم لم ينكروا عليه أبدا هذا القول، ولم
يدع أحد منهم بأن إبراهيم لم يكن موحدا.وفي هذا دلالة واضحة على أن مشركي مكة كانوا يعترفون
بأن إبراهيم كان موحدا، وأن عامة العرب كانوا يعتقدون بأن إبراهيم ل لم يكن من المشركين.ومن
ثم فإن التقاليد العريقة لأبناء إبراهيم من قبل موسى تقوم على عقيدة الإيمان بإله واحد.والزعم بأن
عقيدة التوحيد لم تكن في بني إسرائيل إلا بعد موسى زعم باطل، لأن بني إسرائيل هم من ذرية إبراهيم
ويعتزون بكونه جدهم الأكبر، وإبراهيم هو حامل لواء التوحيد في قومه وبنيه.وخلاصة القول إن الآية الكريمة التي تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك لا تقدم حلقة ارتقائية
متطورة من حلقات عقائد الشرك، بل إنها توطد أركان عقيدة راسخة عريقة في تاريخ الإنسان..قد
عنه :
ضلت عنها الأمم بعض الوقت..وانحرفت عنها الجماعات البشرية فوقعت في الشرك.
Page 204
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُواْ
شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ )
شرح
الكلمات
الله
٢٤
نزَّلنا : نزَّل الشيء: صيّره نازلا ونزَّل القومَ: أنزلهم المنازل.نزَّل الشيء: رتبه.نزَّل العير: قدَّر لها
المنازل.فالتتريل يكون تدريجيا مرة بعد مرة.والإنزال أعم منه (الأقرب).والفرق بين الإنزال والتتريل أن
هذا يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مُفرَّقا ومرة بعد أخرى، والإنزال عام (المفردات).عبدنا: يُقال عبد له: تأله له عَبَدَ الله أي أطاع له وخضع وذل وخدمه والتزم شرائع دينه ووحده
(الأقرب).والعبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية
الإفضال وهو
تعالى.والعبادة ضربان عبادة بالتسخير وعبادة بالاختيار والعبد يقال على أربعة
أضرب: الأول عبد بحكم الشرع، وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه، والثاني عبد بالإيجاد..وذلك
ليس إلا لله تعالى، والثالث عبد بالعبادة والخدمة والناس في هذا ضربان: عبد الله مخلص وجمعه عباد،
وعبد للدنيا، وهذا الرابع (المفردات).قال بعض أئمة الاشتقاق: أصل العبودية الذل والخضوع.وقال آخرون: العبودية الرضا بما يفعل
الرب، والعبادة فعل ما يرضيه الرب.والأول أقوى (التاج).العابد: الموحد.والتعبيدة العبودية.ويُقال: ما عبدك عني ما حَبَسَك عبد به: إذا لزمه ولم يفارقه.قال ابن الأنباري: فلان عابد؛ هو الخاضع لربه، المستسلم المنقاد لأمره، والمتعبد المنفرد بالعبادة (التاج).فمعنى العبد أن
يصير الإنسان في غاية التواضع والتذلل والخضوع والتوحيد والخدمة وعدم المفارقة لله وفي
غاية الانقطاع عن الدنيا إلى الله.شهداء: جمع شهيد والشهادة والشهود الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة.والشهادة قول
صادر عن علم حاصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، وقد يقال للحضور مفردا.وقد يعبر بالشهادة عن الحكم
والإقرار.وشهده اطلع عليه وعاينه شهد على الأمر: أخبر به خبرا قاطعا.والشهيد: الشاهد؛ الأمين
في شهادته؛ الذي لا يغيب عن عمله شيء "الأقرب".قال ابن عباس في قوله تعالى ادعوا شهداءكم
معناه أعوانكم.وقال مجاهد : الذين يشهدون لكم.وقال بعضهم: الذين يُعتد بحضورهم.فمعنى ادعوا
شهداءكم، "١" ادعوا أعوانكم وأصدقاءكم، "۲" ادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم، "م" ادعوا
آلهتكم.
Page 205
التفسير : جاء أول أمر سماوي في القرآن الكريم في الآيتين السابقتين.يتضمن عبادة الله تعالى وتجنب
هي
اتخاذ أندادٍ له.وتشير هذه الآية إلى نتيجة طبيعية تترتب على أول أمر قرآني، تلك قول الكفار : إن
هذا الكلام لم يكن جديرا بأن نرضى به، لأنه قد دمر حياتنا الآمنة، وأورثنا الحرمان من اليقين الذي كنا
مما
نتمتع به، وفتح علينا أبواب الشكوك والشبهات.وكلمة مما في قوله تعالى وإن كنتم في ريب
نزلنا تدل على أن الريب الذي قد سبق ذكره إنما نشأ عند المعترضين بسبب القرآن الكريم، الذي
حسب زعمهم قد جعل حياتهم قلقة.وقوله إن كنتم في ريب ليس تصديقا لمزاعمهم بأن القرآن
يسبب الشك لديهم إنما هو تكذيب لها وقال : إن كنتم صادقين فيما تزعمون فعليكم أن تأتوا بسورة
مثله، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فادعاؤكم هذا أيضًا باطل، لأن الإتيان بمثل الكلام المريب أسهل ما
يكون.ومثاله في كلام العرب قولهم: إن كنت عبدي فأطِعْني.يقال لمن يدَّعي كذبا أنه عبد له فيرد عليه
بذلك، أي إن كنت صادقا فيما تدّعي فأطعني، وإلا فأنت كاذب.د
إن مطالبة القرآن واسعة، ولا تقتصر على الجمال اللغوي وحده، بل الحق أنه لم
ير هناك أي ذكر
للغة، وإنما يستنبط ذلك فقط من قوله تعالى لا ريب فيه فضلا عن المعاني الأخرى الكثيرة.إذ ليس
من الصواب الاقتصار على معنى واحد لقوله : لا ريب فيه وترك ما يتضمنه من معانٍ أخرى.كما
ليس من الصواب الأخذ بقوله لا ريب فيه وترك مطالب بأخرى تشير إليها الآية.والاعتراضات على القرآن الكريم كانت وما تزال تجري على ألسنة الكفار، ولا الكتاب
يبرح
المسيحيون يسوقون الاعتراضات على القرآن المجيد ولكنهم إلى اليوم لم يجرءوا على قبول تحدي القرآن
بالإتيان بمثله.إنهم يدعون بأفواههم أن القرآن وحاشا له قد اقتبس من الإنجيل كذا وكذا، وأخذ من
التوراة كذا وكذا واستعار من كتب المجوس كذا وكذا..وإذا كان الأمر بزعمهم كذلك..فما الذي
يمنعهم من الأخذ والاقتباس والاستعارة ليجمعوا ويؤلفوا كتابا جامعا مثل القرآن؟ إن اعتراضهم هذا هو
بأن العسل ليس له فضل أو مزية، لأن النحل امتص من الأزهار والأثمار رحيقها وأخذ
حلاوتها ورائحتها العذبة..ولكن هل يمكن لهذا المعترض أن يقدم عسلا مثله، وأنى له ذلك؟ ها
الأزهار والأثمار أمامه فهل بوسعه أن يمتص منها ويخرج لنا شهدًا حلوا مغذيا شافيا؟ والقرآن الكريم
يهدم اعتراضهم ويقول بأنه لا يحتوي على كل الحقائق الموجودة في الكتب السابقة فحسب، بل إنه
كقول من يزعم
جامع لحقائق لم تكن معلومة من قبل أيضا، فيقول:
فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ) (البينة: ٤).وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة: ١٥٢)
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة: ٢٤٠)
هي
Page 206
فالقرآن يعترف بأنه يتضمن التعاليم المفيدة التي كانت موجودة في الكتب الأولى، ويؤكد أن به أيضا
تعاليم بديعة أخرى.والطعن في القرآن بعرض بعض المتشابهات يخالف الأمانة، لأن الذي يزعم
بأن
القرآن يحتوي على مقتبسات أو سرقات فقط فليؤلف كتابا مثل القرآن ويجمع فيه ما شاء من السرقات،
ثم لينظر مصير كتابه بإزاء القرآن الحكيم إن أي كتاب ملفق لن يبلغ جزءا من الملايين من معارف
القرآن.وعلاقة هذه الآية بما قبلها أنها استهلت بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدئذ لما دعي
الناس قاطبة إلى عبادة الله الواحد، ثارت ثائرة الأعداء، وقالوا: كيف توجهون إلينا هذه الدعوة وقد
ادعيتم بأنه لا ريب في هذا الكتاب، بينما الريب كل الريب فيما قدمتم في أول هذا الكتاب من التوحيد
الذي يفتح أبواب الشكوك على مصارعها وهو باطل عندنا كل البطلان، لذلك إن أوكد وأوثق ما
تقولونه لا يسمو عن الارتياب، فإلى أي خير في دينكم تدعوننا، وبأي طمأنينة تدعون؟ فردّ الله تعالى
عليهم بقوله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
ويتبين مما سبق من الشرح، أن التحدي هنا يتضمن المطالبة بالإتيان بسورة تبلغ مدى ما تشتمل عليه
الآيات السابقة في أول سورة البقرة من المعاني وليس المراد بذلك أن سائر سور القرآن عدا هذه الآيات
يمكن الإتيان بنظيره، وإنما هذه الحجة على سبيل الإلزام، ومعناها أن عجزكم عن الإتيان بنظير ما في
القرآن كله من معانٍ وتعاليم لبين ومُستبعَد كل الاستبعاد ، فلكم أن تأتوا بمثل ما في بضع آيات سابقة
من مضامين، لأنها هي التي أثارت اعتراضكم.والآن نرى ما في الآيات السابقة على هذا الاعتراض من معان.ففي الآية الأولى ورد قوله تعالى لا
وبسببه قال الكفار إن القرآن يثير الشك لديهم.هذه الآية تشتمل على المعاني التالية:
١ - ذلك الكتاب أي:
ريب فيه ،
أ- هذا هو
الكتب الموعود الذي أخبر الأنبياء السابقون عنه أنكم تعطون كتابا كاملا، وهذا الكتاب
يحقق أنباءهم هذه.هذا
ب- هذا هو الكتاب الكامل الذي يحتوي على كل أمر هام لتكميل الروحانية.هو الكتاب الذي جاء استجابة لدعاء عُلِّمتموه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم...أي صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.ج-
٢ - لا ريب فيه ) أي:
ير
د فيه أمر يثير القلق والاضطراب حقا، بل يقدم على صحة كل دعوى دلائل وبراهين، ويسدّ
باب كل سوء ويفتح باب كل خير ببيان أسباب هذا وذاك.٢٤
Page 207
يرد فيه شيء يُعَدُّ تهمة في حق الله جل وعلا، أو في حق أحد من الأبرار المقربين، أو في حق
كتاب سماوي حق.ج لا يعوزه أمر مما لا بد منه للكمال في الروحانيات.د- لا يتضمن تعليما يوقع الإنسان في المشقة أو الهلاك.هدى للمتقين أي أنه لا يقتصر على مطالبة الإنسان بالأعمال الحسنة فحسب، بل يعد كلّ
من يتبع تعاليمه بإيصاله إلى مقام الوصال والقرب منه سبحانه ويطلعه على مشيئته تعالى.وكل من يرفضه من عنادٍ يعاقبه الله تعالى بعذاب أليم.- والذين لا يقوم إيمانهم به على الإخلاص الصادق، سواء من ناحية العقيدة أو العمل، فأولئك لهم
أيضًا عذاب أليم.٦ - إنه يقدم تعليما صادقا مدعما بالبراهين عن
هذه
الله تعالى.هي مضامين الآيات السابقة للآية التي نحن بصدد تفسيرها، ولا يتحقق الإتيان بمثلها إلا إذا أتوا
بسورة تتضمن كل هذه المضامين.والظاهر أن الإتيان بمثلها خارج عن نطاق قدرة البشر، ولا يكون
مثلها إلا في كتاب نزل من عند الله تعالى.وبناء على هذه الدعوى تحداهم وقال: وادعوا شهداءكم
أي استعينوا بالهتكم ليلهموكم كتابا مثله..كما فتح هذا القرآن باب الإلهام لمتبعيه.هذا هو ما تطالب به هذه الآية، على أن يكون كل ذلك في أسلوب جميل بليغ، لأن اللغة الركيكة لا
تفصح عن المعاني بل تحدث الشك.فعندما قال القرآن إنه لا ريب فيه فكأنه ادعى الفصاحة
والبلاغة.ولكن من الخطأ الظن بأن المطلوب هو الإتيان بكلام مماثل للقرآن في الفصاحة فحسب، لأن
هذا بمثابة تقديم قطرة من البحر لا غير.من
وجملة القول إن القرآن الحكيم ردَّ ردًّا مفحما على المعترضين بأن القرآن مثير للريب فيما قدّمه
دين، وفيمن هو صاحب هذا الدين، وتحداهم بحيث ألقمهم حجرا لم ولن يسيغه أحد.أما الاعتراضات
فما زالت مستمرة، ولن تزال كذلك ما دام هناك قلوب فارغة من التقوى.ولكن إذا تقدم أحد لقبول
ذلك التحدي وهو خال من التعصب..فلن يجد بدا من الإقرار بعجزه، وصدق الله العظيم: فإن لم
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين.إن مسألة سمو القرآن وتحدي العالم بالإتيان بنظيره..عالجها القرآن في خمسة مواضع، وأرى أن
مفهوم التحدي في كل موضع منها يختلف عن غيره:
١ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ..))، وهي آيتنا الحالية.
Page 208
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ
(يونس: ۳۹).٥
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ
صَادِقِينَ (هود: ١٤)..قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْض ظَهيراً (الإسراء: ٨٩).ه أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (الطور : ٣٤-٣٥).ويلاحظ أن التحدي في الموضعين الأول والثاني من نوع واحد، أما تحديات المواضع الأخرى الثلاثة
فكل منها له معنى خاص به ففي سورة الإسراء كان التحدي بالإتيان بمثل القرآن كله، والتحدي في
سورة هود بالإتيان بعشر سور بينما كان التحدي في سورة الطور على إطلاق..ولو كان بالإتيان
ببعض سورة.فما السبب في هذا الاختلاف؟
قيل إن الاختلاف سببه التنزل بهم في التحدي حتى ينكشف لهم عجزهم التام، فطالبهم أولا بمثل
القرآن كله، وعندما عجزوا طالبهم بعشر سور مثله، فلما عجزوا طالبهم بسورة، وحينما عجزوا أيضًا
طالبهم بحديث من القرآن وعندي أن هذا التعليل لا يخلو من اضطراب وضعف، لأن ترتيب الترول
القرآني يخالف ذلك؛ حيث كان الترتيب كالآتي: سورة الطور، ثم سورة الإسراء ثم سورة هود، ثم سورة
يونس وكانت أخيرًا سورة البقرة.فليس من السائغ نظرا لترتيب نزول السور أن يكون التحدي أولا ببعض آي القرآن فإذا عجزوا يرفع
التحدي إلى القرآن كله فلما عجزوا يخفض إلى عشر سور ثم سورة واحدة.وقبل أن أتناول بالبحث كل تحد منها على حدة..أود أن ألفت الأنظار إلى أن كل تحد منها جاء
مقرونا بذكر المال والثروة والقوة..ما عدا الوارد في سورة البقرة ؛ لأنه صورة مماثلة للتحدي الوارد في
سورة يونس أعاده الله تعالى في سورة البقرة.حيث يقول الله تعالى قبل التحدي: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى
تُصْرَفُونَ * كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ (يونس: ٣٢، ٣٥، ٣٦).
Page 209
وكذلك جاء في سورة الطور بعد إيراد التحدي : أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ * أَمْ
عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ * (الطور : ٣٦، ٣٨،٣٧)
وجاء في سورة هود لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَثرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ )) (هود: ۱۳).*
وفي سورة الإسراء: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ
نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْحِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ
وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا " أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ)) (الإسراء: ٩١ إلى ٩٣).ومن ذلك يتبين أن هناك علاقة عميقة بين التحدي المطالب بمثل القرآن وبين الكنوز والخزائن.فالقرآن المجيد أيضًا كتر من كنوز الله وخزائنه.والقرآن يرد على من يطالبون بالكنوز أنهم يطالبون
الرسول ﷺ بما هو فعلا بين يديه..فمعه أعظم الكنوز وأسماها ويرد على من يطالبون بالملائكة فيقول
إن الملائكة لا تنترل لمسابقات مادية، وإنما تتترل بالوحي القرآني، وقد نزلت بالفعل على الرسول الكريم
ومعها كلام الله تعالى.فالمنكرون يطالبون الرسول بما قد حصل من قبل.وإذا أعماهم التعصب فأنكروا
كون القرآن كنزا، أو تنزل الملائكة معه من عند الله تعالى..فليأتوا بمثله.وهكذا يقوم القرآن الكريم
نفسه ككتاب منقطع النظير..يصدق نفسه بنفسه، ويقدم أدلة نزوله من عند الله تعالى بما فيه من الآيات
والسور التي يعجز الجميع عن الإتيان بمثيل لها.ولنلق نظرة بعد ذلك على كل آية يتحدى فيها القرآن المنكرين ليأتوا بمثله، لنفهم الحكمة من كل
تحد، ومناسبته للمقام.جاء التحدي الأكبر في سورة الإسراء يطالب بالإتيان بمثل القرآن كله وليس شرطا أن يكون
الكلام المثيل معزوا إلى الله، بل يجوز لهم أن يأتوا بأي كلام يريدون ومن أي مصدر يشاءون.ولكن
الشرط الوارد في الآية أن يكون مثل القرآن أو أفضل منه.والمماثلة أمر هام، بينها القرآن الكريم في
السورة ذاتها حيث قال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُوراً)) (الإسراء: ٩٠).هذا هو الأمر الجامع الذي طلب الإتيان بمثله، فإذا كان المنكرون يرون القرآن
من كلام البشر فعليهم أن يقدموا كلاما مساويا له في الفضائل التالية:
١.أن يكون الكلام هداية كاملة في أمور الدين، مستوعبا جميع ضرورياته من العقائد وفلسفاتها،
وصفات الله تعالى وحكمة ظهورها، وعلم الكلام والعبادات وفلسفتها، وعلم الأخلاق ومبادئها
الفلسفية والمعاملات وأسسها الحكيمة، وما يتصل بالدين من أمور الحضارة والمدنية والسياسة
والاقتصاد، وحقيقة الحياة الآخرة وما يتعلق بها..وغيرها من الأمور الحيوية الضرورية.
Page 210
٢.أن يتناول الأمور السالفة الذكر من كل نواحيها سعةً وعمقاً، ومرشدًا إلى الخير في كل مسألة
دينية بكل جوانبها الدقيقة..أن تكون كل عناصرها مع سعتها ودقتها لا تقدم إلا النافع الخالي من الضرر.٤.أن يكون الكلام عاما..لا يخص شعبا بعينه ولا يراعي مصلحة فئة خاصة، وإنما ينظر إلى جميع
بني الإنسان ملائما للفطرة البشرية جمعاء، ويصلح لكل الطبائع الإنسانية، ويوافق كل الأوضاع
والظروف، ويناسب كل مستوى من الأفهام.ولعل في هذا التحدي ردا على من يزعمون معرفة الأمور الغيبية ممن يُسَمَّون الروحانيين
(Spiritualists)، فينبههم القرآن إلى أن الإتيان بمثل علوم القرآن مستحيل على الإنسان..سواء
أحاول هو نفسه أو بمعونة الأرواح التي يدعون الاتصال بها.والآية التالية التي ترد على الكفار اعتراضهم بأن الرسول الله لا يملك كترا وليس معه ملك، تقول:
فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات.فلما كان الاعتراض موجها إلى بعض الأمور التي جاء بها القرآن
أنه كتر من عند الله نزلت به الملائكة..لذلك جاء الرد يتحدى بالإتيان بمثل جزء من القرآن وليس
القرآن كله، فعلى المنكرين المعترضين أن يأتوا بعشر سور فقط تماثل عشر سور من القرآن الكريم..وليزعموا أنها
من عند الله تعالى وجاءت بها الملائكة..ثم لينتظروا ما يكون مصيرهم بعد هذا الافتراء.من
وقد استعمل عدد العشرة لأنه عدد تام.ولقد تضمنت سورة الإسراء القول بكمال القرآن الحكيم من كافة الوجوه..ولذلك كان التحدي
فيها بمثل القرآن كله أما هنا فكان الاعتراض على بعض القرآن لا على كله، ولذلك كان التحدي
بعشر سور طويلة أو قصيرة دونما تحديد والفرصة أمامهم متكررة عشر مرات.و في الموضع الثالث أعلن القرآن أنه لا نظير له أبدا، وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة من القرآن.والتحدي هنا دليل من أدلة القرآن وليس ردا على الكفار، وقد جاء قبل هذه الآية أن القدرة على
التصرف المطلق الله وحده والدليل على ذلك هو القرآن الحكيم نفسه.وأورد الله تعالى خمسة تحديات
قائلا: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا
رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (يونس: ۳۸).فهو أولا يحتوي على تعليم لا يمكن أن يؤتى بنظيره، وهو ثانيا يصدق الكتب السماوية السابقة، وهو
ثالثا يكمل الأحكام الناقصة فيما سبق من كتب وهو رابعا مصون عن كل عبث أو تصرف إنساني،
وهو خامسا تعليم عام من رب العالمين لجميع بني النوع الإنساني ولجميع الأزمان.۲۸
Page 211
وعقب على ذلك بقوله: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنتُمْ صَادِقِينَ) (يونس: ٣٩).فإذا لم يكن كل ما ذكرناه عن القرآن حقا وصدقا فأتوا بسورة مثله تتصف بتلك الصفات الخمس.أما وأنكم لن تستطيعوا الإتيان بسورة واحدة فأنى لكم أن تأتوا بكتاب مثل القرآن في فضائله التي لا
تحصى.فالمثلية هنا يراد بها فضائله.والتحدي الرابع فليأتوا بحديث مثله..ويراد به ما جاء في أول السورة: ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَاب
مَسْطُورٍ * فِي رَبِّ مَنْشُورٍ * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ * ﴾ (الطور:٢ إلى ٩).*
وهذا إعلان مؤكد بأن القرآن هو الكتاب الموعود به على جبل الطور، وهو الذي لن يزال مكتوبا
ومنشورا في الدنيا، مقروءاً على الدوام ودون انقطاع، وأن الإسلام سيزداد أهله جدا، وسيدخل فيه ذوو
الفضائل الروحانية والجسمانية العالية، فضلا عن عامة الناس.نقدّم هين الأمرين: الإسلام وهذه العين
التي ستروي مختلف البلاد في العالم كدليل على يوم القيامة.ثم يُعقب الله تعالى بقوله: أم يقولون
افتراه ؟! فإن كان كذلك، فعليهم أن يأتوا بحديث يتضمن مثل هذه الأنباء المتنوعة.ولا يشترط عليهم
أن يكون الحديث مفترى على الله أيضًا، بل لهم أن يستخرجوا ذلك المثل من الكتب السابقة.ولكن
ليعلموا يقينا أنهم لن يمكنهم أن يأتوا بنظيره.الدقاقة
أما التحدي الخامس فهو الوارد في آيتنا من سورة البقرة وقد سبق بيانه.تحد
وقد تبين وتحقق مما أوضحناه أن هذه التحديات الخمسة..هي خمس مطالبات منفصلة، كل منها
على حدة، وكل واحدة منها ثابتة متحققة لا تنسخ إحداها الأخرى ومما أوقع المفسرين في الخطأ
بأن كل من هذه التحديات هو الإتيان بمثل القرآن في الفصاحة فقط، مع
أن الأمر على
عكس ذلك.إن التحدي في هذه السور الخمس ليس واحدا، بل إنها تحديات مختلفة منفصلة.وجاء في
كل تحد منها طَلَبُ الإتيان بمثل القرآن كله أو بعضه طبق الظروف والأحوال.زعمهم
ولا يحسبن أحد أن التحدي مقصور على الإتيان بمثل السور التي جاء بها التحدي، لأن الموضوع في
مفتتح سورة البقرة يعمّ جميع سور الكتاب دون استثناء.ولذلك فكل سور القرآن خالية الريب، وكلها
هدى للمتقين..فإن أتى أحد بمثل سورة ما من سور القرآن..طبق الشروط المذكورة في أول سورة
البقرة والموجودة في جميع السور..فإنه بذلك يكون محقا في تكذيب القرآن المجيد.وهيهات هيهات لما
يحلمون!
Page 212
وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا في رأي بعض المفسرين يشير إلى أن الكفار ارتابوا في هذا
الكتاب بسبب تنزيله شيئا فشيئا ومرة بعد أخرى لأن لفظ نزلنا يقتضي ذلك، وجرت العادة أن
يكون المؤلف أقدر على تأليف كتابه إذا كان على أقساط متقطعة.فردّ عليهم بقوله: فأتوا بسورة من
مثله أي بقطعة منه.والاستدلال، وإن بدا معقولا، إلا أنه لا يستقيم مع قواعد اللغة العربية.ذلك لأن صيغة التفعيل وإن
دلت على التكرار والكثرة إلا أن ذلك ليس مطّردا في كل موضع بل يفيد ذلك في الأفعال التي مجردها
متعد مثل قَطَعَ، فإن قطع تعني جَعَلَه قِطَعًا كثيرة، وكذلك ضَرَبَ وضَرَّب، وذبح وذبح.ولكن التفعيل
يفيد أيضا التعدية إذا كان المجرد لازما مثل: وضح الأمر ووضحه أي جعله واضحا.فالفعل نزل هو
صيغة المتعدي من الفعل نَزَل، ولا تعني التكرار والتدرج والقاعدة المبدئية في اللغة العربية أن زيادة اللفظ
تدل على زيادة المعنى والزيادة هنا حولت الفعل من لازم إلى متعد، وحققت غايتها.ومما يدل على أن نزل لا تعني التكرار أن الكفار لما اعترضوا على تكرار الترول عبر القرآن عن
ذلك بقوله:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (الفرقان (۳۳).فكلمة نزل بمعنى إنزال
القرآن كله مرة واحدة ولا تعني التدرج.وإذن فالاعتراض والريب ليس بسبب نزول القرآن جزءا جزءا،
وإنما اعتراضهم على عقيدة التوحيد التي ذكرت في الآية السابقة، وهي التي أثارت شكوكهم.فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ
الكلمات
۲۵
شرح
الحجارة: جمع حجر.الحجر : الجوهر الصلب (المفردات).الحجران هما الذهب والفضة الأقرب
أعدت أعده للأمر: هيّاه وأحضره (الأقرب).التفسير : يقول الله تعالى في هذه الآية إنكم إذا لم تستطيعوا أن تعارضوا تحدي القرآن بمثله، وإنكم لن
تستطيعوا ذلك أبدا..فعليكم أن تستيقنوا بأنه كلام الله ، وأنكم لا تبارزون الإنسان، بل إنما تبارزون الله
تعالى..وعليكم أن تستعدوا للقاء ذلك العقاب الذي لا يلقاه إلا المعارضون للحقائق السماوية.
Page 213
وقوله لن تفعلوا قد يراد به مجرد المستقبل أيضا أي لن تستعدوا لذلك..لأن الكفار وإن كانوا
يشركون بالله بعض الآلهة الأخرى، غير أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن آلهتهم تلك لا تستطيع إنزال
وحي، ولن تقدر عليه أبدا..كما سبق من قوم إبراهيم عليه السلام..عندما اضطروا للرد عليه بقولهم:
ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) (الأنبياء: ٦٦).وإن في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة تجوز واستعارة لبيان أن العلاقة بين الناس والحجارة،
أي الوثنية، ستكون سببا لإيقاد النار للكافرين.وقد فسر مؤسس الجماعة عليه السلام الناس والحجارة بنوعين من أهل النار: نوع يضمر في
قلوبهم شيئا من حب الله تعالى، وعبر عنهم بلفظ الناس، ونوع آخر منهم شبهوا بالحجارة لأن
قلوبهم خلت من حب الله تعالى لجمودها، فهي كالحجارة الصلبة التي ليس فيها لين ولا رأفة ولا شفقة.وهذا المعنى على درجة كبيرة من الدقة واللطافة ويصدقه القرآن الكريم حيث يقول عن اليهود:
قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ (البقرة: ٧٥).ولقد أطلق القرآن المجيد على الكفار من ناحية شرهم اسمين الجن والإنس ومن ناحية مؤاخذتهم على
الشر سماهما الحجارة والناس، كما جاء في قوله: الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
وما ورد على لسان أهل النار رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالأَنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
مِنَ الْأَسْفَلِينَ (فصلت: ٣٠)
وقد سمي
الصنف الأول جنَّا، لأن مادة جن تعني الخفاء، وهم أهل الشر الذين يضلون الناس من
حيث لا يدرون.ولو أنهم نشروا الشر بطريق بين لما اغتر الناس بوساوسهم، ولكنهم يلجئون إلى
دسائسهم السرية، ولذلك سماهم بالجن.أما عقابهم الشديد فقد دل عليه بالإشارة إلى قسوة قلوبهم..كي تتلاءم شدة العقاب وقسوة القلب، ولذلك سماهم من ناحية عقابهم الشديد بالحجارة.ولا يعزبن عن البال أن الحياة الآخرة ليست مادية محضة وأن العبارات الواردة في القرآن المجيد بشأن
الثواب والعقاب الأخروي لا تُحمل على معناها الحرفي، وإنما هى بلسان التمثيل لتقريب الصور من فهم
الإنسان إلى حد ما.وقوله أعدت للكافرين إشارة إلى أن عذاب الله لا ينزل إلا بالإنكار والعناد، وإلا فإن الله تعالى قد
خلق الإنسان للنجاة.وكذلك تبطل هذه الآية الكريمة ظن الذين يزعمون أن كل إنسان مؤمنا كان أو
كافرا..لا بد من أن يتذوق قليلا أو كثيرا من عذاب النار.
Page 214
ولنعلم
أن العقاب في التعاليم القرآنية ليس بدائم، وليست غايته الانتقام والإيذاء دون مبرر، بل إنه
يهدف إلى تطهير الإنسان لكي يصلح للتقرب إلى الله تعالى وما جهنم إلا كدار للاستشفاء والعلاج من
آثار الأمراض الروحية.وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا.y
الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ
وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ )
شرح الكلمات:
بشر : البَشَرة : ظاهرُ الجلد.وبَشَّرتُه : أي أخبرته بخبر سارٌ بَسَطَ بَشَرَة ،وجهه، وذلك أن النفس إذا
سُرَّت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر.وأما قوله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم فاستعارة ذلك
تنبيه أنَّ أسر ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب (المفردات).البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير، ولا
تكون بالشر إلا إذا كانت مقيدة كقوله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آل عمران).والتبشير يكون بالخير
والشر، وقد يكون هذا على قولهم تحيتك الضرب وعتابك السيف والتبشير في اللغة مختص بالخبر الذي
يفيد السرور؛ إلا أنه بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في البشرة تغيرا، وهذا يكون للحزن
أيضًا، فوجب أن يكون لفظ التبشير حقيقة في القسمين (التاج).الصالحات صلح ضد فسد أو زال عنه الفساد.هذا يصلح لك: أي يناسبك، فالصالحات الأفعال
الطيبة؛ أعمال لا فساد فيها وملائمة ومفيدة وصالحه وافقه الصالح ضد الفاسد.والصلاحية حالة
يكون بها الشيء صالحا (الأقرب).جنات: أصل الجنّ ستر الشيء، يقال: جنَّه الليل: ستره، والجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجار
الأرض.وقد تسمى الأشجار الساترة جنة.وسميت الجنة إما تشبيها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما
بون، وإما لسترها نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
(المفردات).
Page 215
الأنهار واحدها النهر، وهو مجرى الماء الفائض.وجعل الله تعالى ذلك مثلا لما يدرّ من فيضه وفضله
في الجنة على الناس، قال: إن المتقين في جنات ونهر والنهر السعة تشبيها بنهر الماء.ونهر نهر : كثير
الماء (المفردات).أزواج الزوج كل واحد معه آخر من جنسه (الأقرب).وتخطئ العامة فتظن أن الزوج اثنان،
والحقيقة أن الزوج واحد من اثنين.فيقال: زوجان من حمام وزوجان من نعال.وورد في القرآن قلنا
احمل فيها من كل زوجين اثنين.فالمراد من الزوجين في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة )) أن لهم رفقاء من جنسهم يحققون معهم
كل نوع من الازدهار والراحة.والقرآن يقرر أن الله تعالى ليس بحاجة إلى زوج، أما كل شيء آخر فهو بحاجة إلى زوج.وبناء على
هذا فإن الجميع يكونون بحاجة إلى زوج سواء كانوا رجالا ونساء.أما نوعية هذا الزوج فلا يعلم
حقيقتها إلا الله تعالى، وسوف ينكشف للإنسان عندما يدخل الجنة.مطهرة: طهر ضد نجس.طهَّره جعله طاهرًا (الأقرب).والطهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة
نفس.خالدون: الخلد البقاء والدوام.خلد دام وبقي.خلد الرجل: أبطأ عنه المشيب، وقد أسن.خلد
بالمكان وإليه أقام أخلد إلى الأرض: لصق بها واطمأن إليها (الأقرب).والخلود هو تبري الشيء من
اعتراض الفساد وبقاؤه على حالته وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة، ثم استعير للمبقي دائما.والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي هي عليها من غير اعتراض الفساد.وكل ما يتباطأ عنه
التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأيام خوالد، وذلك لطول مكثها لا للدوام
التفسير: تتضمن هذه الآية وصفا مجملا للنعم التي سيلقاها المؤمنون في الجنة.وقد كانت حقيقة نعم
الجنة ولا تزال محل الاعتراض من أعداء الإسلام وأهم اعتراضاتهم ما يلي:
١.أن مثل هذه الوعود المزخرفة إفراط في إثارة الطمع ومناف للإيمان الكامل، لأن الإيمان المجلوب
بالطمع لا يمكن أن يوصف بالإيمان.٢.إن القرآن يقدم النعم المادية جزاء للإيمان، وهذا غير مقبول..٣ إن الإغراء بالنعم المادية دليل على أن القرآن يقول ببقاء هذا الجسم المادي بعد الموت أيضا، الأمر
الذي يخالف العقل، لأن الجسم المادي مصيره الفناء، وأجزاء هذا الجسم الفاني تتحول وتنتقل إلى أجسام
عديدة من البشر وغيرهم، فأنى لذلك الجسم الفاني أن يعود إلى صاحبه؟
Page 216
٤.تتحدث هذه الآية وآيات أخرى عن وجود أزواج لأهل الجنة بما يومئ إلى علاقات جنسية تثير
الشهوة.واستثارة الشهوات الجنسية في الحياة الآخرة تبعث على الاعتراض..لأن الغرض الأساسي من
الاتصالات الجنسية هو التناسل وحفظ النوع، فما الحاجة إلى ذلك في الجنة؟
ه.يتبين من صفات الجنة أنها محل للملذات المادية والمتع الجسدية وليست مقاما للنعيم الروحاني،
ومثل هذه النعم المادية تافهة لا قيمة لها إذا ما قورنت بالنعم الروحانية.وخلاصة هذه الاعتراضات أن الإسلام معاذ الله، قد أسَفَّ بحياة الآخرة إسفافا؛ إذ جعلها محققة
للأهواء النفسانية المنحطة، وبذلك أفسد معاني الحياة السامية الطاهرة.ولإدراك مدى بطلان هذه الاعتراضات ينبغي أن نمعن النظر في صورة الجنة كما يقدمها القرآن
الحكيم.لقد صرّح القرآن بحقيقة الجنة، وقدّم لنا الأساس الذي ندرك به ما جاء في القرآن عن صفاتها
ونعيمها حيث قال تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
(السجدة: ١٨).ويتبين من ذلك أن كل ما ورد في القرآن الحكيم من وصف للجنة إنما هو على سبيل التمثيل ليس
غير.وقد أكد الرسول و هذا المعنى وشرحه فيما رواه عن ربه عز وجل قال: قال الله تعالى: "أعددت
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر".(صحيح البخاري، كتاب
بدء الخلق، باب صفة الجنة.ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها).فيتضح من ذلك أيضًا أن حقيقة نعم الجنة تختلف كل الاختلاف عن حقيقة النعم الدنيوية، فلو كانت
هناك جنات وأثمار وأنهار وأزواج مادية لكانت مما رأته الأعين أو سمعت به الأذن أو خطرت على قلوب
البشر مرارا وتكرارا.ويتحدث القرآن الكريم عن نعيم الجنة فيقول: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ)) (الرعد: ٣٦).تبين لنا الآية أن جنات الحياة الآخرة تختلف عن جنات الدنيا، فثمارها دائمة لا تنقطع، وظلالها ثابتة
ممتدة لا تتقلص ، ولكن ثمار الدنيا وظلالها إلى زوال محتم.ووصف القرآن الحكيم الجنة في موضع آخر فقال: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ
آسينٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّيٍّ وَلَهُمْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ)) (محمد: (١٦).وكذلك وصف القرآن الجنة فقال: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ *)) (الصافات:٤٦ إلى ٤٨).
Page 217
في هذه الآية شرح لقوله لذة للشاربين، فهي لذة لا تُحدث السكر والغيبوبة، وبذلك أشار إلى أن
الدنيا لا تثير لذة حقيقية، بل إنها تورث الغفلة عن الهموم والأحزان ولكن خمر الآخرة ليس لها هذا
الأثر المضيع للعقل.وفي موضع آخر يضيف القرآن الكريم قوله: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوراً (الإنسان: ۲۲).وقال:
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ * عَيْنًا
يَشْرَبُ بهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (المطففين: ٢٦ - ٢٩).وقال: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
(الطور : ٢٤).يتبين مما سبق من الآيات أن أهل الجنة يشربون من خمر لا سكر فيها ولا عربدة، تقرب شاربيها إلى
الله
تعالى، تنبعث منها رائحة طيبة من المسك، وهي طاهرة مطهرة لا يهذي شاربوها ولا يتشاتمون.خمر الآخرة كما يقدمها القرآن، فكيف خمر الدنيا؟ إنها تسبب السكر، وتبعث شاربيها على
العربدة والبذاءة.وقد وصفها القرآن الكريم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ *) (المائدة : ٩١ -
هذه.(۹۲
هي
فخمر الدنيا وخمر الآخرة شيء آخر تماما..وكذلك نعم الجنة لها أسماء نعم الدنيا، ولكنها تختلف
عنها كل الاختلاف ويراد بها النعم الروحانية دون النعم الجسمانية.وشتان ما بينهما! ولقد أدرك ذلك
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ليس في الدنيا مما
في الجنة إلا الأسماء" (تفسير ابن جرير ج ١).وأقول لمن يسأل عن السبب في استعمال القرآن لتلك الأسماء..مع ما بين نعم
ما بين نعم الجنة ونعم الدنيا من
مغايرة: إن القرآن الكريم يخاطب جميع طبقات بني الإنسان..الصديق والعدو، علية القوم وأرذلهم..ولذلك يحدثهم، وعلى الأخص في الأمور التي يتعذر فهمها على الناس، بلغة يفهمها ويطمئن إليها
العامة، وينتفع بها الخاصة، وتفحم الأعداء.وبالنظر إلى هذه الحكمة استعمل القرآن الحكيم في وصف نعيم الآخرة كلمات يجد فيها كل الناس
الطمأنينة والارتياح على قدر عقولهم ودرجاتهم.فحينما يقول القرآن المجيد إن للمؤمنين جنات ذات ظل
ظليل، وأنهارًا جارية، ولبنا سائغا لم يتغير طعمه وماء غير آسن وعسلا مصفى من الشوائب، وخمرا
نقية لا تسكر، مطهرة للقلوب..فإنه بذلك القول يرد على المعترضين قائلا: إن الأشياء التي تعدونها
متاعا وتعتزون بها هي أحط من النعم التي يتمتع بها المؤمنون في الجنة.إن أنهاركم التي تنعمون بها يأسن
۱۳۵
Page 218
ماؤها ويتعفن، أما أنهار المؤمنين فلا يأسن ماؤها.وإن الجنات التي تسعدون بها في الدنيا ليست بنعمة
حقيقية، لأن النعمة كل النعمة هي نعمة أهل الجنة الأخروية التي لن يصيبها الخراب.وإن الخمر الذي
تستلذون بها في هذه الدنيا إنما هي رجس وآفة تعطل العقل، أما الخمر التي يهبها الله المؤمنين فهي تشحذ
العقل وتورث الطهارة والتقوى والعسل الذي تفتخرون به تشوبه الشوائب، ولكن المؤمنين يأكلون في
الجنة عسلا مصفى.وإن الأزواج والرفاق الذين تتباهون بهم، إنما هم غير طاهرين ولكن الله يعطي
المؤمنين أزواجا ورفقاء طاهرين.إن هذه المعاني السامية البينة لا يدركها ولا يبلغ كنهها إلا كل من يتخلى عن التعصب ويتخلص من
الجهالة التي ليس إلى علاجها من سبيل.كان الأجدر بهؤلاء المعترضين النصارى أن ينظروا في كتابهم
المقدس حيث قيل لهم: "اكنزوا لكم كنوزا في السماء" (متى ٦: ٢٠).وقيل أيضًا: "فاذهب وبع أملاكك، وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء" (متى ۱۹ : ۲۱).إذا كان ادخار المال في السماء، ولقاء الكتر بعد الموت هناك ممكنا، فكيف كانت الجنات والأنهار
والعسل واللبن والخمر التي لا تسكر مخالفة للعقل؟
ولست أريد أبدًا بما سبق من البيان تجريد الحياة الآخرة من الجسم كليًا وكأنها ليست إلا روحانيةً،
ولا أن نعمها مقصورة على مشاعر القلب فقط كلا فإن الروح لا بد لها من جسم في كل الأحوال،
وإذا كان الجسم المادي الدنيوي يفنى بعد الموت..فإن الإنسان سيحظى في الحياة الآخرة بجسم يختلف
کی
عنه كل الاختلاف ولإدراك حقيقة الحياة الآخرة أوجد الله تعالى لنا في هذه الدنيا عالم المنام
نقدرها بعض التقدير.وقد أوضح القرآن المجيد العلاقة بين الحياة الآخرة وعالم المنام، وربط بينهما في
قوله تعالى : اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الزمر:٤٣).تدل هذه الآية على أن الموت والمنام متشابهان، وإنما الفارق بينهما أن الروح تفارق الجسم عند الموت
فراقا أبديا، وعند المنام تفارقه فراقا مؤقتا.وترى الروح خلال هذا الفراق المؤقت مناظر عديدة، وتجد لها
جسما جديدا وبيئة جديدة، وتحس بمختلف الأحاسيس، وتأكل وتشرب وتتحرك وتتمتع وتتألم.ومن ثم
يمكن لنا أن نقيس الحياة الآخرة على المنام قياسا قريبا.إن المناظر التي يراها الإنسان في المنام ليست روحانية خالية من الجسم، بل هي خليطة بالجسم..ويمكن أن نسميها شبه مادية، أو مادية على نحو ما، لأننا نرى لها جسما ملموسا.وهذه المناظر أو
الرؤى بتعبير أصح..تعبر عن حقائق معينة.والحق أن النعم الدنيوية صورة ممثلة للنعم الأخروية..بمعنى
الأصل، والنعم الدنيوية تمثيل لها وتصوير لحقائق ذلك الأصل.وإذا كان التمثيل
أن
نعم
الآخرة هي
Page 219
الدنيوي شهيًا لذيذا..فحدث عن الأصل الأخروي ولا حرج؛ إذ إن شعور الروح أقوى من شعور
الجسد وأشد.إن الكتب السماوية تأمر بالأعمال الحسنة من عبادات وإحسان كالصدقة والعفو وأمثالهما، ولكن
القرآن الكريم يمتاز عنها جميعا بأنه يأمر بالأعمال الصالحة..وهي أوسع معنى وأشمل نطاقا.إن تعاليم القرآن المجيد لا تكتفي بمجرد الأعمال الحسنة لتطهير الإنسان..بل من اللازم أن تكون
الأعمال صالحة.فالقيام بالعبادة طبق أوضاعها الظاهرة ليس مقبولا في ميزان القرآن..ما لم تكن تلك
العبادة نقية من شوائب الرياء.نعم، إن شعائر الصلاة عمل حسن، لكن دخول الرياء عليها يجعلها عملا
غير صالح..فلا يقبلها الله تعالى.ولو أن رجلا يحسن السباحة قام إلى الصلاة وهو يسمع صرخات
غريق..فإن صلاته ليست عملا صالحا، وإن كانت من حيث الظاهر عملا حسنا..لأن مقتضى
الأحوال يستدعي إنقاذ الغريق أولا وكذلك عفو القاضي عن الظالم، وصفحه عن المجرم دون مبرر،
وتفريق مال الأمانة على الفقير، وأمثال هذه الأعمال ليست من الصالحات وإن بدت حسنة المظهر.وملخص القول إن العمل الصالح أوسع معنى من العمل الحسن والعمل الصالح هو العمل الحسن..لا من حيث ظاهره فحسب، بل يجب أن يكون حسنا في حقيقته وباطنه ومحله.والقائم بالعمل الصالح
ليس هو الذي يتبع الكلمات على غير هدى، بل إنه الذي يستعمل عقله، وينظر في عمله كي يكون
طبق مقتضى الحال..والذي لا يقتنع بالقيام بعمل حسن، بل ينظر ويفكر في أن تكون أعماله الحسنة
مؤيدة للمصالح الروحانية أو المادية للجميع.ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بأسلوب رائع حيث يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
(الشورى: ٤١).وتتكشف هذه الحقيقة من أقوال النبي الله : عن أبي هريرة قال : سئل النبي : أي الأعمال أفضل؟
قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله" (البخاري، كتاب الحج).وقال ابن
مسعود سألت رسول الله لو قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال الصلاة على ميقاتها.قلت
ثم أي؟ قال: بر الوالدين؟ قلت: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ".(البخاري، كتاب الجهاد).فالرجل الذي أخبره النبي بأن الجهاد خير عمل بعد الإيمان كان يتقاعس عن الجهاد، فكان بناء
إيمانه وتقواه ناقصا، لا يدعمه العمل الصالح من الجهاد، فكأنه يوجهه ويقول له: إن الجهاد أولى
بحالك الآن وأصلح لها دون سائر الأعمال الصالحة التي تقوم بها.وحينما أوصى المصطفى الشخص الآخر بأن خير العمل هو إقامة الصلاة على ميقاتها، ثم
الوالدين ثم الجهاد، رأى أحوال المخاطبين الذين كانوا مقصرين في أداء الصلاة، ولا يقومون ببر الوالدين
Page 220
حق القيام..فكان الأصلح أن يؤمروا بإقامة الصلاة على ميقاتها وبرّ الوالدين..لكي يُسد الفراغ في بناء
أعمالهم.وقد بشر الله تعالى بهذه الآية ذوي الإيمان والعمل الصالح بالجنات وذلك لأن الإيمان كبستان يرويه
العمل الصالح..فينضر ويخضر.والذي لا يقوم بالأعمال الصالحة بعد أن يؤمن تحف شجرة إيمانه
وتذبل..يقول الله جل وعلا: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) (فاطر:١١).ويقول:
كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (إبراهيم : ٢٥).ويشير قوله تعالى : أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى أن لكل إنسان من أهل الجنة نطاقا
محددا من النعم لا يتدخل فيه أحد، ولكل منهم روضة مختصة به دون غيره يسقيها نهر يخصها، ولن
يكون كما نرى في هذه الدنيا أن نهرا واحدا يسقي عدة مزارع فيتنازع أصحابها في مياهه.أما قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فله عندي معنيان.الأول: أن الجنات تمثل الإيمان والثمرات تمثل لذة الإيمان، وحينما يؤتى أهل الجنة أثمار الجنة يقولون:
إنها حلاوة الإيمان الذي وهبه الله لنا في الدنيا، وإن إيماننا الذي آمناه لم يضع، بل إنه ما زال يثمر لنا
أحلى الثمرات.و من البين أن هذه الكلمات تفيض بعاطفة الشكر والامتنان وأليق بشأن أهل الجنة، وأولى وأحق
بعظمة الله
وكبريائه.فهم عندما يؤتون شيئا من الثمرات يذكرون نعمة الإيمان، ويرددون الشكر على
الله الذي أورثهم ذلك الإيمان وأعقبهم ثمراته..وكذلك لا يبرحون يشكرونه تعالى على تلك
النعمة التي يحظون بها بصورة ثمار روحانية لذلك الإيمان.فضل
والمعنى الثاني: أن قوله رزقنا يعني وعدنا به فالمؤمنون كلما أوتوا من ثمرات الجنة قالوا: هذه
الثمرات هي التي وعدنا في الدنيا وهذا الأسلوب وارد في القرآن في قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة: ٢٣٤)..حيث يعني قوله ما آتيتم أي ما قد وعدتم بإيتائه وعدا موثقا.وقوله تعالى: وأتوا به متشابها..فسره البعض بأن ثمرات الجنة تشبه ثمار الدنيا، أو أن الثمرات
تتشابه صورةً وتختلف مذاقا والأول باطل لأن التشابه بين نعم الجنة ونعم الدنيا معدوم بنص القرآن
الكريم وحديث الرسول..والثاني أيضًا باطل لأنه لا دليل عندهم على تشابه صور الثمرات واختلاف
مذاقها.وعندي أن المعنى الصحيح المناسب لذلك ما يلي:
أولا: أن لذة ثمرات الجنة ستكون كلذة العبادات والقربات التي قام بها المؤمنون في الدنيا.فالمؤمن
عندما يذوق شتى ثمرات الجنة ويتلذذ بها يقول: هذه اللذة مثل الصلاة التي أقمتها، وهذه اللذة مثل
٣٨
Page 221
الصوم الذي كنت أصومه، وهذه اللذة كلذة الحج الذي أديته..وهذه كلذة الصدقة التي كنت أتصدق
بها، وهذه اللذة كذلك العفو الذي تعاملت به مع الناس..وهكذا فإن الأعمال الصالحة كلها ستتمثل
لهم في الجنة، فتفيض قلوبهم بعواطف الشكر لربهم قائلين : إن ربنا الرحيم لم ينس كذا وكذا من صلاتنا،
وما أضاع كذا وكذا من صدقاتنا.أجل، إنهم سوف يشعرون في كل ثمرة يذوقونها أن الله تبارك وتعالى
أعمالهم حق قدرها، وسوف يتذكرون تلك اللذات التي تمتعوا بها عند قيامهم بتلك الأعمال
قدر
الصالحة.وثانيا: إن ما يُرزق به أهل الجنة من النّعَم والثمرات سيكون متشابه الخواص متوافق التأثيرات، وهو
بذلك يختلف عن أطعمة الدنيا التي تكون في كثير من الأحيان متضادة التأثير، فقد يكون أحدها مفيدا
للمعدة والآخر مجهدا لها، وقد يكون أحدها نافعا للقلب والآخر مضرا به.وكذلك الأعمال الروحانية
في الدنيا تعارضها وتعرقلها السيئات، فتتناقص هذه وتزيد تلك أو عكس ذلك..لكن غذاء الجنة
الروحاني يكون متشابه التأثير، كل عنصر من عناصره متوافق مع غيره، وكلها متعاونة على التقدم
الروحاني..وتكون الروح الإنسانية بريئة من كل الأسقام.وثالثا : أن غذاء الجنة سيكون بحسب القوى الداخلية للإنسان فينال كل واحد بغيته من الغذاء بما
يكفي متطلبات قوته الباطنية، ويهيئ له كل ما يحتاج إليه من غذاء لتقدمه الروحاني..فلن تزال قواه
الروحانية تنمو وتزدهر ولا تحول دون ذلك أية حوائل.وقوله ولهم فيها أزواج مطهرة هم الرفاق المطهرون، أو الأزواج من الإناث المطهرات، أو الأزواج
من الرجال المطهرين.وبالمعنى الأول فإنه كما يكون الغذاء متوافق الأنواع في الجنة..كذلك يكون أهل
الجنة متعاونين على التقدم الروحاني..وتكون الروح الإنسانية بريئة من كل الأسقام.فهناك أمن كامل
ناتج عن توافق باطني وتعاون خارجي.و كلمة الأزواج تطلق على الذكور والإناث، فيكون المعنى الثاني للجملة أن لكل واحد من أهل الجنة
زوجا صالحا..وليس ذلك مما يدعو للاعتراض..إذ إنه يحث الرجل على أن يرغب في زوجة صالحة،
والمرأة على أن يكون زوجها صالحا، لأنهما إذا رغبا في أن يكونا مجتمعين في الجنة أيضا، فعلى كل واحد
منهما أن يبذل جهده ليجعل زوجه صالحا..لئلا يفترقا في الآخرة..فيكون أحدهما في الجنة والآخر في
النار، وهذا المعنى من أروع التعاليم لنيل الطهارة الروحانية في الدنيا، وهو الأجدر بالتنويه..فضلا عن
أن يكون مدعاة للاعتراض.
Page 222
وإذا أردنا بذلك أنه في الجنة يكون لكل رجل زوجة مطهرة ولكل امرأة زوج مطهر فلا محل أيضًا
للاعتراض، لأن القرآن الكريم يصف هؤلاء الأزواج بالطهر، ولن يكون في الجنة ما ينافي هذه الصفة
أبدا.من
عندئذ
"
"
وقد تحدث المستشرق وليام موير والقسيس "ويري" عن هذه الآية بتعليق قذر حيث قالا: إن السور
المكية من القرآن تكثر من ذكر النساء في الجنة، بينما لا تذكر السور المدنية ذلك إلا قليلا.ويستنتجان
ذلك، والعياذ بالله، أن محمدا لم تكن له في مكة سوى زوجة واحدة أسنّ منه، لذلك كان يكثر
من تذكار النساء، لكنه في المدينة وجد بغيته فقلل من ذكرهن إن هذا المستشرق وليام موير
وأضرابه..عندما يلفقون مثل هذه التهم فإنما يرون نفوسهم وصورهم البغيضة في مرآة القرآن الكريم،
وهم يسلكون مسلك التعصب الصليبي المعروف لدى القساوسة.ومن العجيب أنهم يدعون الأمانة
العلمية، ويتباهون بالاستنارة والثقافة ومع ذلك تراهم يتهجمون بناء على أوهامهم الباطلة على مقامات
أهل القداسة عند الملايين من المسلمين..بينما يكون هؤلاء المعترضون أنفسهم ملطخين بحمأ الرذائل
ومنغمسين في أحط دركات الفجور والخلاعة..بما يندى له وجه الإنسانية.وما بعثهم على هذا التجرؤ
إلا شوكة الحكومات المسيحية في هذا الزمن.ألا يستحي هؤلاء المتهجمون على قدسية أطهر البشر؟! إن
المسلمين قد حكموا النصارى زهاء ألف عام..ومع ذلك ما صدرت من خليفة أو ملك مسلم إهانة أو
كلمة نابية بحق المسيح الناصري ال.ولو أنهم ذكروا هذه المنة من جانب الإسلام والمسلمين، وقللوا
(رضي
(رضي
الله
من اغترارهم بأنفسهم ما تهجموا على مقام سيد الأنبياء وصفوة المرسلين كالذئاب الضارية.والحق أن حياة النبي في مكة كانت أرغد من حياته في المدينة..فزوجته المطهرة السيدة خديجة
عنها كانت ذات ثراء عريض، وقفت كل مالها على خدمة الرسول.وكانت بناتها
المطهرات قد بلغن الشباب وتزوجن بمكة، وجُهّزن بأغلى الحلي..بينما تزوجت أصغرهن السيدة فاطمة
الله عنها) بالمدينة و لم تحظ ولا بحلقة من حديد.وبالجملة كانت الأوضاع المالية للنبي ﷺ في مكة
أحسن منها في المدينة.ولقد أنفق المصطفى الله جميع ثروة السيدة خديجة (رضي الله عنها) في سبل الخير
شيئا فشيئا حتى لم يبق له ذلك الرخاء في حياته المدنية.فلو كان الفرق بين حياته المكية والمدنية لبعض
الدواعي النفسية، لكان الأمر على عكس ما يزعم المستشرق المفتري وأشياعه.وإذا كان استدلال المتهجم الصليبي صحيحا كان معارضو المسيحية أحق بأن يقولوا إن "يسوع"
الناصري لم يكن يجد ملجأ طوال حياته، واضطر أن يفر من مكان إلى مكان خوفا من اليهود ولذلك
كان يتبجح بأنه سيكون ملكا لليهود وأنه كان يحلم دائما بالنساء الأبكار لأنه لم يتزوج طول حياته،
حيث جاء في إنجيل متى:
Page 223
"حينئذ يُشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس.وكان خمس
منهن حكيمات وخمس جاهلات.أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا.وأما
الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن.وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمن.ففي نصف
الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه.فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن
مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات : أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ.فأجابت الحكيمات
قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن اذهبن إلى الباعة وابتعنَ لَكُنَّ.وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس
والمستعدات دخلن معه إلى العُرس وأغلق الباب.أخيرا جاءت بقية العذارى أيضًا قائلات: يا سيد يا سيد
افتح لنا.فأجاب وقال: الحق أقول لكُنَّ إني ما أعرفكن" (متى: ٢٥ من ١ إلى ١٢).ولو أن المتهجمين فكروا بتدبر لعرفوا السبب وراء ما بين السور المكية والمدنية من فرق..ذلك أن
كفار مكة عيّروا المسلمين بالذل والفقر وحرمانهم مما بأيدي الكفار من نعم ومتع مادية..ولذلك رد
عليهم القرآن المكي بوصف الجنة التي اختص بها المؤمنون، وبين أن المسلمين سينالون في الآخرة متاعا
ونعيما أوفر مما يباهي به الكفار.ولما ثبت الله أقدام المسلمين في المدينة لم يسع الكفار أن يعيروهم،
لذلك تغير الأسلوب القرآني كما أن العهد المكي كان يمثل مرحلة تثبيت العقائد واستيفاء شرحها..ومنها عقيدة الجزاء الأخروي وما فيه من جنة ونار ولذلك أفاض القرآن في شرحها في السور المكية.وقوله وهم فيها خالدون يعني أن أهل الجنة لا ينفكون مقيمين فيها، ولن يذوقوا الفناء.وهذه هي
النتيجة المحتمة لما سبق ذكره من أن الهلاك يصيب الإنسان بسبب فساد الطعام والشراب أو بمؤثر
خارجي يقتله.لما كان غذاء الجنة متطابقا مع قوى الإنسان الباطنية وكان أهل الجنة أخيارا متحابين
متطهرين..فلن يكون هناك ما يؤذيهم أبدا، ومن ثم تغلق أبواب الموت نهائيا..ويحظى الإنسان بالحياة
الأبدية.6
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفَسِقِينَ
۲۷
Page 224
شرح
الكلمات :
يستحيي: حَيِي منه حياء احتشم استحيا حيي.الحياء: انقباض النفس عن شيء وتركه حذرا من
اللوم فيه.استحيا الأمر ومنه: امتنع عنه وانقبض منه (الأقرب).فقوله لا يستحيي أي لا يمتنع.يضرب ضربه بيده صدمه وأصابه بها.ضربه بالسوط جلده.وضرب له مثلا: وصفه وقاله وبينه.المثل: الشبه والنظير ؛ الصفة الحجة، يقال أقام له مثلا أي حجة الحديث؛ القول السائر؛ العبرة؛ الآية
(الأقرب).فوقها: الفوق من الأضداد، فإذا كان مستخدمًا في معنى الكبر فيعني أنه أكبر منه، وإذا كان مستخدما
في معنى الصغر فيعني أنه أصغر منه.ويمكن أن نأخذه هنا بكلا المعنيين أي ما هو أكبر من البعوضة أو ما
هو أصغر منها.يقولون : فلان أسفل الناس وأرذلهم؛ فيقال : هو فوق ذلك؛ أي أكثرهم سفالةً من ذلك
(الكشاف).الحق: ضد الباطل؛ الأمر المقضي؛ العدل؛ الملك؛ الموجود الثابت؛ اليقين بعد الشك (الأقرب).يضل أضله: غيَّبه؛ دفنه؛ أضاعه؛ أهلكه.أضل فلان الفرس والبعير : شردا وذهبا عنه ولم يدر أين
أخذا (الأقرب).أضل الله فلانا صيّره إلى الضلال وإضلال الله للإنسان على أحد وجهين: أحدهما أن
يكون سببه الضلال، وهو أن يَضلَّ الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق الجنة
إلى النار في الآخرة، والثاني من إضلال الله هو أنه تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعت طريقًا،
محمودا كان أو مذموما، ألفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه، ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى
على الناقل.وكل ما هو سبب في وقوع شيء صح نسبة ذلك الفعل إليه، فصح أن يُنسب ضلال العبد
إلى الله من هذا الوجه "المفردات الكليات".يضل به كثيرا أي بحسب تعاليم القرآن يحكم الله عليهم
بالضلال.الفاسقين: جمعُ فاسق.فَسَق: ترك أمر الله ؛ عصى وجار عن قصد السبيل، يقال: فسقت الركاب عن
قصد السبيل : خرج عن طريق الحق؛ فجر؛ يقال: فسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت.فسق فلان
ماله : أهلكه وأنفقه (الأقرب).الفاسق من يتنكب الطريق السوي الفسوق الخروج عن الدين؛ الميل
إلى المعصية؛ النسيان والترك لأمر الله؛ الخروج عن طريق الحق.وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها على
الناس وإفسادها (اللسان).وأكثر ما يُقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به، ثم أخل بجميع
أو بعضها.وإذا قيل للكافر الأصل فاسق..فلأنه أضل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة (المفردات).فالفاسق العاصي؛ التارك لحكم الله ؛ والرافض له؛ تارك الحق بعد قبوله.أحكامه
١٤٢
Page 225
التفسير : ذكرت الآية السابقة نعيم الجنة ومشابهته لنعيم الدنيا..ردا على تباهي الكفار بما لديهم من
متاع دنيوي، وبثا للطمأنينة في قلوب فقراء المسلمين.ولما كان نعيم الجنة أسمى من نعيم الدنيا في طبيعته
ودرجته ومقداره..فإن هذا لا يقاس بذلك أبدا إلا على وجه التمثيل وتقريب المعنى.ولقد
القرآن
صرح
الكريم بأن نعيم الجنة هو النعيم الحق، وأن حياة الجنة هي الحياة الروحانية الأسمى، وأن متع الدنيا ما هي
إلا قطرة من بحر متع الجنة.وتتضمن هذه الآية إزالة أية شبهة والإجابة على أي اعتراض بسبب هذا
الفارق الشاسع بين حقيقة الجنة وما يساق لها من وصف وتقول الآية إن أسلوب التمثيل مفيد في
تقريب الحقائق من الأفهام، وليس في استخدامه ما يدعو للاستنكار.والعلم في قوله يعلمون أنه الحق من ربهم يعني اليقين، لأن الفعل له مفعولان.وتدل الجملة على
أن المؤمنين يعرفون حق المعرفة على أنه هو الحق، لأنه من عند الله، أو أنه الحق لأنهم يحسون بهذه المتع
تماما كما يخبر الله تعالى إن نعم الجنة تشبيهات دقيقة لا تصوّر حقيقة تلك النعم، وإنما هي استعارات
فقط.يقال للرجل إنه جبل..إذا كان رابط الجأش ثابت الجنان، ولا يعني ذلك أن حقيقة الرجل هي
حقيقة الجبل، وإنما يراد أن مكانة الرجل في عالم الأخلاق كمكانة الجبل في عالم الأجسام.فالمؤمنون
ينوهون بصحة تلك الاستعارات ويعرفون مطابقتها لما يحسون به، ولكن الكفار على عكس ذلك لا
يشعرون بشيء منها، أو أنهم يرفضون العلم بها ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.واستنكارهم هذا
ليس إلا عن تعصب وجهل..لأن الاستعارة والتشبيه أسلوب معروف في كيان كل لغة، ويعتبرها
الكتاب البارعون من أروع الأساليب والحق أن المعاني اللطيفة غير المرئية لا يمكن تقريبها إلى الأفهام إلا
بالتشبيهات فالاستعارات والتشبيهات ليست مجرد أسلوب للتعبير عن المبالغة..بل إنها من ضروريات
اللغة الإنسانية، لأنها تقرب الحقيقة إلى الأفهام.وقوله يُضِلُّ به كثيرا ويهدي به كثيرا
كثيرا
يعني أن المؤمنين هم أبطال الروحانية الذين يتمتعون
بلذائذها، ولذلك يستشعرون بقلوبهم بعض حقيقتها عندما يقرءون تلك الاستعارات القرآنية.إنهم
تذوقوا طعم الصلاة، وعرفوا متعة الصيام، وتمتعوا بلذة الصدقات، كذلك جربوا نعيم هذه الأعمال.لقد
ذاقوا طعم العمل ولذة عقباه..ومن ثم فهم يدركون كنه المشابهة بين الثمار الجسمانية والملذات
الروحانية.لكن الكفار الذين حمد شعورهم الروحاني، وهم أبعد ما يكونون عن التلذذ بالعبادات،
وليسوا من تذوق نعم الله المنزلة في شيء، فمثلهم كالأعمى الذي توصف له الألوان فلا يتبين منها شيئًا،
ويستنكر الوصف!
وكما رأينا في معاني كلمة يضل فإن قوله يضل به كثير يهلكهم أو يدخلهم في عداد
الضالين.ويؤكد هذا المعنى قوله وما يضل به إلا الفاسقين.فالذين فسقوا يدخلون في زمرة الضالين
يعني
١٤٣
Page 226
ويلاقون مصيرهم.فالضلال ينشأ عن فعل الإنسان نفسه، والحكم الأخير الله تعالى الذي يقضي بأن هذا
ضال وذاك مهتد.الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ )
شرح
الكلمات :
ينقضون: نقض العهد والأمر: ضد أبرمه؛ أفسده بعد إحكامه (الأقرب).عهد: العهد الوفاء الضمان المودة؛ الذمة؛ الوصية؛ الموثق.عهد فلان الشيء: حفظه ورعاه حالا
بعد حال قيل هذا أصله ثم استعمل في الموثق الذي يلزم مراعاته (الأقرب).الخاسرون خسر التاجر ضد ربح خسر الرجل: ضلّ وهلك.(الأقرب)
وبهذه المناسبة أذكر أني بحثت في المعاجم والقواميس عن فعل "خسر" فلم أجده يستعمل إلا لازمًا،
ولكن العجيب أن جميع المفسرين فسروا كلمة خسروا أنفسهم متعدية بمعنى أهلكوا.أما صاحب
التاج) فيقول: "لا يستعمل هذا الباب إلا لازما كما صرح به أئمة التصريف".ثم يقول: "إن هؤلاء
الأئمة أخطئوا لأن القرآن استخدم هذا الفعل متعديا".الواقع أن الفعل لازم، ولكن الأسف أن معاجمنا وقواميسنا متأثرة بالدين حتى جعلوا اللغة أيضا تحت
تأثير التفسير، وهذا لم يخدم الإسلام شيئا وإنما أضر به..إذ اختفت بسبب هذا التصرف الكثير من
معارف القرآن عن أعين الناس ليت هناك من يشمر عن ساعد الهمة والجد ويصنف قاموسا لغويا حرا
تماما عن تأثير التفاسير الدينية، حتى يخرج الناس من هذا القيد الضاغط المجافي للحق..فيسهل عليهم فهم
القرآن الكريم!
فمثلا في قضية "خسر" لو أننا لم نخضع لرعب التفاسير، والتزمنا بقواعد اللغة..لحللنا هذه المسألة
بدون اللجوء إلى مخالفة القواعد الجعله متعديا.فيمكن أن نعامله معاملتنا لفعل "سفه" كما في قوله تعالى
سفه نفسه..بتقدير حرف جر محذوف تقديره "في"، أي سفه في نفسه؛ أو نعتبر كلمة "نفس" تمييزا
يأتي أيضًا معرفة كشاذ.كذلك في خسروا أنفسهم يجوز تقدير المعنى خسروا في أنفسهم، أو اعتبار
أنفسهم تمييزا.١٤٤
Page 227
التفسير: تبين هذه الآية بعضًا من صفات الفاسقين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة.فهم أولا:
ينقضون ما عاهدوا الله عليه وهم ثانيا: يقطعون الصلات التي أمر الله تبارك وتعالى بإحكامها، وهم
ثالثا: يثيرون في الأرض الاضطراب والفساد.أما
عن نقض العهد فيراد به أمران :أولا ترك التوحيد الذي يقوم على شهادة الفطرة الإنسانية والتي
أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) (الأعراف:.(۱۷۳
فالذين يعرضون عن هذه الفطرة السوية يقعون في هوة الشرك، ويكونون كمن ينقض ذلك العهد
الذي تعهدت به كل فطرة إنسانية من التمسك بالتوحيد.ثانيا، العهد الذي يأخذه كل نبي على قومه بأن يؤمنوا بأي نبي يرسله الله إليهم، وقد ذكر ذلك في
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ
مِنَ الشَّاهِدِينَ ( آل عمران: ۸۲).وفيما يتعلق بقطعهم الصلات فإن محبة الله تذوي في قلوبهم، ولا يرعون صلتهم بالله تعالى فتنقطع
علاقتهم به ويكون حبهم قاصرا على الدنيا وشهواتها.أما الصفة الثالثة، وهي الفساد في الأرض، فهي نتيجة حتمية لعدم إخلاصهم حتى في حب الدنيا..إذ
إنهم لا يحفظونها من الاضطراب والسوء، ومن ثم فهم الخاسرون من جميع الوجوه: فساد في الحياة الدنيا،
وضياع الحياة المخلدة في الآخرة.كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَنًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
تُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )
شرح الكلمات:
أموات: جمع
۲۹
ميت وميت.والميت من فارق الحياة؛ من لا حياة فيه أصلا (الأقرب).ولمزيد من
المعاني راجع شرح المفردات للآية رقم ٢٠).١٤٥
Page 228
التفسير قوله كيف تكفرون بالله عود إلى الموضوع الأصلي..الوحي الإلهي الذي ورد في قوله
تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.والكفر على نوعين: الكفر بذات الله تعالى، وكفر
بأحكامه أو ببعض صفاته، وهذا هو المراد هنا..أي الكفر بكلام الله تعالى.إن الحياة الروحانية مستحيلة بدون الوحي الإلهي، ولا يمكن للعقل أن يدرك وسائلها.فالآية الكريمة
تلفت الأنظار إلى ضرورة التفكر في أن الله تعالى قد هيأ للإنسان جميع الوسائل للحياة الدنيوية، فكيف
يمكن أن يحرمه من وسائل الحياة الأخروية..مع أنها هي الأهم والأسمى؟
وكنتم أمواتا...أي عدَما بلا حياة ولا وجود، فأحياكم..أي وهبكم الحياة وأوجدكم من
عدم ثم يميتكم..بأن يقبض أرواحكم، ثم يحييكم..أي يعيدكم إلى الحياة الآخرة التي بها
الرجوع إلى الله تعالى في نهاية المطاف.فكأن الإنسان يتعرض لأحوال أربع: عدم ثم حياة ثم موت ثم
عودة إلى الحياة يرجع بها إلى الله.وبهذه الآية يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه وقد أعطانا الوجود والحياة، ثم يسلبها منا..كيف يُستغرب منه
أن يعيدنا إلى الحياة؟ إن استحالة ذلك يناقض العقل.وإذا كانت الحياة الآخرة حقا..فلا بد أن يمدنا
من عنده بشريعة هادية، نستعد بها لتلك الحياة كما أمدنا بوسائل العيش في الحياة الدنيوية.وبهذه الآية أيضا يبطل الله تعالى زعم من ينكرون عذاب القبر ونعيمه.إن استعمال حرف ثم قبل
قوله إليه ترجعون إنما يدل على أن الميت يلقى حياة عاجلة بعد موته الدنيوي مباشرة وقبيل حشره.وهذه الحياة القصيرة لا تخلو من ثواب وعقاب..وإلا كانت مهملة ولا لزوم لها.فإذا كان فيها ثواب
وعقاب بصورة موجزة فقد تحقق وجود ثواب القبر وعقابه.والأحاديث النبوية تدعم هذا، كما أن
القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على هذه الحقيقة في قوله: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب (غافر : ٤٧)..أي أن آل فرعون يذوقون عذاب النار قبل
يوم الحشر والحساب النهائي، ونظرا للأسلوب الذي ذكرت به الآية وعد الحياة بعد الموت يمكن أن
تكون فيها أيضا إشارة إلى الموت القومي والحياة القومية؛ والمراد بأن العالم كان ميتا فأحياه الله بالقرآن،
وسوف يموت مرة أخرى وسوف يحيبه الله أيضًا مرة أخرى، وكأن الآية تتنبأ ببعثتين للإسلام؛ الأولى في
زمن المصطفى ، والثانية في هذا الزمن الأخير والتي أشير إليها في قوله تعالى: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا
يَلْحَقُوا بِهم (الجمعة).وبناء على هذا يعني قوله تعالى:
قوله تعالى ثم إليه ترجعون أن القيامة ستقوم بعد البعثة
الأخيرة للإسلام، ومن ثم فهي إشارة إلى أن الإسلام هو آخر الأديان، ولا دين سواه إلى يوم القيامة.١٤٦
Page 229
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
ج و
فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
شرح
الكلمات
استوى وسوى استوى صار سویا؛ اعتدل؛ لم يبق فيه نقص؛ زال اعوجاجه.استوى الطعام نضج.استوى الإنسان صار شابا أو بلغ الكمال.استوى الملك على سرير الملك: استولى عليه، يقول الشاعر:
"فلما علونا واستوينا عليهم.استوى علا وارتفع استوى إلى شيء اتجه إليه.فمعنى استوى إلى
السماء : قصدها سوى الشيء جعله سويا؛ صنعه مستويا.سوى به أو بينهما: عدلهما (الأقرب):
فمعنى سواهن خلقهن مراعيا كل ما يلزمهن.سبع يراد به الكثرة أيضًا لأن عدد السبع والسبعين تستعملان في اللغة العربية لمجرد الكثرة أيضًا.التفسير تخبر هذه الآية أن الإنسان لما جاء إلى حياته الأولى على الأرض..وجد أن الله تعالى قد هيأ
له كل ما في الأرض لكي يستخدمه وينتفع به، وهذه حقيقة قيمة قدمها القرآن وحده بهذه الصورة.فأولا: قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يبطل عقيدة الشرك.فكل كائن في
الأرض مخلوق لخدمة الإنسان..وبذلك بطلت ألوهيته، إذ من المستحيل أن يكون الخادم معبودا يؤله.ثانيا: فتح بذكر هذه الحقيقة أبواب التقدم في العلوم الطبيعية، لأن هذا العلوم تتوقف على البحث
والتنقيب، والآية الكريمة تقرر أن كل ما في الأرض مخلوق لصالح الإنسان، وبذلك تحقق الدافع القوي
للبحث الدءوب في كل النواحي..إذ ليس في هذا العالم شيء باطل دون فائدة.ويكشف العلم كل يوم
مصداق هذه الآية الكريمة..التي أزاحت الغطاء عن هذا المبدأ العلمي العظيم في تلك القرون المظلمة.ثالثا: إن كلمة جميعا تبين أن الشيء النافع إذا تركب من أجزاء..فكلها أيضا تدخل في باب
النافع للإنسان.وبذلك يدعو الإنسان لبحث تركيب الأشياء للانتفاع بمركباتها الأصلية أيضًا.رابعا: تشير الآية إلى أن كل ما في الأرض تراث عام لبني الإنسان قاطبة، فلا يصح استعماله بصورة
تجعله ملكا مقصورا على فرد واحد أو شعب واحد.إن الانصراف عن هذا المبدأ القيم هو الذي يؤدي
بالعالم إلى ما يتعرض له من دمار ولو أن الدول الكبرى طبقت تعاليم القرآن هذه لقضت على هذا
التحاسد والتباغض المتفاقم بين الشمال والجنوب، وبين الشعوب والطوائف والأفراد.لقد أسس الإسلام
نظامه الاقتصادي على قاعدة أن كل الأشياء في هذه الأرض مخلوقة لبني نوع الإنسان..للبشرية جمعاء.
Page 230
والملكية الفردية في الإسلام تخدم هذه القاعدة فهي لا تحرم سائر المستحقين منافعها، بل إن المالك
يستخدم ما يملكه فيما يعود عليه وعلى المجتمع البشري بالنفع والخير.ولقد حكمت هذه الآية الكريمة حكما بديعا في الجدل الجاري بين الأديان حول حقيقة الدنيا.فالهندوس يرون الحياة الدنيا نجسا تكون النجاة منها بالنفور منها، وعلى ذلك يؤسسون اعتقادهم
بالتناسخ، والخلاص عندهم يعني النجاة من الآلام.والمسيحية تزعم
أن الدنيا رجس يجب التخلص منه كما جاء في الإنجيل "فاذهب وبع أملاكك، أعط
الفقراء، فيكون لك كتر في السماء، وتعال اتبعني (متی ۲۱:۱۹).والبوذية تكره الأهواء والرغبات الدنيوية، والنجاة عندهم بالخلاص من هذه الرغبات.والزرداشتية
تقسم الدنيا إلى شر وخير وتزعم أن لها الهين خالق للخير وخالق للشر.فالديانات كلها ترى حقيقة الدنيا على أنها بلاء مكروه ينبغي التجنب عنه.ولكن الإسلام واليهودية
لا يريان الدنيا عقابا.والفرق بين الإسلام واليهودية أن اليهودية اتخذت الدنيا غاية تتوخاها، والإسلام
هو الدين الوحيد الذي يعلن بأن الإنسان قد خلق في هذه الدنيا لا ليفر منها..وإنما ليستخدمها
الاستخدام الحسن..لتكون وسيلة للحياة الآخرة والعجيب أننا اليوم نرى أولئك الذين تقول دياناتهم
بأن الدنيا نجس وشر يعضون عليها بالنواجذ.وفي قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات إشارة إلى أن الله بعد أن جعل كل ما
في الأرض ذا نفع للإنسان أعد للمنتفعين به انتفاعا صحيحا سبع درجات من الرقي، وهم الذين يحظون
بتلك المراتب العليا.والمراد بسبع درجات من الرقي درجات كثيرة، لأن عدد السبع يدل على الكثرة
أيضًا.وقوله : وهو بكل شيء عليم يشير إلى أن الله تعالى بعد أن جعل كل ما في الأرض نافعا للبشر..أيضًا نظاما يجازي به وينعم على من استعمل هذه الوسائل الأرضية الاستعمال الأمثل طبق
لا بد أن يضع
أوامره تعالى.وهذه العبارة دليل ناصع على صدق الإسلام إن القرآن كتاب الإسلام..هو كلام الله تعالى ولا
يناقض العلوم الطبيعية التي تشرح فعل الله تعالى في هذا الكون وما دام القول والفعل من الله تعالى..فلا
يمكن أن يحدث بينهما تناقض.لأن الله عليم بدقائق خلقه ما ظهر منها وما بطن.إن غاية العلوم الطبيعية
إدراك خواص الأشياء، ومعرفة تلك الخواص ستوطد دعائم صدق الإسلام ولن تضره شيئا.وإذا كانت
الديانات الأخرى تنظر نظرة عداء إلى تقدم العلوم وتتوجس منها خطرا يهدد بهدم بنيانها، فإن الإسلام
على عكس ذلك يزداد طمأنينة وسرورا..لأن كل ما يقدمه العلم دليل على صدق الإسلام.١٤٨
Page 231
وبعد أن أشار الله تعالى بقوله: فسواهن سبع سماوات إلى كثرة الدرجات الروحانية وتعددها، رمز
إلى أن سنة الارتقاء كما هي جارية في العالم الجسماني، كذلك هي سارية في العالم الروحاني أيضًا، وهو
منقسم إلى عدة أقسام، والقسم الأخير منها هو الذي ظهر فيه سيدنا ومولانا محمد.وفي حديث
الإسراء الذي رأى فيه النبي آدم الا في السماء الأولى، ورأى نفسه في السماء السابعة إشارة إلى أن
العلم
آدم هو الحلقة الأولى في سلسلة ارتقاء العالم الروحاني، وأن محمدا هو الحلقة الأخيرة منها.وكأن العالم
الذي كانت بدايته بآدم العلل اكتمل في شخص النبي.الروحي
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
صلے
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ )
شرح
الكلمات:
قال : القول يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق، مفردا أو
مركبا؛ الثاني : يقال للمُتَصَوَّر في النفس قبل الإبراز باللفظ؛ الثالث للاعتقاد نحو " فلان يقول بقول أبي
حنيفة "؛ الرابع: يقال للدلالة على الشيء نحو قول الشاعر : " امتلأ الحوض وقال قطني" (المفردات).وهناك أمثلة أخرى في اللغة لاستخدام القول لبيان حقيقة حادث، نحو قول الشاعر:
قالت له العينان سمعا وطاعة وحـــدرتا كالدر ما يُثَقَّب
وقول آخر:
قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع إلا حامـــــدا
(اللسان)
الخامس : يقال للعناية الصادقة بالشيء؛ السادس في الإلهام نحو قوله تعالى "قلنا يا ذا القرنين"
(المفردات).وقال الثعالبي : "ومن سنن العرب أن تعبر عن الجماد بفعل الإنسان كما قال الراجز: امتلأ الحوض
فقال قطني" (فقه اللغة)
149
Page 232
الملائكة: جمع
مَلَك، أصله مألك، وقيل هو مقلوب من ملاك، والملاك والألوك
ملك، والملاك والألوك هو الرسالة، ومنه،
الِكْني أَي أَبْلِغُهُ رسالتي.وقال: إنه من الملك.والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له مَلَك، ومن البشر يقال له مَلِك
(المفردات).عني رسالة.اسم
وقال البعض إن الملك من لأك، يقال: ألاكه إلى فلان إلاكة: أبلغه
أن الملك
رسالة.وهذا يعني
كان في الأصل ملاك ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال.(الأقرب).ألاك الشيء: أداره في فمه.ولاك الفرس اللجام عض عليه (التاج).وكأن الرسول يلوك الرسالة في فمه، أي يراجعها حتى لا
تفلت منه.ومنه سُمي الرسل الذين يأتون برسالة الله إلى الأنبياء ملائكة.فالملائكة
لكائنات تترل
برسالة الله إلى الناس، وتنفذ إرادته في الدنيا؛ أو اسم لكائنات شديدة القوى.خليفة: الخليفة جمعه خلفاء: يعني الإمام الذي ليس فوقه إمام؛ الذي يخلف ويقوم مقامه؛ السلطان
الأعظم أو الملك أو الحاكم والخلافة الإمارة النيابة عن الغير..إما لغيبة المنوب عنه أو لموته أو لعجزه
أو لتشريف المستخلف.والمعنى الشرعي للخلافة الإمامة.(الأقرب)
نسبح : سبَّح الله وسبح له : نزَّهه من العيوب والنقائص.وسبَّح صلى ؛ قال سبحان الله.(الأقرب).والتسبيح هو التنزيه الله من الصاحبة والولد؛ وقيل تتريه عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف به.وجماع
معناه: بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند (اللسان).ومعنى (سبحانك اللهم :
أنزهك وأبرئك يا رب من كل سوء وسبحانك مصدر يقوم مقابل الفعل؛ قيل: دل على التتريه من
جميع القبائح التي يضيفها إليه المشركون.وفي (العجائب للكرمني) أن سبحان مصدر سبح..إذا رفع
صوته بالدعاء والذكر والتسبيح قد يطلق ويراد به الصلاة والذكر والتحميد والتمجيد.وسميت الصلاة
تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله وتتزيهه من كل سوء (التاج).والسبح: المر السريع في الماء أو الهواء، والتسبيح تتريه الله تعالى، لأن أصله المر السريع في عبادة الله.وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر، فقيل أبعده الله وجعل التسبيح عاما في العبادات
قولا كان أو فعلا أو نية (المفردات).نقدس: التقديس التطهير.ومعنى قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نطهر الأشياء
ارتساما "أي امتثالا" لك.وقيل نقدسك أي نصفك بالتقديس "المفردات".والفرق بين السبوح
والقدوس، وهما من أسماء الله تعالى أن السبوح هو الذي نترهه عن كل سوء؛ والقدوس هو المبارك ذو
Page 233
البركة، الجامع للمحاسن كلها، والطاهر أي الطاهر بنفسه ويُطهر الآخرين (اللسان).فالفرق بين
التسبيح والتقديس، أن التسبيح فيه تتريه أما التقديس فيجمع التتريه والتعظيم.التفسير: يرى بعض المفسرين أن الخليفة المذكور هنا هو آدم اللي سماه الله خليفة لأنه قدر له أن
يكون نبيًّا منفذا لأحكام الله تعالى.وإني أرى هذا الرأي، ولكني لا اتفق مع من قال بأن الملائكة كانوا
سكان الأرض قبل آدم لأنه لا سند لذلك.وكذلك لا أتفق مع القول بأن الجن من غير البشر هم
السكان السابقون، فهو قول وادٍ وزعم لا دليل عليه.ولم تكن تسمية آدم خليفة بسبب مجيئه بعد
الملائكة أو الجن، بل هذا سبب باطل واءٍ، إذ إن الخليفة يصلح لأن يطلق على كل مخلوق يخلف مخلوقا
جاء قبله..والحال أنه لا يملك أحد تحديد بداية الخلق.كما لا يصح عندي القول بأن الخليفة هم ذرية آدم من بعده، لأن القرآن عندما أراد ذكر خلافة
الشعوب بعد آدم استخدم صيغة الجمع مثل قوله تعالى:
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ (الأنعام: ١٦٦)
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) (فاطر: ٤٠)
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ)) (يونس: ١٥)
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ) (يونس: ٧٤)
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ (الأعراف: ۷۰)
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ (النمل: ٦٣)
بعد أن أشار القرآن إلى اصطفاء المصطفى الله وبعثته إلى الناس بالقرآن الكريم الذي لا ريب فيه،
وهدى للمتقين، من عند الله تعالى..ذكر اصطفاء الله تعالى لآدم..فدل بذلك على أن نزول الوحي
السماوي وبعث الأنبياء ليس من البدع، بل إنه سنة مطردة منذ خلق الإنسان على هذه البسيطة، ولا
يزال مستمرا دون انقطاع، وأن آدم هو الإنسان الأول، ومعه بدأ نزول الوحي السماوي، وأن الله تعالى
لم يترك الإنسان مهملا مضيعا أبدا، بل ما زال قائما على هدايته منذ البداية.وبذكر قصة آدم مع الملائكة يقدم القرآن درسا مفيدا للناس فيما يتعلق بالوحي والنبوة، وهما من أمور
الغيب.فقد أشار الله تعالى بتساؤل الملائكة إلى حقيقة أن الناس عادة، قبل بعث نبي، لا يدركون الحاجة
إلى الوحي وإرسال نبي إلى أن يبعثه الله، فيتم رسالته، ويظهر للناس مدى حاجتهم إليه، وذلك بسبب ما
يحدث من تطورات تدفعهم إلى الاعتراف بأنه لولا ظهوره لظلت الدنيا محرومة من تطور نافع.إن
تساؤل الملائكة يشير إلى أنه حتى أمثال الملائكة لا يستطيعون إدراك حقيقة ذلك التطور العظيم الذي
يحدث في الدنيا بعد بعث نبي من الأنبياء، فما بالك بالأشرار والسفلة من الناس.فمن لوازم الحكمة ألا
ه
Page 234
يخالف المرء أمرا قبل وقوعه؛ إذا لم يمكن له الإيمان به، فعلى الأقل أن لا يعارضه، بل ينتظر حتى يتم
المبعوث مهمته، فإن يك صادقا تحقق صدقه بعمله، وأن يك كاذبا تبين كذبه بعمله.وقد ذكر القرآن
هذا المعنى على لسان واحد من قوم فرعون فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ)) (غافر: ٢٩).وقال: أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ *
يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل:
(۲،۳
جي
*
منه..وذكر الملائكة في هذا الوضع إشارة إلى دورهم في مهمة المبعوث السماوي.يخبرنا القرآن الكريم..وسائر الأديان تؤيده في ذلك، أن تدبير أمر هذا العالم يتم بإذن الله تعالى بواسطة الملائكة..فهم
مأمورون بإتمام الأعمال المختلفة..فهناك ملائكة لتنفيذ أوامر الموت، وملائكة موكلة بالكواكب
وحركاتها، وملائكة لتدبير الأمطار والرياح.وفي الأمر الإلهي للملائكة بجعل آدم خليفة ثم السجود له..إشارة إلى أن الملائكة مكلفون بتأييد آدم في مهمته كخليفة أو نبي، ولذلك فإن فلاح النبي في مهمته أمر
حتمي؛ إذ تسانده الملائكة المدبرون لنظام هذا العالم.ونرى في حياة الأنبياء من الشواهد ما يدل على
هذه الحقيقة.ففي نجاة نوح من ،الطوفان وسلامة إبراهيم من النيران واجتياز موسى البحر وهلاك
فرعون؛ ونجاة عيسى من الصليب، وانتصار رام" شندر جي" رغم إحداق أعدائه به، وغلبة "كرشن
" على أعدائه الجبابرة، وتغلب "زرداشت" على أعدائه الأشداء، وفوق كل ذلك كله وأعظم
مبارزة الرسول ﷺ لجميع العرب وهو وحيد منفرد، وانتصاره عليهم جميعا بصورة خارقة..في تلك
الحوادث كلها معجزات بينات لا ينكرها إلا العميان المعاندون، ودلالة على صدق هذه الحقيقة، وتذكير
للناس بأن الملائكة الذين أمروا بمساندة آدم مأمورون أيضًا بمساندة محمد ال في مهمته، وأنهم سوف
يحدثون تطورات حاسمة يترتب عليها الانتصار النهائي لرسول الله ﷺ بالرغم من كل العداء.وتشير الآية أيضًا إلى أن آدم خلق على هذه الأرض، وكانت مهمته في هذه الدنيا، وعلى هذه الأرض
ذاتها..وذلك بخلاف ما يزعم البعض من أن آدم أُدخل الجنة التي يدخلها الصالحون بعد موتهم.ومما
يدعوا للتعجب أن الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة، ومع ذلك يصر البعض على
دخول آدم في الجنة الموعودة في الآخرة.وقد قال بعضهم بأن الله خلق آدم أولا على الأرض ثم أدخله
الجنة..ولكن الآية لا تسيغ هذا القول، لأنها صريحة في جعل الخليفة في هذه الأرض.ومن البين أنه
يستخلف في الأرض من أجل هدف وغاية، ولا يتحقق ذلك بدخول آدم في الجنة.ه
و آيات القرآن الأخرى تدحض هذا الزعم فمثلا: يقول تعالى عن الجنة الموعودة بأنها لا لَغْوٌّ فِيهَا وَلَا
(الطور : ٢٤)..ولكن الجنة التي دخلها آدم دخلها معه الشيطان، وحرضه على معصية الله تعالى.
Page 235
يصف الله الجنة بقوله لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) (الحجر: ٤٩)..لكن آدم
أخرج من الجنة.وكذلك يقول عن الجنة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) (فصلت:۳۲)، ولكن آدم أُخرج من
الجنة بسبب اقترابه من الشجرة.وجاء في وصف جنة الآخرة تتبوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
نَتَبَوَّأُ
(الزمر: (٧٥ ، ولكن آدم أمر بألا يقرب الشجرة.تبين مما سبق أن جنة آدم اللي كانت على هذه الأرض، لأنه كان خليفة لأهل هذه الأرض، فكان
محتماً بقاؤه فيها حتى الموت.وقد اعترض بعض الناس على قوله وإذ قال ربك للملائكة..، فقالوا:
١.لقد استشار الله تعالى الملائكة، فهل يحتاج الله عز وجلّ إلى استشارة؟
٢.ارتاب الملائكة في حكم الله تعالى بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها..فهل لهم حق الاعتراض
على حكم الله تعالى؟.لقد تحقق قول الملائكة وأفسدت ذرية آدم في الأرض.وقبل أن أجيب عن هذه الأسئلة ينبغي أن نفهم معنى كلمة "قال".إن هذه الكلمة التي ترددت في
الآية لا تعني
أن الله عز وجل قد دعا الملائكة والناس إلى مجلس ثم وجه الخطاب إلى الملائكة؛ وإنما المراد
منها التعبير عن المُتَصَوَّر في النفس قبل الإبراز باللفظ، كما جاء في شرح الكلمات.وقد ورد هذا
الأسلوب في القرآن الكريم، كما في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا تَقُولُ
(المجادلة:٩).وهي أيضا تدل على لسان الحال كما جاء في القرآن الكريم: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ
دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (فصلت:۱۲).فليس من الضروري أن يكون القول الوارد في الآية الكريمة قد تم بصورة ظاهرة، وإنما أريد بهذا
الحوار تصوير لما جرى على لسان حال كل شيء من الاستجابة لحكم الله تعالى.وإذن فإن ما تحكيه آيتنا من قول إما مناقشة بلسان الحال، أو أنه تصوير للوحي السماوي الذي أنزل
على الملائكة، وهذا ما أرجحه وكل ما قال الله تعالى للملائكة إعلان بقراره تعالى لا يمت إلى
الاستشارة بصلة..لأن سياق الآية وألفاظها لم تذكر الاستشارة..لا صراحة ولا ضمنيا، فالآية تقول:
إني جاعل في الأرض خليفة ، فليت شعري! من أين استخرج المعترضون معنى الاستشارة؟ إن الله
تعالى أخبر ملائكته بالأمر كي ينشط كل واحد منهم في نطاق عمله لمناصرة آدم عليه السلام، ويدرك
الأمر الموجه له ويتفهم نواحيه الغامضة.فإذا استفسر عن شيء منها فليس ذلك عن اعتراض، وإنما
استزادة من العلم.ولا أدل على براءة الملائكة من تهمة الاعتراض من قولهم: ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك.
Page 236
ومن زاوية أخرى يمكننا أن نأخذ هذه العبارة كتساؤل شبيه بالاعتراض.ذلك أن آدم كما كان نائبا
لله تعالى، كذلك كان هناك أناس شبيهون بالملائكة..تجوز تسميتهم ملائكة.فيمكن أن يكون قد خطر
ببال هؤلاء أنهم ما داموا يعبدون الله عز وجل بقدر ما أتوا من العقل..فأي حاجة هناك لبعث إنسان
بالشريعة؟ وفي ضوء هذا المعنى تعتبر هذه العبارة ردًّا على ما خطر ببال هؤلاء من اعتراض.فكلما يبعث
الله نبيًّا فإن أصحاب الصلاح في الظاهر يفكرون بنفس هذا الأسلوب فمن كان منهم ذا تقوى حقيقية
يفطن لخطئه، ويؤمن بإمام زمانه وأما اللذين تنقصهم التقوى الحقيقية الكاملة فتزل قدمهم، ويخرجون
من صفوف الملائكة إلى صفوف الأبالسة.هذا المشهد يتكرر في زمن كل نبي..ففي زمن النبي ﷺ أيضا نجد شخصا اسمه زيد، وكان يدعي أنه
يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويدعو العرب قبل بعثة النبي إلى عدم الإشراك بالله تعالى.ومرة اجتمع على
الأكل مع النبي، فرفض الأكل معه بحجة أنه لا يأكل مع المشركين.فأجابه النبي بأنه لم يقع في
الإشراك بالله قط.وبعد فترة عندما ادعى النبي بأنه بعث رسولا من الله تعالى لم يوفق هذا الرجل إلى
التصديق به، وإنما قال: لو كان الله باعثا نبيا لبعثتي أنا الذي حاربت الشرك طيلة الحياة.(البخاري،
كتاب المناقب، مناقب الأنصار وسيرة ابن هشام
يعني
فانظروا كيف أن هذا الرجل الذي كان قبل بعثة النبي الله بمثابة ملك من الملائكة بين العرب..رفض
أن يؤمن به واعتبر بعثته عبثا وأمثال هؤلاء يوجدون في عصر كل نبي، ورغم أنهم يكونون فيما
يظهر ظلالا للملائكة..إلا أنهم يدخلون في الأبالسة بالاعتراض على بعث إمام زمانهم.أما المسألة الأخيرة..من حيث تحقق قول الملائكة وعدم تحقق قول الله تعالى..فهي أيضًا ناشئة عن
تفكير قاصر، فالله تبارك الله تعالى لم يقل بنفي الفساد وسفك الدماء، بل إن مفهوم سفك الدماء
والفساد متضمن في إعلان بعث خليفة.يقول الله صحيح أن بعث آدم كخليفة
أن أفعال الناس
سوف تقاس بمقياس الشريعة وسوف تعد بعضها فسادا وسفكا للدماء، ولكنه مع ذلك سيحقق غاية
عظيمة لا يمكن أن يحققها أحد من سائر المخلوقات.ويؤكد هذا قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون..حيث لم يخطئهم في دعواهم، بل قال : هناك شيء أعرفه ولا تعرفونه.وهكذا وجد الملائكة الجواب على
سؤالهم كما تحقق ما أخبرهم الله
ورب سائل عن قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء..أيتصل هذا القول
بآدم أم ببعض من بعث إليهم، أم بذرية آدم المقبلة؟
به.والجواب عن ذلك أن هذه الجملة تتصل بهؤلاء الثلاثة جميعا.أما علاقتها بآدم فلأنه أول الأنبياء،
وعلى يده جاءت الشريعة قيدًا على الإنسان ومن البين أن من يتولى أمر تطبيق النظام قد يعمد أحيانا
١٥٤
Page 237
إلى سجن بعض الأفراد، وقتل المجرمين منهم..توطيدا لدعائم النظام، وقد يفرض الضرائب عند
الضرورة.وهذه التصرفات قد تبدو بادئ النظر نوعا من الفساد عند من لا يعرف مصالح النظام،
وعندئذ يتساءل متحيرا: كيف يجوز الاستيلاء على أموال الناس بالإكراه؟ وكيف يسجن الأحرار ويقتل
الأحياء؟ ولكن لا يمكن أن يقوم بتثبيت قواعد الأمن من دون فرض الضرائب وسجن المجرمين وقتل
القاتلين.وأما علاقة ذلك القول بمن بُعث إليهم آدم وبذريته المقبلة، فذلك لأن حدود الشريعة هي التي تميز
المسيء من المحسن، والمذنب من البريء.إن الحيوان يفترس ويقتل ويلدغ ولا يُعدّ مفسدا، لأنه محروم من
العقل الذي يفرق بين الخير والشر، ولا يخضع لحدود الشريعة.وهكذا كان البشر قبل آدم، فإذا بلغ
الإنسان من العقل مبلغًا يؤهله لاتباع الشريعة..كان عندئذ التمييز بين المفسد والمصلح، وأصبح منذ
ذلك الوقت مطالبا على لسان آدم ألا يعتدي على حق غيره ولا يفسد في الأرض، وأصبح الحاكم المنفذ
للشريعة مسئولا عن إعطاء كل ذي حق حقه.ومن خالف الشريعة فهو المفسد أو سافك الدماء..الأمر
الذي لم يكن معروفا قبل الشريعة.سم.ومن الطرائف الغريبة أن الإنجيل أشار إلى هذا المعنى ولكن بصورة ناقصة في رسالة بولس إلى رومية."..لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد..على أن الخطية لا تحسب إن لم
يكن ناموس" (صح: ٤،٥).ولقد استدلت المسيحية بهذا المعنى الناقص استدلالا خاطئا إذ ظنت أن
الشريعة محض عقاب، وأن المسيح الناصري هو الذي نجى الإنسان من هذا العقاب.وهكذا تغافلوا عن
أن الخطيئة سم.وهي ليست سما لأن الشريعة حسبتها كذلك، بل لأنها في حد ذاتها ولذلك عدها
الله تعالى معصية.إن وصف السم بالسمية لا يزيد من مضرته، بل إنه يفتح أمام الإنسان أبواب اجتنابه
والنجاة منه.إن الطفل الصغير محروم من الوعي والشعور الصائب، ولذلك كانت أفعاله حرة مطلقة من
المسؤولية، فإذا فعل ما يؤذيه أو يؤذي غيره، فليس بمسؤول عن فعله، لا لأن ما فعله ليس بشر..وإنما
لأن الطفل لا يقدر على التمييز بين الخير والشر.وعندما يبلغ الطفل مبلغ الإدراك والفهم الواعي يُحكم
على فعله بالصواب والخطأ، وعلينا عندئذ أن تعلمه الأوامر والنواهي..أي ماذا يفعل وماذا يترك، وعليه
أن يعمل وفق ما نعمله..فإن فعل أصاب، وإن خالف أخطأ.وقصارى القول: إن سؤال الملائكة يعني أن حالة البشر سوف تتغير بعد نزول الشريعة وتعيين
خليفة، وعندئذ سيكون منهم مفسدون وسفاكو دماء طبقا لهذه الشريعة وما كانوا من قبل الشريعة
يدانون على مثل هذه الأفعال..فاستفسارهم هذا في محله ويحتاجون شرحه وبيانه.ولم تكن الحكمة
الإلهية ترمي إلى إدانة الإنسان ووصمه بالإجرام، وإنما كان الفكر الإنساني قد بلغ عندئذ من التقدم
100
Page 238
والدنو من الكمال بحيث تترك أفعاله هذه أثرا سيئا في قلبه، فلذلك أراد الله تعالى أن يترل على البشر
وحيه، فيصطفي آدم من بينهم خليفة ليقود البشرية إلى مكانتها المرموقة، ويسعى إلى تلك المثل العليا التي
أصبح الإنسان أهلا لها.وهنا نقطة جديرة بالذكر..فكل ما قاله عز وجل عند استخلاف آدم قول صحيح تماما..وتساؤل
الملائكة أيضًا تساؤل صائب..والاختلاف بينهما إنما هو من ناحية وجهة النظر فقط.فالله تعالى كان
يرى من استخلاف آدم تجليا عظيما لظهور سيدنا ومولانا محمد..فآدم هو المرحلة الأولى لوضع
البشرية على طريق الكمال الذي يصل إلى ذروته في شخص خاتم النبيين ، بينما كانت الملائكة
تخشى على البشرية من أجل مظاهر الشر المصطبغة بصبغة أبي جهل وأمثاله.إن تأسيس الخلافة سيكون مدعاة لإنزال العقاب بطائفة معدودة من المفسدين والقاتلين، ولكن هناك
طائفة أخرى قدر لها أن تتفوق على الملائكة أنفسهم، وتنال محبة الله والقرب منه.وهذه الطائفة الناجحة
أحد
هي
الغاية من خلق هذا المجتمع الإنساني المنظم.ولوجود هذه الطبقة الممتازة من البشر..لا يجرؤ
على الادعاء بفشل النظام البشري، بل إن كل واحد من أفراد هذه الفئة العليا لجدير بأن يُخلق هذا
أجله.وأعلاهم شأنا وأحقهم بذلك..هو محمد ﷺ، الذي خاطبه الله تعالى فقال له: "لولاك
النظام من
لما خلقت الأفلاك".الله
هذا الحديث القدسي ورد في حق المصطفى ، وقد تلقى أشخاص كمل إلهامات مماثلة.وهؤلاء
الأبرار الكاملون لدليل على أن مشيئة هي الحكيمة، وأنه لم يكن لمخاوف الملائكة أي وزن.وقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يُبطل الظن باعتراضهم على الله تبارك وتعالى،
فهم الحامدون المقدسون، وما كان لحامد مقدس الله أن يعترض على أمر منه عز وجل..إنما هم
يتساءلون عن ذلك لفهم حقيقة الأمر لا غير.ويمكن أن يكون لهذه العبارة معنى آخر، فالملائكة يعبرون بقولهم هذا عن الشك في كمال عبادتهم لله
قائلين: إننا نحمدك ونسبحك ونقدس لك بما في وسعنا، ولعل ضعفًا قد حدث في عبادتنا هذه، فاقتضى
ذلك خلق كائن آخر يكون ظلا لك.ومن ناحية هذا المعنى لا يكون في قول الملائكة مظنة الاعتراض،
وإنما هو مظهر لطيف رائع لخشية الله تعالى، وهو الأجدر بشأن المقربين عنده عز وجل.وقوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون جواب محمل كاف لإقناع أمثال الملائكة المقربين..لأنهم
يعرفون عظمة الله عز وجل.فلما قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون من المصالح العظيمة في خلق آدم
أيقنوا بأنه هو الحق.ثم أراد الله تعالى أن يبين ذلك للأجيال المقبلة من بني آدم، ولذلك أورد جوابا
مفصلا كما سنرى في الآيات التالية.
Page 239
وجدير ذكره أيضًا أن القرآن الكريم يتميز عن الكتب السماوية الأخرى بأنه يجمع بين التسبيح
والتحميد والتقديس.إن التسبيح يتضمن التنزيه عن العيوب، وأهل السمو لا يقنعون بصفات التتريه،
لأن الكمال يتطلب الصفات الإيجابية الحقيقية.إن نفي بعض العيوب لا يعطي الصورة الحقيقية، ولكن
ذكر الصفات الثابتة الإيجابية هو الذي يجلي الحقيقية.فمثلا لو قلنا إن الله تبارك وتعالى ليس بمادة، وأنه
لا يجوع ولا يعطش، ولا يأخذه نوم ولا يطرأ عليه ،موت ولا يخضع للأهواء..تبين للسامع من قولنا
هذا أن الله تعالى مختلف عن سائر الموجودات بعض الاختلاف..ولكن لا يستبين له من ذلك عظمة الله
وكبرياؤه بحيث يقدره حق قدره.لقد اهتمت الديانات البدائية بناحية التتريه والتسبيح، لأن العقل الإنساني لم يكن قد بلغ عندئذ مبلغا
من كمال النشوء بحيث يدرك ناحية الحمد والتقديس.ولكن القرآن الكريم لم يُول الصفات الإلهية
التتريهية اهتماما كبيرا، وإنما أعطى الناحية التقديسية أعظم الأهمية، وبها يقدم للناس صورة واضحة جلية
للصفات الإلهية لم يسبق لها مثال في الوضوح والشمول والتمام، بحيث يعرف الإنسان عن ربه ما يملأ
قلبه حبًا وإجلالا لصاحب الحمد المطلق والقداسة التامة.وعلى سبيل المثال يقول القرآن الكريم عن الله
تعالى أنه : لا يَمُوت (الفرقان: ٥٩) لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ (الإخلاص: ٤)، لا يُطعم
(الأنعام: ١٥) ، لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) (البقرة:٢٥٦).إذا تأملنا هذه الصفات السلبية وجدناها لا تتحدث في الحقيقة عن عظمة الله، وإنما هي صفات تبطل
معتقدات الشرك الشائعة في النصارى وأمثالهم من المشركين، الذين كانوا يصفون الله تعالى بصفات
البشر.لقد صرح القرآن في هذه الآيات أن الآلهة التي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، وتولد من بطون
الأمهات، وتتزوج وتنجب وتنام ويغلبها النعاس من التعب..ليست من الله تعالى في شيء..إنه متعال
عن كل ذلك علو كبيرا.أما صفته لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (الشورى: ۱۲)، فهي أيضا ليست سلبية محضة، وإنما تبين أن الله
تعالى ذكر لنا في القرآن الكريم صفاته الإيجابية الذاتية بصورة تقربها إلى فهمنا، ولكن علينا ألا ننخدع بها
ونحسبها تشابه صفات الإنسان فإنها في الحقيقة مختلفة عنها تمام الاختلاف إن الله تعالى متكلم، ولكنه
لا يتكلم بالكيفية التي يتكلم بها البشر بحيث يحتاج إلى لسان وحلق وشفاه وما إلى ذلك أدوات
النطق البشري.وهو يسمع ويبصر، ولكنه ليس كمثله شيء في سمعه وبصره.وهكذا يعرفنا القرآن
بالصفات الإلهية الذاتية مع بيان اختلافها عن الصفات البشرية.الكريم
من
إن قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إشارة إلى ما يراه ذوو العرفان الكامل من عباد
الله المقربين.إنهم لا يرون الله تعالى عن طريق صفاته التريهية السلبية، بل يتشرفون بعرفانه عن طريق
١٥٧
Page 240
صفاته الحقيقية الإيجابية.كما أنه إشارة أيضًا إلى أن القرآن الذي يؤكد على وجود هذه الصفات
الإيجابية الحقيقية..سيكون ذريعة إلى خلق المظاهر الملائكية التي تهتم بالحمد والتقديس مع اهتمامهم
بالتسبيح، وأنها ستقرب الوجود الإلهي إلى عباد الله بصفاته المتصلة بتجلي قدرته تعالى، ولن يقتصر
اهتمامها على صفاته التتريهية السلبية التى تجعله جل وعلا، كما لو كان وجودا خفيا متواريا منقطعا
عن عباده.والحق أن الاتصال الكامل بالله عز وجل لا يمكن إلا بالتفكر في صفاته الإيجابية والانتفاع بها، ومن
يتمسك بالتسبيح فقط فإنما يعترف بأن الله تعالى وجودا أسمى؛ لكن الذي يسبح بحمده فإنه يراه إلها حيا
فعالا، ويُحظي به الآخرين أيضًا.الله
لقد علم
عز وجل أمة الإسلام بقول الملائكة هذا درسا عظيما، فعلى المسلمين ألا يكتفوا بتتريه
الله تعالى بالصفات السلبية بل عليهم أيضًا أن يذكروه بالصفات الإيجابية كي يستفيدوا منها ويحمدوه
بها، ويكونوا بذلك الجواب العملي على تساؤل الملائكة، والبرهان الفعلي على أهمية خلق البشر بتفوقهم
في التسبيح والحمد ويصبحوا شهادة حاسمة على كمال حكمة الله عز وجل.بعض مفاهيم الآية على ضوء آيات أخرى
أولا: إن آدم عليه السلام هو الحلقة الأولى من سلسلة النظام الإنساني، بدأ الله به نزول الوحي
السماوي إلى الناس حسبما ورد في القرآن الكريم.وأود أن أكشف الغطاء عن أن آدم المذكور في هذه
الآية لم يكن أبا البشر الذي بدأ به خلق الإنسان، فالقرآن الكريم لا يصدق هذا الزعم، ولا يقول بأن الله
تعالى خلق آدم دفعة واحدة، ثم خلق زوجه حواء من ضلعه..بل إن ذلك القول مأخوذ من التوراة
وغيرها من الكتب، وعزوه إلى الإسلام افتراء عليه جاء في التوراة: "وقال الله: نعمل الإنسان على
صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى
ميع الدبابات التي تدب على الأرض.فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه، ذكرا
وأنثى خلقهم، وباركهم الله، وقال لهم : أَثمروا وأَكثروا واملئوا الأرض..وغرس الرب الإله جنة في عدن
شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله..وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا
نظيره..وأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب
الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من
لحمي، هذه تدعى امرأة، لأنها من امرئ أخذت".(سفر تكوين،صح ١ و٢)
وتقول الكتب الهندوسية إن خلق الإنسان تم بصورة زوجية، إما بانشطار الإله إلى شطرين عند
البعض، أو بانقسام "براهما" عند الآخرين، ومنه انتشر النوع الإنساني.
Page 241
إن قصص خلق الإنسان هذه جاءت بأسلوب المجاز، ويبدو أن الكتاب المتأخرين ألحقوا بها زيادات
هنا وهناك من عند أنفسهم فجاءت بهذه الصورة الأسطورية.ولكن هناك تشابها بين مختلف القصص
الواردة في كتب الهندوسية، وتتفق في خطوطها العامة.وقام "دارون" أحد علماء وفلاسفة العصر الحديث، بتقديم النظرية القائلة بنشأة جرثومة الحياة على
الأرض، ثم أخذت تنشأ وتنمو بعد عدد من التطورات المتتابعة عبر زمن طويل إلى أن وصلت إلى طور
الحيوانات المتنوعة، وأخيرا وصلت إلى نوع أشبه ما يكون بالقرد، ومن هذا النوع الحيواني تطور وجود
الإنسان.فطبقا لهذه النظرية، مثل خلق الإنسان الحلقة الأخيرة من نشوء بذرة الحياة، ولم يخرج إلى الحياة
دفعة واحدة.ولقد حاول بعض العلماء الألمان والفرنسيين المعاصرين تصوير المعتقدات الهندوسية والبابلية القديمة
بقوالب علوم طبيعية..فقالوا إن وجود الله هو الذي نشأ وتطور إلى وجود الإنسان، أو بعبارة أخرى:
إن مبدأ النواميس الأزلية هو الذي تحول إلى صورة الإنسان..الذي هو آخر طور من هذا الارتقاء
المطرد.أما القرآن فقد اختار طريقا بديعا لكشف أسرار خلق هذا الكون وإزالة الستار عن حقائقه الغامضة..يختلف عن سائر هذه الآراء.يتبين من تعاليم القرآن أن سنة الارتقاء والتطور جارية في العالمين الروحاني
والمادي دون مراء، وأن العالم المادي قد بلغ منتهى أوج كماله بعد تطورات ارتقائية طويلة، وكذلك
وصل العالم الروحاني إلى قمة كماله بعد أن طوى مراحل الارتقاء الطويلة ولكن القرآن الكريم لا يسلم
بأن الإنسان كان آخر حلقة من سلسلة الارتقاء في الحيوانات المختلفة وإنما يقول بأن التطور الإنساني
مستقل بنفسه ومنفصل عن غيره من التطورات، وأنه ليس مجرد مظهر صادف التطور الحيواني، ويتبين
قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
من
الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا)) (نوح: ١٤ -
ذلك.(۱۹
يتبين من هذه الآية ما يلي:
١.تدل كلمة أطوارا على أن خلق الإنسان قطع أحوالا وحدودا ومراحل عديدة قبل أن يكتمل..أن خلق الإنسان بدأ قبل خلق السماوات والأرض، وأن مراحله الأخيرة كانت من الأرض بعد
ذلك..أي أن مراحل الخلق الإنساني بدأت على صورة ما حينما كانت السماء والأرض مجرد دخان، ثم
تطورت هذه الصورة فيما بعد إلى أن اكتملت صورة الإنسان على الأرض بعد خلق السماوات
والأرض.
Page 242
3.أنه بعد أن تجمعت المادة الدخانية وتكونت منها السماوات والأرض، دخلت مرحلة جديدة في
خلق الإنسان، فبرز فيها وجوده من بطن الأرض إلى ظهرها كمثل النبات الضعيف الذي لا يتحرك
ويستمد غذاءه من رطوبتها، ثم أخذ يتحول شيئا فشيئا إلى صورة وجود متحرك.٤.أن ما يجري على الإنسان بعد موته لدليل على صدق ما يقرره القرآن بهذا الشأن.فالجسد يتحول
إلى تراب الأمر الذي يشهد على أن بدء الخلق كان من الطين.ثم يقول : إن موت الإنسان وتحوله إلى
أن
التراب لا يعني جميع أجزائه تفنى وتفقد الحياة، بل يُبقي الله تعالى منه تلك الحالة المتطورة الدائمة بعد
خلقه من الطين..والتي يعيدها إليه ببعثة أخرى يحاسب فيها الإنسان بأعماله.ومجمل القول إن خلق الإنسان بحسب تعليم القرآن لم يكن دفعة واحدة ولا في وقت واحد، بل إنه
تعالى أسس بنيان خلقه منذ بدأ خلق النظام الكوني ، ثم أنبته من الأرض نباتا متطور النشوء في مختلف
الأزمان، وأعطاه الصورة الإنسانية، ووهب له العقل والشعور.ويذكر القرآن للإنسان حالة أخرى سابقة لتلك، وهي التي لم يوجد فيها حتى ولا جرثومته البدائية أو
ذراته الأولى..فيقول : أَوَلا يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا)) (مريم: ٦٨).وفي هذه
الآية يقرر أن الله تعالى مؤلّف مادة الخلق الإنساني بعد أن خلقها من عدم.وآيات القرآن الكريم تتناول موضوع الخلق مشيرة إلى مراحله المتعددة، منها مثلا:
* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب (فاطر: ۱۲)
الَّذِي أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (السجدة: ٨)
* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً)) (الفرقان: ٥٥)
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) (الأنبياء: ۳۱)
* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين (السجدة: ٩)
ويتبين من هذه الآيات أن المرحلة الأولى لخلق الإنسان كانت نشأته
دور
نشأته بهذا الطريق أخذت ذريته تتناسل من ماء مهين مِنْ مَنِي يُمْنَى)) (القيامة : ٣٨).من الطين، ثم لما تطورت
ويتضح أيضًا أن دور نشوء الإنسان من الطين يختلف عن دور تناسله من الماء المهين.ثم إن القرآن فيما تحكيه آياته يبين لنا أن خلق الإنسان لم يكن بنشأة متطورة من الحيوانات الأخرى،
بل إن الجرثومة الإنسانية منذ بدء الخلق كانت مستقلة بذاتها، مختصة لتكون بصورة الإنسان، فالله تعالى
يقول في الآية إن ذرية الإنسان أخذت في التناسل بعد أن صار الإنسان بشرا سويا، ولكن التسليم بنظرية
"دارون" يستلزم الإقرار بأن الإنسان كان يتناسل عن طريق الحيوانات حتى قبل أن يبلغ مبلغ البشرية.
Page 243
وهناك آية أخرى تدلنا على حالة الإنسان قبل أن يكون بشرا..قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْأَنْسَانِ
حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً) (الدهر : ۲)..أي أن الإنسان في هذا الدور من حياته لم يكن قد
نشأت فيه القدرة الفكرية، ولم يكن عندئذ كائنا ناطقا عاقلا، وإنما كان كائنا منطويا على قوة كامنة
للتقدم والتطور..ثم تقول الآية التي تليها: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ )) (الدهر:٣).وفي هذا إشارة إلى
أن تناسل الإنسان من خلال النطفة قد بدأ بعد أن ظهر بصورة الكائن الحي، وكانت نطفته هذه
أمشاجا، أي خليطا من القوى المتنوعة التي تميز النطفة الإنسانية عن نطفة سائر الحيوانات.ونطف
الحيوانات الأخرى ليست بأمشاج، أي أنها ليست خليطا من قوى مختلفة، لذلك فليست الحيوانات
قادرة على اختيار طرق مختلفة.ولكن البشر الذين خُلقوا من نطفة أمشاج فهم مختلفون في أمزجتهم،
وقادرون على الاختلاف في اختيار الطرق.أما القرد فيتمتع اليوم أيضا بنفس القوى التي كان بها
يتمتع
قبل آلاف السنين، وكذلك الأسد وسائر الحيوانات الأخرى..ولكن ذرية الإنسان المخلوق
نطفة
من
أمشاج اختلفوا عن آبائهم في أفعالهم وقواهم، فأصبحوا قادرين على التقدم المستمر في العلوم والفنون.وكأن في كلمة نطفة أمشاج إشارة إلى كون الإنسان حيوانا ناطقا.وتكتمل الآية بقوله: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيراً (الإنسان:۳).وهاتان الصفتان تدلان على المبالغة والكمال، وهما ميزتان تختصان بالإنسان دون سائر الحيوانات.الحيوان يسمع ولكنه ليس سميعا لأنه لا يعقل ولا يفكر في ما يسمع.وهو يبصر، ولكنه ليس بصيرا،
لأنه لا يتفكر فيما يرى ولا يُعمل عقله فيه.وهكذا فإن آدم كان أول مظهر لتلك القوى المودعة في
النطفة الأمشاج والتي تجلت في الصفتين: السميع والبصير.ولا يراد بالآيات السابقة النفي المطلق لوجود البشر قبل ،آدم بل إنها تدل على أن الجنس البشري
كان موجودا ،قبله ولكن لم يكن أحد منهم مُتَصفًا بهاتين الصفتين غير آدم ال، لأن قواهم لم تتطور
إلى حد يؤهلهم لسماع كلام الله تعالى والنظر في آياته ومظاهر قدرته، فلذلك لم ينزل إليهم عندئذ
الوحي السماوي، ولم يظهر الله لهم آياته الخاصة بالشريعة.ولما ترقى الإنسان وتقدم في نشأته حتى صار
سميعا بصيرا..اصطفاه الله لكلامه وشرفه بوحيه.وقد ورد في القرآن الكريم ما يوضح المراد بهاتين
أنهما تدلان على النظر الفكري والفهم لآيات الله وتدبرها..قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخَبْتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (هود: ٢٤، ٢٥).الصفتين من
Page 244
فالسميع البصير هو من عرف آيات الله فآمن بها وعمل الصالحات، وأما الذين لا يفطنون لها، أو لا
يدركونها، أو يتعامون عنها ويعرضون..فهم عمي صم.مما سبق من الآيات يتبين أن خلق البشر، كما يقدمه القرآن الكريم، لم يكن دفعة واحدة، ولم يبدأ
بخلق آدم العل، بل إن آدم كان أول مظهر لحالة الكمال البشري التي استحق بها أن يدعى إنسانا حقيقيا
جديرا بحمل الشريعة.وبذلك جاز أن يكون آدم أبا البشر من الناحية الروحية، لأنه المبتدأ للعالم
الروحاني، وكان أول إنسان تشرف بالوحي الإلهي، ولكنه ليس بالمحتم أن يكون أبا للبشر من الناحية
الجسمانية، بل من الممكن أن يوجد عندئذ بعض بني نوع الإنسان من نسل أناس آخرين من البشر،
منهم من آمن بآدم ومنهم من لم يؤمن به في حياته، ولكنهم لا زالوا يدخلون في نطاق المطالبين بالإيمان
وإذا تأملنا بعض آيات القرآن التي تتناول خلق آدم لتبين لنا أن النوع الإنساني لم يبدأ به، وأن كثيرين
من البشر كانوا موجودين في عصره..منها قوله تعالى:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ (البقرة: (٣١).وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ (الأعراف: ۱۲).وقوله: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (طه: ١١٦).وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِينَ) (الحجر ۲۷..٣٠).وقوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
ساجدين (ص: ۷۳۰.۷۲).فخلق الإنسان المذكور في هذه الآيات لا يشير إلى خلق آدم بذاته كما زعم بعض الناس، وإنما المراد
به خلق البشر البدائي.ويجوز أن يكون الله تعالى قد أخبر الملائكة عند أول خلقه للبشر، بأن هذا البشر
سيكون في يوم من الأيام المقبلة أحق بتلقي الوحي، ثم بعدئذ عندما حان استخلاف آدم أخبرهم مرة
ثانية بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة ، وذلك بعد أن تمت تسوية آدم لهذا المنصب الجليل، كما
أشار إلى ذلك بقوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.ويصدق هذا المعنى قوله تعالى: وَالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلا
مَا تَشْكُرُون) (السجدة: ٨-١٠)
Page 245
تبين هذه الآية أن ترتيب خلق الإنسان كما يلي:.١ خلق الإنسان أولا من طين.۲ ثم استمرار نسله بالنطفة المنوية،.ثم تمام اكتمال القوى الإنسانية فيه،
٤.ثم بعد ذلك نزول الوحي الإلهي عليه.فآدم الذي تشرف بكلام الله تعالى..كان من ذرية الناس الذين خلقوا من النطفة، وليس من الذين
تطوروا من خلق الطين كحلقة أولى للبشرية.وثمة آيات أخرى تدل على أن آدم الله لم يكن أول إنسان ظهر في الوجود، بل كان في عصره كثير
من الناس الآخرين..ففي سورتنا هذه يقول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.ويصح من الناحية اللغوية أن يكون المراد بالزوج الأصحاب والجماعة، وبمعنى ذلك أن
بني نوعه أيضا
كانوا موجودين من قبله.ثم قال عز وجل بعد هذه الآية: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ
حين (البقرة: ٣٦)..وهنا الخطاب للجماعة، وبعدها قال: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقال أيضًا: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (طه:١٢٤).وخطاب آدم هنا يراد به جماعة آدم وجماعة الشيطان، وهما الجمع.ولعل هناك من يتساءل عن أن مفهوم الآية الأخيرة يدل على أن الشيطان كان من جنس البشر، مع
أن القرآن ينص على اختلاف جنسيهما حيث قال: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين (الأعراف:۱۳)، وفي موضع آخر قال عن الشيطان: كَانَ مِنَ الْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)) (الكهف: ٥١).كما جاء في الجن قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ) (الرحمن: ١٦).وجوابنا على ذلك بأن القرآن يفرق بين إبليس والشيطان، فحيثما ذكر الامتناع عن السجود لآدم
نسبه إلى إبليس، وحينما ذكر محاولة إغواء آدم أسندها إلى الشيطان..وإليكم بعض الشواهد:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ فَأَزَلَّهُمَا
الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ )) (البقرة: ٣٥-٣٧)
Page 246
٢ - وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ) (الأعراف: ١٢)....فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (الأعراف: ٢١).﴾
قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى (طه: ۱۱۷)
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (طه: ۱۲۱)
واختلاف الكلمتين في كل مرة لا يخلو من حكمة، والقرآن الحكيم يرعى الحكمة في كل كلمة من
كلماته، فمن المستحيل أن يكون الاختلاف بين الكلمتين فيه دون حكمة.فلزم أن يكون الممتنع عن
السجود غير الذي حاول الإغواء..ولذلك أطلق على الأول اسم : إبليس، وعلى الثاني اسم: الشيطان.أما الجواب الأجدر بالاعتبار، فهو أن القول بخلق الجان من النار لا يعني ولا يستلزم أن يكون إبليس
أو الجن قد خلقوا فعلا من النار المادية، وإنما يدل هذا الأسلوب اللغوي العربي على أن إبليس كان
مطبوعا على طبائع نارية من التمرد والعصيان ومثل هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم في مواضع
أخرى مثل: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (الأنبياء:۳۸)، واللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ )) (الروم : ٥٥).والخلاصة:
١.أن خلق آدم كما أخبر القرآن الكريم..لم يتم دفعة واحدة، بل إن الجزئيات الدقيقة تطورت في
نشوئها، ومرت بمراحل عديدة مختلفة إلى أن تحولت للصورة الإنسانية.٢.أن مكونات الإنسان منذ بدايتها في أبسط صورها كانت مهيئة لتكون في النهاية ذلك الكائن
البشري، وليس كما زعم الفلاسفة..نتيجة تطور مصادف في الحيوانات المختلفة.٣.أن الوجود البشري الأول لم يكن يتلقى الوحي السماوي، ولكن جيلا من سلالته التي خلقت من
هو الذي وصل إلى حد من الكمال أهله لتلقي الوحي، وأول من حاز هذا المقام الجليل هو من
نطفة
أسماه القرآن الكريم..آدم.٤.أنه كان قبل ،آدم، وفي زمنه كثير من بني جنسه.وقد اختار الله تعالى آدم ليكون خليفة يجمع
بنظام وهداية سماوية، وأن معاصريه هؤلاء أقاموا معه في تلك الجنة الأرضية التي عاش فيها، وأنهم
شملهم
أُخرجوا منها أيضا معه.وأذكر في هذه المناسبة حوارا جرى بين مؤسس الجماعة الأحمدية وبين مُنجم أسترالي حول مسألة
خلق آدم وقد زار هذا المنجم عدة مدن في الهند والتقى معه في لاهور حيث دار بينهما هذا الحوار:
Page 247
سؤال: ورد في التوراة أن آدم أو الإنسان الأول ظهر في أرض جيحون وسيحون، وقطن هناك، فهل
هؤلاء المقيمون في أمريكا وأستراليا وغيرها هم أيضًا من أبنائه؟
أن
جواب: لسنا نقول بذلك، ولا نتبع التوراة في هذه القضية..فنقول بما تدعيه من أن الدنيا بدأت بخلق
آدم منذ ستة آلاف عام أو سبعة، و لم يكن قبل ذلك شيء، فكأن الله عز وجل كان متعطلا.كما أننا لا
ندعي
بني نوع الإنسان الذي يقطنون اليوم في مختلف أنحاء الأرض هم أولاد آدم هذا الأخير، بل إننا
نعتقد بأن بني الإنسان كانوا موجودين قبله..كما يتبين من كلمات القرآن الحكيم..إني جاعل في
الأرض خليفة.فلا يمكن لنا الجزم بأن سكان أستراليا وأمريكا من أولاد آدم هذا، ومن الجائز أن يكون
بعض الأوادم الآخرين.وأشير بهذا الصدد إلى كشف عجيب رآه الشيخ محيي الدين بن عربي، وهو شخصية إسلامية بارزة،
فقد قال:
"
أراني الحق تعالى فيما يراه النائم..وأنا أطوف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعرفهم بوجوههم،
فأنشدونا بيتين نسيت أحدهما وأذكر الثاني وهو:
لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طُرًّا أجمعينـــا
فتعجبت من
ذلك.وتَسمَّى لي أحدهم باسم لا أذكره، ثم قال لي أنا من أجدادك.قلت: كم لك منذ
مت؟ فقال: لي بضع وأربعون ألف سنة.فقلت له: فما لآدم هذا القدر من السنين؟! فقال لي: عن أي
آدم تقول عن هذا الأقرب إليك عن غيره؟ فتذكرت حديثا لرسول الله ﷺ " أن الله خلق مائة ألف آدم،
وقلت: قد يكون ذلك الجد الذي نسبني إليه من أولئك ".(كتاب الفتوحات المكيةج ٣، الفصل الخامس
في المنازلات باب ۳۰۹
يفهم من هذا الكشف أن آدم الموحى إليه، والذي ينتسب إليه بنو آدم ،اليوم، لم يكن آدم الأول، بل
إنه آخر الأوادم.وكذلك يظهر منه أن كلمة "آدم" قد تستعمل كصفة أيضا بمعنى الجد الأكبر، وأن
الوجود البشري ما زال مستمرا منذ أقدم العصور، وأن الدور المذكور في الأحاديث النبوية الشريفة..والمحدد بسبعة آلاف سنة..إنما أريد به دور آدم الأخير فقط..وليس أدوار البشرية جمعاء.ورب سائل يقول: إذا كان الجيل البشري موجودا قبل آدم المذكور، وأنه تتابعت ولادته عن نطفة،
فلماذا إذن يقول القرآن الحكيم بأن الخلق من زوجين؟..ولماذا قيل في الحديث النبوي أن المرأة قد
خلقت من ضلع أعوج؟
والجواب على ذلك أن الآيات المتضمنة لهذا الموضوع..لا تذكر آدم بتاتا، بل إنها تصرح بأن الله
تعالى خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها..فيقول:
٦٥
Page 248
.۱
١ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ..﴾ (النساء:۲).هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً
حَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (الأعراف: ١٩)..خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) (الزمر:۷).منهم
ولا يراد بالنفس الواحدة هنا البشر الأول أو آدم الل..وإنما يراد بها أن الأفراد والآحاد تنشأ
الأمم الكبرى، وأن الأجيال إذا اقتفت آثار آبائهم صاروا مثلهم..إن كفارا فكفارا، وإن مؤمنين
فمؤمنين.أما قوله تعالى: جعل منها زوجها فيعني أنه تعالى خلق زوجها من نوعها ليكون الزوجان
متجانسين..يؤثر أحدهما في الآخر.ولا يخطئن أحد فهم حديث الرسول ﷺ: "استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خُلقت من ضلع"
(صحيح مسلم، كتاب الرضاعة باب الوصية بالنساء..فالحديث لا يختص بزوج آدم، بل يخص جميع
نساء العالم، وهيئة ولادة النساء معلومة مشهودة ولا يريد الحديث المعني الظاهري للضلع، بل إن المراد
به: "فإنهن خلقهن من ضلع استعارة للمعوج، أي خلقن خلقا فيه الاعوجاج" (كتاب مجمع بحار الأنوار،
ج ١ ، للشيخ محمد الطاهر).والخلاصة أن الآيات السابقة والحديث المذكور..لا يدلان على أن آدم الذي جعله الله خليفة كان
هو أول البشر، أو أن زوجته خلقت من جسمه، ولكن الآيات تتناول جميع بني الإنسان كقاعدة كلية
شاملة لجميع هذا النوع رجالا كانوا أو نساء.تمدن آدم
ولما كان آدم الله هو أول من جعله الله تعالى خليفة في هذه الأرض، كي يقيم التمدن الإنساني،
وهو الهدف الحقيقي من بعثته واستخلافه..كان من المناسب هنا أن نذكر المبادئ التي تأسس عليها تمدن
آدم:
١.نظام الزواج: إذ شُرع لأتباعه ما لم يكن قد عرفوه من قبل من علاقة شرعية محددة بين الرجل
والمرأة طبقا لأمر الله تعالى: يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٣٦) ﴿يَا
٢.نظام التحليل والتحريم: فقد بدأ الأمر بالعمل طبقا لبعض الأحكام والنهي عن بعض الأعمال،
كما قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)).(البقرة: ٣٦)
Page 249
.نظام التعاون على تهيئة وسائل الطعام والشراب للجميع.٤.نظام
الكساء..نظام السكن.ويجمع
هذه النظم الثلاثة الأخيرة قول الله تعالى: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأْ
*
فِيهَا وَلا تَضْحَى )) (طه: ۱۱۹ - ۱۲۰).وليست هذه صورة مفصلة لجنة آدم كما زعم بعضهم خطأ،
بل إنها الصورة المرسومة لتمدن آدم والتي دعا إليها المجتمع الإنساني الأول.إن اجتماع الناس يؤدي
أحيانا إلى حرمان قسم من الناس من وسائل الغذاء والكساء، فعلى الآخرين الذين يتمتعون بخيرات
التمدن أن يسعوا جهدهم لسدّ هذا الفراغ، ويتعاونوا على إعانة الفقراء والمسنين والعاجزين، ويهيئوا لهم
حاجتهم من الغذاء والكساء والخباء.الخلافة
إن كلمة خليفة تطلق على المعاني التالية:.١ الذي يخلف عن قوم أو شخص خلا.٢.الذي ينوب عن حاكم أعلى في حياته لتنفيذ أحكامه ببلد آخر..الذي يقوم من بعد شخص ليضطلع بسلطاته ويدير أعماله، أو يواصل نسله وولده.ولكن معنى هذه الكلمة في القرآن الكريم يتردد في ثلاثة استعمالات:
١.الخليفة بمعنى النبي، كما في آيتنا الحالية؛ لأن فضيلة آدم لا تتوقف على مجرد الأبوة لجيل جديد،
بل إن فضيلته الكبرى هي تشرفه بالنبوة كما تصرح هذه الآية.وقد وصف داود العليا بهذه الصفة في
قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سبيل الله..(ص: ۲۷)
٢.الخليفة من يخلف عن قوم هلك من قبل..كما جاء على لسان هود العل: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ
ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ..(الأعراف:.(V.من
الأنبياء.الخليفة الذي يخلف عن نبي ويقتدي بأثره، ويوجه قومه إلى شريعته، ويجمع شمل أمته؛
كان أو غيرهم..كما قال موسى لهارون ال: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
(الأعراف:١٤٣).٦٧
Page 250
والأمة الإسلامية موعودة في القرآن بهذه الأنواع الثلاثة من الخلافة وعدا مؤكدا، لكن مع الأسف
ظل المسلمون معرضين عن هذه الحقيقة فلم يستفيدوا من نعمة الخلافة حق الاستفادة، وفقا لقوله عز
وجل: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور : ٥٦)
ولقد أوفى الله عز وجل بوعده في حياة النبي الله، إذ أورث المسلمين مكانة الأمم الخالية، وأهلك
أعداءهم ودمرهم تدميرا.فلو تمسك المسلمون بالإيمان والعمل الصالح لظل عزهم وشرفهم ثابتا شامخا،
ولكنهم، وأسفاه، انصرفوا بعد برهة من الزمان عن الدين، واندفعوا نحو الدنيا.إن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعتقد أن الله تعالى قد فتح بمؤسسها مرزا غلام أحمد (عليه وعلى
مطاعه الصلاة والسلام أبواب النبوة المحمدية النابعة من معين سيده وسيدنا ومولانا محمد المصطفى..تلك النبوة اللائقة بشأنه الأجل الأعظم، والمختصة بأمته فقط، والتي تعكس أنوار كمالاته ، لأجل
إصلاح هذا العصر الغاص بالفتن ولاسترداد مجد الإسلام الغابر وبهذه الجماعة جدد الخلافة للأمة
المسلمة، وأنشأ بها جماعة نشيطة تلبي دعوة الخلافة إلى خدمة الإسلام، ولا تزال بفضل الله تعالى، وببركة
الاقتداء الكامل بالمصطفى ﷺ ساهرة على الكفاح المتواصل لاستعادة حقوق الإسلام والمسلمين في جميع
أنحاء العالم.وليس ببعيد ذلك اليوم المبارك الذي تعلو فيه كلمة الإسلام الحق، وتندحر جموع الكفر..مصداقا للبشارة الإلهية:
سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) (القمر : (٤٦)..إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير.الملائكة
وفي هذه الآية الكريمة جاء ذكر الملائكة، ويحسن بنا أن نذكرها ببعض التفصيل، إذ إن الجيل الجديد
من الشبان المتأثرين بالفلسفة العصرية..بعد أن أخطئوا الطريق إلى معرفة الله تعالى، وتقاصروا عن إدراك
وجوده وصفاته عز وجل ظنوا أن وجود الملائكة باطل لأنه ينافي الألوهية؛ والذين لم تزل بهم عقيدة
دينية طمأنوا أنفسهم بقولهم إن الملائكة ليست إلا من قبيل المشاعر الصالحة التي يختلج بها قلب الإنسان.والواقع أن وجود الملائكة لا يتعارض أبدا مع كمال الألوهية وأيا كانت الصورة التي اخترتموها من
هاتين الصورتين، فإن وجود الملائكة لا يكون مظنة الارتياب والاعتراض.فإذا كان الله تعالى فعالا منذ
الأزل تسألنا هل كان يتخذ عندئذ وسائط من مخلوقه لأجل القيام بأعماله..أي أكانت هناك سنن
طبيعية لوجود هذا الكون عند بدء الخليقة أم كان كل تطوّر يحصل بنفسه دون أي قانون أو سبب،
كعجائب الشعوذة والسحر؟ ولئن سلّمنا بأن كيان هذا العالم وبنيته تقتضي خضوع كل تطور حادث
٦٨
Page 251
فيه لقاعدة أو سنة ما..اضطررنا للتسليم بأن الله عز وجل خلق بعض الوسائط لتكوين هذا العالم،
وأصدر سننا خاصة سببت وجود هذا العالم بهذه الصورة.فإذا سلمنا بذلك، ولا بد من التسليم، فلا
مفر إذن من الإقرار بأن وجود الملائكة أرباً وأسمى عن الاعتراض، لأنه إذا لم يكن اختيار وسيلة ما
منافية لقدرة الله تعالى، فإن اختيار وسيلة غيرها لا يُعدّ أيضًا منافيا لقدرته عز وجل.وكذلك إذا اعتقدنا بأن الله عز وجل علاقة فعالة بإدارة هذا العالم اليوم أيضا، فلا داعي إذن إلى
الاعتراض على وجود الملائكة..فإن الله تعالى يستعمل النطفة الإنسانية للولادة، ويبرد غليل الإنسان
بالماء، وينور على العالم بالشمس..وإذا كانت هذه الوسائط لا تنال من قدرته فكيف يكون توسيطه
تعالى للملائكة في إدارة نظام هذا الكون مدعاة إلى المساس بكبريائه وجبروته؟
والحق..كما يتبين من القرآن وتُصدّقه نواميس القدرة الإلهية أن الله عز وجل، بقدرته الكاملة
أخضع نظام العالم لقانون واسع متشعب..يقول تعالى: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضُحَاهَا (النازعات: ۲۹ - ۳۰)، وتدلنا هذه الآية على أن النظام السماوي مؤسس على قانون كامل..منه ما هو خفى كالليل ولا يتبين إلا بإمعان النظر وإمعان التدبر ؛ ومنه ما هو ظاهر واضح وضوح
النهار، ويتبين من الوهلة الأولى..هذان النوعان من نواميس القدرة واضحان للناظرين فيهما، فالشمس
والقمر مثلا يعرف الناس بعض تأثيراتهما، ولكن بعض أسرارها في غاية الخفاء حتى أن العلماء
المتخصصين لا يزالون يبحثون فيها لمعرفة أسرارهما.هي
إن أول حلقة في سلسة العلل والمعلولات هي الملائكة.فالقول بأن وجودها ينافي القدرة الإلهية وهم
أوهى من بيت العنكبوت..فإن العالم كله قائم على آلاف العلل والمعلولات، ولا يقول عاقل بأن هذه
القوانين تتعارض مع قدرة الله تعالى، فكيف يكون وجود الملائكة كحلقة أولى في السلسلة مما ينال من
قوته وسلطانه عز وجل.إذا كان النور سببا لإبصار العين وذبذبات الهواء علة لحاسة السمع..ولا يمس
ذلك قدرة الله، فكذلك وجود الملائكة كعلة في إدارة نظام هذا الكون لن ينال شيئًا من قدرة الله تعالى.وكما أن الملائكة هي العلة الأولى لخلق الإنسان، كذلك العلة النهائية للاتصال بالله تعالى؛ يقول
عز وجل: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (النجم : ٤٣)..أي أن المصير النهائي لكل مخلوق إلى الله تعالى.وهذا الاتصال الأخير يتم عن طريق الملائكة كما يُفهم من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (غافر:۸).ونوجز القول هنا عن الملائكة بأنهم كائنات روحانية، خلقهم الله تعالى كالحلقة الأولى في خلق العالم
المادي، وجعلهم مدبرين له وهم ليسوا عند الله تعالى كأصحاب الحظوة المقربين عند الملوك؛ بل إن الله
تعالى أو جدهم سببا مبدئيا وعلة أولى لإدارة نظام هذا العالم ولإجراء التطورات والتغيرات الظاهرة في
°
Page 252
الكون، وهم لا يبرحون قائمين على إحداث التطورات في العالم بإذن الله تعالى، وطبق القواعد التي
حددها عز وجل.إن الذين مروا بتجارب روحية أتيحت لهم معرفة الملائكة ومشاهدتهم، فقد ورد في الإنجيل نزول
الملائكة على بعض الصالحين والصالحات، ونزول جبريل على المسيح الناصري الليل.وذكر القرآن
الكريم والأحاديث النبوية نزول الروح الأمين جبريل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى.وفي هذا
العصر حظي مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية بهذا الاتصال الملائكي كما إنني تشرفت شخصيا
ببعض المشاهدات بفضل الله تعالى ورحمته إن الذين يحسبون الملائكة مجرد قوى كامنة في الإنسان يبنون
رأيهم على الوهم والجهل وإنكار تجارب الصادقين، ولكن المرء إذ نال المشاهدة الشخصية لا يمكن له إلا
اليقين بحقيقة وجودهم.إن هذه الآية الكريمة تشكل الدليل الناصع على أن من سنة الله المستمرة بعث الأنبياء عند مقتضى
الحاجة إليهم، وأنه تعالى عند ذلك يخبر ملائكته بخبر ظهور النبي، فينشط كل منهم في نطاق عمله،
ويحرك في الأجواء التيارات الخاصة بتأييد ذلك المبعوث ونصرته.وتحمل الآية أيضا إشارة إلى أن مثل هذا الاعتراض ليس بمستغرب أو مستبعد عند بعثة المصطفى
وعند نزول القرآن الكريم، بل كان لا بد من ذلك وفقا لسنة الله المتواترة منذ آدم الله.وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَيكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
متولاً و إن كُنتُمْ صَدِقِينَ )
شرح
الكلمات :
آدم أبو البشر.قيل هو اسم أعجمي، وقيل هو مشتق.وعندي هو مشتق من: أدَمَ يأدَمُ بينهم أدما :
ألف وَوَفَّق وآدَمَ الخبزَ: خلطه بالإدام.وآدَمَ أهلَهُ صار لهم أسوة.وأديم الأرض سطحها.والأدمة الوسيلة (الأقرب).فيسمى آدم آدما لأنه جمع الناس على تمدن؛ أو لأنه تكون من عناصر
وقوى متعددة، أو لأنه صار أسوة لقومه؛ أو لأنه عاش على سطح البسيطة؛ أو لأنه كان وسيلة بين
تعالى وبين عباده.الله
الأسماء: الاسم اللفظ الموضوع للدلالة على الجوهر أو العرض لتمييزه؛ والعلامة (الأقرب)؛ والاسم:
ما يعرف به ذات الشيء أو أصله، والاسم: الصفة (الكليات).١٧٠
Page 253
عرضهم: عرض الشيء له: أظهره له.عرض المتاع للبيع: إذا أظهره للراغبين في شرائه.عرض الشيء
عليه : أراه إياه (الأقرب)
صادقين: صدق في الحديث ضد كذب.صدقه الحديث: أنبأه بالصدق (الأقرب).صدقني فلان: قال
لي الصدق "التاج".وفي البخاري ومسلم أن جبريل سأل الرسول الا الله و سؤالا ، فلما أجابه قال له: صدقت،
أي أصبت القول..وهذا هو المعنى المراد في الآية.التفسير: لقد اختلف المفسرون في الأسماء التي عُلّمها.آدم فقال البعض أنها أسماء الأشياء مثل كوب
وقدر..بمعنى أنه علمه اللغة (الدر المنثور).وزاد عليه البعض أنه علمه كل اللغات (فتح البيان)، ولكن
هذا المعنى خلاف للعقل والنقل كلية.وقال آخرون إنه علمه أسماء أولاده الدر المنثور).ولكن إذا رجعنا
إلى القرآن نفسه عرفنا بسهولة حقيقة هذه الأسماء.لا شك أن الإنسان عندما شرع في التمدن كان بحاجة إلى لغة، ولا بد أن الله تعالى قد علم آدم لغة
ما، ولكن القرآن الكريم يخبرنا أن ثمة أسماء خاصة يجب على الإنسان أن يتعلمها ليكمل له دينه وخلقه،
ولا يمكن أن يعلمها إلا الله جل وعلا.يقول الكتاب الكريم: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف: ۱۸۱).يتبين من هذه الآية الكريمة أمران:
الأول: أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى والاتصال به هي أن يعلم الإنسان أسماءه، أي صفاته..علما صحيحا.والثاني: أن العلم الصحيح بهذه الأسماء لا يتأتى إلا بتعليم من الله تعالى، وأن محاولة إدراكها بالاجتهاد
الشخصي يوقع المرء في الخطأ.ولما كان آدم قد بعث لتأسيس الدين، وتعزيز علاقة المخلوق بالخالق
جل وعلا، فلذلك كان من اللازم أن يتعلم من الله تعالى الصفات الإلهية، ويعرفها بأسمائها..كي تعرف
أمته إلهها وتتصل به.وإذا لم يتعلم آدم تلك الأسماء خيف عليه وعلى أمته من الإلحاد والانحراف عن
الدين.ويتبين من الآيات التالية أن الأسماء التي علمها الله تعالى آدمَ لم تكن معروفة للملائكة تمام المعرفة.والأسماء التي لا يعرفها بكاملها جميع الملائكة فردا فردا إنما هي الصفات الإلهية، لأن الملائكة كما
وصفهم القرآن الكريم يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (النحل: ٥١)..فهم يعرفون ما يؤمرون بفعله، أما ما سوى
ذلك فأنى لهم معرفته؟
نعم، لا يعلم الصفات الإلهية علما كاملا إلا الإنسان وليس الملائكة من هذا العالم الكامل في شيء.إنهم يعلمون من الصفات ما يتصل بنطاق عملهم فحسب، ولكل منهم عمل محدد لا يتجاوزه، فهو
۱۷۱
Page 254
يعرف صفة واحدة أو بعض الصفات.أما الإنسان فكما يؤكد القرآن الكريم، يعلم الأسماء كلها.إن
الإنسان مزوّد بالقدرات التي تجعله أهلا لأن يتصف بتلك الصفات.إنه يصلح للاتصاف بالصفات
الإلهية، فيكون رحيما وغفارا وقهارا وجبارا وشكورا..ولكن الملائكة لا تصلح لأن تجمع كل تلك
الصفات في واحد منها.ويرى بعض المفسرين أن الآية تشير إلى معنى تعليم اللغة أو اللسان وأرى أن الآية تتضمن هذا المعنى
أيضًا، لأن اللغة ضرورية لتأسيس مجتمع متمدن.ويبدو أن الله تعالى علم آدم مبادئ اللغة التي تأسست
عليها اللغات.هي
و بالتدبر في معنى الآية يتبين لنا أن تلك اللغة
اللسان العربي؛ فالآية تصرح أن آدم العلا تعلم
الأسماء عن طريق مسمياتها، بمعنى أن أساس اللغة التي تعلمها قام على علاقة بين الأسماء والمسميات، أي
أن كل شيء سُمِّي باسمه بناء على خواصه فلم تكن الأسماء بدون سبب يربطها بمسمياتها.وهذه الميزة
مختصة باللغة العربية دون سائر اللغات..لأن الأسماء فيها تفيد التعرف على الشيء، ولو غيرنا أسماء
المسميات ما حدث خلل ما.فمثلا باللغة الأردية يسمى الطعام المصنوع من الغلال "روتي" ويسمى
بالإنجليزية "برد" وبالفارسية "نان"..ولو استبدلناها بأية أسماء أخرى ما كان لذلك أثر يذكر.ولكن
اسم هذا الطعام في اللغة العربية "خبز" وهو اسم ذو معنى..إذ إن مادة "خ" ب ز" تدل على الصنع
والانتفاخ.فمثلا بزخ: نفخ صدره وأبرزه، خزب سمن بدون مرض أو عيب، خبز: صنع شيئا بضرب
الكفين بسرعة فالخبز شيء صنعته الأيدي بسرعة، وهو أيضًا منتفخ.وهذه الكلمة تصوير حقيقي لهذا
الطعام.والآن لو استبدلنا كلمة "خبز" بكلمة أخرى ما أفادت هذا المعنى.وخذ مثلا كلمة "رب" ومعناها في العربية الذي يربي ويرتقي بالشيء من حالة أدنى إلى حالة أعلى.ولا يتأتى هذا المفهوم باستبدالها بكلمة أخرى.ثم كلمة "سماء" مشتقة من "س"م" و" التي تدل على الارتفاع ،والعلو، ولكن كلمة "آسمان" الفارسية أو
"سكاي" الإنجليزية لا تبين هذا المدلول.و لا أعني بذلك أن سيدنا آدم تعلم اللغة العربية بشكلها الحالي، أو أنها لم تتطور بعد آدم العلة..وإنما
أعني أن أصول تلك اللغة هي التي تطورت وتوسعت وقامت عليها اللغة العربية فيما بعد.فالمراد بتعليم اللغة أن الله تعالى علم آدم لغة مبنيّة على حكمة، إذ إنها متناسقة في ربطها بين المبنى
والمعنى، أي أن كل كلمة فيها ذات معنى تعبر عنه..أو بعبارة أخرى، إن الله العليم الخبير علم آدم اللغة
العربية التي صارت فيما بعد أمَّا لسائر اللغات.راجع كتاب "منن الرحمان" لمؤسس الجماعة الإسلامية
الأحمدية، الذي بين فيه بالبيان الرائع كيف أن اللغة العربية هي أم الألسنة).۱۷۲
Page 255
ويمكن أن يراد بقوله : وعلم آدم الأسماء التعليم الفطري الطبيعي دون التعليم الحاصل عن الوسائل
الخارجية، فالفطرة الآدمية مزودة بصلاحية التعلم.والأسماء من ناحية هذا المعنى هي خواص الأشياء.فنرى الإنسان منذ عهد آدم وإلى اليوم، لا يزال عاكفا على الاختراع والاكتشاف في شتى نواحي
الكون، وعلمه يزدهر بذلك ويتقدم كل يوم.وما الأسماء إلا تلك الخواص والصفات الطبيعية والمنافع
التي يبتكرها للأشياء.وقوله كلها..لا يراد منه جميع الصفات الظاهرة في كل الأزمان ، وإنما ما يتصل منها بعصر آدم
من الصفات.ومن الممكن أن تكون مستوعبة لكل الصفات، ويكون معنى الآية في هذه الحالة أن الله
تعالى أودع في آدم وذريته كفاءة لإدراك كل الصفات؛ فكأن تعليم الأسماء لآدم كان بالقوة وبالإجمال،
أي تزويده بالقدرة على الإدراك، وبصفة عامة وليس بالفعل وبالتفصيل..وإن كان التعليم بالفعل
والتفصيل قد بلغ ذروة كماله بوجود سيدنا ومولانا محمد.وكذلك ليس المراد بتعليم أسماء اللغة تعليم كل أسمائها وموادها، بل المراد به تعليم مبادئ اللغة التي
تطورت فيما بعد بصورة اللغة العربية المتكاملة.وفي قوله ثم عرضهم على الملائكة..لا يعود ضمير الغائب "هم" على الأسماء.لأن الضمير لجمع
المذكر العاقل..وكلمة "الأسماء" مؤنثة ومؤكدة بكلمة "كلها"؛ وتبين من ذلك أن الضمير راجع إلى
المسمّين بهذه الأسماء دون الأسماء نفسها.ولا يلزم من قوله عرضهم أن يكون العرض بصورة مادية،
فمن الممكن أن يكون بصورة كشف المظاهر المقبلة للأسماء، وبخاصة إذا كان الضمير "هم" راجعا على
ذرية آدم في المستقبل.كما يمكن أن يكون المعروضون على الملائكة هم أولئك الأعوان والأنصار الذين وهبهم
الله لآدم بعد
أن تعلم الأسماء وتولى الخلافة، والذين كانوا مظاهر لصفات الله المختلفة.ويكون المعنى أن الله تعالى
عرضهم على الملائكة بعد أن أثمرت فيهم تربية آدم وتعاليمه، وأصبحوا مظاهر للصفات الإلهية، وسأل
الملائكة: أخبروني عن صفات هؤلاء إذا كان رأيكم السابق في البشر صادقا.إن هؤلاء أبناء الصلاح
والسلام، ولا يمكن أن يصدر عنهم فساد أو سفك دماء.أما أعداء آدم وحاسدوه فهم على عكس
أولئك الأوفياء، وليس آدم مسئولا عنهم.والحق أن بعثة كل نبي كانت مقرونة بسفك دماء وهياج ،فتن، لكن ذلك لم يكن ناشئا عن أعمال
الأنبياء وأتباعهم و لم يكن بهم رغبة في ذلك ولا يرضونه بل كان يحدث على عكس إرادتهم وبسبب
شرور أعدائهم.فالفساد الذي يظهر ليس من فعل الأنبياء، وإنما هم مخرجوه من صدور الفاسدين دفينا
في أعماقهم، ويكونون عاملا قويا في إخراج الخبائث الباطنية لاجتثاثها من نفوس الأشرار.۱۷۳
Page 256
ويتبين من معاني الآية أن الله تعالى يطلع الأنبياء على شيء من مواهب أتباعهم والأنبياء المبعوثين من
بعدهم.فنرى جليا أن سنة الله مع من بعثوا بعد آدم من الأنبياء أنهم ما زالوا ينبئون ببعثة نبي أو أنبياء
يأتون من بعدهم، أما سيدنا ومولانا محمد الله الذي جمع الله فيه الكمالات كلها فقد أخبر ببعثته كل
نبي.وكذلك بالنظر في حياة الأنبياء نجد أنهم ينكشف لهم أحوال خاصة أتباعهم بصورة إجمالية، ولذلك
نرى أنه لم يخطئ نبي قط في اختيار أصحابه واصطفاء أنصاره، أي لم تجتمع أغلبيتهم على الخطأ بتاتا.ويا ليت إخواننا الشيعة أدركوا هذه الحقيقة فكفُّوا عن معاداة الخلفاء الراشدين.يظن البعض أن تعليم الصغار في مدارس وروضات الأطفال حيث يتبع أسلوب خاص للتعليم، فلا
يعلمون الأطفال عن طريق حفظ ما في الكتب، بل يكون ذلك بتعليم أسماء الأشياء بعرضها عليهم مما
يساعدهم على حفظها دونما ضغط على أذهانهم وذاكرتهم..أقول يحسب البعض أن هذا الأسلوب من
مستحدثات أوروبا، ولكن القرآن الكريم يقدم في هذه الآية الوجيزة هذا الأسلوب التعليمي تقديما رائعا.الله تعالى لم يعلم آدم بحفظ الأسماء عن ظهر الغيب، بل علمها إياه بعرض مسمياتها الملموسة المشهودة
عليه، وتعيين خواصها بصورة عملية.إن
ثم إذا جاء دور تعليم الملائكة فلم يجبهم بالكلمات فقط، بل اتبع نفس الأسلوب وعرضهم على
الملائكة..أي عرض عليهم الأشياء بصورتها الأصلية، أو في صورة كشف..إذ طريق التعليم المؤثر أن
تعرض الأشياء بأصلها أو نماذجها مع أسمائها وخواصها ووظائفها.فأول درس على منهاج روضة
الأطفال لم يكن في أوروبا أو ألمانيا على وجه الخصوص..بل كان في الجنة..أو روضة آدم، فكانت
بذلك أول روضة لتعليم الأطفال.حيث علم الله تعالى بوحيه آدم ثم الملائكة.ومن الأمثلة الحديثة للتعليم الإلهي ما جرى مع مؤسس الحركة الإسلامية الأحمدية في هذا العصر، إنه
لم يتعلم في مدرسة من المدارس ومع ذلك لما بدأ في تأليف الكتب باللغة العربية امتثالا لأمر الله تعالى..علمه الله في ليلة واحدة أربعين ألف مادة من اللغة العربية، فقام بعدها يتحدى العلماء في كل العالم بأن
يأتوا بمثل هذه الكتب في بلاغتها وما تحتويه من أدق المعاني..تحداهم جميعا أو آحادا، ولكن لم يكن
لأحد أن يأتي لها بمثيل حتى اليوم، رغم كثرة توزيعها وقتئذ في البلاد العربية ومثل هذا الإعجاز ليس إلا
ثمرة لإعجاز القرآن الكريم وتصديقا له.قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (3)
۳۳
١٧٤
Page 257
شرح
الكلمات
سبحانك: تبرئك اللهم من السوء براءة راجع" الشرح السابق في آية رقم ٣١.الحكيم العالم، صاحب الحكمة؛ المتقن للأمور والحكمة العدل العلم الحلم؛ ما يمنع من الجهالة؛
كل كلام موافق للحق؛ وقيل: وضع الشيء في موضعه؛ وصواب الأمر وسداده (الأقرب).حكم منع منعا للإصلاح من ذلك يقال للجام ،حكمة، قال الشاعر: "أبي حنيفة أحكموا
سفهاءكم"..أي امنعوهم من السفاهة (المفردات).التفسير: يتبين من نص ما قاله الملائكة أنهم لم يكونوا بسؤالهم يعترضون على الله سبحانه وتعالى، ولا
يحتجون باستحقاقهم للخلافة، وإنما كانوا يستفسرون عن الحاجة الداعية إلى تأسيس هذا النظام الجديد..ما يضمره من خطر سفك الدماء وانتشار الفساد كان سؤالهم استفهاما عن الحقيقة، وكان الجواب
الممكن إما بالنفي البات لإمكان سفك الدماء والفساد بعد الخلافة، أو بإقرار ذلك الإمكان مع تأكيد
أهمية هذا النظام لبني نوع الإنسان، وإيضاح أن نفع النظام الجديد أكثر من ضرره.مع
وكان الوجه الثاني للجواب هو الأصح لنظام الخلافة الإنسانية، وهو الذي صدر الجواب به: إنه لم
ينف عن النظام إمكانية حدوث شيء من سفك الدماء والفساد، فذلك ممكن على يد بعض الجناة،
ولكنه صرح
بأن النظام سينتج عنه شخصيات عظيمة متحلية بعديد من صفات الله عز وجل، ولذلك
فلا بد من خلق مثل هذه الشخصيات القادرة على إظهار الصفات الإلهية على الأرض، على الرغم من
وجود الشخصيات الناقصة أيضًا، فذلك أنفع جدا لنظام العالم.وكان من الممكن أن يكون هذا الوجه من الجواب على قسمين:
الأول: أن يدعم بالأدلة العقلية.الثاني : أن يؤيد بالدليل العلمي، فيظهر مواهب الخليفة الأول وكفاءاته بصورة واقعية، ويكشف
للملائكة وجود الكُمَّل من أتباع آدم ومثل هذا الجواب يكون أقوى تأثيرا وأعظم إقناعا.وهذا ما
اختاره الله تعالى إذ علم آدم صفاته، فأثبت بالاتصاف بها أنه لا يمكن أن يُظهر الصفات الإلهية ظهورا
كاملا إلا مَن يكون مُخيَّرا بين الخير والشر، فيطغى عليه الحب الإلهي فيندفع نحو إنماء قوى الخير في
نفسه ليتقرب إلى الله.ويتبين من قول الملائكة أنهم قد اطمأنوا بجواب الله كل الاطمئنان وأنهم اعترفوا بأن علمهم ناقص
ومحدود بالنسبة إلى علم الإنسان الموهوب من لدن الله تعالى، وأنهم أقروا بأن الله تعالى هو وحده العليم
الحكيم الذي لا يخلو فعل من أفعاله من الحكمة الكاملة.۱۷۵
Page 258
ويتبين أيضا من التفسير السابق لهذه الآية أن الرد المفصل لما جرى لآدم إنما يهدف إلى تحديد الغاية
من خلق الكون وتعيين حكمته، ويرمي إلى بيان أن سبب نزول الوحي السماوي في كل زمن إنما هو
لتحقيق هذه الغاية فكأن الذين يعترضون على بعثة الأنبياء إنما يعترضون على إرادة الله تعالى لتحقيق
غاية خلق الإنسان..فهذا اعتراض يفند نفسه بنفسه، وليس بمانع لتزول الوحي.أما قول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا فليس المراد منه الأمر البديهي من أن علمهم مقصور
على ما علمهم الله وإنما لبيان أن علمهم لا يزداد كازدياد علم الإنسان الذي زوده الله بالقدرة عليه،
وأن ما آتاهم الله تعالى من قوى لا يستطيعون بها أن يدركوا شأو الإنسان في علومه المتنوعة الجامعة، أي
أنهم أيقنوا بأن الإنسان مخلوق لحكمة، وأنه مكلف بعمل لا يستطيعونه، وأن خلق الإنسان لفعل حكيم
من أفعال الله عز وجل، وإن كان بعض جنسه سببا لسفك الدماء وإثارة الفتن.قَالَ يَتَفَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَابِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَابِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي
أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ )
شرح الكلمات:
تبدون بدا الأمر ظهر وأبدى الأمر: أظهره (الأقرب).تكتمون: كتم الشيء أو الحديث أخفاه، كتم الفرسُ الرَّبوَ أي ضاق منخره عن نفسه (الأقرب).فحالة عجز الفرس عن إخراج نفسه تسمى كتما.وقد قال ابن عباس في قوله تعالى (ولا يكتمون الله
حديثا) أن المشركين إذا رأوا أهل (يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا من لم يكن مشركا قالوا: (والله ربنا ما
كنا مشركين)..فتشهد عليهم جوارحهم، فحينئذ يودون أن لم يكتموا الله حديثا (المفردات).التفسير: مع
أن الملائكة فهموا على وجه الإجمال الغرض من خلق آدم الل..ولكن استكمالا
للدليل أمر الله تعالى آدم ببيان كمالات الخاصة من أمته أو نسله لكي تتبين الحقيقة عمليا بعد أن
اتضحت علميا.وليس المراد بهذه الآية أن محادثة جرت بين رب العزة وبين الملائكة ،وآدم بل إنها تعبر عن بعض
الحقائق بلسان الحال، حسب أساليب اللغة العربية المعروفة مثل قولهم: قالت له العينان سمعا وطاعة، أو
قولهم: امتلأ الحوضُ فقال قطني..فليس ضروريًا أن يكون هذا الحوار قد تم فعلا بين الله وآدم، بل يمكن
١٧٦
Page 259
أن يكون آدم قد بدأ بأمر الله تعالى بيان الصفات الإلهية التي كان من المقدر ظهورها عن طريق نسله،
وهكذا انكشف للملائكة مدى الرقي الروحاني الذي يمكن أن يحققه الإنسان.كما ليس المراد من تعليم آدم أن الله أجلسه أمامه يعلمه، وإنما معناه أنه تعالى آتاه علم الصفات الإلهية
واللغة وخواص الأشياء؛ إما بالوحي الخفي أو بالوحي الجلي أو بكليهما.وقوله: فلما أنبأهم
أن آدم العليلا
بأسمائهم يعني
شرع في بيان تلك الصفات الإلهية التي سوف تظهر في أمته عامة وفي
الكاملين منها خاصة علم الملائكة أن لا أحد يستطيع الاتصاف بالصفات الإلهية كما يقدر الإنسان
على ذلك.تما
أما والأمر كذلك..فقد انكشف للجميع أن الله تعالى العليم الخبير هو الأعلم بحاجات الأرض
ومقتضياتها لترول الفضل الإلهي، وهو أعرف لما تتطلب صفاته عز وجل.إنه العليم بما أودع في الملائكة
من القوى: ظاهرة يبدونها، وباطنة لا يمكن لهم إظهارها.ومن الخطأ أن يتصور أحد أن الملائكة حاولت
إخفاء شيء عن الله تعالى، وإنما يُراد بالكتمان هنا العجز والقصور الفطري، إذ إنهم لا يملكون الإرادة
والحرية التي يتمتع بها الإنسان..ولكنهم يظهرون ما زُوِّدوا به من صفات، ويكتمون ما ليس بوسعهم
من صفات.وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الكفرين )
شرح
الكلمات:
اسجدوا سجد: خضع وذل؛ انحنى.وسجد البعير: خفض رأسه.وسجدت السفينة للرياح: أطاعتها
ومالت بميلها.يقال : فلان ساجد المنخر : ذليل؛ خاضع والسجود التذلل (الأقرب).وقوله تعالى:
اسجدوا لآدم : قيل : أمروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح أولاده؛ أو معناه اسجدوا لأجل خلق
آدم.وقوله ادخلوا الباب سجدا ) : أي متذللين منقادين (المفردات).لآدم اللام تأتي صلة لسجد تقوية لمعنى السجود وتعديته، كقوله اسجدوا الله ؛ كما تأتي لمجرد
الصلة وتؤدي معنى من معانيها المستقلة وهي العلة والسببية..كما قال امرؤ القيس: "ويوم عقرت
للعذارى مطيتي".فيكون معنى اسجدوا لآدم ) : أي اسجدوا الله بسبب خلافة آدم.۱۷۷
Page 260
إلا: حرف استثناء، أي إخراج ما بعده من حكم ما قبله والاستثناء في اللغة على ضربين: استثناء
أن يكون المستثنى منه والمستثنى من جنس واحد كقولهم: جاءني القوم إلا زيدا، فزيد واحد
من جنس القوم؛ واستثناء منقطع، إذا لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه كقولهم: ما جاءني القوم إلا
متصل، وهو
حمار.ولا
إبليس: أبلس: قل خيره؛ يئس من رحمة الله؛ انكسر وحزن؛ أبلس في عمله تحير؛ سكت غما.أبلس
غيره: جعله يائسا.فإبليس هو ذلك الذي قلّ جانب الخير فيه، وتحير وارتبك، ويئس من رحمة الله،
يزال مغموما.(الأقرب)
أبى أباه لم يرضه الأقرب).الإباء: شدة الامتناع (المفردات).أباه كرهه.الإباء: الامتناع عن
الشيء والكراهية له لبغضه وعدم ملاءمته (التاج).استكبر كان ذا كبرياء.استكبر الشيء: رآه كبيرا وعظم عنده الأقرب).الكبر: الحالة التي يختص
بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره.والاستكبار يقال على
وجهين: (١) أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصيرا كبيرا، (۲) أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له
:
(المفردات).كان: من
الأفعال الناقصة، ويدل عموما على حدوث الفعل في الماضي.ويكون بمعنى "صار" أيضًا.فمعنى كان من الكافرين كان من قبل كافرا؛ صار من الكافرين.التفسير: من المحقق أن السجود بمعنى العبادة لغير الله تعالى يناقض تعاليم القرآن الكريم، وأن الملائكة
لا يسجدون لغير الله تعالى أبدا، ولذا فإن المراد من الأمر الإلهي اسجدوا لآدم لا يعني سجود التعبد
لآدم، وإنما يعني اسجدوا الله بسبب استخلافه آدم، لأن الله تعالى قد أسس هذا النظام الرائع، فكأن الله
عز وجل حينما أثبت للملائكة بالدليل العملي أن خلافة آدم لها حكمتها السامية، إذ أنيط بها الظهور
الكامل لصفات الله تعالى عندئذ أمر الله الملائكة أن يسجدوا له عز وجل سجود حمد على هذه النعمة..وذلك كما نرى أن عباد الله الشاكرين يخرون سجدا حينما تتراءى لهم مظاهر قدرة الله تعالى وجبروته.ونظرا إلى هذا المعنى، ينبغي على المؤمن أن يخر ساجدا لله كلما نزل عليه فضل الله، لأن ذلك أدعى
إلى زيادة نزول أفضاله جل وعلا ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس بدلا من أن يشكروا، يأخذهم
الاستكبار عندما يحظون بنعم الله، ويحسبون ازدهار أعمالهم من آثار نبوغهم وبراعتهم.والسجود هو الطاعة أيضًا، فقوله اسجدوا لآدم يعني أطيعوه وانقادوا له..أي قوموا بمصالحه
ومصالح أولاده.ومن ناحية هذا المعنى يكون المراد من الأمر بالسجود أن الله عز وجل بعد أن شرف آدم
۱۷۸
Page 261
بالخلافة أمر الملائكة بطاعته، وقال إن آدم اليوم هو مظهر مرضاتنا في الدنيا، فعليكم أن تساعدوه في
مهمته وتعاونوه على إنجاز ما كلف به، وتُسخّروا له من هذا النظام الكوني ما هو تحت إدارتكم، والذي
أنتم حلقة من حلقاته فسجدوا أي فاندفعوا نحو تأييد آدم والعمل على تحقيق عزائمه.وقوله تعالى إلا إبليس) استثناء منقطع، وإلا لا ترادف "سوى" في هذا المكان وإنما تعني
"لكن"..أي لكن إبليس أبى.وهنا يمكن أن يتساءل أحد إذا كان إبليس من غير الملائكة فلماذا ذكر معهم حينما أُمروا بالسجود
والطاعة؟ وإذا لم يكن مأمورا ومكلفا فلماذا طلب منه السجود؟
والجواب عن ذلك أن الملائكة هم مدبرو أمر هذا الكون طبقا لقول الله تعالى: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً
(النازعات: ٦)، فهم العلة الأولى لإدارة نظامه، ولذلك يكون الأمر الصادر إليهم عاما يشمل جميع من
يليهم من الأفراد.ولقد جاء في الحديث النبوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى إذا
أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل.ثم ينادي جبريل في
السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض" (صحيح البخاري
).وهذا الحديث يبين تسلسل الأمر الإلهي حتى يصل إلى الناس فيما يتعلق بالأمور التي تخص البشر.فأمر
الله تعالى للناس يبدأ بالملائكة..فإذا ما صدر لهؤلاء فقد شمل السلسلة كلها حتى البشر.وقوله تعالى : أبى واستكبر وكان من الكافرين بيان الموقف إبليس من السجود لآدم، لقد أبى إبليس
لأنه لم ير هذا النظام ملائما لنفسه.إنه في تقديره نظام ناقص..فمن مقتضيات الإباء الامتناع عما يحط
شأن المتأبي..إن الناس يرون الحقائق منظار أهوائهم ومصالحهم الشخصية، ولا يرونها في ضوء
المصالح العامة، فإذا وجدوا فيها إضرارا بمصالحهم العاجلة..نسوا عاقبتهم وأعرضوا عن مصالح عامة
الدنيا، واجتهدوا وشمروا لمعاداة الحق.من
والاستكبار دافع ثان لإنكار الحق ورفضه ولقد عبر إبليس عن هذا الاستكبار بقوله: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ
أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ (الأعراف:١٣).فزها بكونه
ناري الطبع، وأن آدم طيني الطبع إذ يتشكل في كل القوالب كالعبيد.وهكذا فإن اتباع الحق الذي
يورث الإنسان خُلُق التواضع هو في نظر أعداء الحق معرة ومنقصة.إنه عندهم ينافي المصالح الوطنية
والملية..ويرون أهل التواضع خونة لبلادهم.إنهم يتباهون بشراستهم وطبائعهم الشريرة، ويحسبون أنهم
بعاداتهم العدوانية قادرون على تشييد مجدهم.إنهم ينخدعون بما يحصلون عليه من إثارة الشر والفتن..ولكن ذلك كله لا يحقق المصالح الثابتة الدائمة.۱۷۹
Page 262
والسبب الثالث للإباء أن يرى المرء ما يُعرض عليه كبيرا ومستحيلا، وقد عبّر عن هذا الأمر في قوله
تعالى على لسان الكفار : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ
اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوا كَبِيراً (الفرقان (۲۲)، فهم يحسبون لقاء الله تعالى أمرا مستحيلا فأبوا
أن يصدقوه.والسبب الرابع للإباء أن يعتاد المرء إنكار الحقائق، ويدل على ذلك وصف الله له في قوله: وكان
الكافرين..واليوم أيضا نجد أن المنكرين للحقائق يتعرضون لمثل هذه الأوضاع.وليت الناس حاولوا
إدراك تلك الحقائق متخلين عن هذه العيوب الأربعة، فعرفوا أن الله تعالى قد فتح لهم في هذه الأيام أبوابا
واسعة للتقدم والرقي، وأتاح لانتصار الإسلام وسائل عديدة، ولكن قل منهم من يجرؤ على ملاقاة
التضحيات وجها لوجه لكي يحظوا فيما بعد بالحياة الخالدة لهم وللإسلام ولكنهم يبذلون كل جهد
لتحقيق المصالح العاجلة وإن كانت مؤقتة زائلة يا ليت قلوبهم انشرحت وتطهرت من الصدأ !
يرى البعض أن انخداع آدم بكلام إبليس أمر غير معقول..فقد حذره الله تعالى منه صراحة، وقال له
عز وجل: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِ جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (طه:۱۱۸)،
بينما ذكر في القرآن في مكان آخر براءة آدم عليه السلام من هذا الظن فيقول: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ
عَزْماً (طه: ١١٦)!؟
ويمكن تفسير هذا التعارض الظاهري باعتبار الشيطان الذي خدع آدم غير إبليس الذي حذر الله تعالى
آدم
منه.إن آدم انخدع من الشيطان و لم يعرف أنه أيضًا من أعوان إبليس وأظلاله، فلم يأخذ الحذر منه.فوقع في الخطأ.وهذا ما يؤكده القرآن، فإنه كلما ذكر الكائن الذي امتنع عن السجود سماه إبليس،
وهو الذي حذر الله آدم ولكنه كلما ذكر الذي وسوس لآدم وأخرجه من الجنة سماه الشيطان.فالقرآن يقرر أن المخرج هو إبليس والموسوس هو الشيطان.فإبليس هو الكائن المخالف للملائكة والمحرض على الشر، والشيطان اسم عام يطلق على جميع القوى
الشريرة..يمكن أن يطلق على إبليس نفسه، أو على غيره ممن يتبعه، أو ينوب عنه في إغواء الناس
وتوجيههم إلى المنكرات وإغرائهم على مقاومة رسالة الأنبياء والشيطان على عكس إبليس يطلق أيضا
على الأرواح الخبيثة كما يطلق على بني البشر؛ غير أن استعماله في المعنى الأول أكثر من استعماله في
وصف الإنسان..كما جاء في وصف المنافقين حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا
مَعَكُمْ) (البقرة : ١٥).والمراد بالشياطين هنا أئمة الكفر؛ كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ
أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ١٧٦)؛ وكقوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
۱۸۰
Page 263
لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً (الأنعام:
۱۱۳)..فهؤلاء كلهم أهل الشر الذين يتزعمون المعارضة والتحريض عليه.الملائكة وإبليس:
لقد تساءل البعض..هل خلق الله تعالى إبليس كي يضل الناس؟ هل يريد الله سبحانه أن يضلل
عباده؟
الواقع أن الأمر على العكس من ذلك..فالله عز وجل زوّد الإنسان بالقدرة على الخير والشر، وخلق
معه الملائكة وأظلالهم وإبليس وأظلاله أيضًا.الفريق الأول يُرغب القلوب في الخيرات، والفريق الثاني
يغريها على الشرور، فالذي يلبي دعوة الملائكة وأظلالهم استحق الأجر، والذي ينقاد لتحريض إبليس
وأوليائه يستحق العقاب.والكمال الإنساني يتطلب أن يكون الإنسان مخيرا بين هاتين الحركتين، لكي
يحكم بنفسه ويختار الطريق الذي يقبله، فيستحق بذلك النعم العليا.ولولا تعرضه لمجال الشر لما أمكن أن
يكون مستحقا لأعلى النعم وأمثالها.أجل، لقد أوضح القرآن الكريم أيما إيضاح أنه ليس لإبليس ولا للشيطان أي تصرف في أمر أحد
من الناس..فهم مخيرون بين اتباعه ومخالفة تحريضه، كما يقول تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانُ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الحجر:٤٣)
وقصارى القول: أن القرآن الكريم يدلنا على أن حركات إبليس لا تتأسس على دليل أو برهان،
الله
080
منهم
ولكنها تقوم على الوعد والوعيد بأمور مزخرفة كاذبة..كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ
بِصَوْتِكَ وَأَخْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُوراً (الإسراء: ٦٥).لذلك فلا يمكن القول بأن الله قد عمل على أن يضل عباده بخلق إبليس، تعالى
عن ذلك علوا كبيرا..إنما كان يصح ذلك لو أنه عز وعلا قد أعطى للشيطان سلطانا من عنده، لكن
الأدلة كلها تؤيد الملائكة دون إبليس، فمن يتبع إبليس إنما يتبعه باختياره، وهو مسئول بنفسه عما يفعل.الله
عز وجل في قوله إلا إبليس جعل إبليس تابعًا للملائكة، الأمر الذي يدل على أن الخير
غالب، والشر مغلوب وعلى أن الملائكة هم المدبرون لنظام هذا الكون وهم منابع الخير؛ وإبليس ما
هو إلا الانحراف عن طريق الخير.وقد صرح القرآن الكريم مرارا بأن الإنسان مفطور على الخير، فقال:
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا *
الشمس : ٨ إلى (۱۱) ومعنى ذلك بلفظ آخر..أن الإنسان مفطور على الاستعداد لقبول توجيه الملائكة،
وعندما يولد يكون بريئا من تدخل الشيطان، لكن بعدئذ يقتفي هو بنفسه آثار الشيطان فيهلك.وقد
إن
Page 264
وضح ذلك الحديث النبوي: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"
(البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين).وَقُلْنَا يَتَفَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِفْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ )
شرح الكلمات:
زوجك راجع شرح الكلمات في الآية ٢٦ من السورة.حقه
رغَدًا : رغد عيشه رغدًا : طاب واتَّسع الأقرب).والرغَدُ الكثير الواسع الذي لا يُعييك من مال أو
ماء أو عيش أو كلأ (التاج).حيث تفيد ظرفية الزمان والمكان..أي كلوا من حيث شئتم ومتى شئتم (الأقرب).الظالمين: جمع ظالم.ظلَمَ ظُلما وضع الشيء في غير موضعه.وظلم فلانًا: فعل له الظلم.ظلم
نقصه إياه.والظلم كذلك تجاوز الحد والاعتداء على حقوق الغير (الأقرب).والظلم ثلاثة: الأول: ظلم
بين الإنسان وبين الله وأعظمه الكفر والشرك والنفاق..لذلك قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.والثاني: ظلم بينه وبين الناس والثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد في قوله تعالى: "فمنهم ظالم
لنفسه" (المفردات).فالظالم (۱) مَن يضع الشيء في غير موضعه ويعمل عملا في غير محله، (٢) مَن
ينقص حقوق الآخرين، (۳) مَن يتجاوز الحد ويعتدي على ملك غيره، (٤) المشرك، (٥) مَن يفعل
وصف
دوه
الظلم.التفسير: قيل إن هذه الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي يدخلها الصالحون بعد الموت ، أي أنها جنة
سماوية.ولكن ذلك خطأ بالبداهة ذلك (أولا) لأن القرآن الكريم يقول: إني جاعل في الأرض
خليفة، فكيف يعقل أن يرسل الله آدم لإقامة نظامه السماوي في الأرض ويُبقيه في السماء.(وثانيا) لقد
الله تعالى الجنة الأخروية في سياق قصة سيدنا آدم الواردة في سورة الحجر بقوله : لا يمسهم
فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) (الحجر: ٤٩)..ولكن آدم اللي أخرج من الجنة التي عاش فيها،
فلم تكن جنة آدم هذه إذن جنة سماوية، وإنما كانت جنة أرضية..(وثالثا) تصرح الآيات القرآنية أن
الشيطان وذريته دخلوا تلك الجنة، ولما كان دخول الشيطان وذريته في الجنة السماوية محالا..فلا يمكن
أن تكون الجنة المشار إليها في هذه الآية هي جنة النعيم الأخروي، وإنما هي جنة أرضية.۱۸۲
Page 265
ويستنبط
منه.منه
الآية أيضا أن آدم الله كان يسكن مع زوجته أو أصحابه في موضع ما، ثم انتقل
من
بأمر الله إلى موضع آخر سماه الله "الجنة"، لأن كلمات الآية تقول اسكن أنت وزوجك الجنة، فالله
تعالى يوجهه ليغادر مكانه إلى مكان آخر أفضل
وجاء في العهد القديم: "وغرس الرب الإله جنة من عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله"
(تكوين صح ٨:٢).وأشار العهد القديم بعد ذلك إلى أن هذه الجنة تسقى من دجلة والفرات.فكأن
شهادة العهد القديم بصدد هذه الجنة خليط من الحقيقة ،والمجاز وهي تحدد حدود تلك الجنة بجوار دجلة
والفرات.وهناك من القرائن ما يجعل شهادة العهد القديم أقرب إلى الصواب؛ فأحوال نوح الله وقومه
تتصل بهذه المنطقة، وإبراهيم العلل مولود في "أور" بالعراق.وتدل البحوث العصرية والحفريات الحديثة
على أن هذه المنطقة كانت موطن أقدم حضارة إنسانية.كل ذلك يحمل على الظن بأن آدم مولود في
أرض العراق، وأن الجنة التي ذكرت في قصته تقع في موضع من هذه المنطقة، وأنها سميت بالجنة لحسن
نظامها الذي وضعه آدم.ومما يصدق ذلك أن الآثار التي اكتشفها الباحثان "هال" و"ووليه" ترجع إلى ٣٥٠٠ عام قبل المسيح،
وبعضها أقدم من ذلك."دائرة المعارف البريطانية، تحت كلمة أور".وإننا حينما نرى في غرب شبه الجزيرة العربية أقدم بيت من بيوت الله، وهو الكعبة المشرفة في مكة،
وفي شرقها أقدم آثار الحضارة في "أور"، وفي المنطقة وقعت أقوى التطورات في التاريخ المعلوم..فإننا لا
نستبعد أن يكون مولد آدم أو مبدأ التطور البشري الحضاري في هذه المنطقة.وفي قوله رغدا إشارة إلى أن طيب العيش واتساعه وخصوبته والرخاء في لوازم الحياة..إنما هي
من ثمار المدنية التي تهيئ للإنسان حياة وفيرة المرافق.فالآية تشير إلى مزايا التمدن الاجتماعي الذي يسبب
توفير لوازم الحياة وادخارها لمواجهة الحاجات المفاجئة..وهذه هي الجنة الأرضية التي قام بنيانها على
التمدن الاجتماعي، والتي أسسها آدم اللام.إن الأمم التي توجه اهتمامها إلى هذه الناحية..ناحية التمدن والاجتماع، تحقق لأفرادها خفض
العيش والدَّعة.ولقد سارت الأمة المسلمة على هذا المبدأ، وطبقت تعاليم السماء بشأنها في عهدها
الأول، فكان كل فرد فيها كبيرا وصغيرا بمأمن من الجوع والعري والفقر.ولا يظنن أحد أن هذا الأمر من الأمور الدنيوية البحتة، فالحق أن هذا المنهج من الحياة هو الذي
يساعد على نجاة الإنسان من المعاصي.إن الفقر والحرمان من أقوى الدواعي إلى السلب والنهب والغش،
والأمة التي توفر لأفرادها جميعا مأكلهم وملبسهم ومسكنهم..إنما توفر لهم أسباب النجاة من الوقوع في
حفرة المعاصي، وتبعدهم من أقوى الحوافز على العدوان والشرور.نعم، قد يبدو هذا الأمر ذا مظهر
١٨٣
Page 266
دنيوي سياسي، ولكنه في الواقع من صميم الدين، ويساعد على اجتثاث جذور المآثم والمعاصي.إن من
أسباب انتشار التراعات الدولية هو ذلك البون الشاسع بين الأثرياء المترفين والفقراء الصقعي الدفعى،
ولئن تأسس في العالم نظام يهيئ لكل إنسان ما يلزمه من وسائل الحياة، فقد حسمت كل التراعات
والخصومات.ويشير قوله تعالى: حيث شئتما إلى أن تسهيلات الانتقال والإقامة من أهم عناصر الحياة الإنسانية
المدنية الكاملة، وأنه يجب رفع القيود المفروضة على السفر والإقامة من بعض الدول ضد دول أخرى،
والتي تهدف بها إلى الاستئثار بنعم الله الواسعة وحرمان الناس منها.إن هذه القيود كبيرة من الكبائر التي
تثير الحسد والشر.مثلا هناك قارة عظيمة المساحة والخيرات مثل أستراليا يسكنها بضعة ملايين من
البشر، ويمنعون الآخرين من الإقامة فيها.وعن قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين..قيل إن الشجرة هي شجرة القمح
أو العنب، أو هي المرأة.وقيل هي شجرة التمييز بين الخير والشر.ومثل هذه المعاني مستبعدة عقلا، لأن
الاقتراب من شجرة القمح أو العنب لا يجعل المرء ظالما..فكلاهما حلال..بل قال الله لهما: فكلا منها
رغدا أي كلوا حتى تشبعوا من طعام هذه المنطقة.أما المرأة فقد أمر الله تعالى آدم أن يسكن هناك مع
امرأته.كما أنه ليس هناك شجرة لمعرفة الخير والشر، وإن كان هناك مثل هذه الشجرة فليس من الظلم
أن يميز الإنسان بين الخير والشر، لأن التمييز بين الخير والشر يجعل الإنسان أشرف من الحيوانات
الأخرى.يتبين من القرآن الحكيم أن هذه الشجرة قد تسببت في انكشاف عورة آدم، وفي هذا دليل على أن
الشجرة المذكورة ليست شجرة نباتية أرضية حقيقية، وإنما هي شجرة على سبيل المجاز..فإننا لم نر على
البسيطة شجرة يؤدي الاقتراب منها أو أكل ثمارها إلى كشف العورات كما لا نجد لا في الشريعة
الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع السابقة شجرة يحرم أكلها شرعا.ويؤكد هذا المعنى أيضًا قول القرآن
بأن اقتراب آدم وزوجته وأصحابه من تلك الشجرة سيجعلهم من الظالمين، في حين كان من المفروض
أن يقول القرآن بأنه سيجعلهم من الآثمين، لأن الظلم قد ورد في القرآن الكريم بمعنى الشرك بالله، أو
بمعنى هضم حقوق الغير.وأيضًا لو أنها كانت شجرة مادية ملموسة مرئية لكانت مقاربة آدم إياها
عصيانا متعمدا، وليس عن خطأ أو نسيان، لكن القرآن الكريم ينص على أن آدم قد نسي ولم يتعمد
ذلك، الأمر الذي يدل على أن تلك الشجرة لم تكن مادية، بل كانت شيئا معنويا.فما
هي تلك الشجرة إذن؟ لقد استعيرت كلمة الشجرة في القرآن الحكيم لمعان طيبة ولمعان مكروهة.يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ...وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
ΠΛΕ
Page 267
(إبراهيم: ٢٥،٢٧).ومن ناحية هذا المعنى فإن الله تعالى أمر آدم أن يتجنب شجرة المنكرات.أما
وقد شبه الله عز وجل نظام الحسنات التي وهبت لآدم بالجنة، كذلك وصف الأمور المناقضة لهذا النظام
بالشجرة التي نهى عن مقاربتها؛ فكأن الله تعالى يخبر آدم ومن معه بأنهم قد أمروا بالإقامة في جنة
الحسنات هذه، بالابتعاد عن الأمور المعاكسة لها لكيلا تضيع منهم تلك الجنة.يعني
وعلى ضوء هذا المعنى..يكون من السهل جدا تفهم خطأ آدم في أمر من دقائق الأمور، إذ كان من
اليسير أن يخدعه أحد في هذا.فمع أنه من الممكن أن يكون المراد بالشجرة الممنوعة كل تلك المنكرات
نهى الله تعالى آدم عنها، إلا أن الابتعاد عن الشجرة في ضوء موضوع هذه الآية،
خاصة أخذ
الحيطة والحذر من إبليس وذريته، لأنه أقسم بإغواء آدم وذريته.ويؤكد ذلك في قوله تعالى: فقلنا يا
آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (طه:١١٨).ومما يؤيد هذا المعنى
التي
أيضًا استعمالنا لكلمة شجرة بمعنى شجرة النسب.فالامتناع عن الشجرة إذن إنما يعني
أخذ
الحيطة من إبليس وذريته..أي أصحابه وأعوانه فإطلاق تسمية الشجرة على إبليس استخدام لطيف
للغاية، إذ شبه بذلك إبليس وأعوانه بشجرة محرمة، مكتفيا بذكر جذعها الرئيس، وهو إبليس، الذي
يتفرع منه سائر الأعوان والذراري.و لا يغيبن عن البال أن محادثة الله عز وجل مع آدم لم تكن كالمحادثات الإنسانية، بل كانت بصورة
وحي سماوي مما يتلقاه الأنبياء، وما زال الوحي السماوي محلّى بألوان من الاستعارات والمجازات
والتمثيلات العديدة.أمر الله تعالى آدم بأن يقيم في مكان هو كالجنة راحة ونعمة، ووهب له شريعة
تحوّل هذه الدنيا إلى الجنة، وأنعم عليه بزوج وأصحاب كانوا منقادين له مطيعين، محولين هذه الحياة إلى
جنة آمنة فنظرا لكل هذه النعم الجليلة أمر الله عز وجل آدم وأصحابه معه بالإقامة في تلك الجنة؛ بينما
عن صفات معاكسة للجنة باستخدام كلمة الشجرة.فاستعمال كلمة الشجرة جاء لأجل
مناسبتها لكلمة الجنة.وقد أشير بذلك إلى الأمور التالية:
نهاه
۱.أن أصل التعاليم التي تلقاها آدم من ربه هو الحل، أما التحريم فهو لأجل الضرورة.٢.أن جماعة آدم ستكون هي الغالبة والأكثر عددا، وأن أعداءه سوف يتحولون إلى أقلية، بحيث
تكون النسبة بين آدم وجماعته من ناحية..وأعدائه من ناحية أخرى..كالنسبة بين جنة كثيرة الأشجار
وشجرة مفردة محدودة النطاق.١٨٥
Page 268
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ (3)
شرح
الكلمات
۳۷
أزلهما: أزله يعني أزلقَهُ؛ حمله على الزلل والزَّلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد.وقيل
للذنب بغير قصد زلةٌ تشبيها بزلة الرجل."المفردات أزله: حمله على الزلل (اللسان).عنها: عن حرف جر، ويؤدي عشرة معان منها التعليل نحو: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن
موعدة" (الأقرب والمعنى)..أي بسبب وعد فمعنى أزلهما الشيطان عنها حملهما على الزلة بسببها،
أي بسبب الشجرة.اهبطوا هبط من الجبل: نزل منه هبَطَه أنزله هبط بلدا دخله.وهبَطَه بلدا: أدخله فيها.هبط
السوق : أتاها.وهبط من موضع إلى موضع آخر: انتقل (الأقرب).فمعنى اهبطوا منها أي انتقلوا إلى
مكان آخر؛ اخرجوا.مستقر: استقر بالمكان ثبت وسكن المستقر : موضع الاستقرار (الأقرب).متاع كل ما يُنتفع به من الحوائج كالطعام والبز "الثياب" وأثاث البيت، والأدوات والسلع؛ وقيل ما
ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها ما سوى الفضة والذهب؛ وعُرفا كل ما يلبسه الناس ويبسطه.وفي (الكليات): المتاع والمتعة ما يُنتفع به انتفاعا قليلا غير باق بل ينقضي عن قريب.وأصل المتاع ما
يُتبلغ به من الزاد: ويأتي المتاع اسما بمعنى التمتيع (الأقرب).حين الحين وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر.وقيل: الدهر؛ المدة (الأقرب).التفسير: يُحتمل أن يكون ضمير المؤنث في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها راجعا إلى الجنة أو
إلى الشجرة.فإذا كان مرجعه إلى الجنة فالمعنى أن الشيطان أبعد آدم عليه السلام عن الجنة، أو أن حالة
الجنة تغيرت بسبب خداع الشيطان فصارت موضع أذى لهم.وأما إذا كان مرجع الضمير إلى الشجرة
فالمعنى أن الشيطان اتخذ الشجرة ذريعة لخداع آدم وأزلقه من مكانه.وكما بينا في شرح الكلمات أن أزلَه تعني جعله يتزلق بدون إرادة منه.فالمعنى الصحيح أن الشيطان
أزل قدم آدم عن طريق الشجرة بدون عزم من آدم العل.فكل ما حصل كان بالخداع والمكر من
جانب الشيطان.١٨٦
Page 269
حالة
وقوله تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه يمكن أن يعني أن الشيطان أخرجهما مما كانا عليه من
الأمن والاطمئنان؛ أو من الجنة التي كانا فيها.ولكن المعنى الأول هو الأصح، لأنهما أُمرا بالخروج من
الجنة بعد ذلك.ولو أخذنا بالمعنى الثاني فيعني قوله "فأخرجهما" أي جعلهما مستحقين للخروج من
الجنة.وقوله تعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو أي ،اذهبوا، فقد وقع العداء بينكم، ولا تحسبن أن
هذا العداء سوف ينتهي هنا..بل سوف يستمر بينكم في المستقبل أيضًا، ولسوف يسعى الشيطان لشن
هجوم كهذا عند مبعث كل نبي من الله.وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني: سوف تمكثون في هذه الأرض
وتنتفعون من أسباب العيش فيها.فعليكم بالحذر لأنه ليس أمامكم مفر إلا أن تعيشوا مع ذراري
الشيطان.ثم إن هذه الحياة ذريعة مؤقتة بغرض التزود للحياة الآخرة، فلا تتغافلوا وتتشاغلوا عن
الهدف وتنهمكوا في جمع متاع هذه الحياة الدنيا.وتفيد هذه الآية الكريمة عدة أمور جديرة بالانتباه :
هذا
الأمر الأول: أن من مقتضى المجتمع البشري أن يجتمع فيه المؤمن والكافر في مكان واحد ويقيما فيه
معا، وأن العداء بين الخير والشر قائم لا ينفك، فلذلك كان على المؤمنين الصالحين أن لا يألوا جهدا في
دفع الشيطان وشروره عن أنفسهم وعن أولادهم، وهذا الأمر مهم جدا؛ فإن الغفلة عنه تؤدي إلى
انقضاء عهد الحسنات، وكلما ظن المؤمنون أنهم بمأمن من هجمات الشيطان سادهم دور التدهور
والانهيار، وأخذ الشيطان يغلبهم شيئا فشيئا، يا ليت كان هناك قوم يرعون هذا الأمر حق رعايته،
فيحطمون رأس الشيطان.كما أن من عادة أهل الصلاح أنهم يُفرطون في حب أولادهم ويثقون بهم
أكثر من اللازم..مما يوقع الأولاد في شراك الشيطان بعد أن كانوا صالحين.الأمر الثاني:
أن الله تعالى قد قضى بأن آدم وذريته سيسكنون هذه الأرض، ولن يغادروها فرارا من
هجمات الشيطان، بل عليهم أن يعيشوا فيها معا يواجه كل منهم الآخر.ولكن للأسف، يزعم بعض
المسلمين أن ذرية الشيطان لما هجموا على عيسى بن مريم (عليهما السلام) رفعه الله تعالى إلى السماء،
وأبعده عن نطاق الأرض ليحفظه من كيد أعدائه إن هذا الاعتقاد يناقض هذه الآية مناقضة صريحة، لأن
الله تعالى يقول: إن على آدم وذريته أن يعيشوا في هذه الأرض..فهي مستقرهم، أي مكان إقامتهم
الدائم الثابت، فكيف يمكن أن يرفع المسيح الناصري إلى السماء؟ لو كان أحد أحق بالرفع إلى السماء
عند التعرض لهجمات الأعداء لكان آدم..أول الأنبياء، أو محمد المصطفى سيد ولد آدم.إن هؤلاء
۱۸۷
Page 270
يعتقدون بأن آدم بعد أن تعرّض لهجوم الشيطان طرح من السماء إلى الأرض، ويوقنون بأن محمدا
أتباعه
اضطر للهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يرفعه الله تعالى إلى السماء مع أنه الأحق بذلك والأولى!
الأمر الثالث: أن انخداع آدم بقول الشيطان راجع إلى ظن آدم بأنه مأمور بالابتعاد عن مظهر معين
للشيطان، لكن الله تعالى كان يريد أن يبتعد آدم من الشيطان وأتباعه جميعا..ذلك لأن الشيطان إنما هو
روح معنوية مثيرة للسيئات وما كان من الممكن أن يُخدع آدم بصورة جسمانية وبطريق مباشر، ولكن
الذين يهيجون حركات الشر، وهم من بني الإنسان، ولذلك تتعذر معرفتهم، لأنهم أحيانا
يتظاهرون بالإيمان فيعتبرون من المسلمين، وبذلك ينجحون في مكائدهم ويصعب تمييزهم..هل هم
أتباع الشيطان أم هم من المؤمنين الناصحين حقا.إن مظهر الشيطان المذكور في الآية استعمل ذات
المكيدة الشيطانية التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾
(الأعراف:٢٢).ومثل هذا الخداع لا يخالف العقل، وقد يقع فيه الإنسان.وأمثال هؤلاء الشياطين
المنافقين كانوا في عهد رسول الله له أيضًا، وجاء في حقهم: إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ
لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ *
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَحْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ
عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ * (المنافقون: ٢ إلى ٥).ورب متسائل يقول: لو سلمنا بأن الشيطان ظهر لآدم مظهر مخالف لإبليس، وتظاهر له بالإيمان
والإخلاص مما جعل آدم ينخدع به فكيف يصح ذلك مع أن ما أمر به الشيطان كان معصية الله تعالى،
وكيف يقدم آدم على مخالفة أمر الله؟
وجوابنا على ذلك أن الإنسان كما يخدع غيره بتغيير زيه ومظهره..كذلك يخدعه بتصوير الحقائق
على عكسها، وتقديمها بصورة مزيفة.وقد ذكر القرآن هذا الأسلوب عن المنافقين في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (البقرة: ۱۲).ويخبرنا القرآن أيضًا أن الشيطان
اتبع مع آدم نفس المكيدة؛ فعندما حرّضه على مقاربة الشجرة الممنوعة قال له: مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ
هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ) (الأعراف: ۲۱)..فكأن الشيطان يقول لسيدنا
آدم: يجب أن تفكر في حكمة الامتناع عن الشجرة بدل من التمسك بظاهر نص الأمر الإلهي، إن الله
يريد لك أن تصبح ملكا وتنال خلودا بالامتناع عنها..ويمكن لك تحقيق هذا الغرض نفسه الآن باقترابك
بروح الأمر ولا تتردد في الاقتراب من الشجرة فتحقق المشيئة الإلهية.منها.فتمسك
۱۸۸
Page 271
وقد أوضح القرآن هذا المعنى في موضع آخر قائلا: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى
شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى (طه): (۱۲۱).وقوله تعالى وملك لا يبلى أي حياة كحياة الملائكة لا
يصيبها الانحطاط.وبالنظر في الآيتين السابقتين معا نلاحظ في الأولى أن الشيطان تظاهر أمام آدم بالإيمان وتصديق ما
به آدم من حيث الغرض من الابتعاد عن تلك الشجرة.وفي الآية الثانية ارتدى عباءة الناصح
المجتهد..وأوهم آدم بأن الظروف قد تغيرت وأن بوسعه الآن تحقيق الغرض الإلهي نفسه بالاقتراب من
الشجرة بدلا من تجنبها؛ فالأولى هو العمل بروح الأمر وليس بنص الكلمات، وما دام الهدف الأصلي
متحققا فلا بأس ذلك.من
ويتبين من ذلك أن الخواص فضلا عن العوام يمكن أيضًا أن يخطئوا هكذا في فهم بعض المسائل
الدقيقة.ثم إن آدم كان أول الأنبياء، ولم يكن قبله مثل هذه الأحداث حتى تكون له عبرة منها.وربما
شاء الله تعالى أن يقع آدم في هذا الخطأ ليكون عبرة لمن بعده.ففي أيامنا هذه ينخدع عامة المسلمين بمثل
هذه الاجتهادات الخاطئة رغم وجود هذه العبر في الماضي.فمثلا يخدع بعض
هذه العبر في الماضي.فمثلا يخدع بعض "العلماء " التجار وغيرهم
بقولهم بأن الربا الذي حرمه الإسلام هو غير الفائدة التي تعطيها البنوك في هذه الأيام، وإذا كان أخذ
الربا مهلكا للقوم في تلك الأيام، فإن ترك هذه الفوائد يهلكهم اليوم، لذلك لا حرج في أخذ فوائد
البنوك، بل هي ضرورية لأجل الحياة القومية.وهناك العديد من المسلمين الذي يودون بصدق أن يعملوا
بالتعاليم الإسلامية في شأن الربا، ولكنهم ينخدعون بهذه الأقوال ويأخذون الربا.كذلك يخدع البعض المرأة المسلمة قائلا: إن العرب كانوا جهالا، وكان سفور النساء مدعاة
لفسادهن في تلك الأيام، أما اليوم فنحن في زمن العلم والحضارة فلا حرج في ترك الحجاب، بل إن
خروج
النساء المسلمات سافرات سوف يدعم الإسلام ويقويه وقد انخدعت الكثيرات من المسلمات
المخلصات بهذه الأقاويل وتركن الحجاب.ويخطئ بعض الناس في فهم قوله تعالى اهبطوا)، فيقولون إن معناها أن الله تعالى أسقط آدم من
السماء على الأرض، ولكن من معاني الهبوط الانتقال من مكان إلى آخر كما ورد في قوله تعالى حكاية
عن بني إسرائيل اهْبِطُوا مِصْراً..)) (البقرة: ٦٢)..أي ارتحلوا من هنا إلى بلد آخر.وهذا المعنى أنسب
وأوفق مع قول الله تعالى عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة ، فهو خليفة في مكانه الأول وفي مكانه
الثاني من الأرض بعد ارتحاله.۱۸۹
Page 272
ج
فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ، كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )
شرح
الكلمات:
ء
۳۸
تلقى فلان يتلقى فلانا: يستقبله.تلقى الشيء: لقيه.وتلقى الشي منه: تلقنه (الأقرب).وتلقى آدم
من ربه كلمات: أي أخذها عنه، وقيل تعلمها (اللسان).فمعنى تلقى آدم من ربه أنه تلقن أو تعلم
بالوحي من ربه بعض عبارات الدعاء.كلمات : جمع كلمة أي لفظة؛ وكل ما ينطق به اللسان مفردا كان
به اللسان مفردا كان أو مركبا.والكلمة: الخطبة؛
القصيدة (الأقرب).تاب تاب إليه وعليه: رجع عليه بفضله.التفسير : عندما خدع الشيطان سيدنا آدم وأطلعه الله على زلته..دعا الله تعالى مبتهلا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف: ٢٤)..ويبدو أن هذا هو
الذي
تلقنه
من ربه.الدعاء
تدل هذه الآية على حقيقة لطيفة، ذلك أن الله تعالى يتفضل على الإنسان فيعلمه الأدعية التي تستدر
الرحمة الإلهية.وكثير من الناس يصطنعون أدعية من عند أنفسهم، وقد تتسم بالنقص والانحراف، مما
يجعلها تتحول إلى دعاء عليهم ولا نعني بذلك أن يمتنع الإنسان مطلقا عن الدعاء بكلماته..بل المراد به
أن يسعى الإنسان كما سعى آدم عليه السلام للاتصال بالله اتصال وثيقا..لكي يتلقى من الله تعالى
الدعاء عندما يتعرض لمشكلة أو مصيبة، ولكي يرث فضل الله تعالى بذلك الدعاء.صلے
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )
شرح الكلمات:
۳۹
خوف: الخوف انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب.(الأقرب)
يحزنون حزن عليه وله ضد سُرَّ.الحُزن: الغمُّ؛ خلاف السرور.الحزن: الغم الحاصل لوقوع مكروه
أو فوات محبوب في الماضي" التاج".الحزن خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم، ويضاده الفرح
الماضي"التاج".(المفردات).فالفرق بين الخوف والحزن أن الخوف يخص المستقبل والحزن يخص الماضي.۹۰
Page 273
التفسير: في قوله تعالى اهبطوا بصيغة الجمع دلالة على أن آدم وزوجه لم يكونا وحدهما في الجنة،
بل كان معهما أتباع آدم عليه السلام أيضًا.الله
ولقد وعد
عز وجل بهذه الآية أنه لن يزال يظهر من ذرية آدم دعاة يحملون إلى الناس الهدي
الإلهي، ويدعونهم إلى الأعمال الصالحة وأن من يستجيب لهم ويهتدي سيدخل الجنة في هذه الدنيا
أيضًا، أي أن قلوبهم ستكون عامرة بالقوة الإيمانية التي تورثهم الطمأنينة في كل حال، فلن يداخل قلوبهم
الخوف من المصائب المقبلة، ولا الحزن على ما قد أصابهم من قبل، بل تكون قلوبهم المطمئنة بمثابة الجنة
لهم.ثم إن جنة الآخرة بعد الموت ميراث لهم يجدون فيها من نعيم الله تعالى ما لا يحصى.وتدلنا الآية أيضًا على أن الوحي الإلهي لم ينقطع بعد آدم لأن الله تعالى وعد منذ ذلك العهد بأن
وحيه لن ينقطع نزوله، وأن المؤمنين به سوف يحظون بفضل الله دون انقطاع.وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَتِنَا أُوْلَتِبِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (3)
شرح المفردات:
كذبوا كذَّب: نَسبه إلى الكذب؛ وقيل: قال له: كذبت كذَّب بالأمر تكذيبا وكذابا: أنكره
وجحده.(الأقرب)
آيات جمع آية وهي: العلامة الدليل والآية كل قطعة من القرآن فصلت عن غيرها بعلامة.(التاج)
خالدون الخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدم.التفسير : الذين يتنكبون عن طريق الهدى ولا يؤمنون بالآيات التي جعلها الله تعالى لمعرفته سيقعون في
النار، ولن يجدوا طمأنينة القلب وسكينة النفس رغم كثرة النعم التي تحيط بهم، كما ينالون العقاب بعد
الموت.إن الإسلام لا يقول بالعذاب الدائم غير المنقطع، بل إنه يعد جهنم كالمستشفى الذي سيدخله الناس
للاستشفاء من أمراضهم.فإذا ما تحقق الإصلاح والشفاء ينتهي العذاب والعلاج، لأن الهدف من العقاب
ليس الانتقام الناجم عن غيظ أو غضب أو عداوة، بل هو للإصلاح فقط، ولقد ورد في الحديث النبوي
أنه "يأتي على جهنم زمان لا يبقى فيها أحد، ونسيم الصبا تحرك أبوابها (تفسير معالم التنزيل، آية: أما
الذين شقوا...
Page 274
يجب أن تكون قصة آدم الموعظة وذكرى لكل واحد من بني آدم لأن كل إنسان يولد فهو
كآدم ويؤمر الملائكة بمساعدته، لأنهم خلقوا كواسطة لتدبير نظام هذا الكون، فتكون كل الأشياء
الخاضعة لتدبير الملائكة معاونة للإنسان، وتنفعه في الاستمتاع بحياته.بيد أن بعض الأشرار لا يرتاحون
لارتياح إخوانهم، فهم كالشيطان يحاولون إخراجهم من تلك الجنة الروحانية التي أُورِثُها كلُّ إنسان منذ
ولادته، ساعين إلى إيذائهم.لكن الذي يخضع لربه كما خضع آدم، ويلجأ إليه عند المصائب ينال
النجاح، ويعلو عن متناول الخوف والحزن، أما الذين لا يقتفون بآثار آدم وتزل أقدامهم في الابتلاءات،
ويصالحون الشيطان ويعرضون عن هدى ربهم فإنهم يصيرون عرضة للآلام فيهلكون.تطلع الشمس في كل يوم لترى تكرار هذا الحادث في الدنيا، ولكن الإنسان الذي بنفسه واقع في
أنواع المعاصي الخطيرة يلوم آدم لاتباعه الشيطان؛ مع أن آدم أخطأ ولم يكن له عزم على الخطأ.ومثل
هؤلاء المعترضين الذين لا يتورعون عن الاعتراض على آدم لا يدركون أن الشيطان قابع في قلوبهم هم.وتخبرنا الآيات السابقة:
۱.أن الوحي الإلهي موجب لشرف الإنسان وفضيلته على سائر الحيوانات.فالأمم التي لا تقدر
الوحي الإلهي حق قدره فإنها محرمة بتفضيل الحيوانية على الإنسانية وإنها لتعرقل طريق النهضة الحضارية
اليوم وتحول دونها في المستقبل أيضًا، وأنه لن يدفع عجلة التقدم الحضاري إلا أولئك الذين يلبون الدعوة
السماوية، وإن الذين استجابوا لدعوة محمد الله في هذا العصر هم الذين سيؤسسون مدنية جديدة نافعة.وهذا ما وقع فعلا..إذ إن أتباع هذه الحركة الروحانية الكبرى أصبحوا طبق سنة الله المستمرة مؤسسين
لمدنية جديدة عظيمة.إن الحضارة الغربية العصرية، وإن بدت رائعة جدا، إلا أنها مقتطفةٌ إلى حد كبير
من المدنية الإسلامية، وإن النواحي التي تختلف فيها مدنية الغرب عن المدنية الإسلامية هي التي سببت
الإخلال بالأمن والسلام العالمي.اللازم
أن
٢.أنه كلما ظهرت للناس حركة إصلاحية جديدة عارضوها، لأنها تكون في بداية الأمر من العظمة
والروعة بحيث يقصر عن إدراك أعماقها وقوة تأثيراتها حتى الصالحون من عباد الله.فكان
يحدث ذلك عند ظهور الإسلام أيضًا، وكذلك حدث.من.أما الصالحون فلا يلبثون بعدئذ أن يعترفوا بأخطائهم، ويذعنون لعظمتها، ويندفعون إلى تأييدها.أما الأشرار فإنهم يبدءون في مقاومتها، وكذلك جرى للإسلام وسيجري أيضًا.وقد رأينا أن صالحي
الفطرة من الناس تتابعوا في الدخول في الإسلام أفرادا، وقاموا لمناصرته غير أن المطبوعين على طبائع
إبليس تمسكوا بالتمرد والعصيان.۹۲
Page 275
٤.عندما يخيب الأعداء في مقاومتهم العلنية ضد الجماعات الإلهية، فإنهم ينضمون إليها نفاقا، ليقوموا
بالدسائس السرية من داخلها، كما تظاهر الشيطان بالنصيحة لآدم.وكما خاب شيطانُ آدمَ وخسر،
فإن أعداء الإسلام سيخيبون ويُحبط الله مكائدهم ولن يمسوه بسوء، ولسوف يتقدم الإسلام ويزدهر
بالرغم من عدواتهم ومقاومتهم، وسيتجرعون الغصص من عذاب الغيظ الدائم.0
إن الهداية السماوية ليست مقصورة على زمن دون زمن، بل إن الله لن يزال يرسل الهداية طبق
مقتضى كل عصر.فلو كانت سنة إرسال الهداية محدودة لانسدت أبوابها بمجرد ظهور النبي الأول كما
تزعم الهندوس مثلا.فانقطاع الهداية السماوية يخالف مقتضيات العقل ويناقض متطلبات الوحي
السماوي أيضًا.٦.إن الذين يؤمنون بالهداية السماوية يحفظهم الله من سيئات أعمالهم السابقة كما حفظ آدم عليه
السلام.وبسبب الإيمان بهذا الوعد يصير المؤمن جريئا شجاعا مقداما لا يخاف العواقب عند الفداء بكل
ما يملك، لأنه يوقن بأن الوحي السماوي هو العروة الوثقى التي إذا استمسك بها نجا من جميع الهموم
والآلام فله إحدى الحسنين: إما القيادة والصدارة إذا كتبت له الحياة أو الشهادة المريحة في أحضان
الله تعالى.فمم يخاف؟
يبَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ
بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنى فَأَرْهَبُونِ (2)
شرح الكلمات:
٤١
بني إسرائيل: إسرائيل لقب لسيدنا يعقوب ال، وتقول التوراة إن هذه التسمية أطلقها الله تعالى
عليه لشجاعته: "فقال: لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس
و قدرت (التكوين : ۲۸:۲۳).وهذا اللقب يطلق أيضًا على نسل يعقوب فيسمون "إسرائيل" بدلا من
بني إسرائيل.(Analytical Hebrew and Chaldec)
ويقال لإسرائيل بالعبرانية "يسرائيل" وهي كلمة تتركب من "يسر" أي المقاتل الباسل و "إيل" أي
الرب..بمعنى "المقاتل الباسل للرب".وتتركب الكلمة العربية "إسرائيل" من "إسر" و "إيل".ويمكن أن تكون عبرانية الأصل معربة، ولكن
الواقع أن اللغتين لغة واحدة وحسب تحقيقنا فإن العبرانية صورة مشوهة من العربية.ويرى هذا الرأي
۹۳
Page 276
بعض العلماء الغربيين وإن كان معظمهم بسبب تعصبهم الديني يعتبرون اللغتين متفرعتين عن لغة
أخرى؛ بل قال بعضهم إن العربية انحدرت من العبرانية! ولا يسمح المجال ببحث هذه القضية.وإنما
نكتفي هنا بالقول إن كلمة "إسرائيل" عربية الأصل، تغير شكلها في العبرية.يقال في العربية: أسَرَ الرجل: قبض عليه وأخذه (الأقرب).ويكون معنى كلمة "إسر" القوي الشجاع
الذي يتغلب على خصمه ويأسره.وإذا لاحظنا كلمة "يسر" العبرانية التي تعني في العربية اللين والانقياد
كان معناها: من يتقبل القول بلين وينقاد دون معارضة.وكلمة "إيل" في صورتها هذه لا تعني في العربية معنى الرب، ولكن إذا أمعنا النظر وجدنا أن معناها
الحقيقي يصدق على الله تعالى، لأنها مشتقة من فعل "آل" واسم الفاعل منها "آئل"، والصفة المشبهة منها
"إيل".ويعني "آل" ساس؛ يقال آلَ الرجلُ أهله أي ساسهم (الأقرب)؛ وآل الملك الرعية: تفقد أحوالها
ودبر أمورها؛ وآل على القوم: وليهم أي صار ولي أمرهم.فتعني كلمة "آئل": المدبر؛ الحاكم؛ الملك؛
وتعني كلمة "إيل" الكائن المتصف أزلا وأبدا بصفات التدبير والحكم والملك؛ وهي صفات لا توجد إلا
في ذات الله تعالى، لأنه أزلي أبدي.ومن معاني آل عاد، وبناء على ذلك تعني كلمة "إيل" الكائن المتصف أزلا أبدا بصفة الرجوع، وهذا
المعنى نفسه مدلول صفة "التواب" الإلهية، أي الذي يرجع على عباده برحمته مرارا وتكرارا.فيكون المراد من إسرائيل بناء على اشتقاقه من "إسر": (۱) العبد القوي الشجاع للملك الأزلي
الأبدي سبحانه وتعالى، (۲) العبد القوي الشجاع للكائن المدبر أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، (۳) العبد
القوي الشجاع لمن يعود على العباد مراراً..أي التواب سبحانه وتعالى.وبناء على الاشتقاق من "يسر" فتعني: عبد الله المطيع المتخلق بأخلاقه تعالى.وإذا اعتبرناها صفة
الله
مشبهة من "يسر" كانت إشارة إلى صفة مميزة توجد في فطرة الأنبياء..وهي استسلامهم التام الدائم
تعالى..فكأن إسرائيل تعني المطيع المستسلم لله تعالى، والمنقاد دائما لأحكامه.ويتأكد هذا المعنى من
معجم تاج العروس أيضًا حيث جاء فيه: إسرائيل معناه صفوة الله، وقيل: عبد الله، وقيل: سري الله..والسري هو السيد الشريف ذو المروءة والكرم والعز.ويصرح المعجم العبراني الإنجليزي للعهد القديم " Hebrew & English Lexicon of the
old Testament" أن المعنى الحقيقي لكلمة "يسر" ليس "سري" وإنما قريب منها.والحق أن كلمة "يسر" تعني المقاتل الشجاع، ومثل هذا الإنسان يُؤمر على الجيش، وكان العرب
يسيدون عليهم أشجعهم وأشرفهم وأكثرهم مروءة وكرما.وهكذا تتضمن كلمة "يسر" معنى "سري"
أيضا.٩٤
Page 277
أذكروا : ذكر الشيء ذكرا وتذكارا: حفظه في ذهنه.وذكر الشيء بلسانه: قال فيه شيئا.وذكر
لفلان حديثا قاله له.وذكر ما كان قد نسي: فطن به (الأقرب).والذكر تارة يقال ويراد به هيئة
للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه،
والذكر يقال اعتبارا باستحضاره وتارة يقال لحضور الشيء القلبَ أو القول، ولذلك قيل: الذكر
ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان وكل واحد منهما ضربان ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان
بل عن إدامة الحفظ (المفردات).نعمتي
النعمة الصنيعة والمنة ما أنعم به عليك من رزق ومال وغيرهما؛ المسرة؛ اليد البيضاء الصالحة.وفي الكليات: النعمة في أصل وضعها الحالة التي يستلذ بها الإنسان، وهذا مبني على ما اشتهر عندهم أن
النعمة للحالة، والنّعمة للمرة ونعمة الله ما أعطاه الله للعبد مما لا يتمنى غيره أن يعطى إياه " أي حتى لا
يتمنى بعده شيئا يعطاه ".وجمع نعمة نعم وأنْعُم.يقال : فلان واسع النعمة أي واسع المال (الأقرب).عهدي: العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد بحال.وسُمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا.وعهد
الله تارةً يكون بما ركزه في عقولنا، وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وسنة رسله، وتارةً بما نلتزمه
(المفردات).والعهد: الوصية والأمر؛ الموثِقُ واليمين؛ الحفاظ ورعاية الحرمة؛ الأمان؛ الذمة؛ الالتقاء؛ المعرفة
الزمان الوفاء؛ توحيد الله تعالى الضمان؛ الذي يُكتب للولاة (التاج).ارهبون: رهب الرجلُ يرهب رهبةً: خاف (الأقرب).وأصل ارهبون ارهبوني.التفسير وبذكر مثال سيدنا آدم عليه السلام بين أن دعوى محمد رسول الله ﷺ ليست أمرا مبتدعا..فما أن اكتمل العقل البشري حتى أنزل الله تعالى وحيه على آدم وبعد آدم كان يمكن أن يتساءل أحد
عن الحاجة إلى إرسال وحي آخر بعده؛ وهذا سؤال عام يثيره منكرو النبوة، بل أتباع الديانات السابقة.وغرض المنكرين للنبوة من السؤال هو التشكيك فيها، بناء على أن المدعي الجديد قد يكون على خطأ،
والأنبياء السابقون قد مضوا في سبيلهم وليس لهم من يخلفهم أو ينوب عنهم ليطاع أو يتبع.أما أتباع
الديانات السابقة فيعترضون على أساس أنه ما الحاجة إلى نبي جديد مع وجود ديننا؟
ويمكن الرد على هذا السؤال بطريقين: الأول أن نثبت ضرورة النبوة عقلا والثاني أن نقدم شهادة
التاريخ على أن النبوة كانت مستمرة بعد.آدم وقد تناول القرآن الكريم ضرورة النبوة من حيث العقل
في مواضع أخرى عديدة، وقد اختار هنا الطريق الثاني، وبين أن هناك من ادعى النبوة قبل الإسلام بزمن
قريب، وبذلك أبطل القرآن الاعتراض على نزول شريعة أو وحي نبوة رغم وجود شريعة سابقة.قال:
۹۵
Page 278
فكيف تنكرون صدق أولئك الذين تحقق صدقهم بالشواهد والدلائل؟ وإذا كانوا صادقين في دعواهم،
فكيف يمكن إنكار الوحي الذي أتى بعد الوحي الأول؟ وإذا كان نزول الوحي مستمرا بعده، بل بعث
الله تعالى الأنبياء حتى إلى ما قبل الإسلام بزمن قريب..فكيف يصح الاعتراض على الإسلام بترول
الوحي الجديد فيه رغم وجود الشرائع السابقة؟
الأنبياء
وهناك فائدة أخرى لاختيار هذا الأسلوب في الرد على ذلك السؤال..ذلك أن اليهود والنصارى
كانوا من أول المخاطبين بالقرآن الكريم.فاستدل على استمرار الوحي بتقديم أمثلة من أنبيائهم وبين أنه
كانت هناك حلقة في سلسلة النبوة لا تكتمل إلا بها ألا وهي بعث النبي من بني إسماعيل.فلقد أخبر
منذ عهد إبراهيم ببعث نبي من أبناء إسماعيل أيضًا.وقد أوضح موسى ومن جاء بعده من
عليهم السلام نباً مجيء هذا النبي بمزيد من البيان فالاستشهاد بوحي هؤلاء الأنبياء له فائدتان: إحداهما
ضرورة استمرار النبوة، والثانية أن ثبوت انتقال الوحي الإلهي بعد هذه السلسلة من النبوة إلى بني
إسماعيل كان حتما ولازما.الو
وحي
ولبيان هذا الدليل..شرع الله تعالى بدءا بهذه الآيات يخاطب بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمه عليهم.وطالبهم بتقديم شهادة صادقة بأن الوحي الإلهي كان مستمرا في العالم، وأنكم كنتم مهبطا له، بل إن
انتقال سلسلة الوحي منكم إلى بني إسماعيل مذكور في كتبكم.إسرائيل
كان إسحاق الابن الأصغر لسيدنا إبراهيم؛ وهو والد يعقوب الذي أنجب يوسف ال.وليعقوب
مقام خاص عند اليهود، ويبنون تفوقهم العرقي على بنوتهم له، وقد نال لقب إسماعيل من
الله تعالى
فسمي أولاده بنو إسرائيل، إذ ورد في التوراة أن يعقوب أثناء سفر له صارع شخصا طوال الليل..وأن
هذا الشخص كان "الرب" "فقال له : ما اسمك؟ فقال: يعقوب.فقال لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب
بل إسرائيل.لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت".(تكوين ٣٣: ٢٨ إلى ٣٠)
ويقول شراح التوراة إن ذلك المصارع كان ملكا دون أن يقدموا دليلا على ذلك.وسواء كان من
رآه يعقوب في عالم الكشف أو الرؤيا ملكًا أم الرب نفسه..فهو الذي سماه إسرائيل، لأنه كان في نظر
الله تعالى والخلق قويا غالبا، فمعنى إسرائيل، بحسب التوراة، العبد القوي للرب، أو العبد الغالب في سبيل
الرب.والمعنى اللغوي لإسرائيل كما جاء في شرح المفردات هو "المقاتل الباسل أو الجندي القوي للرب،
أو العبد المطيع الله".وبسبب هذا اللقب سُمي أولاده بني إسرائيل.٩٦
Page 279
بنو إسرائيل واليهود
لم تذكر هذه الآية كلمة اليهود، ولكنها وردت في القرآن الكريم في مواضع أخرى في صيغة
"يهودي" أو صيغة "هود"..ومن المناسب أن نعرف الفرق بين كلمتي يهود وبني إسرائيل.تردد اسم "بني إسرائيل" في ٤٨ موضعا في القرآن الكريم، وجاءت كلمة "اليهود " في ٩ مواضع منه.وكلمة "هود" في ٣ مواضع.وإذا نظرنا إلى هذه المواضع وجدنا أنه كلما أراد القرآن ذكر أتباع دين
موسى قال "اليهود" أو "هود"، وكلما أراد الإشارة إلى نسل يعقوب قال "بني إسرائيل".وكلمة "هود"
في المواضع الثلاثة تقابل كلمة "النصارى" إشارةً إلى أتباع الملة اليهودية والملة النصرانية، وكذلك كلمة
"اليهود" في تسعة أماكن وردت في ثمان منها مقابل كلمة نصارى..مما يدل على أن المراد منها هو الملة
المرسومة وليس الشعب الإسرائيلي.أما في الموضع التاسع "المائدة : ٦٥" فيدل السياق أن الموضوع أيضًا
يدور حول عقائد الديانة اليهودية.ولكن كلما وردت كلمة "بنو إسرائيل"..في القرآن كانت دلالة على
الشعب الموسوي، وليس هناك موضع استخدم فيه القرآن الكريم كلمة "النصارى" بإزائها.وبناء على هذا التباين بين الكلمتين.يمكن أن يندرج تحت خطاب "بني إسرائيل" أيضًا من كانوا من
نسل يعقوب وإن تركوا الدين اليهودي ودخلوا مثلا في النصرانية أو الإسلام كذلك بالنسبة لكلمة
"يهود" أو "هود"، فمن اعتنق الديانة الموسوية وإن لم يكن من بني إسرائيل يمكن أن يسمى يهوديا.وربما يتشكك أحد في أن اليهود لا يسمحون بدخول الناس في ديانتهم فكيف نستسيغ أن يدخل
أحد من غير بني إسرائيل في الدين اليهودي.فالجواب على ذلك أنهم لا شك يعتبرون دين موسى خاصا
بهم، ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات أيضًا.فقد رخصوا لبعض الناس الدخول في دينهم مثل
عبيدهم أو الذين هاجروا إلى بلادهم واستوطنوها وعاشوا تحت حكمهم، فقد جاء ذكر ذلك في
التوراة: "وإذا نزل عندك نزيل وصنع فِصحًا للرب فليُخْتَتَن كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه، فيكون
كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل
بينكم".(خروج ١٢ : ٤٨ و ٤٩)
منه
يتضح من هذه الفقرات أن شريعة موسى وإن كانت تعتبر خاصة لبني إسرائيل ولكنها، لغرض
التوحيد بين طوائف المجتمع، تسمح بدخول من يترل بلادهم ويقيم معهم ويكون تابعا لحكومتهم.وكذلك ورد في (سفر تثنية ٣:٢٣ إلى (۸) قائمة بشعوب تدخل في النظام اليهودي بشروط خاصة.وورد أيضاً: "وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا..كل
الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت
۹۷
Page 280
الصلاة، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة في مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يُدعى لكل الشعوب".(إشعياء ٥٦: ١ - ٨)
والمراد بالتمسك بالعهد هنا هو الاختتان..لأنه علامة العهد الإلهي لإبراهيم.ج ۱۰).ويقول العالم اليهودي يوسيفوس إن الذي يغير دينه ويدخل في اليهودية هو من يتقيد بالتقاليد اليهودية
ويتبع القانون اليهودي ويقوم بعبادة الرب كعبادة اليهود له (الموسوعة اليهودية،
ويتبين من التوراة أيضًا أن بعض الناس كانوا يدخلون في الديانة الموسوية عمليا.فهناك راعوث فتاة
مؤابية تزوجت من رجل إسرائيلى واعتنقت الديانة الموسوية (سفر راعوث).وكذلك يتبين من التوراة أن الآشوريين الذين استوطنوا فلسطين اتبعوا شريعة اليهود.(عزرا٣: ٢)
وهذا ما يؤكده التاريخ أيضًا، فقد ذكر المؤرخون الرومان تاسيتوس Tacitus، وديكاسيوس
وهوريس Horecse، وغيرهم في كتبهم أسماء الرومان الذين اعتنقوا الدين
Diocassious
اليهودي (الموسوعة اليهودية ج ١٠).ويتبين من التاريخ الإسلامي أيضًا أن بعض عرب المدينة دخلوا في دين اليهود، مثل كعب ابن
الأشرف الذي نقض عهده مع رسول الله ﷺ وحض أعداء الإسلام على الهجوم على المدينة واستئصال
شأفة المسلمين، مما جعل النبي ﷺ يصدر الأمر بقتله.كان أبوه من قبيلة بني نبهان.فر إلى المدينة لاجئا
بعد أن قتل أحد الناس وتحالف مع يهود بني النضير، ثم تزوج فتاة منهم تدعى عقيلة بنت أبي الحقيق،
وهكذا دخل دين اليهود، وكان ابنه كعب يهوديا كذلك شرح) المواهب اللدنية للزرقاني..ذكر قتل
كعب ابن الأشرف).كذلك يتضح من بعض الروايات أن بعض مشركي المدينة كانوا ينذرون أبناءهم لليهود، فيدخلونهم
الديانة اليهودية عندما يشبون، فقد ورد كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد
تموده.فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار.فقالوا: لا ندع أبناءنا.فأنزل الله
عز وجل:
لا إكراه في الدين)) (أبو داود، كتاب الجهاد).والخلاصة أن اختصاص الديانة الموسوية ببني إسرائيل لا يعني أنه لا يمكن أن يدخل غير إسرائيل في
اليهودية..بل إنه بحسب الشريعة التي جاء بها موسى يمكن للرقيق أو التابع لحكم اليهود أن يدخل الدين
اليهودي إذا عمل بحسب شريعته واختتن ويعني الاختصاص هنا فقط أن هذه الديانة ليست ديانة
تبشيرية، ولم يؤمروا بالخروج إلى الأمم الأخرى لدعوتهم إلى اليهودية ويعني أيضا أن الوعود المتعلقة
بالرقي والازدهار خاصة بالإسرائيليين، أما الأمم الأخرى فيمكن أن ينالوا منها شيئا بشرط أن يكونوا
۹۸
Page 281
تابعين ومطيعين لهم تماما.ولكن الإسلام خلافا لذلك، يأمر بالتبليغ ودعوة الناس كافة، ولا يعتبر ما
يَعِدُ به المؤمنين خاصا بالعرب، بل كل وعوده تشمل المؤمنين جميعا عربا وعجمًا.ولما كان مسموحا ليهود بني إسرائيل أن يُدخلوا في دينهم أبناء الأمم الأخرى بصفة استثنائية، وقد
دخل فيه عدد محدود من هؤلاء، لذلك لزم أن يكون لهم اسم سوى "بني إسرائيل" ينسبهم إلى الدين
بدلا من الشعب.وبمرور الوقت استخدم وصف "اليهود" تحقيقا لهذا الغرض.كان عدد الداخلين في اليهودية من غير بني إسرائيل بعد موسى بفترة قصيرة قليلا، وكان بنو إسرائيل
يسمونهم
"أجانب أو غرباء"، ولكن بعد أن قامت دولة إسرائيل في زمن داود عليه السلام، واتسع نطاق
حكمهم، وبدأت الشعوب الأخرى تنظر إليهم باحترام، ودخل من رعاياهم عدد لا بأس به في
اليهودية..مست الحاجة أن يكون هناك اسم غير بني إسرائيل يشمل هؤلاء أيضًا.كما لعبت الظروف السياسية دورًا في اختيار هذا الاسم..فقد خلف سليمان عليه السلام ابنه
رحبعام وكان ذا ميول دنيوية، ولما جاء بنو إسرائيل في حفل تتويجه طلبوا منه أن يجري تعديلات
تخفف من وطأة القانون ولكنه بناء على مشورة أصدقاء من الشباب اشتد عليهم في الجواب وطردهم
من المجلس.وعلى إثر ذلك قام عشرة من رؤساء قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة بإعلان التمرد عليه بمجرد
خروجهم من المجلس؛ و لم يبق تحت حكمه سوى منطقة اليهودية التي تدعى اليوم فلسطين، وكانت تضم
قبيلتي يهوذا وبنيامين وسبب وفائهما له أن سيدنا داود عليه السلام كان من سبط يهوذا وَوُلد ونَشَأ في
قبيلة بنيامين، وبمعونتها استولى على منطقة يهوذا ثم على سائر مناطق بني إسرائيل.(الموسوعة اليهودية،
تحت كلمة داود)
ونتيجة لهذا التمرد انقسمت حكومة بني إسرائيل إلى دولتين : أطلق على أحدهما اسم يهوذا، وكانت
تضم منطقة اليهودية حيث تقطن قبيلتا يهوذا وبنيامين (أخبار الأيام الأول ۱: ۳: ۷ و ۱۰، متی ۱: ۲،
لوقا ۳: ۳۳؛ أخبار الأيام الثاني: ۱:۱۱)، وسميت الأخرى إسرائيل لأنها كانت تضم معظم القبائل
الإسرائيلية، وكانت تشغل شمال فلسطين وغرب الشام.وبسبب هذا الانقسام مالت حكومة إسرائيل إلى
الشرك، وفَرَّ علماء التوراة منها إلى اليهودية وصارت اليهودية مركزا للعقيدة الموسوية، وحاملة لواء
هذه الديانة شيئًا فشيئًا.هكذا سمي
أهل يهوذا يهودا للتفريق بينهم وبين سكان إسرائيل.وباتساع هوة الخلاف شيئًا فشيئًا بدأ
اسم "يهود" يستعمل تعبيرا عن الدين بدلا من الدلالة على المكان وحده.وعندما عُمرت اليهودية على
أيدي النبيين "عُزير ونَحيما"، وصار زمام الدين الموسوي في يد أهلها وحدهم اقتصر مدلول الكلمة على
اتباع الدين الموسوي ولم يعد يعبر عن اسم القبيلة أو المكان..ذلك أن إحياء الدين الموسوي في ذلك
۹۹
Page 282
الزمن كان يجري على يد أهل اليهودية.وعندما بدأ هذا الاسم يطلق بالمعنى الديني فقط شمل أيضًا أتباع
دين موسى من غير بني إسرائيل.نشأة..من
وعندما آمنت طائفة من بني إسرائيل بالمسيح عيسى اللي انقسموا إلى فئتين: فئة بقيت على اليهودية،
وقسم آخر سُمّوا النصارى.ثم جاء الإسلام وجعل بعضهم مسلمين فكان هناك من بني إسرائيل من
كانوا مسلمين.والخلاصة أنه لما ازدهر الدين الموسوي على أيدي أهل يهوذا، وجاء كل الأنبياء العظام منهم أصلا أو
أمثال أرميا، وحزقيال، ودانيال، وعزرا، ونحميا وغيرهم، ولما كانت حكومة إسرائيل في
الشمال قد مالت إلى الشرك..اشتهر أهل يهوذا باسم اليهود.ولما كان الكثير من غير بني إسرائيل قد
دخلوا الدين الموسوي في ذلك الزمن..صار اسم اليهود يطلق على كل من يدخل هذه الديانة تمييزا لهم
عن أهل الديانات الأخرى.وقبل الإسلام ببضعة قرون كانت كلمة "يهودي" تعني: من ينتسب إلى دين
موسى عليه السلام.ولما كانت الوعود الإلهية لإبراهيم وموسى عليهما السلام فيما يتعلق بالمجد الدنيوي
والترقي الروحاني تخص ذريتهما..بقيت تسمية بني إسرائيل قائمة للتمييز بين الأقوام.لقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل إلى حد ما لأبين أن القرآن الكريم الذي ينسبه أعداؤه إلى الجهل
بالدين اليهودي وتاريخ بني إسرائيل قد لاحظ هذا الفرق بدقة تامة..بمعنى أنه كلما أراد ذكر الدين
استخدم كلمة اليهود، وإذا أراد ذكر الوعود القومية الخاصة بآل إبراهيم أو آل موسى أو آل داود أو من
بعث فيهم من أنبياء السلسلة الموسوية..لم يستخدم كلمة "اليهود" بل كلمة بني إسرائيل"، لأن تلك
الوعود لم تكن موجهة إلى أتباع الدين الموسوي وإنما كانت خاصة للقائمين على عهد الله تعالى من بني
"
6
إسرائيل..سواء أكانوا على دين موسى أو على أي دين سماوي بعده كمن أسلم من بني إسرائيل.ومن المضحك أن الكتب السماوية لهؤلاء الذين يرمون القرآن بجهله بتاريخ بني إسرائيل هي نفسها
تخطئ في هذا الصدد..فمثلا جاء في الأناجيل عن المسيح أنه ملك اليهود وقد ورد أن بيلاطس عندما
سأل المسيح أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول (متی ۲۷ ۱۱ مرقص ٢:١٥، لوقا ٣:٢٣).وتتأسس دعوى الملوكية هذه على ما جاء في العهد القديم: "ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا
بنت أورشليم هو ذا ملكك يأتي إليك" (زكريا (٩٩)
وتبين هذه العبارة أن زكريا أخبر بمجيء ملك يعيد لأورشليم مجدها، فالمراد به ملك للإسرائيليين
وليس ملك اليهود.فقد ورد يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل" (يوحنا: ٤٩).وهذا هو
الصحيح، لأن الوعود برقي السلسلة الموسوية كانت مخصوصة ببني إسرائيل وليس بمن يدخل في الدين
اليهودي.ثم إن خطاب المسيح عليه السلام كان موجها إلى بني إسرائيل، فقد ورد عنه أنه عندما أرسل
Page 283
تلاميذه للتبشير قال لهم: "إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" (متى ١٠: (٥).وجدير بالذكر هنا أن معظم السامريين كانوا ينتمون
إلى آباء من اليهود، وكانوا يؤمنون بالتوراة ويعملون بها.وما دام المسيح قد نهى تلاميذه عن الذهاب
حتى إلى السامريين..فما بالكم بالأمم الأخرى الأجنبية؟
ولقد التصق هذا الخطأ بالنصارى وما زال ملازما لهم إلى اليوم.فلا يفرقون بين اليهودي
والإسرائيلي.ففي هذه الثورة الحالية في ألمانيا وبعض البلاد الأوروبية ضد الجنس الإسرائيلي..يرفعون
شعار: اطردوا اليهود من البلاد.ولا يريدون بذلك كل تابع للدين الموسوي فحسب، بل أيضًا من تنصر
من اليهود.صحيح أنهم من بني إسرائيل إلا أنهم لم يظلوا بعد تنصرهم يهودا.وقد ازداد هذا الحماس في
ألمانيا لدرجة أن كل من كان في عروقه دم من أم إسرائيلية اعتبروه عدوا للوطن، قائلين إنه يهودي أو أن
فيه دما يهوديًا، مع أنه لا يدين بدين اليهود ولم تكن أمهاته يهوديات وإنما كن نصرانيات وكان نسله
أيضا نصرانيا.إذا، ففي هذا العصر الذي يطلقون عليه عصر العلوم، وتزهو به أوروبا لما تحقق فيه من ازدهار
علمي..أقول في هذا العصر أيضًا لا يفرقون في أوروبا بين اليهودي والإسرائيلي.لكن القرآن الكريم قد
لاحظ ذلك قبل ثلاثة عشر قرنا فكلما تناول ذكر الوعود المتعلقة بالازدهار القومي أو خطاب الأنبياء
لهم استخدم كلمة "بني إسرائيل"، وكلما ذكر العقيدة الدينية اكتفى بكلمة "اليهود".ولما كانت الآية
الكريمة التي نحدد بصدد تفسيرها تشير إلى وعود كانت مخصوصة بذرية إبراهيم عليه السلام، أو تشير إلى
دعوى مخصوصة لهم عن طريق موسى عليه السلام..لذلك استخدم فيها وفي الآيات التالية اسم "بني
إسرائيل".ولم يكتف بقوله اذكروا نعمتي بل زاد وقال : التي أنعمت عليكم ليضيف إليه معنى آخر..لأن
من خصائص اللغة العربية أن الزيادة في الحروف أو الكلمات تعني زيادة أو جدة في المعنى.والمعنى
المضاف هنا هو بيان أنها نعمة خاصة بقومكم.فنعم الله تعالى على نوعين: الأول ما هو عام يتمتع به
المؤمن والكافر على حد سواء..كالهواء والماء والنار والغذاء وغيرها؛ والثاني ما يناله عباد الله المقربون
بتحقيق شروط معينة، أو ما يترل بحسب وعود خاصة.فلو كان المراد من قوله نعمتي النوع الأول
الذي يستوي فيه الكافر والمؤمن لقال: (اذكروا نعمي)، ولكنه تعالى استخدم كلمة "نعمة" مفردة إشارة
إلى نعمة خاصة، ثم زاد عليها عبارة أنعمت عليكم لبيان أنها كانت خاصة لكم، ولم يشارككم فيها
سواكم.
Page 284
ما هي
نعْمَةَ
تلك النعمة؟ يجيب القرآن الكريم في موضع آخر : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) (المائدة: ٢١).هكذا خاطب موسى عليه السلام بني إسرائيل عندما اقتربوا من الأرض المقدسة، وأُمروا بدخولها..ولم
يكونوا عندئذ ملوكا، بل كانوا يتيهون في الفيافي؛ كما أنهم لم ينالوا الملك من قبل، ولم يكن فيهم ملك
قط منذ زمن إبراهيم حتى يوسف (عليهما السلام).أما بعد يوسف فكانوا عبيدا في مصر، وخرجوا من
هذه العبودية على يد موسى نفسه، ووعدوا بالملك في الأرض المقدسة التي لم يكونوا قد دخلوها بعد..كما تبين الآية التالية من سورة المائدة.إذا، فليس المراد من قوله تعالى: جعلكم ملوكا أنهم فعلا
كانوا ملوكا في الماضي، وإنما المراد أنه تعالى وعدهم بالملك.وكذلك قوله تعالى : إذ جعل فيكم أنبياء
لا يشير إلى الماضي، وإنما هو وعد بالمستقبل ولم يذكرهم بأمجاد سابقة وإنما بما ينتظرهم في المستقبل..فذكر لهم موسى وعد الله تعالى بأنهم ينالون الملك ويكثر فيهم الأنبياء ويُعطون ما لم يُعْطَ أحد
العالمين..وجاء الخطاب بصيغة الماضي لحتمية تحقيق ما يعد الله تعالى به بعد دخولهم الأرض المقدسة..فلا يتقاعسن عن فتحها ودخولها.ولقد كانت الأحداث التالية دليلا ثابتا على تحقق هذا الوعد..حيث
ظهر في بني إسرائيل الأنبياء بكثرة، وصاروا ملوكا، وفتح الله عليهم عن طريق سلسلة طويلة من الأنبياء
علوما روحانية لا نجد نظيرها في أمة من الأمم الغابرة.من
متى تم هذا الوعد؟ يتضح من التوراة أن هذا الوعد بدأ منذ زمن إبراهيم اللة.فقد ورد: "وقال له:
أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها تكوين ١٥: ٧).وورد بعده
أيضا أن هذا الوعد سوف يتحقق بهجرة قومه إلى بلد آخر حيث يصيرون عبيدا، وبعد أربعة أجيال
سوف يخرجهم الرب منها إلى فلسطين فيملكونها.وتكون هذه الفترة لأن الآشوريين، سكان فلسطين،
لم يتورطوا بعد في الإثم بحيث يستحقون الطرد منها عقابا لهم.ويتبين من هذا أن أول عهد كان على
لسان إبراهيم، وكان موعد وفائه حين يخرج بنو إسرائيل من مصر بعد أن عاشوا هناك عبيدا.وهذا هو
كما يتضح من التوراة والقرآن والتاريخ.فقول موسى في هذه الآية القرآنية يشير إلى
زمن موسى
هذا الوعد الإبراهيمي.ذلك
ورب معترض يقول إن الوعد الإبراهيمي هذا لا يتضمن ذكر النبوة وإنما يشير إلى الملك فحسب.ولكن إذا قرأناه في ضوء ما جاء في أماكن أخرى من التوراة اتضح لنا الأمر تماما، فقد جاء فيها: "أجعل
عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا.فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا
عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوكا منك يخرجون،
وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك من أجيالك عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من
Page 285
بعدك.وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غُربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا.وأكون إلههم"
(تكوين ١٧: ٢ إلى ٨).يتبين من
هذا أن الله تعالى وعد إبراهيم عليه السلام وعدين: أولا أنه سيُدخل قومه في أرض كنعان
ويجعلهم ملوكا لها، وثانيا أن سيكون إلههم.وهذا القول يشير إلى الرقي الروحاني، أما الرقي المادي فقد
أشار إليه في وعده لهم بالملك.6
هذا الوعد الذي كان على لسان إبراهيم تكرر على لسان يعقوب وموسى عليهم السلام، ولكن
بدايته كانت مع إبراهيم، فالنبوة والملك الموعود بهما في قوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ، هما نفس ما وعدوا به على لسان إبراهيم في التوراة، وهي نفس النعمة
التي تشير إليها آيتنا الحالية في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.وبذكر
هذه النعمة أخبرهم أن نعمة النبوة لم تنته بآدم وإنما كانت في بني إسرائيل أنفسهم سلسلة طويلة من
الأنبياء..فلماذا الإنكار؟
الله
تعالى أن يمتد
وقد ذكرت هذه النعمة الموعودة في موضع آخر من سورة البقرة في سياق الحديث عن إبراهيم عليه
السلام؛ حيث قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرة: ١٢٥).وتبين هذه الآية أولا: أن الله تعالى وعد
إبراهيم بأن يجعله إماما أي يقيمه في مرتبة الأنبياء أولي الأمر؛ ثانيا: طلب إبراهيم من
الوعد إلى نسله، فقبل جل وعلا ذلك بشروط؛ حيث قال: إن عهده يتحقق لبعض أولاده الذين لا
يحرمون أنفسهم منه بممارسة الظلم القومي، أي بصفة جماعية.وقوله تعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم إشارة إلى أن هؤلاء الذين استمرت فيهم سلسلة الوحي
لمدة طويلة، وهم بنو إسرائيل، كان العهد لهم مشروطا بشروط ، وما داموا مستحقين لهذا العهد وفاه الله
تعالى لهم..ولكنهم عندما باتوا غير مستحقين كلية لنعم هذا العهد حوّله الله تعالى إلى الجانب الثاني
حتما.عهدي
وتذكر التوراة أيضًا أن هذا العهد كان مشروطا، فقد جاء فيها: "وقال الله لإبراهيم: أما أنت فتحفظ
أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم.هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من
بعدك.يُختن منكم كل ذكر.فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم..وأما الذكر
الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها.إنه قد نكث عهدي" (تكوين ١٧:
14، ۱۱ ، ۹،۱۰).تبين هذه العبارة أن العهد مع إبراهيم في نسله كان مشروطا وعلامته الظاهرية هي
الختان، وأنّ مَن لم يلتزم بهذا العهد لا يكون له عهد مع الله تعالى ولن ينال نعمه التي وعدوا بها على
Page 286
الله
لسان إبراهيم العلة.وجدير ذكره أنه قد قيل هنا صراحة إن هذا الختان هو علامة العهد الذي بين
تعالى وعبده، ويتبين من هذا أن الختان لم يكن هو العهد نفسه وإنما هو العلامة الظاهرية للعهد.ولكن
اليهود لم يدركوا هذا واكتفوا بالختان فقط، فنبههم موسى عليه السلام إلى ذلك قائلا بألا يفرحوا بعمل
واحد ويظنوا أنهم قد وفّوا جانبهم من العهد كما قال الرب : ولكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل
هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي، بل نكثتم
ميثاقي..فإني أعمل هذه بكم: أسلّط عليكم رعبا وسلاً وحُمّى تُفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون
باطلا زرعكم، فيأكله أعداؤكم ، وأجعل وجهي ضدكم " اللاويين ٢ : ١٤ إلى ١٧).يتبين من هذا أن الختان كان فقط علامة ظاهرية، وليس العهد المتوقع وفاؤه من ذرية إبراهيم..أي أن
هذا
يكونوا طاهري القلوب، مطمئني النفوس بسنن الله، عاملين بأحكامه وقد وضح الأنبياء بعد موسى
الموضوع أيما توضيح، فقال النبي إرميا منذرا بني إسرائيل من عذاب الله : "ها أيام تأتي يقول الرب،
وأعاقب كل مختون وأغلف..لأن كل الأمم غلف وكل بيت بني إسرائيل غلف القلوب" (إرميا ٩:
٢٥: (٢٦).ويبين هذا أن النبي إرميا لا يعتبر الختان البدني وفاء للعهد، وإنما هو ختان القلب الذي يوفي
العهد.وخلاصة القول أن الله تعالى عاهد نسل إبراهيم عن طريقه أولا: أن يُخرج منهم عبادا مقربين..أو
بحسب تعبير القرآن الكريم "أئمة"...أي أنبياء من أولي العزم؛ وثانيا أن يورثهم أرض كنعان
فيملكونها.إنّ الوحي النازل على إبراهيم غير محفوظ بصورته الأصلية، وما نجده في التوراة من هذا
الوحي لا يعطي شرحا وافيا للختان، ولكني أثبتُ من أسفار موسى "اللاويين" وسفر النبي إرميا أن المراد
بالختان ليس الختان الظاهري، بل المراد الحقيقي تطهير القلب والطاعة الكاملة، وكان الختان البدني مجرد
علامة ظاهرية لهذا.بعد هذا الشرح يكون معنى قوله تعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم أن يا بني إسرائيل، تذكروا
أنه ثمة معاهدة معقودة بيني وبينكم، وقد وفيت بما عاهدتكم عليه، وبعثنا فيكم الأنبياء متتابعين، وجعلنا
فيكم ملوكا؛ ولكنكم لم توفوا بجانبكم من العهد، وصارت قلوبكم غير مختونة، ونسيتم أحكامي،
واستولى على أفئدتكم خشية من سواي؛ ولو وفيتم بنصيبكم من العهد فإني مستعد للمضي في الوفاء
بنصيبي منه، أما إذا توقعتم مني الوفاء بينما أنتم دائما تنكثون بعهدكم فهذا خطأ منكم.وكما ذكرت من قبل أن هذا العهد الإبراهيمي أعيد بعده على لسان أنبياء آخرين..فقد كرر موسى
الذي أتى بالشريعة لبني إسرائيل-العهد نفسه، وهو مشهور ومعروف ورد ذكره كثيرا في التوراة،
وأطلق عليه اسم "العهد" مرارا ورد في التوراة أن الله تعالى دعا موسى إلى جبل سيناء أو "حوريب"،
Page 287
حيث تلقى أحكام الرب في الوصايا العشر، وجدد معه العهد لبني إسرائيل "خروج ۱۰، تكوين ٢٠،
تثنية : ٥ : ٢ ، وتثنية :۱۸: ۱۸ و ۱۹ " ، وقال: " في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون
لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكونها" (تثنية ٥: ٣٣).عندما كانت هذه الوصايا العشر تتزل على موسى عند جبل حوريب كان جلال الله تعالى يتجلى
على الجبل، وكان هناك بريق شديد يلمع، وأصوات رعد مرعبة فارتعب من ذلك بنو إسرائيل الذين
كانوا قد خرجوا من خيامهم وجاءوا إلى سفح الجبل لعقد العهد مع
أن
الله تعالى، وطلبوا من موسى
يسمع هو لكلام الرب ثم يخبرهم بما سمع، لأنهم يرتعدون ويخشون الموت من سماع هذا الكلام.(خروج
٢٠: ١٩).وعندما قالوا هذا قال الرب لموسى: حسنا، سوف أباركهم ما داموا متبعين أحكامي، ولكن
عقوبتهم على سوء تصرفهم هذا أني لن أقيم النبي المثيل لك منهم، بل أقيمه من إخوتهم.ومع
أن العبارة تقول: يقيم" لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلك" تثنية).۱۸ (۱٥
إلى أن الوحي بعده مباشرة يقول بخلاف ذلك حيث لم يذكر "من وسطك" بل فقط قال: "من وسط
إخوتهم".فلا
أنفسهم..الاجتماع
ثم إن عبارة "من وسطك من إخوتك" تصبح بلا معنى فما دام المخاطبون هم بنو إسرائيل فقول "من
وسطك" ثم "من إخوتك" يصيرا لغوا، لأنه ما دام الخطاب موجها لبني إسرائيل، حيث قيل لهم: سيُقام
لهم نبي من إخوتهم، فمعنى ذلك أنه سيكون من قوم غير بني إسرائيل وليس منهم، ولو كان منهم
يعد من إخوتهم.وثالثا : كانت إقامة نبي من إخوة بني إسرائيل عقابا لهم، فإذا كان هذا النبي سيبعث من
فأين العقاب إذن؟ وقد ورد في التوراة: حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم
قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضًا لئلا أموت.قال لي الرب: قد
أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما
أوصيه به" (تثنية ١٦:١٨ إلى (١٨).يتبين من هذا النص أن بني إسرائيل لما رفضوا سماع كلام الله
المتعلق بالشريعة أغلق الله تعالى باب الشريعة عليهم، وقال إنه عندما تدعو الحاجة إلى نبي مثل موسى،
أي نبي مشرع كموسى، فسيقيمه من إخوتهم.وبحسب هذا الوعد أحرز بنو إسرائيل كل نوع من الازدهار واستمرت فيهم سلسلة النبوة لرعاية
حياتهم الروحانية، وكان لهم حكم على الأرض المقدسة فيما عدا فترة السبي القصيرة.وانتقل الحكم على
الأرض المقدسة بعد نزول المسيح عليه السلام إلى طائفة آمنت به من بني إسرائيل.وفي آيتنا التي نحن
بصدد تفسيرها..يذكر الله تعالى بني إسرائيل على لسان موسى بأننا قطعنا معكم عهدا، ووعدناكم بحياة
6
Page 288
مباركة، وقد وفينا بعهدنا معكم ما وفيتم بعهدكم معنا، والآن إذا وفيتم به فنحن مستعدون أيضا للوفاء
به
وكما مرَّ ذكر العهد الإبراهيمي في القرآن الكريم، كذلك ذكر القرآن هذا العهد الموسوي فقال:
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
(الأعراف ١٥٧ و ١٥٨)
يعني
معه
فقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون
أن الذين يؤمنون به ويُعينونه باللسان والسيف ويتبعون نور القرآن الكريم لا بد أن ينالوا الفلاح
وإن كانوا من غير العرب، لأن محمدا رسول الله ﷺ ليس نبي شعب واحد بل نبي الشعوب جميعها.وقد
جاء نفس المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً (الأعراف : ١٥٩)
وفي الآية السابقة من سورة الأعراف ذكر الله تعالى الوعد الذي وعد به موسى وبين أن في كتاب
موسى نبأ بمجيء نبي أمي، وأمر بالإيمان به وطاعته، ليتحقق هذا الوعد الذي أعطى لقومه..لأن الله
تعالى كان أخبر موسى
أنه عندما يأتي ذلك النبي الموعود فلن يتحقق الوعد إلا لمن آمنوا به، حيث قال:
"أقيم لهم نبيا من وسط إخوتك مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به.ويكون أن
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا "أطالبه تثنية ۱۸:۱۸ و ۱۹).ويتبين من هذا
أن الوعد الذي قطعه الله مع موسى لبني إسرائيل كان أثره ممتدا إلى ما قبل بعثة النبي المصطفى ، أما
بعد بعثته فينال بنو إسرائيل إنعام الله تعالى إذا آمنوا بهذا النبي الموعود، وإلا استحقوا العقاب.وإلى هذا
يشير قوله تعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم.وهناك مسألتان يجب الرد عليهما ؛ الأولى : أن مَن يَكفر بأي نبي ينال العقاب، وكان هناك عدد من
الله تعالى بين موسى ونبينا عليهما السلام لم يؤمن بهم بنو إسرائيل، فكانوا قد نكثوا العهد مسبقا،
فكيف يكون هذا الوعيد الوارد في التوراة خاصا بالنبي محمد ﷺ والثانية: إذا كان الأمر هكذا فإن
عصر نبوة بني إسرائيل قد انتهى بمبعث النبي..فلماذا قيل لهم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ؟
وخاصة أن النبوة لا يمكن أن ترتد إليهم مرة أخرى وإن تابوا ودخلوا في طاعة النبي ؟
وجوابا عن المسألة الأولى نقول : لا شك أن بني إسرائيل قبل المصطفى و قد كفروا بأنبياء كثيرين..لكنهم
كانوا أنبياءهم القوميين من ناحية ومن ناحية أخرى لا شك أنهم كفروهم أول الأمر ولكن فيما
رسل
Page 289
بعد أدخلت أحوالهم وإلهاماتهم في مجموعة كتبهم المقدسة فأصبح كفرهم بهم مؤقتا، ولم يحدث فرقة
قومية، ولم يُحرم القوم من الإلهامات والإنعامات الروحانية التي كانت تأتي عن طريق هؤلاء الأنبياء.فكان مَثَلُهم كمَثَل أولئك العرب الذين كفروا بالرسول الله في بداية الأمر، ولكنهم في النهاية آمنوا.لقد
منهم
كفرت طائفة من بني إسرائيل أشد الكفر بنبيهم الأخير عيسى ابن مريم، واستمروا على الكفر به بعد
ذلك، ولكنه على أية حال كان نبيا إسرائيليا، ثم إن طائفة آمنت
به..وهكذا كان إيمانهم امتدادا
للوعد الإبراهيمي لهم، ولو أنهم استقاموا على العهد لظلت فيهم نعمة النبوة، لكنهم لم يفعلوا ذلك.أما
اليهود فنسوا الجانب الروحاني للعهد..أي طهارة القلب وبذلك نقضوا العهد، وأما الذين آمنوا من بني
إسرائيل بعيسى ابن مريم فتركوا الختان البدني وبذلك تخلوا عن علامة ذلك العهد..وهكذا لم يبق أحد
من بني إسرائيل على عهدهم فحوّل الله العهد إلى إخوتهم بني إسماعيل وموجز القول إن إنكار بني
إسرائيل للأنبياء الذين خلوا من قبل سيدنا محمد ﷺ كان إنكارا عابرًا مؤقتا؛ إذ كانوا بعد ذلك
يعتبرونهم من أنبيائهم القوميين..ما عدا المسيح عليه السلام الذي استمر على الكفر به معظمهم.ولكونه
إسرائيليا نُسب إلى بني إسرائيل.وثبت من الإنجيل أنه كان يأمر باتباع شريعة موسى، وكان أول
المؤمنين به من بني إسرائيل أنفسهم.وهكذا استمر الوعد يتحقق بصورة قومية عن طريق المؤمنين به من
بني إسرائيل.أما رسولنا فلم يكن كفرهم به كمثل كفرهم بأنبيائهم القوميين، لأنه لم يكن تابعا للشريعة
الموسوية، بل إنه كما أخبر موسى ال - جاء بشريعة جديدة؛ ولم يكن مبعوثا إلى بني إسرائيل وحدهم
بل بعث للدنيا كافة.كما لم يكن الدين الذي أسسه امتدادا للدين الموسوي، وما كان لبني إسرائيل أن
يفتخروا به، بل كان نهاية لعصر تفوقهم القومي.لذلك قال الله تعالى لهم: ما دمتم قد نكثتم عهدكم
معي، فقد أنهيت عهدي معكم.والجواب على المسألة الثانية أن سلسلة الأنبياء الإسرائيليين وإن كانت قد انقطعت ببعثة الرسول ،
ولا يمكن أن تستأنف بشكلها السابق ولو آمنوا بالرسول ﷺ، ولكن كان بوسعهم مع
ذلك أن ينالوا
رحمات الله تعالى حسب قوله : أوفوا بعهدي أوف بعهدكم.وقد قال القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ
الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ * يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة : ٦٦ إلى ٦٨).وتبين هذه الآية أن أصحاب التوراة
والإنجيل لو آمنوا بما نزل لهدايتهم في زمن الرسول ﷺ تصديقا لما في كتبهم واتقوا، لفتح
الله عليهم
Page 290
أبواب الوحي السماوي من فوقهم، والرزق الدنيوي من الأرض من تحتهم، وحفظهم من عواقب
سيئاتهم السابقة..وهكذا يوفي الله لهم عهدهم، ويمتعهم بالنعم السماوية والدنيوية.ثم يأمر الله تعالى
الرسول أن يبلغ هؤلاء الأمم لتقوم عليهم الحجة، ولينجوا منهم من يمكن إنقاذه.إذن فَمَعَ أن النبوة قد انتقلت بحسب نبأ موسى من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلا أن هؤلاء لو
جاهدوا للوفاء بعهدهم لعاملهم الله تعالى باستمرار عهده معهم.وفي هذه الآية من سورة المائدة إشارة لطيفة إلى النبأ الوارد في سفر التثنية في التوراة (۱۸: ۱۸)..إذ
إنه بعد أن حض بني إسرائيل على الإيمان بهذا الهدي السماوي الجديد قال لرسوله : "يا أيها الرسول
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" أي بلغهم كل ما أنزلناه عليك.وهي نفس
الكلمات الواردة في نبأ) التثنية (۱۸:۱۸ القائل: "..وأجعل كلامى في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه
11
ويستنبط من قوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم أن باب النبوة بلا شرع لم يغلق على الأمة
الإسلامية وبيان ذلك أن الله تعالى يقول لبني إسرائيل: إذا وفيتم بوعدي واتبعتم أحكامي وآمنتم
برسولي محمد..أوف لكم ما وعدتكم به.وقد سبق أن بينا أن هذا الوعد يتضمن بعث أنبياء فيهم.فثبت أن الأمة المحمدية لم يُسدّ عليها باب النبوة، وإنما انتهت الشريعة، وإلا فيمكن الآن أيضا بعث أنبياء
غير مشرعين تابعين للقرآن خادمين للرسول محمد.وإذا لم يكن هذا ممكنا..فما معنى قوله تعالى:
وفوا بعهدي أوف بعهدكم ؟ يصح هذا فقط إذا كان باب النبوة مفتوحا للأمة المحمدية.ويجب أن نتذكر أنه بحسب نبأ موسى سالف الذكر كان باب النبوة التشريعية مسدودا على بني
إسرائيل؛ وكان الباب مفتوحا للنبوة التابعة للشريعة الموسوية...لأن عبارة (تثنية ١٨:١٨) تصرح
بوضوح أن النبي المشرع مثيل لموسى لن يأتي من بني إسرائيل، وإنما يأتي من إخوتهم بني إسماعيل، فكان
باب النبوة بلا تشريع مفتوحًا قبل محمد المصطفى ، وكان يأتي فيهم أنبياء غير مشرعين.وبعد الإيمان
بنبوة محمد ﷺ لم يُسدّ هذا الباب في وجههم.وقوله وإياي فارهبون صورة مؤكدة لعبارة ارهَبوني.وقد يعترض بعض المتأثرين بفلسفة الغرب
ويتساءل عن السبب في وجود هذا التأكيد المتكرر بخشية الله تعالى في القرآن.والجواب على ذلك أولا: أن الخوف ليس شيئا معيبًا، بل هو ضروري لنشأة التقوى، لأن الناس على
أحوال..فبعضهم ينقادون بالحب.وبعضهم بالخوف والمربي يراعي الحافزين كليهما: الخوف والحب.الفلسفة لا يمكن أن تصلح الإنسان، وإنما يتم الإصلاح بالعلاج حسب المرض.فالذين فسد حالهم لا
Page 291
يمكن إصلاحهم إلا بتحذيرهم من العواقب الوخيمة المترتبة على فسادهم ومن لم يلاحظ ذلك لا يقدر
على الإصلاح.وثانيا: إن كلمة "رهب" لا يعني الخوف بالمفهوم العام، وإنما يتضمن معنى الاجتهاد والسعي.تقول
العرب: رهبت الناقة أي جَهَدَها السيرُ.فالرهب هو الخوف الذي يدفع إلى العمل، ولأجل ذلك يقولون
للعابد راهب.وأود أن أزيل هنا شبهة أخرى.يقال إن إسماعيل كان الابن الأكبر لإبراهيم "عليهما السلام"، فلماذا
حَرَم الله ذريته لهذه المدة من نعمه الخاصة؟ والجواب على ذلك أن بني إسحاق مهما ساءت أحوالهم فيما
بعد، إلا أن الواقع أنهم كانوا حملة لواء الدين لمئات السنين، فكان لا بد وأن يكونوا مهبطا لأفضال إلهية
خاصة.أما بنو إسماعيل فما كانوا قد وصلوا إلى هذه المكانة قبل زمن سيدنا محمد رسول الله ﷺ من
أجل ذلك نالوا الإنعام بحسب مقتضيات الأحوال أجل كان نبينا الله جوهرة كامنة سدت كل نقص..ولما كان من المقدر أن يكون الله خاتم النبيين..لزم أن يسبقه كل الأنبياء الذين نالوا النبوة بطريقة
مباشرة..ليأتي سيدنا في آخرهم ليسدّ باب النبوة التشريعية والمباشرة.وَعَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا
تَشْتَرُوا بِفَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُون (2)
شرح الكلمات:
مُصدِّقًا: صدقه ضد كذبه التصديق نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل؛ وقيل: أن تنسب
باختيارك الصدق إلى المخبر.المصدِّق الذي يصدقك في حديثك (الأقرب).ثمنا : الثمن : ما قدره العاقدان عِوَضًا (الأقرب).الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينًا كان
أو سلفةً.وكلّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمن (المفردات).والثمن ما تستحق به الشيء؛ والثمن
ثمن البيع؛ وثمن كل شيء قيمته.التفسير : تبين هذه الآية أن معنى قوله أوفوا بعهدي هو التصديق بالنبي الموعود به في نبأ سفر تثنية
"١٨:١٨"، لأنه قال بعدها : وآمنوا بما أنزلت ليشير إلى أن الوفاء بالعهد وخشية
الله
نزل على محمد..كل هذه الأمور ترتبط ارتباطا خاصا بتكميل النعم الموعودة لبني إسرائيل.والإيمان بما
Page 292
وقوله تعالى: مصدقا لما معكم يعني آمنوا بما أنزلت من الكلام الذي يصدق ما عندكم..أي أن
هذا الكلام يحقق نبأ موسى الوارد في سفر (تثنية ۱۸:۱۸)، وكذلك أنباء الأنبياء الآخرين من بني
إسرائيل.فالتصديق بهذا الكلام ومن نزل عليه يكون تصديقا لأسفاركم السابقة وعملا بها؛ وتكذيبه
يعتبر تكذيبا ورفضا لها فكأن الذي يؤمن بما يقدمه له محمد رسول الله الله من وحي قرآني..يؤمن
بموسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل لأنهم الذين أنبئوا بمجيئه، ومن رفض الكلام المنزل على محمد
ﷺ
بني إسرائيل، لأنه يرفض تحقق كلامهم..فلن يستحق النعمة
فكأنما رفض موسى وغيره من أنبياء
المترتبة على التصديق والإيمان بهم.ولغير المسلم أن يسأل: هل لموسى ومن بعده من الأنبياء نبأ بمجيء نبي تحقق ببعثة محمد ؟ والجواب
أن كل أمة من الدنيا قد أخبرت بمجيء نبي آخر الزمان مع بيان بعض علاماته التي تحققت في شخص
محمد رسول الله ﷺ، وخاصة أنباء أنبياء بني إسرائيل التي تواترت بكثرة بحيث يمكن للإنسان أن يصنف
كتابا ضخما عنها.وحيث إن هذه الآية لم تتناول ذكر نبوءات جميع الأنبياء والأديان، لذلك لن أتناولها،
وإنما أكتفي بذكر نبوءات أنبياء بني إسرائيل ذكرا موجزا في ضوء قوله تعالى: (مصدقا لما معكم.
Page 293
وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )
شرح الكلمات:
لا تلبسوا لبس عليه الأمر لبسا خلطه وجعله مشتبها بغيره (الأقرب).:
الباطل : نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص (المفردات).٤٣
التفسير قوله تعالى : لا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا الحق بالباطل فتجعلوه مشتبها.وهذا
دأب أعداء رسل الله دائما..يأخذون من الحق شيئا ويخلطون به الباطل ويثيرون ضجة ضد
النبي قائلين
إنه كاذب كان اليهود في زمن الرسول يعترفون بظهور كل العلامات المتعلقة بالنبي الموعود، ومع
ذلك كانوا يحتجون حينًا بأن العلامة الأساسية له أن يظهر من بني إسرائيل، وتارة يقولون إنه سيظهر من
أورشليم، وهكذا كانوا يحرمون العوام من قبول الحق؛ مع أن الأصل في قبول الحق أن يُفحص ما إذا
كان الموعود يحقق الغرض من بعثه أم لا؟ وهل ظهر في زمن هو في أمس الحاجة إلى ظهوره؟ وهل
تحققت بعض الأنباء المتعلقة به
تحققا ظاهرا بلا تأويل؟ إذ إن بعض الأنباء تنطوي على معان مجازية
وتحتاج إلى تأويل، لا شك أنه ورد في بعض المواضع خبر ظهور هذا الموعود من بني إسرائيل، ولكن
هناك أخبارا عن مجيئه من بني إسماعيل في مواضع أخرى.فيكون معنى ظهوره في بني إسرائيل أنه
أن هناك كلمات تخبر بظهوره من صهيون، ولكن هذا فقط أن
الله تعالى.يعني
يرث
بركاتهم، ويحل محلهم.وصحيح
المكان الذي يظهر منه الموعود، أي مكة المكرمة، يكون كصهيون من الأماكن المقدسة عند
فعلى الرغم من تحقق العديد من العلامات الأخرى لهذا الموعود تحققًا حرفيًّا، وظهوره في زمن كان في
أمس الحاجة إلى ظهوره، وقيامه بأعمال قدّر له القيام بها..فإن اعتراض بني إسرائيل بأن النبأ الفلاني لم
يتحقق بعد، أو لم يتحقق تحققا حرفيا..كل ذلك ليس إلا لبس الحق بالباطل..ومحاولة ماكرة لصدّ
الناس عن قبول الحق.ولكن مثل هذه المحاولات لم تُفلح في الماضي، ولا في زمن الرسول، ولن تفلح في
المستقبل.وقوله تعالى: وتكتموا الحق أصله ولا تكتموا الحق..ويبين أسلوبا آخر من خداع بني إسرائيل،
فقد كانوا يخفون الأنباء التي تبين صدق النبي الله فكأنهم كانوا يقاومون بطريقين: أحدهما خلط الأنباء
عند ذكرها للناس، فمثلا كانوا يخلطون ما هو صريح منها بما هو مجاز يتطلب تأويلا، أو كانوا يخلطون
بين الأنباء المتعلقة بالنبي الموعود وبين أنباء عن آخرين سابقين، ويقولون إنها أيضا علامات الموعود.وهذا
ما يفعله المشايخ بين المسلمين اليوم.فقد أخبر الإسلام بمجيء أكثر من ،مهدي، وقد جاء بعضهم وتحقق
۲۳۱
Page 294
فيهم ما ورد عنهم من أنباء ولكن هؤلاء المشايخ لا يزالون يربطون هذه الأنباء بمجيء المهدي المنتظر،
وهكذا يلبسون على الناس الأنباء المتعلقة به وحده.والطريق الثاني للمكر الذي لجأ إليه اليهود ضد
النبي أنهم كانوا يخفون بعض الأنباء عن أعين
العوام، ويعرضون عن ذكرها في وعظهم الديني، وإذا نبههم المسلمون إليها أنكروها إنكارا تاما، وإذا
اضطرهم عالم مطلع تملصوا واختلقوا الأعذار.وقوله تعالى: (وأنتم تعلمون أي أنكم لا تفعلون ما تفعلون من لبس الحق بالباطل وكتمانه مصادفة
أو سهوا، بل تفعلونه متعمدين عالمين به.ومن يرتكب مثل هذا الإثم متعمدا لن يكون ممن يرثون فضل
الله تعالى.وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )
شرح
الكلمات:
٤٤
الزكاة: زكا الشيء: نما.زكا الرجل : صلح وتنعم وكان في خضب زكت الأرض: اخضرت.زكّاه
الله : أنماه؛ طهره.زكّى فلان ماله أدّى عنه زكاة زكي نفسه مدحها.وتزكي: تصدق.والزكاة:
صفوة الشيء؛ طاعة الله؛ ما أخرجته من مالك لتطهره به وقيل سُميت الصدقة بالزكاة لأنها تزيد في
المال الذي تُخرج منه وتوفره وتقيه من الآفات (الأقرب).اركعوا ركع المصلي ركعا وركوعا طأطأ رأسه.ركع إلى الله اطمأن إليه.ركع الرجل: انحطت
حالته وافتقر.وركع المصلي في الصلاة خفض رأسه بعد قومة القراءة حتى تنال راحتاه ركبتيه، أو حتى
يطمئن ظهره والراكع كل شيء يخفض رأسه (الأقرب).الركوع الانحناء، فتارة يستخدم للهيئة
المخصوصة للصلاة، وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها (المفردات).كل شيء ينكب
لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه فهو راكع قال ثعلبة: الركوع الخضوع.وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحنيف راكعا إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون: ركع إلى الله (التاج).فمعنى اركعوا تواضعوا؛ اعبدوا الله خالصا.التفسير : في الآيات السابقة أمر الله تعالى بني إسرائيل بإصلاح إيمانهم، والآن يوجههم إلى إصلاح
أعمالهم قائلا: لا مناص لكم من تصديق محمد رسول الله الله لكميل إيمانكم..وكذلك لا بد لكم من
إصلاح أعمالكم بتصديقه.لا شك أنكم تؤدون العبادة بطريقتكم ولكنها الآن غير مقبولة، وإذا اتبعتم
محمدا في أسلوب عبادته لله تعالى قبلت العبادة منكم.وإنكم لتؤدون تضحيات مالية قومية ولكنكم لن
۲۳۲
Page 295
تحظوا برضى الله تعالى ما لم تؤدّوا الزكاة بحسب شريعة محمد الله وإن عبادتكم وأعمالكم قد تتتره عن
الشرك إلى حد ما، ولكن معيار التوحيد قد تغير، فلن ترثوا اليوم أفضال الله تعالى ما لم تصلوا إلى
مستوى التوحيد الذي أقامه عن طريق محمد رسول الله.ومما
قوله تعالى وآتوا الزكاة..الزكاة إخراج نسبة محددة من الأموال في سبيل الله.وسوف نبحث
مسألة الزكاة فيما بعد، وكذلك راجع تفسير الآية رقم ٤ من هذه السورة عند شرح قوله تعالى : و
رزقناهم ينفقون حيث ورد ذكر الواجبات المالية على المسلم.قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين..ذكرنا في شرح الكلمات أن الركوع هو الهيئة المعروفة في
يعني
الركوع
الصلاة، وكذلك
بالله ولم يعبد الأوثان قال النابغة الذبياني في هذا المعنى:
سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرئ إلى ربه رب البركة راكعُ
أن يعيش المرء عيشة مترهة عن الشرك؛ لأن الراكع عند العرب من آمن
فلا يعني الركوع هنا ركوع الصلاة لأنها لا تقتصر على الركوع وحده، بل فيها غير ذلك من
الحركات والهيئات، ومن ثم فليس هناك داع لذكر الركوع خاصة.ثم إن قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة))
قد تناول موضوع الصلاة بصفة عامة، وكذلك صلاة الجماعة التي تتضمن كل حركات الصلاة وهيئاتها
من قيام سجود وركوع وتلاوة ،وغيرها فلم يكن هناك حاجة لتخصيص الركوع بالذكر بعد ذكر
الصلاة الشاملة.فالمعنى أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أولا بإقامة الصلاة مع المسلمين وأداء الزكاة مثلهم، ثم أمرهم ثانيا
بأن يخلصوا أعمالهم الله وحده كما يفعل المسلمون وينتهجوا التوحيد الكامل، ويتزهوا أعمالهم من
شوائب الشرك؛ وعندئذ سيرثون النعم التي وعدوا بها في الوعد الإبراهيمي.ولقد دعت الحاجة إلى هذا الشرح كي لا ينخدع أحد ويظن أن اليهود يغنيهم اليوم العمل بأحكام
التوراة، فليكن واضحا للجميع أن العمل الصالح هو ما جاء في الشريعة الإسلامية، ولا يُقبل إلا إذا أداه
الإنسان بالطريقة الإسلامية.أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
۲۳۳
0:0
Page 296
شرح
الكلمات :
البر: الصلة أي الإنعام والعطية والإحسان الطاعة؛ الصدق (الأقرب).وأصل معنى البر السعة ثم شاع
في الشفقة والإحسان والصلة.قال الإمام أبو منصور اللغوي: البر خير الدنيا والآخرة.والبر أيضًا
الصلاح الخير ؛ الاتساع في الإحسان إلى الناس (التاج).تنسون: نسي الشيء نسيا: ضدُّ حفظه.قال الراغب: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استُودِع إما
لضعف قلب وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره الأقرب).وفسره أكثر أهل
اللغة بالترك، وقال ثعلب في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم : لا ينسى الله عز وجل، إنما معناها تركوا
الله فتركهم.وإذا نسب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم استهانة ومجازاة لما تركوا (التاج).وقوله تعالى:
ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي لا تقصدوا الترك والإهمال (الأقرب).فمعنى تنسون أنكم تهملون؛ تغفلون؛ تتركون.أنفسكم: الأنفس جمع نفس، والنفس: الروح الجسم ؛ ويراد بها الشخص والإنسان بجملته؛ العظمة؛
العزة؛ الهمة؛ الإرادة ؛ الرأي (الأقرب).تتلون تلا الكلام تلاوة قرأه (الأقرب).تعقلون: عقل الدواء البطن أمسكه.عقل الغلامُ : أدرك.عقل الشيء: فهمه وتدبره.عقل البعير: ثنى
وظيفه مع ذراع فشدهما معا بحبل.عقل الوعلُ عقلا: صعد وامتنع في الجبل العالي.والعقل نور روحاني
به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية (الأقرب).فمعنى أفلا تعقلون : ألا تستخدمون العقل؛ ألا
تمتنعون عن الأنشطة المشينة..التفسير: بينا في شرح الكلمات..أن البر هو أعلى درجات الإحسان والخير..وتنبه الآية بني إسرائيل
أنهم بحسب تعاليم كتبهم كانوا يأمرون الناس كثيرا بفعل الخير والإحسان إلى الناس والآخرين، ولكنهم
رفضوا الدخول في طاعة النبي العظيم خشية أن يضيع منهم الجاه الدنيوي، وتقول لهم: إذا كنتم تأمرون
الناس بالخير فلا تنسوا أنفسكم؛ فحقها عليكم أعظم.ومن معاني النسيان الترك، وفي ضوء هذا المعنى تقول الآية: أتأمرون الناس بالخيرات وتتركون
أنفسكم؟ فلماذا لا تحصونها على البر حتى لا يتعارض عملكم مع قولكم؟
قوله تعالى: (وأنتم تتلون الكتاب.لا يعني هذا أن كتابهم خال من التحريف والتبديل، كما يستنتج
بعض الجهال..وإنما قيل الكتاب بمناسبة الموضوع السابق..أي أنكم تقرءون كتابكم على الأقل، وهو
لا يأمر أبدا أن تنصحوا الآخرين بالخير وتسيروا أنتم في طريق الشر.وإذا كنتم تصدقون كتابكم
٢٣٤
Page 297
وتؤمنون به وهو لا يجيز هذا الأسلوب..فلماذا سلكتموه؟ عليكم أن تُضحوا في سبيل الحق كما تأمرون
غيركم بالتضحية، ولا تهلكوا أنفسكم بسلوككم هذا.قوله تعالى: أفلا تعقلون..أي أفلا تمتنعون؟ إذا كانت كتبكم لا تعلمكم أن تسيروا في طريق
البر..لأمكن التماس العذر لكم، ولكن انحرافكم عن طريق الخير برغم وجود هذا التعليم في كتبكم لأمر
مؤسف جدا.فإذا كنتم لا تنصاعون لنصيحة أحد فعلى الأقل اتبعوا تعاليم كتابكم واسلكوا سبل الخير
والتقوى.ج
٤٦
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ )
شرح الكلمات :
الصبر : :
: تركُ الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله.فإذا دعا الله العبد في كشف الضر عنه لا
يُقدح في صبره.وقال في "الكليات": الصبر في المصيبة.وصبر الرجل على الأمر : نقيضُ جزع أي جرؤ
وشجع وتجلدَ.وصبر عن الشيء: أمسك عنه.صبر الدابة: حبسها بلا علف.صبرتُ نفسي على كذا:
حبستها.وتقول: صبرتُ على ما أكره، وصبرتُ عمّا أحب (الأقرب).فمعنى الصبر، أولا: الامتناع عن
الآثام والثبات على الحسنات، وثانيا: عدم الجزع عند المصيبة في سبيل الله.الخاشعين: جمع خاشع..خشع ذلَّ وتطَأمَن.خشع ببصره : غضه.والخشوع في الصوت والبصر
كالخضوع في البدن (الأقرب).والخشوع: الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع في ما يوجد على
الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب (المفردات).التفسير : هناك مانعان لقبول الصدق : الأول ضغط الحكومات أو القوم والأقارب والأصدقاء الذين
بسبب عدم فهمهم للحق أو تعصبهم لمصالحهم الشخصية لا يقبلون الحق ويصدّون الآخرين عن قبوله؛
والثاني:
صدأ العادات المتأصلة وران المعاصى السابقة الذي يميت القلب ويسلب الهمة.وتشير هذه الآية
إلى السببين كليهما، وتقول: يا بني إسرائيل إذا كان الحق قد حصحص لكم فلا تتأخروا عن قبوله،
سوف تتعرضون لضغوط من أقربائكم وأصدقائكم، وتواجهون الظلم والاضطهاد..ولكن لا تحفلوا
بكل هذا، وقاوموه بعادة الصبر الطيبة.كما عليكم أن تدعو الله تعالى لتطهير قلوبكم ليزول عنها الصدأ
فتتهيأ لقبول الحق.وتبين هذه الآية نكتة أخرى من علم النفس ألا وهي أنه لا بد لصلاح أي شيء من أمرين: الأول أن
التأثيرات الخارجية؛ والثاني: أن تُزاد قوته الداخلية.وباستخدام كلمة الصبر تشير الآية إلى
من
يُصان
۲۳۵
Page 298
ضرورة مقاومة التأثيرات الخارجية، وباستخدام كلمة الصلاة تشير إلى ضرورة جذب الفضل الإلهي
بالدعاء..فذلك يسد أبواب النقص ويفتح أبواب القوة ويُفلح الإنسان.وكما بينا في شرح المفردات
فإن الصبر لا يعني ترك الجزع فقط، بل يعني أيضًا الامتناع عن التأثر بالأفكار السيئة ومقاومتها.فعندما
يرفض أحد التأثير السيئ ويستجيب للمؤثرات الحسنة بمعونة الدعاء..تتولد في قلبه روحانية تسهل له ما
كان يبدو له صعبا من قبل، فيحقق الانتصار في معركة الرقي الروحاني.وفي قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وردت كلمة "كبيرة" صفة لمحذوف والتقدير إنها
لمهمة كبيرة أي صعبة والخاشع هو الخائف وحيثما وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم كانت بمعنى
الخائف مما يكون الخوف منه مناسبًا ولائقًا.فقد وردت في كل مرة إما بمعنى الخوف من الله تعالى أو من
عذابه.يمكن أن يقول قائل بأن وصف مثل هذا العلاج يسير، ولكن العمل به صعب.فردت الآية قائلة: إنها
لكبيرة إلا على الخاشعين.نعم إن العمل بمثل هذه الوصفة أمر شاق، ولكن من كان من الخاشعين
وَجَدَه سهلا.وكأن العلاج الحقيقي للتقصير والمعاصي هو الإيمان الكامل بالله تعالى، وبدونه لا يُصان
منها أحد مهما اتخذ من الوسائل.لقد اختبرت الدنيا هذا مرارا، ولكنها للأسف تنسى ذلك في كل مرة.إن الخير الحقيقي الكامل لا يتولد أبدا في الإنسان إلا باليقين الكامل بالله تعالى.إن الدلائل الفلسفية لا
تستطيع خلق التقوى الصادقة في الإنسان وإن خوف المعاصي الذي يتولد في القلب بالإيمان الكامل بالله
تعالى لا يمكن أن يتولد بأي طريق آخر.ومن أجل ذلك..فإن الأمثلة التي قدمتها جماعات الأنبياء
الخيرات والتضحيات لا يمكن أن تقدم نظيرها أية جماعة في الدنيا.من
إن ما وعظ به بنو إسرائيل في هذه الآية من الحب والنصح لدليل بين على تلك الروح السامية التي
يريد الإسلام غرسها في العالم.فكل لفظ من الآية يقطر نصحا ويشع صدقا بما يدل على صدق
ناصحهم لإنقاذهم من الخطأ.يقول بعض الحمقى إن هذا القرآن الكريم كلام محمد ﷺ كان يريد به أن
ينال القبول لدى اليهود.ولكن تدبروا كلمات هذه الآية..فهل هي لطالب صيت وقبول؟ ثم فكروا في
عدم إيمان بني إسرائيل به رغم نصحه هذا فمن كان المتضرّر ؟ هل تضرر الإسلام؟ كلا.فعند تقديم هذه
النصيحة لبني إسرائيل لم يكن قد آمن بمحمد رسول الله الله إلا بضعة آلاف، لكن اليوم ينطق بشهادة
صدقه أكثر من أربعمائة مليون من البشر ، وحكم المسلون الدنيا لألف عام، واليوم أيضًا
الوسائل لازدهارهم مرة أخرى ولو آمن بنو إسرائيل ما زادوا على ذلك شيئا يذكر، ولو كانت ثمة
مصلحة لكانت مصلحتهم.هم.لقد تنصر منهم مئات الآلاف فماذا كانت النتيجة؟ أخرجوا من
بلادهم ونهبت ممتلكاتهم و لم يكونوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.ولو أنهم أسلموا لدخلوا في زمرة مئات
الله
٢٣٦
Page 299
الملايين من المسلمين شركاء على قدم المساواة في كل البركات، ولم يصبهم
أحد بأذى باعتبارهم من
الأجانب.فزعم الكتاب النصارى رغم كل هذه الحقائق بأن محمدا ﷺ كان يغري بني إسرائيل لضمهم
إلى صفه..لافتراء يخالف العقل والواقع.وكل ما في الأمر أن القرآن قدَّم لبني إسرائيل النصح لمحض
منفعتهم، ولكنهم لم يقبلوه ، فلا يزالون يتحملون تبعات ذلك.الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهُم مُّلَقُوا بَهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
شرح الكلمات :
٤٧
يظنون: ظنّ الشيء: علمه واستيقنه.والظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في
اليقين والشك (الأقرب).وقد استُعمل الظن هنا بمعنى اليقين.التفسير: من الأسلوب القرآني أنه عندما يستخدم كلمة ما لمعنى خاص فإنه يتبعها بشرح
لهذا المعنى.فهنا يوضح المعنى الاصطلاحي لكلمة "خاشعين" الواردة في الآية السابقة، فبين أنها لا تعني مجرد الخائفين،
وإنما تعني الذين يتولد في قلوبهم خشية الله تعالى نتيجة يقينهم الكامل بوجوده ولقائه، ولا يتأسس
هذا على مخافة الأذى..وإنما الخشية من فوات الترقيات الروحية العليا.وهذا الخوف ليس من
قبيل خوف الجبان، وإنما هو قلق العارف بالله..وتجده في أشجع الشجعان، بل يجب أن يوجد فيه.فقيل
لليهود في الآية السابقة إن طرد خوف مصائب الدنيا عملية صعبة بلا شك، ولكنها سهلة على
الخاشعين، أي الخائفين من الحرمان من الترقيات الروحانية.شعورهم
و لا يستقيم المعنى إذا أخذنا كلمة "الخاشعين" بمعنى الخوف العادي، بل يصير معنى الآية عجيبا
هكذا: لا تخافوا الناس، وإن كان تجنب الخوف أمرا صعبا إلا أنه سهل على الخائفين! إذا فالخشوع يعني
هنا خوف الإنسان من أن يُحرم القرب من ذلك الوجود الكامل الذي يؤمن به.والمراد من الآية: لا تخافوا المصاعب والمشاكل الدنيوية.إن تجنب هذا الخوف صعب بلا شك، ولكن
الذين ينصبون لهم هدفا ساميا بحيث يشق عليهم ترك هذا الهدف لا يعود تحمل المشاق صعبا عليهم.والخوف من فوات المرام يُعَدّ في الحقيقة شجاعة وحذرا وليس جبنا.قوله تعالى وأنهم إليه راجعون..الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤكد الحياة بعد الموت حق
التأكيد، وليس هناك دين غير الإسلام يتخذ من الحياة الأخروية أساسا لبناء التقوى في الدنيا.إنه يعتبر
الحياة الدنيا حلقة
من
حلقات حياة طويلة يكتمل خلالها رقي الروح الإنسانية، ولا يعتبر الموت نهاية
ستمضي بعده في كفاح مستمر والفرق بين الحياتين أن الإنسان يكافح في
لصراع الروح، بل يرى أنها
۲۳۷
Page 300
الأولى وهو في ظلام نسبي، ولكن في الآخرة ينال الصالح والطالح بصيرة يسعون بها للرقي.الأشرار
سوف يكافحون للتخلص مما هم فيه من شدة وبلاء قدمته أيديهم وأما الأبرار فيسعون للمزيد من
الرقي.هذا هو اليقين الذي جعل المسلمين الصادقين لا يخافون الموت أبدا، وكلما يهب المسلمون بهذا
الإيمان واليقين يُكتب لهم النصر على العالم.أما الذين يعتبرون هذه الحياة الدنيا نهاية رقيهم فلا يمكن أن
يجتهدوا لفعل الخيرات بمثل اجتهاد المؤمنين بالحياة بعد الموت، وإنما يميلون دائما نحو ملذات الدنيا، ولا
يصرفون أنظارهم عن المتع المادية ولا يمكن أن يضحوا براحة أبدانهم.يَنبَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ
ΕΛ
شرح
الكلمات
فضلتكم: فضله على غيره: جعل له مزية عليه وحكم له بالفضل وفضله: صيره أفضل منه
(الأقرب).العالمين: راجع معنى الكلمة في شرح الكلمات سورة الفاتحة.التفسير: في هذه الآية اختار الله تعالى أسلوبا آخر لترغيب بني إسرائيل في الإيمان بالشريعة الأخيرة.ففي الآيات السابقة وجّه أنظارهم إلى أن الله قد وعدكم وعدا وأنه وفّى بما عليه من عهد، ولكنكم لم
تؤدوا ما في ذمتكم من العهد، فحُرمتم من فضله، وها قد نزل مرة أخرى وحي جديد بحسب أنباء
كتبكم، فآمنوا به، ولو آمنتم به لاستأنف الله إنزال نعمه عليكم.وأما في هذه الآية فينبههم إلى أن حب
المحسن دأب الشرفاء.ولقد أحسن الله إليكم كثيرا إذ رفعكم من الحضيض إلى درجات عليا حتى جعلكم
من أفضل الأمم، فلماذا لا تقدرون صنيعه حق قدره وترفضون رسالته؟ اشكروا هذا الإحسان ولا
تعرضوا عمن أحسن إليكم.وقوله تعالى : إني فضلتكم على العالمين لا يعني أن الله تعالى فضلهم على الأولين والآخرين من
الأمم جميعا، وإنما المراد أنه فضلهم على من كان في زمنهم من الأمم.فالقرآن يصف أمة الإسلام التي
أسسها محمد رسول الله ﷺ بأنها خير الأمم، فقال: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران:
۱۱۱).وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) (البقرة: ١٤٤).۲۳۸
Page 301
يتعين معنى العالمين من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ (آل عمران : ٣٤).فالمراد منه المعاصرون لكل واحد من هؤلاء، لأن الأنبياء والأمم المذكورين
في هذه الآية عاشوا في أزمنة مختلفة، ولا يصح القول إن كل واحد منهم كان أفضل من أهل الأزمنة
كلها.تعني
وهناك آية أخرى تلقي مزيدا من الضوء على معنى كلمة "العالمين".عندما استضاف سيدنا لوط ال
بعض الناس في بيته جاءه قومه وقالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ) (الحجر: ۷۱)..أي ألم نمنعك من
إحضار الأجانب من الجيران إلى القرية؟ فمعنى العالمين هنا : الأغراب أو الأجانب من حول المنطقة.إذن فحيثما جاء في القرآن كلمة العالمين فلم ترد بالضرورة بمعناها الواسع؛ بل يمكن أن
الجيران أو المعاصرين.وهذان المعنيان هما مراد آيتنا هذه.ولم يقل الله تعالى : فضلتكم على الناس ليشير إلى أن فضلهم كان على أنواع.وسبق أن ذكرنا
معاني لفظ العالمين عند شرح الكلمات لسورة الفاتحة وبينا أن معناه أيضا طائفة أو نوع من الناس
ينهضون دليلا على وجود الله تعالى.فكلمة العالمين تشير إلى طوائف ذات خواص متنوعة، ومعنى
الآية: إننا فضلناكم على البارعين في كل العلوم والمجالات..روحانية وشرعية وأخلاقية وغيرها، وخلقنا
فيكم أصحاب كمال في كل مجال، ففاقوا نظائرهم في عصرهم أو فيمن حولهم من الأمم.وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَسُ عَن نَّسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَعَةٌ وَلَا
يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ )
شرح الكلمات:
لا تجزي: الجزاء: المكافأة على الشيء.جزى الشيءُ: كفى (المحيط).جزيت فلانا حقه: قضيته..وتأتي جزى بمعنى أغنى (اللسان)."لا تجزي نفس: -۱ لا تقوم نفس مقام أخرى؛ -۲- لا يستطيع أحد تأدية واجبات غيره.فمعنى
-
شفاعة: شفع شفاعة وشفعًا.والشفع ضمّ الشيء إلى مثله.والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له أو
سائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حُرمةً ومرتبة إلى من هو أدنى (المفردات).وشفع
الصلاة أو العدد صيّره شفعا أي زوجا..أي أضاف إلى الواحد ثانيا وإلى الركعة أخرى.يقال: كان
وترا فشفعوه بآخر أي قرنوه به وشفع لي الأشخاص..أي أرى الشخص شخصين لضعف بصري.۲۳۹
Page 302
وشفع له أو فيه إلى فلان شفاعة طلب أن يعاونه وشفع لفلان في المطلب سعى.وشفع لي بالعداوة:
أعان علي.والشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه.وقيل: لا
تستعمل إلا بضم الناجي إلى نفسه من خاف من سطوة الغير (الأقرب).بالمفهوم
عدل: العدل ضد الجور؛ المثل؛ النظير؛ الجزاء؛ الفداء؛ النافلة (الأقرب).التفسير الآية دَحْضُ لمعتقدات عند بني إسرائيل كانت تشجعهم على المعاصي، وتحرمهم الحسنات.كانت طوائف من بني إسرائيل تظن أن أحدا ممن سواهم سوف يتحمل عبء ذنوبهم أولا، وأنه سوف
يشفع لهم الأبرار منهم وينقذونهم ثانيًا، وثالثًا أن فيهم بعض الحسنات التي تزيد على ذنوبهم في كل
حال، وأن منها سيسددون فدية لذنوبهم ويستحقون الجنة.وتدحض الآية هذه الأفكار وتخبرهم
الحقيقي للحسنات كيلا يهلكوا أنفسهم بإنكار الحقائق.ولفهم هذه الآية يجب أن نعرف أن الفطرة الإنسانية جُبلت على حب نيل المراتب الروحانية العليا.هذا الإحساس تجاه الكمال موجود بشكل أو آخر حتى في القبائل البدائية غير المتحضرة..سواء كانوا
من الزنوج الأفارقة أو الهنود الحمر المكسيك أو سكان أستراليا الأصليين.ويوجد هذا الإحساس في
بعضهم بصورة معينة وفي بعضهم بصورة مبهمة.وقد أشار القرآن إلى هذا الإحساس بأسلوب لطيف
جدا حيث قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) (الأعراف: ١٧٣ و ١٧٤).=
تتضمن هذه الآية استعارة لطيفة بأن كل إنسان يخرج من ظهر ،آبائه أي ،يولد، حاملا أثر التوحيد، ثم
بعد ذلك يصبغه أبواه بصبغة الشرك.فلو لم يترك الله أثر التوحيد هذا في الفطرة الإنسانية لكان له عذر
في الوقوع في الشرك.ولكن الله تعالى أقام الحجة على كل إنسان بأن غرس في فطرته الاعتراف بالتوحيد
قبل مولده، فلا يستطيع الاعتذار بالجهل، أو بتأثير آبائه هذا الأثر الفطري نجده في كل قوم وفي كل
قبيلة، ومنذ الأزل يحاول الإنسان أن ينال القرب من خالقه، مما يدل على أن هذه الرغبة وديعة في
فطرته، ولم تأت من خارجه.ولكننا مع ذلك نرى أن الإنسان كسلا منه أو غفلة يلتمس طرقا سهلة لنيل هذا المرام.أما
المتأثرون بالفلسفة فيختارون طريقا لهم بهذا المنطق: بما أن الله تعالى قد خلقنا في خضم هذه الظروف
الدنيوية فلا يتوقع منا إلا أن نعيش مواطنين طيبين؛ ولو حققنا هذا الغرض فقط لنكونن قد أدينا كل ما
ألقى الله علينا من واجبات.٢٤٠
Page 303
أما غيرهم فيحاولون في زعمهم إجابة النداء الرباني بتضحيات مؤقتة متنوعة..قد تبدو أحيانا للناس
جسيمة، ولكنها في الحقيقة لا تمثل إلا القليل التافه بالقياس إلى التضحية الواجبة.فمثلا يلجأ بعض الناس
تهربا من الجهد والكفاح إلى قطع أعضاء أجسادهم..بدلا من اتباع سبل الخير الدائم، وإصلاح النفس
ليل نهار، وسلوك الطريق الوعر من قمع الأهواء..ويحسبون هذا عملا يغنيهم عن تضحية كاملة غير
منقطعة..فرضها الله على الناس لنيل طهارة حقيقية.وبعضهم، عجزا منهم عن كبح ميولهم الشهوانية،
يقطعون العضو المثير لها.وبعضهم لضعف عزيمتهم عن الامتناع عن الغيبة والنميمة والكذب وفحش
القول، يقطعون ألسنتهم.وبعضهم بسبب عدم قدرتهم على ذكر الله تعالى في مشاغل محيطهم يفرون إلى
الغابات والجبال.وبين الهندوس من يعيشون عراة ظانين أنهم يضحون براحتهم في سبيل الله، وأحيانا
يعلقون أنفسهم في وضع مقلوب أداء لحق الله عليهم!
كل هذه الطرق ليست إلا بمثابة الفرار من الواجبات الحقيقية المجدية.فلو أن الله تعالى جعل تكميل
الإنسان متوقفا على هذه الأعمال فما الداعي من خلق إنسان ذي فطرة مدنية؟ لو كانت الرهبانية أي
الامتناع عن الزواج، طريقا حقيقيا للخير لكان معنى ذلك أن سبيل كمال الإنسانية هو في إفنائها.وهذا
باطل بالبداهة.إذا كانت الرهبانية ذريعة كمال الحياة الإنسانية لوجب أن يكون كل الناس متبتلين
ليصبحوا من الكاملين.ولو تبتلوا جميعا لقُضي على الإنسانية في جيل واحد.يقول البعض: الرهبانية ليست وسيلة للكمال وإنما الكُمَّل.هم الذين يترهبون.ولكنها أيضا فكرة
باطلة بالبداهة..لأن ذلك يعني انقطاع نسل الكُمَّل واستمرار نسل الناقصين.ومع أنهم ينتخبون الحيوان
الكامل الأصيل من بين الخيل والماشية والجمال وغيرها لإنتاج نسلها وتكاثرها.وكذلك يفعلون في
إكثار نباتات الفاكهة والزهور والمحاصيل والخضراوات وغيرها للحصول على إنتاج جيد.فلماذا نتبع
هذا الأسلوب في إنتاج النبات الجيد والحيوان الجيد وندع السلالة الناقصة من البشر لتنتج الذراري
الضعيفة ونهمل السلالة الجيدة متبتلة دون إنتاج؟ لن يقبل هذه الفكرة إنسان عاقل.كان بعض الأقوام يقدمون أولادهم قرابين الله استرضاء له أو تجنبًا لغضبه..وتوجد أمثلة لذلك في كل
البلاد تقريبا.وللقضاء على هذه العادة أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم اللي في الرؤيا بالتضحية بابنه، ذلك
لتعرف الدنيا قوة إيمانه وليمحو الله هذه العادة محوا أبديا.وفي بعض الأمم كانوا يقبضون على المجرمين
أو الأجانب ويقدمونهم قرابين الله.كل هذه الأفكار غير طبيعية ولا معقولة، تولدت نتيجة عدم إدراك
صفات الله من جهة، ولعدم فهم صفاء الفطرة الإنسانية من جهة أخرى.ولو أنهم أعملوا عقلهم لعرفوا
أن هذا الطريق ليس طريقًا لتكميل الروحانية، وإنما سبيل ذلك هو الحذر الدائم من الأهواء السيئة،
وجهاد النفس دائما، والتوجه المستمر إلى الله تعالى للاستعانة به في ذلك.٢٤١
Page 304
لقد انتشرت هذه الأفكار الخاطئة في أقوام لم يكن لديهم علم تفصيلي عن الدين.ومن جهة
اخترع أهل الديانات هذه الطرق كلها تسكينا لضمائرهم وفرارا من الجهاد الحقيقي نحو الكمال
الروحاني.ولا أعني بقولي هذا أن الأمم التي ليس لديها شريعة كاملة تخلو من هذه الأفكار، بل إنها أيضًا
تخفي خواطر نفوسها في ستار هذه الأفكار؛ ولكن أتباع الديانات التفصيلية يولون لها أهمية أكثر بدلا
من الجهاد الحقيقي للنفس.والخطاب في الآية مُوَجّه أصلا إلى بني إسرائيل الذين كانوا منقسمين إلى طائفتين: اليهود والنصارى.وقد تقوَّت هذه الأفكار بينهم في زمن الانحطاط عندما اندرس فيهم مفهوم الخير الحقيقي.فبدلا من
الحذر والتنبه الدائم إلى دسائس الشيطان والسعي الدعوب للتقرب إلى الله تعالى مدفوعين بحبه ليل نهار..ظنوا أنهم لو صرفوا النظر عن الشريعة والمنهج السماوي فلا ضرر في ذلك..فهم سينالون النجاة على
أي حال إما بكفارة قدمها أسلافهم حسب زعمهم، أو بفضل شفاعتهم لهم، أو إكراما لنسبهم العريق،
أو بسبب تضحيات مالية يقدمونها في الدنيا.هي
،والآن، أقدم حول هذه الأمور تعليم اليهود والنصارى، لأبين كيف وقعت هذه الأمم في الخطأ
وابتعدت عن طريق النجاة الصحيح؛ فأول فكرة خاطئة نشأت بين اليهود والنصارى ولا تزال باقية
فيهم، وقد دحضها القرآن الكريم في هذه الآية..هي أن أحدا آخر سيكون كفارة لخطاياهم فينجون من
تبعاتها.وقد نمت هذه الفكرة بين اليهود من القرابين التي كانت مفروضة عليهم بحكم الدين كي تلفت
أنظارهم إلى ضرورة التوبة من الذنوب.فعندما ضعفت فيهم روح التقوى بدءوا يظنون أن هذه القرابين
الكفارة لذنوبهم.يقول موسى ال: ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي، ويقر عليه بكل
"
ذنب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى
البرية، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية" (اللاويين ١٦: ٢١ -
(۲۲).وقال أيضا: "وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم.( عدد ۲۸ : ۲۲).أي بالإضافة إلى
أضاحي أخرى..قدموا تيسا واحدا كفارة لذنوبكم فيمحو كل خطاياكم.لا شك أن هذه كانت أوامر من موسى عليه السلام، ولكن بالنظر إلى تعاليمه الأخرى لبني إسرائيل
القول بأن تضحية التيس أو العجل كفارة تمحو خطايا الإنسان يقول موسى في موضع آخر:
"وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم
عابرون إليها لتتملكوها.لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه أنا أوصيك بها أنت وابنك
وابن ابنك كل أيام حياتك، ولكي تطول أيامك".ويضيف قائلا: "اسمع يا إسرائيل، إلهنا رب واحد.٢٢).لا
يصح
فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.ولتكن هذه الكلمات التي
أنا
٢٤٢
Page 305
أوصيك بها اليوم على قلبك، وقُصَّها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق
وحين تنام وحين تقوم.واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم
أبواب بيتك، وعلى أبوابك".ويقول أيضًا واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير"
(تثنية: ٦).تبين هذه التعاليم أن موسى عليه السلام كان يؤكد بشدة على تطهير القلب وفعل الخيرات والتمسك
بالتوحيد والعمل بأحكام الشريعة لدرجة أنه كان يوصي بنشرها باللسان والكتابة وتلقينها للآخرين..حتى يقول : احتفظوا بها بالكتابة على الجدران والأبواب.هل يتصور أحد للحظة واحدة بعد كل هذه
التعاليم أن موسى يعتقد بأن تضحية تيس واحد تمحو كل خطايا قومه جميعا؟! إذا كان محو الذنوب بهذه
السهولة فما الحاجة للحض على الشريعة بهذه القوة والحماس، بل ما الحاجة أصلا لإنزال الشريعة على
الناس؟
يدحض القرآن الكريم هذه الفكرة الباطلة عند اليهود، ويحذرهم بأنهم سيقفون أمام الله تعالى يوما لا
تجزي فيه نفس أي أضحية تيس عن نفس، أي عن يهودي، ولا تغني عنه شيئا..بل لا تنفعه يومئذ إلا
طهارة نفسه.فلم يكن الغرض من تعليم موسى لليهود بتضحية تيس أو غيره إلا أن يكون رمزا للتضحية
بأهواء النفس وشهواتها، ولكن اليهود مالوا إلى التراخي والتكاسل وصرفوا النظر عن التعاليم الحقة،
واعتبروا هذا التمثيل أصلا وتركوا الأصل، وهو طهارة النفس.الواقع أن الناس في زمن موسى كان
مولعين بالمراسم الظاهرية والتمثيلات، لذلك مُثل لهم موضوع تضحية النفس برسم ذبح تيس أو حيوان
آخر..لكي يهتم القوم جميعا في يوم معين بأهمية الخلاص من ذنوبهم ولكنهم نسوا المغزى الحقيقي من
التمثيل وتمسكوا بمظهره.وقد تركزت فكرة الكفارة هذه في طباع بني إسرائيل لدرجة أن الملك البابلي بختنصر عندما هدم
الهيكل في أورشليم حيث كانوا يقدمون قرابينهم أصابهم الهلع وظنوا أنه لم تعد لديهم وسيلة لغفران
الذنوب..ووصلت شدة الصدمة بكثير منهم لدرجة أنهم فرّوا من الدنيا وترهبوا (الموسوعة اليهودية: ج
۱).وصرخ يومئذ عالمهم الكبير يوشع بن حنانيا قائلا واحسرتاه كيف تتم الآن كفارة سيئاتنا!"
(المرجع السابق).والصدمة التي أصابت اليهود بهدم الهيكل جعلت أنبياءهم يشرعون في معارضة هذه الأفكار، ويبينون
لهم أن ذنوب الإنسان لا يحملها ثور ولا تيس فقال النبي هوشع ارجع" يا إسرائيل إلى الرب إلهك
لأنك قد تعذبت بإثمك.خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب.قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم
عُجول شفاهنا" (هوشع ١٤: ١و٢).هنا يوضح هوشع لليهود أن العجل أو التيس لا يكون كفارة
٢٤٣
Page 306
للذنوب وإنما هو التوبة والتسبيح والتحميد التي تنجي الإنسان من تأثير الإثم.ليس العجل ولد البقرة،
وإنما العجل المتولد من لسان التائب، هو الذي يمثل كفارة حقيقية.وقبل هوشع بسنين نبه النبي عاموس إلى خطر الاعتماد على هذه القرابين الظاهرية فقال: "إني إذا
قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي، وذبائح السلامة من مُسمَّناتكم لا ألتفت إليها.أبعد عنى
ضجة أغانيك، ونغمة ربابك لا أسمع ولْيَجْرِ الحق كالمياه، والبِرُّ كنهر دائم" (عاموس ٥: ٢٢ – ٢٤).وقال النبي إشعياء: "لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة.البخور هو مَكْرَهة لي.رأسُ الشهر والسبتُ
ونداء المحفل.لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم بغَضَتْها نفسي، صارت عليَّ
ثقلا، مللتُ حملها.وأضاف أيضًا اغتسلوا، تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني.كفوا عن فعل
الشر، تعلموا فعل الخير.اطلبوا الحق.انصفوا المظلوم.اقضوا لليتيم.حاموا عن الأرملة.هلم نتحاجج
يقول الرب.إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج.إن كانت حمراء كالدّودي تصير كالصوف"
(إشعياء ۱: ۱۳: ١٦:١٤ إلى ١٨).ويقول النبي ميخا: "بم أتقدم للرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات، بعجول أبناء سنة؟ هل
يُسرّ الربُّ بألوف الكباش؟ بربوات أنهار زيت هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية
نفسي.قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة
وتسلك متواضعا مع إلهك".(ميخا ٦: ٦ إلى ٨).تبين هذه العبارات أنه كان لدى اليهود اعتقاد راسخ بأن القرابين تكفر ذنوبهم، وأن عديدا من
أنبيائهم حاولوا صدهم عن هذه العقيدة وبينوا لهم أن الله تعالى لا يرضى بالأضاحي من التيوس
والعجول والبكر من الأبناء، بل هناك طريق واحد للوقاية من عواقب ما ارتكبه الإنسان من السيئات..أن يتوب باللسان والقلب، ويعود إلى فعل الخير والصلاح مرة أخرى، فيغفر له الله تعالى ما
ذلك هو
تقدم من ذنبه.ولكن أثر هذا التعليم لم يبق فيهم طويلا..حيث تركوا تعظيم القرابين من الحيوانات، ولكن اخترعوا
كفارة أخرى..فقالوا بأن ما تحمله كبار صلحائهم من مشاق وتضحيات يكون كفارة لذنوبهم، وإذا لم
يكن في زمن ما مثل هؤلاء الأبرار فإن الله تعالى يكفر عنهم ذنوبهم بإهلاك مواليدهم الأبرار.فقد ورد
في كتب اليهود: "الجيل الذي لا يوجد فيه الأبرار والصالحون يذهب الرب منهم بأطفالهم الأبرار
(الموسوعة اليهودية، ج۱).ا ربوات أنهار زيت تعني آلاف الأنهار.الناشر
٢٤٤
Page 307
وينبه القرآن اليهود بأنه لم تُغنهم نفس، سواء أكانت نفس تيس من أنعامهم أو نفس رجل من
صلحائهم، أو نفس طفل من أبنائهم، وهذا ما أكد عليه أنبياؤهم من قبل.وأما الفرع الثاني من بني إسرائيل، وهم النصارى، فتأثروا بنفس الفكرة اليهودية وبنوا عليها عقيدة
الكفارة.فهم يعتقدون أن المسيح صار كفّارة لخطيئتهم بموته على الصليب، ويظنون أن تعاليم موسى
عليه السلام بذبح تيس قربانا عن ذنوبهم يتضمن في الحقيقة نبأ بمجيء المسيح..بمعنى أن هذه القرابين
توجه أنظارهم نحو كبش للرب، أي المسيح، سيأتي ويموت كفارة لذنوب بني آدم.ودليلهم أن الكبش لا
يقدر على حمل ذنوب كل الدنيا ولكن ابن الله تعالى قادر على حملها وينفون زعم اليهود بأن
صلحاءهم قد تحملوا من المشاق ما يكفر ذنوبهم بقولهم إن أسلافهم كانوا أنفسهم ملوثين بالخطيئة؛
والخاطئ لا يستطيع حمل خطيئة غيره، أما المسيح فكان بلا خطيئة، وبالتالي قادر وحده على حمل خطايا
البشر.يقولون لقد صلب المسيح لا لذنب جناه، وإنما لأجل ذنوب الآخرين.إن بني البشر ورثوا الخطيئة
أبيهم آدم، ولما كان المسيح بلا أب فلم يرث شيئا عن آدم وكان بلا خطيئة، وتأهل بذلك ليكون
من
كفارة لذنوب البشر.ولقد أيد بعض المسلمين لجهلهم النصارى في عقيدتهم هذه؛ إذ قالوا: ليس هناك أحد لم يمسه
الشيطان إلا المسيح وأمه، وبذلك خطوا خطوة أبعد من النصارى.فهؤلاء يعتبرون المسيح وحده مترها
عن الخطية، ولكن المسلمين ضمُّوا إليه أمه أيضًا.وكأنه لم يوجد نبي سواه لم يمسه الشيطان، نعوذ بالله
من هذا القول!
إن النصارى لم ولن يقدموا قولا واحدا للمسيح اللي يقول فيه إنه معصوم من الذنب، أو أن موته
على الصليب كفارة لخطايا الآخرين.فتعاليم المسيح مخالفة لهذا الاعتقاد تماما.وإذا كان هناك قول له
بمثل هذا المعنى في أناجيلهم الحالية، فلا اعتبار له..لأنها مصابة بتحريف شديد.إنهم يقدمون أقوالا للحوارين في هذا الصدد منها:
١.قول بولس: إن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب " (الرسالة الأولى لأهل كورنثوس.(٣:١٥
٢.وقوله أيضا: "يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت
لأجل كل واحد رسالته إلى العبرانيين ٢: ٩)..وأيضًا: "لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينًا في ما الله حتى يكفر خطايا الشعب" (المرجع السابق:
٢٤٥.(۱۷
Page 308
٤.وأيضا المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب: ملعون كل من عُلِّق على
خشبة" (رسالته إلى غلاطية ٣: ١٣).بهذه الأقوال وغيرها يستنتج المسيحيون أن المسيح كان بلا خطية، ولكنه مات ميتة اللعنة لأنه علق
على الخشبة..فثبت أن موته لم يكن لنفسه بل للآخرين كفارة لخطاياهم.وكما سبق
أن ذكرنا..أن هذه العقيدة النصرانية تولدت عن نظرية فشت في اليهود زمن انحطاطهم
الروحي عندما ظنوا بأن ما يتحمله صلحاؤهم من مشاق وصعاب يكفر ذنوب سائر بني إسرائيل.ولكن
عقيدة النصارى هذه مخالفة لما ورد في الإنجيل نفسه يقول المسيح نفسه: "ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني
من
فلا يستحقني (متى ۱۰ (۳۸) ونفس المعنى موجود في الأناجيل الأخرى بكلمات أخرى.فتبين
هذه العبارة أن المسيح عليه السلام لا يعتبر صلبه ذريعة لنجاة البشر، بل على كل إنسان أن يُصلب على
صليب نفسه ليفوز بالنجاة.موسی
وتدحض عقيدة الكفار أيضا أحوال الذي كان مؤسس السلسلة الموسوية، والذي ادعى
المسيح بأنه جاء لتجديد وإقامة تعاليمه.فقد جاء في التوراة أنه عندما ذهب موسى إلى الجبل أربعين ليلة،
واتخذ بنو إسرائيل العجل إلها لهم في غيابه..ثار عليهم غضب الرب وأراد أن يهلكهم قائلا: "رأيت هذا
الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة.فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم.فأصيرك شعبا عظيما"
(خروج (۳۲ (۹-۱۰ ورجع موسى إلى قومه وغضب عليهم لشركهم وقال لهم: "أنتم قد أخطأتم
خطيئة عظيمة.فاصعد الآن إلى الرب لعلي أكفّر خطيتكم".وتحكي التوراة: "فرجع موسى إلى الرب
وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب.والآن إن غفرت
خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي"
المرجع السابق: ٣٠ إلى (٣٣).فلم يقل
الله
تعالى لموسى: أنت مخطئ لكونك من بني آدم، فكيف لمخطئ أن
فكيف لمخطئ أن يصير كفارة للمخطئين
الآخرين، ولكنه قال من أخطأ إلي سأمحوه من كتابي.ويوضح هذا الجواب أن الله تعالى لا يعاقب أحدا
بدل مذنب آخر، وإنما سنته تعالى ألا يعاقب إلا المذنب.فعلى الرغم من وجود هذا التعليم يقول
النصارى إن المسيح صلب كفارة لذنوب قومه، ويخالفون تعاليم الكتاب المقدس.ورب قائل يقول إن هذا التعليم التوراتي نسخ زمن المسيح.فالرد على ذلك أن هذه السنة الإلهية
حقيقة أزلية، والحقائق الأزلية لا تنسخ قد تتبدل الأحكام المتعلقة بالناس ولكن سنن الله تعالى لا تتغير
ولا تتبدل.٢٤٦
Page 309
بروح
أما الأدلة التي يبني عليها النصارى موضوع الكفارة فهي أيضًا باطلة عقلا ونقلا.فمثلا قولهم إن
الإنسان ورث الخطيئة من آدم، فلا يستطيع أن يتخلص منها، أو بعبارة أخرى: إن فطرة الإنسان ملوثة
بالخطيئة.هذا الزعم يفنّده القرآن الكريم حين يعلن: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين: ٥)..يقينا، إننا خلقنا الإنسان مزودا بقوى خالية من أي نوع من الاعوجاج.ويقول النبي ﷺ: "كل مولد
يولد على الفطرة" (صحيح البخاري، كتاب الجنائز)..فكل إنسان يولد طاعة كاملة.والعجيب أن النصارى يدَّعون من جهة أن الإنسان لا يستطيع التغلب على الخطيئة الموروثة من جده
الأكبر آدم، ولذلك دعت الحاجة إلى كائن مولود بلا أب للكفارة عنها..ولكنهم من جهة أخرى
يدعون أيضًا أن الشخصين اللذين لم يرثا الخطيئة أي آدم وحواء، كلاهما خاطئان.إذا كان الأمر هكذا
فكيف نجزم إذن أن من لم يرث الخطيئة يكون بارا غير خاطئ هذا القول لا يثبت إلا إذا وجدت أمثلة
لأشخاص لم يرثوا الخطية ومع
ذلك كانوا أبرارا، ولكن ليس هناك مثل هذه الأمثلة لدى النصارى سوى
شخصين اثنين، وكلاهما مذنب أي آدم وحواء"، أما الشخص الثالث فهو المسيح.فادعاؤهم بأنه لم
يرث الخطية لأنه مولود بغير أب تحكم ليس إلا..لأن المولود لا يرث من قوى أبيه فقط، بل أيضًا من
قوى أمه.لا ندري من هذا الأحمق الذي وسوس إلى قلب مخترع هذه النظرية أن المولود يرث قوى أبيه
فقط.فالمولود يكون أحيانا على صورة أبيه وأحيانا على صورة ،أمه، وأحيانا يرث من قوى أبيه أكثر من
قوى ،أمه، ويحدث العكس أيضًا، وأحيانا يرث قدرا متقاربا من الجانبين.فكيف يصح استنتاج أن المسيح
لم يرث الخطية لأنه بدون أب؟ لقد ولد من بطن السيدة مريم وورث منها خصائصها.والمرأة وارثة
للخطية في عرف النصارى مثل الرجل، بل تقول التوراة إن الشيطان عن طريق حواء أغوى آدم
التكوين ٣ : ١ إلى ( ومعنى ذلك أن الشيطان وجد المرأة أكثر ميلا نحو الخطية من الرجل..ولذلك
اتخذها ذريعة لإغواء.آدم فالمولود الذي وُلد وارثا ضَعْفَ حواء وحدَها كان أقرب إلى الخطية ممن ولد
لأبوين.أما المسيح فيرى في نفسه غير ما يقول النصارى عنه.فقد ورد في الإنجيل أن شخصا جاءه وناداه:
•
(متى
"أيها المعلم الصالح.فقال له المسيح: لماذا تدعونني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله"
١٩: ١٦ و ١٧).ويتضح من هذا القول أن المسيح الله لا يعتبر نفسه صالحا.فكيف يسوغ إذن
اعتباره الصالح الوحيد..ثم تأسيس عقيدة الكفارة على ذلك؟
وأقول هنا بكل أسف عندما اعترض سيدنا مرزا غلام أحمد مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه
:
السلام على عقيدة الكفّارة والفداء مستشهدًا بقول المسيح عليه السلام هذا، بادر النصارى إلى تحريف
نصه في بعض طبعاتهم الجديدة كالأردية مثلا، مع أنه كان بحسب اعتقادهم جزءا من الإنجيل منذ تسعة
٢٤٧
Page 310
لماذا
عشر قرنا.وكانت حجتهم بعد تحريفهم هذا أن الترجمة السابقة كانت خطأ.قالوا لم يقل المسيح:
تدعوني صالحا، وإنما قال: لماذا تسألني عن الصلاح؟ وللعاقل أن يتساءل: كيف لم ينتبهوا لهذا الخطأ طيلة
تسعة عشر قرنا..وبمجرد أن أشار إليه سيدنا مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عرفوه وصححوه ؟
إن هذا تحريف جريء ارتكبوه في زمن مضى على اختراع المطبعة فيه مئات السنين، وصدرت من
الأناجيل مئات الطبعات وملايين النسخ بكل اللغات.فالأمة التي تتجاسر على هذا التحريف الخطير بعد
اختراع المطابع وانتشارها..فيمكن أن تتصوّر حجم التحريف الذي أدخلته في كتابها قبل ذلك؟
بيد أن ما قلته فقد قلته استنادا إلى بيان الكتاب المقدس، وإلا فإن الإسلام يعلمنا أن كل مولود يولد
بفطرة طيبة نقية، وخاصة رسل الله تعالى كالمسيح أو موسى أو غيرهم عليهم السلام..كل واحد منهم
كان في عصمة الله ، و لم يكن للمسيح بهذا الصدد أي خصوصية.والجدير بالذكر أيضًا أنهم يؤسسون كفارة المسيح على اعتقادهم بأنه اختار الموت على الصليب عن
طيب خاطر لحمل خطايا الناس وقضية موته على الصليب سوف أفصلها في موضعها من القرآن
الكريم، إن شاء الله، واكتفي هنا بالقول إنه لا يثبت من الإنجيل أبدا أن وضع المسيح فوق الصليب كان
عن رضا وطيب خاطر منه ولا أنه مات على الصليب.فقد جاء في الإنجيل: "ثم تقدم قليلا وخر على
وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس.ولكن ليس كما أريد أنا بل كما
تريد أنت" (متى ٢٦ ٣٩.فهل يقبل العقل السليم أن الذي أتى من السماء برغبته لحمل خطايا
البشر..يبكي ويخرّ على وجهه ساجدا محاولا الخلاص من هذه المحنة؟
يحتج النصارى ردًّا على هذا التعجب بأن المسيح قال أيضا: "ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد
أنت"..فنقول: إن قوله هذا يدل على أن إرادة المسيح لم تكن ليصبح كفارة لذنوب الناس، فكيف
والحال هذه، صار كفارة لها؟ هل وضع الله تعالى أعباء الناس ظلما على كتفي شخص يأبى ذلك؟ نلحظ
شدة كراهية المسيح لعملية الصلب هذه لدرجة أنه عندما عُلّق على الصليب قال، كما ورد في الإنجيل:
"إيلي إيلي لما شبقتني" (متى :۲۷ (٤٦ أي إلهي إلهي لماذا تركتني.تكشف هذه العبارة بوضوح تام
التأويل الذي يقدمه النصارى لقول المسيح ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" تأويل خاطئ
وباطل، لأن الإنجيل يقول بأنه لما تحققت إرادة الله تعالى وعلق المسيح على الصليب..فإنه بدلا من
الاستسلام لما يرضى الله تعالى شَرَع يشتكي إليه تعالى صارخا: لماذا تركتني؟
"
أن
الخلاصة أن المسيح عليه السلام ما كان يريد أن يُصلب بحال من الأحوال.فالقول بأنه جاء إلى الدنيا
ليحمل خطايا الآثمين باطل تماما.لو كان المسيح حقا جاء إلى الدنيا لهذا الغرض لم يحاول قط أن يتخلص
مما يحسبه النصارى الوسيلة الوحيدة لتخليص الناس من الخطايا.٢٤٨
Page 311
عن
أما مسألة موت المسيح على الصليب..فهناك شهادة للمسيح أبينها بإيجاز.جاءه وفد من فقهاء
اليهود وطائفة الفريسيين وطلبوا منه أن يريهم آية فقال: "جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا
آية يونان النبي.لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في
قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال متى :۱۲ ۳۹ و ٤٠).دخل النبي يونس "يونان" الله في بطن
الحوت حيا، ومكث في بطنه حيًّا، وخرج من بطنه حيًّا.فثبت أن المسيح أيضا دخل القبر حيًّا، ومكث
فيه حيًّا، فزعم النصارى أنه مات على الصليب باطل، وما دام لم يمت على الصليب بطلت العقيدة
القائلة بأنه قبل الموت ليحمل خطايا الآخرين.فإما أن يكون المسيح، والعياذ بالله، كاذبا فيما قاله
هذه الآية، أو نكذب هؤلاء الذين زعموا أنه مات على الصليب، ودخل القبر ميتا، ومكث فيه ميتا.هناك لطيفة جديرة بالذكر، فعلى الرغم من أن عادة التضحية بإنسان أي أن يقتل الناس أحدا منهم
كفارة لذنوبهم كانت قد أُلغيت منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلا أن اليهود لم يكونوا قد تحرروا من
تأثيرها تماما.فقد ورد في التوراة أن أحد رؤساء بني إسرائيل "يفتاح الجلعادي" عندما خرج لقتال
عمون نذر للرب أنه إذا حقق له النصر فسوف يقدم قربانا له من يخرج من أبواب بيته قبل غيره للقائه
عند رجوعه سالما من المعركة.وحدث أن ابنته الوحيدة كانت أول من خرج للقائه.فقتلها وفاء بنذره.ومثل هذه النذور تكون نوعا من الكفارة، إذ يريدون بها محو خطاياهم التي تحول دون فلاحهم في مهمة
ما.بني
إذا فإعلان القرآن بأنه لا يمكن لنفس أن تمثل للحساب أمام الله تعالى نيابة عن نفس أخرى..لهو
إعلان حق ومنطقي، وتؤيده كتب اليهود والنصارى، وأقوال موسى وعيسى عليهما السلام).وأما ما
يوجد خلافه من نظريات خاطئة لدى هؤلاء القوم فقد نشأ عندهم بسبب أهواء ورغبات باطلة.ولقد
ارتكبوا إهانة كبيرة في حق أسلافهم الصالحين باعتبارهم كفارة لذنوبهم، كما فتحوا باب الإثم على
مصراعيه.الشفاعة:
والأمر الثاني المذكور في الآية أنه لا تُقبل شفاعة أحد لأحد.وفي هذا أيضا دحض لما عند اليهود
والنصارى من أفكار حول هذا الموضوع كان اليهود يعتقدون بشفاعة النسب.لقد ظنوا أن كونهم من
ذرية إبراهيم يوجب شفاعته لهم، فلن يعاقبهم الله تعالى، وإن عاقبهم يكون عقابا محدودا.وقد ذكر
القرآن الكريم زعمهم هذا في قوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) (البقرة: (۸۱).٢٤٩
Page 312
ويقول المستشرق "سيل" في ترجمته للقرآن الكريم عند تعليقه على هذه الآية إن من مسلمات اليهود
في عصرنا هذا أنه لن يدخل منهم أحد الجحيم، إلا "دارتن" وأبيرام" والملحدون أكثر من أحد عشر شهرا
أو سنة على الأكثر "ترجمة سيل للقرآن".ولم أستطع العثور في الكتابات القديمة على نص بهذا المعنى، ذلك لاندراس الكثير منها، وأما الكتاب
العصريون فقد ظنوا خطأ أن اليهود كقوم ينكرون البعث بعد الموت، ولذلك لم يبذلوا جهدا لمعرفة
عقائد اليهود عن الحياة بعد الموت.ولكن نعرف من التراث الإسلامي أن اليهود كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت على الأقل حتى إلى
زمن الرسول ﷺ فقوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغيره من آيات القرآن تؤيد
ذلك.كما وردت روايات في الكتب الإسلامية حول هذا المعنى، فقد ذكر ابن إسحاق وابن جرير
برواية ابن عباس أن اليهود يعتقدون بأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، وبأنهم سيعاقبون يوما مقابل كل
ألف سنة، ثم ينتهي عقابهم.وروى ابن جرير عن ابن عباس أن بعض اليهود يظنون أنهم يدخلون جهنم
لأربعين يوما فقط، لأنهم عبدوا العجل أربعين يوما، ما عدا داتن وأبيرام اللذين تمردا على موسى وهلكا،
وكذلك الملحدين.هذا الاختلاف الوارد في رواية ابن عباس عن عدد أيام عقاب اليهود بأنها سبعة أو أربعون يرجع إلى
اختلاف فرق اليهود في هذا الأمر.على أية حال تؤكد هذه الروايات أن اليهود إلى زمن نزول القرآن
الكريم كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، ولكنهم كانوا يحسبون أنهم لن يعاقبوا طويلا لانتسابهم إلى أبيهم
إبراهيم.ويعود ظنهم هذا إلى قرون عديدة مضت، لأن اليهود الذين استوطنوا الجزيرة العربية جاءوها
قبل الإسلام ببضعة قرون، وهذا يجعلنا نسلم بأن أفكار اليهود هذه كانت موجودة في البلاد الأخرى.ولو أمعنا النظر في أسفار العهد القديم لوجدنا فيها إشارات إلى الحياة بعد الموت.والحق أن أي دين
لا يُعتبر دينا كاملا ما لم يقدم التعاليم حول مسألة الحياة بعد الموت، لأنها الوسيلة لتحقيق الغرض من
خلق الإنسان، وحرمان الناس من علمها يُعَدّ حرمانا من غرض الدين فكل دين يقصر في هذه الناحية
من التعاليم يحكم على نفسه بالبطلان جاء في التوراة : وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد آبائك"
مع
(تثنية: ٣١:١٦).العبارة واضحة في دلالتها على أن روح موسى تكون بعد الموت مع أرواح آبائه، لأن
قبره لم يكن حيث مقابر ،آبائه، فقد مات موسى في البرية و لم يبق لقبره علامة يعرف بها.قالت التوراة:
ولم يعرف إنسان قبره إلى "هذا "اليوم تثنية) ٣٤ (٦.فالمراد من رقوده مع آبائه هو لقاء روحه
بأرواحهم بعد الموت.٢٥
Page 313
"
وكذلك ورد في التوراة أن الله تعالى قال لموسى ال: "ومت في الجبل الذي تصعد إليه، وانضمّ إلى
قومك كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى "قومه تثنية (۳۲ (۵۰.تثبت هذه العبارة الحياة
بعد الموت، وتشير إلى أن الأرواح البارة تقيم معا في مكان خاص، وإلا فما معنى الانضمام إلى الآباء بعد
الموت؟
ويقول أيوب ال: "ليتني كنت مثل أجنة لم يروا النور..أي لم يُعَمّروا.ثم يصف حالهم.: "هناك
يكف المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون الأسرى يطمئنون جميعا، لا يسمعون صوت
المسخر.الصغير كما الكبير هناك.والعبد حر من سيده." (أيوب ٣: ١٧-١٩)
ويقول داود عليه السلام مخاطبا ربه لن تترك نفسي في الهاوية.لن تَدَع تقيك يرى فسادا.تعرفني
سبيل الحياة" (مزامير ۱۶: ۱۰ و ۱۱).ويقول أيضًا: "من الناس بيدك يا رب.من أهل الدنيا.نصيبهم ١٦:
في حياتهم.بذخائرك تملأ بطونهم.يشبعون أولادا ويتركون فضالتهم لأطفالهم.أما أنا فبالبر أنظر
وجهك.أشبعُ إذا استيقظتُ بشَبَهك" (مزامير ١٧: ١٤-١٥).تبين كلمات داود الا هذه أن بعض الناس يكتفون بالحياة الدنيا، ولكن المؤمن يضع الحياة بعد
الموت نصب عينيه، لأنه سيحظى هناك بلقاء الله تعالى على وجه أتم وتكون روحه في الحياة الآخرة
على شبه الله تعالى، أي كاملة الصفات."
ويضيف داود مخاطبا ربه حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد" (مزامير ٢١: ٤).يتبين من هذه العبارات أن في تعاليم موسى ومن بعده من الأنبياء دليلا قطعيا على الحياة بعد الموت.وإذا قرنا هذه الشهادة مع شهادة القرآن الكريم وهي شهادة تاريخية يراها حتى المخالفون وثيقة بشأن
حال اليهود إلى العصر النبوي على الأقل..فلا بد من الاعتراف بخطأ ما يقول به الباحثون المعاصرون
من أن تعاليم أنبياء بني إسرائيل ليس فيها ذكر للحياة بعد الموت.إنه رأي ناتج عن قلة التدبر ولا يستند
إلى دليل.والحق أن هذا التعليم كان موجودا في الديانة اليهودية منذ البداية، وكانوا يتعللون بأفكار
وأماني يختلقونها فرارا من خوفهم من العقاب في الحياة الآخرة على ما سلف من أعمالهم في الدنيا.ومن
هذه الأماني أنهم أولاد الأنبياء، وبشفاعتهم ينجون من عذاب الآخرة كلية أو يخفف عنهم فيعذبون أياما
معدودة.والله تعالى ينفي هذه الفكرة ويبين أن ليست الشفاعة كي يتمادى الإنسان في الإثم، ولن تنالوا
مثل هذه الرخصة أبدا، فأصلحوا أعمالكم ولا تفسدوا عاقبتكم مغترين بأمانيكم التي ما أنزلنا بها من
سلطان.٢٥
Page 314
وربما اغتر اليهود في مسألة الشفاعة أيضًا لأنهم أنذروا مرارا بعقاب سماوي، ولكن الله تعالى رفعه عنهم
بدعاء أنبيائهم..فظنوا أن الحال سيكون كذلك في الآخرة.ولكن الحياة الآخرة لا تقاس بالحياة الدنيا،
لأن رفع العذاب في هذه يهيئ للإنسان فرصة للتوبة وفعل الخير، أما الآخرة فهي دار الحساب والحكم
النهائي.ولو كانت النجاة في الآخرة تتحقق بمثل هذه السبيل لكانت الحياة الدنيا عبثا محضًا.وفكرة الشفاعة موجودة لدى النصارى أيضًا.جاء في الإنجيل: " يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكيلا
تخطئوا.وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا
فقط بل لخطايا كل العالم أيضًا" (رسالة يوحنا الأولى ٢ ١-٢).وهنا ينشأ سؤال: هل الكفارة
والشفاعة شيء واحد؟ وإذا كان هكذا فلماذا ذكر كل واحد منهما على حدة؟ تصمت الكتب
المسيحية حسب معلوماتي عن الإجابة على هذا السؤال، ولكن بالنظر في معنى الكلمتين نجد هناك فرقا
بينهما.فالكفارة محو أثر فعل بفعل آخر.ولكن الشفاعة لا تدل على الفعل العوض، وإنما تعني
يتوسط أحد لصالح مخطئ وإن كان الوسيط لا يقدم عوضا عن خطأ الفاعل..وإنما يطلب له الغفران بناء
على علاقته بصاحب الأمر.وأرى أن النصارى لم يدركوا هذا الفرق بين الشفاعة والكفارة وخلطوا
بينهما.أن
وموجز القول أن اليهود والنصارى كانوا ولا يزالون يظنون خطأ أن الله تعالى لن يعذبهم، أو يعذبهم أقل
العذاب بسبب أسلافهم الصالحين المقربين.وهذا ما شجعهم على ارتكاب المعاصي، وجعلهم لا يتجهون
إلى التفكير في الحقائق الإلهية.وبكشف خطئهم هذا يسعى القرآن لإيقاذ فطرتهم النائمة ويحيي فيهم
ملكة التفكر في الحقائق الدينية.ومن الضرروي هنا إزالة سوء فهم يروجه الكتاب النصارى ضد الإسلام ومؤسسه.يقولون استنادًا
إلى هذه الآية ومثيلاتها أن الإسلام لا يقول بمبدأ الشفاعة وأن المسيح وحده الذي ادعى بشفاعته
للناس، وأن نبي الإسلام ليس شفيعا لأحد بحسب ما ورد في القرآن (ترجمة) ويري للقرآن)، وأن اعتقاد
المسلمين بكونه شفيعًا لهم اعتقاد باطل ومن بنات أفكارهم، ولا يستند إلى نصوص القرآن وإنما إلى
أحاديث ضعيفة.ولكن زعمه هذا ناشئ عن سوء فهم.ولسوف أتناول موضوع الشفاعة في مكانها في القرآن الكريم، إن
شاء الله تعالى، ولكني أود هنا بيان أن القرآن لا ينكر الشفاعة، وإنما يعلن بطلان الشفاعة التي يؤمن بها
اليهود والنصارى.ففي سورتنا هذه يقول القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه](٢٥٦)، ويقول:
٢٥٢
Page 315
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ](الزخرف:۸۷)..أي هؤلاء
الذين يشركونهم بالله لا يملكون حق الشفاعة لأحد وإنما يملكه عبدنا هذا الذي يشهد بالحق، وهم
يعرفون أنه الشاهد بالحق.فالقرآن يقول بالشفاعة وينفي فقط تلك الشفاعة غير المنطقية التي تشجع
الناس على الذنوب وتصرفهم عن إعمال الفكر في الحقائق.ثم إن كلمات الآية التي نفسرها وحدها كافية لتأكيد ما نقول، إذ لم تقل بأنه لن تكون هناك شفاعة
مطلقا، بل تقول: لا تقبل من أحد بمعنى أنه لا تقبل شفاعة من محرم.وقوله تعالى: [و لا يؤخذ منها عدل رد لخطأ ثالث كان يشجع اليهود والنصارى على الذنوب، إذ
ظنوا أن الآثمين سوف ينجون من العقاب بتقديم عوض عن أخطائهم.وهذه العقيدة موجودة عند اليهود
والنصارى كليهما.وطائفة الرومان الكاثوليك من بين النصارى أشد تمسكًا بهذا الاعتقاد من اليهود.فعندما يرتكب أحدهم إنما يذهب إلى القسيس، فيُقدِّر له عقوبة ما، فإذا أوقعها على نفسه ظنَّ بأن ذنبه
قد غفر.وكان اليهود، ولا يزالون، معتادين على أداء عوض عن ذنوبهم بتقديم القرابين.ولكن الإسلام لا يقبل بمثل هذا العوض عن الذنوب، وإنما مفهوم الاستغفار في الإسلام أن يكره الإنسان
الإثم ويتجنبه.والحق أنه ليس هناك معنى آخر للاستغفار من الذنوب.على سبيل المثال، لو قتل أحد
شخصا ثم قدم صدقة، فكيف يُغفَر له ذنبه ذلك؟ أو اعتكف في الكنيسة صائما فكيف يحصل له
الغفران؟
عنه
لا شك أن الإسلام أيضا شرع بعض الأعمال كفارة لبعض الأخطاء، ولكنها أخطاء تتعلق بأشكال
ظاهرية للعبادة، وليس هناك تعليم كهذا فيما يتصل بتضييع حق من حقوق العباد أو حقوق الله تعالى.فمثلاً لو ترك أحد ركنا من أركان الحج اضطرارًا أو نسيانًا أُمر بتعويضه بعمل من أعمال الخير كصدقة
أو صيام أو نسك.ولو قتل أحدًا خطأ أمر بفعل خير عوضا عنه.ولا يعني ذلك أن فعل الخير أزال
الإثم، وإنما الهدف من ذلك أن يتحقق الغرض من الشكل الظاهري للعبادة بطريق آخر، أو أن ينتبه
الإنسان في المستقبل فلا يقع بسبب عدم الحيطة في خطأ يتضرر به الآخرون.قوله تعالى: [ولا هم ينصرون ]..أي لا ينجيهم من عذاب الله تعالى أي من هذه الطرق غير الطبيعية.هناك طريق واحد للنجاة من العذاب..ذلك أن يبذل الإنسان غاية جهده لفهم الحق وقبوله، ويتبع
أحكام الله تعالى بكل ما في وسعه ويلبي دعوته.فعلى اليهود والنصارى ألا يعتمدوا على طرق اختلقوها
:
بأنفسهم، بل عليهم أن يقبلوا الحق الجديد من الله تعالى وإلا فلن تجديهم حيلة أخرى.٢٥٣
Page 316
وعلاقة هذه الآية بالتي قبلها أن الآية السابقة تقول أن الله تعالى فضلكم على أهل زمانكم، فكان
الواجب عليكم أن تكونوا عبادًا شاكرين مطيعين له، ولكنكم على عكس ذلك تلجأون إلى الحيل
للتخلص من طاعته وتحاولون استغلال هذه الفضيلة لخداع من لا يعرفون.وَ إِذْ نَجَّيْنَاكُم منْ آل فرعونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي
ذَلِكُم بَلاءُ مِنْ رَبِّكُم عَظِيمٌ ) (٥٠)
شرح الكلمات:
آل الآل هم
الأهل والقوم (الأقرب).وقيل: الآل مقلوب من الأهل.(المفردات).وأهل الرجل: عشيرته
وذوو قرباه؛ زوجته وأهل نبي أمته وأهل بيت ساكنوه وأهل الأمر: أصحاب الحكم والسلطان
(الأقرب).هناك فرق بين الأهل والآل فقالوا: إن الآل حُصَّ بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات
ودون الأزمنة والأمكنة، يقال آل فلان ولا يقال آل الرجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا، ولا يقال
آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف الأفضل، فيقال آل الله وآل السلطان والأهل يضاف إلى الكل يقال:
أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا (المفردات).فمعنى "آل فرعون" أي قوم
فرعون.فرعون: لقب كل من ملك مصر في زمن قدماء المصريين، ويطلقه البعض على كل عات متكبر متمرد،
وجمعه فراعنة فرعن الرجل كان ذا دهاء ومكر.تفرعن فلان طغى وتجبر.وتفرعن النبات: طال
وقوي.ويقال للتمساح فرعون.(الأقرب).فكأن هذا الاسم أطلق على الملوك القدامى المصريين لشدة
ذكائهم وبأسهم وسلطانهم.يسومونكم: سام فلانا الأمر: كلفه أياه.وأكثر ما يُستعمل في الشر والعذاب.سام البائع السلعة:
عرضها وذكر ثمنها.سامه خسفًا أولاه إياه وأراده عليه.(الأقرب).والسَّوم: الذهاب في ابتغاء الشيء،
فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء، وأُجْرِيَ محرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي
سائمة، ومجرى الابتغاء في قولهم: سُمْتُ كذا قال : يسومونكم سوء العذاب (المفردات).وسامه:
ألزمه وجشمه (التاج).فمعنى: يسومونكم سوء العذاب أنهم كانوا يعذبونكم عذابًا شديدًا، أو كانوا يريدون أن يعذبوكم
عذابًا شديدًا.٢٥٤
Page 317
يذبحون ذبح : شقَّ؛ حنق؛ نحر (الأقرب).الذبح قطعُ الحلقوم (اللسان).الذبح: الهلاك (التاج).والمراد
به في الآية القتل أو الخنق.يستحيون استحياه أبقاه حيًا، وقال اللحياني : استبقاه و لم يقتله (اللسان).بلاء: بلوت الرجل بلاء وبلوا وابتليته: اختبرته.ابتلاه الله: امتحنه، والاسم منه البلوي والبلوة والبلية
والبلاء.والبلاء يكون في الخير والشر..يقال ابتليته بلاءً حسنًا وبلاءً سيئًا.والله تعالى يبلي العبد بلاءً
حسنًا ويبليه بلاء سيئا.والبلاء: الإنعام (اللسان).وفي القرآن وبلوناهم بالحسنات والسيئات.عظيم : عظم الشيء عظمًا وعظمة: كبر.وعظم الأمر على فلان: شق وصعب (الأقرب).فمعنى عظيم:
كبير، شاق وصعب.النعم أن
التفسير :
: بهذه الآية بدأ الله تعالى يعدد النعم التي لم يزل ينعم بها على بني إسرائيل لمدة طويلة.وأول هذه
بني إسرائيل كانوا يعيشون تحت حكم الفراعنة في مصر عبيدا، فأرسل الله عبده موسى وأ
وأنجاهم
به.لقد صور كتابهم المقدس حياة العبودية التي عاشوها فقال : " ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن
يعرف يوسف.فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا.هل نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون
إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون الأرض.فجعلوا عليهم رؤساء تسخير
كي يُذلّوهم بأثقالهم.فَبنوا لفِرْعَوْنَ مَدِينَتَيْ مَخَازِنَ: فِيثُومَ، وَرَعَمْسيس.وَلَكِنْ بِحَسْبمَا أَذَلُّوهُمْ هكَذَا
نَمَوْا وَامْتَدُّوا، فَاحْتَشَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف وَمَرَّرُوا حياتهم بعبود
قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل.كل عملهم الذي عملوه بواستطهم عنفا." (خروج ١:
(12-A
ودية
قوله تعالى : يذبحون أبناء كم كان رعمسيس الثاني، الذي ولد موسى في زمنه، شديد العداوة لبني
إسرائيل، فأمر بقتل أبنائهم خوفا من ازدهارهم، ولكنه لم يفلح في خطته تماما لإشفاق القابلات على
المواليد فأمر أخيرًا أن يطرح أبناؤهم دون البنات في النهر.(خروج ١: ٢٢).وتوجد مثل هذه الروايات في التلمود كما ورد في الإنجيل: " فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا
حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا " (أعمال:١٨).لقد انخدع البعض من كلمة "يذبحون" في الآية فظنوا أن القرآن يقول بأن المصريين كانوا يخنقون مواليد
بني إسرائيل مع أن التاريخ يقول بغير ذلك.وأوقعهم في هذا الوهم كون الخنق من معاني الذبح، وغفلوا
عن المعنى الآخر وهو الهلاك كما بينا في شرح الكلمات.فالمعنى الحقيقي أنهم كانوا يهلكون المواليد بأي
٢٥٥
Page 318
طريقة كانت.وقد وضح القرآن هذا المعنى في موضع آخر حيث قال: يقتلون أبناءكم] (الأعراف:.(٤٢
وقوله تعالى: [ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي في نجاتكم من هذا الكرب إنعام من
ترتبت على هذه النجاة سلسلة من نعم عظيمة أخرى.الله كبير، إذ
وَإِذ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ فَأنجيناكم وأغرقنا عَالَ فِرعَونَ وَأَنتُم تَنظُرُونَ) (٥١)
شرح الكلمات:
فرقنا : فرقنا بكم البحر أي فلقناه (الأقرب).تنظرون نظره ونظر إليه : أبصره وتأمله بعينه نظره مد طرفه إليه رآه أو لم يره.نظر في الأمر نظرا:
تدبره وتفكر فيه يقدره ويقيسه نظر بين الناس: حكم وفصل دعاواهم.ونظر للقوم: رثى لهم وأعانهم.نظر الشيء: انتظره.يقال داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها (الأقرب).فمعنى [وأنتم تنظرون]:.۱
كنتم تشاهدون آل فرعون وهم يغرقون.كنتم تحكمون عند غرق آل فرعون أنهم على الباطل وأنكم على الحق.كنتم تشفقون على آل فرعون عند غرقهم وتقولون في أنفسكم ليتهم لم يرتكبوا الشر ولم
يلقوا هذا المصير..{
كنتم تنتظرون هلاكهم.كنتم بمقابل آل فرعون عند غرقهم.هذا
التفسير قوله تعالى: [وإذ فرقنا بكم البحر] يعني لفظيًا : عندما شققنا البحر بواسطتكم، وبسبب
المعنى لحرف الباء انخدع معظم المفسرين، وفسروا الآية أن بني إسرائيل كانوا ذريعة لفلق البحر.أُمروا
بخوض البحر..فكانوا كلما تقدّموا فيه تراجع الماء على جانبهم.ولكن هذا المعنى باطل لقوله تعالى
في موضع آخر: [فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود
العظيم ] (الشعراء: (٦٤.يتبين من ذلك أن بني إسرائيل لم يكونوا سببًا في انفلاق البحر، وإنما كانت
العصا
هي
السبب الظاهري فيما جرى.فما معنى حرف الباء" هنا إذا؟ والجواب أن حرف الباء يفيد أيضًا التعليل والسببية.فالمعنى: أننا فرّقنا
لأجلكم البحر..أي لنجاتكم، أو بعبارة أخرى فرقنا لكم البحر.(البحر المحيط والكشاف)
٢٥٦
Page 319
وقوله تعالى إشارة إلى معجزة أظهرها الله لموسى عندما كان يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الشام،
وطاردهم فرعون مع جنوده لإعادتهم.وقد ورد في التوراة: "ومد موسى يده على البحر، فأجرى الرب
البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء.فدخل بنو إسرائيل وسط البحر على
اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم.وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم..جميع خيل فرعون
ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر.وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في
عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين، وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة.فقال
المصريون : نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم.فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر
الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم فمد موسى يده على البحر.فرجع البحر عند إقبال
الصبح إلى حاله الدائمة والمصريون هاربون إلى لقائه فدفع الرب المصريون إلى وسط البحر.فرجع الماء
وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر.لم يبق منهم ولا واحد.وأما
بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم.فخلص الرب
"
في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين.ونظر إسرائيل المصريين أموات على شاطئ البحر.ورأى إسرائيل
الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين.فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى
(خروج ١٤: ٢١-٣١)
لقد وردت هذه القصة في القرآن الكريم في مواضع أخرى أيضًا..فجاء قوله: [فأوحينا إلى موسى أن
اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ] (الشعراء: ٦٤ ) ، وجاء أيضًا: [ولقد أوحينا
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسا.لا تخاف دركًا ولا تخشى { فأتبعهم
إلى موسى
فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى (طه: ۷۸ - ۸۰).بالجمع بين هذه الآيات كلها تبدو تفاصيل الحادثة كما يلي: كان بنو إسرائيل سائرين يريدون الأرض
المقدسة.وعندما لحق بهم فرعون بجيشه أصابهم الهلع وظنوا أنهم مدركون ولكن الله تعالى طمأنهم بأن
أوحى إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه ففعل فتراجع الماء على الجانبين وظهر لهم طريق في البحر
وتقدموا فيه، وكان الماء يمتد على الجانبين، فيتراءى لهم مرتفعًا كالتلال.وتبعهم فرعون وجنوده
يطاردونهم.ولما وصل بنو إسرائيل إلى الجانب الآخر سالمين تراجع الماء مرة أخرى وأغرق المصريون.ولفهم هذا الحادث يجب أن نتذكر أن القرآن الكريم يعلمنا بأن كل المعجزات تكون من الله تعالى، ولا
دخل ولا تصرف للإنسان فيها فكان ضرب موسى البحر بعصاه بمثابة علامة لا غير، وليس معناه أنه
كان لموسى أو لعصاه أي دخل في تراجع ماء البحر.كما يجب أن نتذكر أيضا أنه لا يثبت أبدا من
ألفاظ القرآن أن البحر انشق إلى جزئين منفصلين وأن موسى مر بينهما.ولقد عبر القرآن عن
هذا
٢٥٧
Page 320
الحادث بكلمتين: "الفرق" و"الانفلاق" ومعناهما: "الانفصال".فكأن ماء البحر انفصل مبتعدا عن
اليابسة عند مرور بني إسرائيل، فظهرت الأرض، ومرّوا عليها.وتحدث هذه الظاهرة على شواطئ البحر.المد
فقد ورد في كتاب حياة نابليون أنه عندما غزا مصر مرّ مع بعض جنوده على شاطئ البحر الأحمر وقت
الجزر، وبينما كان هذا الموضع جاء وقت
يعبر
وارتفع الماء وتمكن هو وجنوده من النجاة بصعوبة.والمعجزة في هذا الحادث هي أن الله تعالى أتى ببني إسرائيل إزاء البحر في وقت الجزر ، وما أن رفع
موسى يده بالعصا لضرب البحر حتى بدأ الجزر وتراجع الماء.وعندما دخل فرعون مع جنوده البحر
وقعت لهم من العوائق غير العادية أثناء العبور ما قلل سرعتهم كثيرًا، وكانوا لا يزالون في وسط البحر
عندما أدركهم المدّ فغرقوا.وهذا ما يؤيده وصف القرآن للحادث بقوله: [فكان كل فرق كالطود
العظيم..أي عندما تراجع ماء البحر كان كل جزء منه كالتل الرملي المرتفع.فلو كان القرآن يريد
القول بأن البحر قد انشق جزئين لما استخدم كلمة "كل" التي تدخل على نكرة مفردة.فلفظ "كل" تبين
أن البحر لم ينشق إلى قسمين وإنما تراجع الماء عن أماكنه..كما يحدث في البحار التي توجد على
جوانبها حفر ومنخفضات، فتبقى ممتلئة بالماء وقت الجزر.وهذا ما حدث وقتها هناك.كان على جانب
بني إسرائيل بحر من ناحية، ومن ناحية أخرى تلك البحيرات الصغيرة والحفر الممتلئة ماء.وكما هي
ظاهرة طبيعية..تبدو هذه المساحات المائية لمن يمر بينها كأنها تلال من الماء.ويتبين من خريطة خليج
توجد على شواطئه العديد من البحيرات التي كانت أكثر عددًا في الماضي كما تدل على
أنه
السويس
ذلك الخرائط القديمة.موسی
العليا عبر
بعد ذكر معنى الآية من وجهة نظري أرى من المناسب ذكر ما رآه المفسرون السابقون.يرى هؤلاء أن
النيل، ويضيفون أن النهر انشق من اثني عشر موضعًا.ويستدلون على هذا بقوله تعالى:
فكان كل فرق كالطود العظيم.ويرون أنه انشق هكذا لتعبر قبائل بني إسرائيل الاثنتا عشرة كل على
حدة.ويبالغون في هذه القصة إلى قول أنه كان هناك حاجز من الماء يفصل بين كل قبيلة وأخرى،
ورفضت القبائل العبور ما لم تر كل واحدة منها الأخرى.فدعا موسى ربه، فأمره أن يدخل عصاه في
جدار الماء ففعل.فحدثت ثقوب في الحاجز حتى سمع ورأى منها بعضهم بعضًا (الكشاف).وكأن الماء
قد تجمد بحيث يبقى الثقب على حاله وكأن عصا موسى طالت حتى شقت بضربة واحدة كل الحواجز
الاثني عشر التي مرت بينها بنو إسرائيل!! و لم يلق أحد من المفسرين الضوء على سبب إنشاء طريق لكل
قبيلة على حدة، مع أنهم على هذا الحب الشديد الذي جعلهم لا يرتاحون إلا برؤية بعضهم البعض، و لم
يطمئنوا للعبور مع وجود موسى بصحبتهم؟ لماذا لم يستطيعوا العبور جميعا عن طريق واحد؟!
٢٥٨
Page 321
إن المفسرين وقعوا في خطأ خطير ظنًا منهم أن الماء الذي عبره موسى مع قومه هو ماء النيل، ولكن
الأحداث لا تثبت ذلك.فكما يتبين من التاريخ والآثار القديمة كان سكان العاصمة في زمن موسى
الع وإلى زمننا هذا يقيمون على الجانب الشرقي من النيل لا الغربي منه انظر الخريطة)؛ يتبين من هذه
الخريطة بوضوح أن أرض كنعان التي قصدها موسى وقومه تقع إلى الشمال الشرقي من النيل.وكانت
عاصمة الفراعنة في منطقة (جوشن) وتسمى أيضًا (وادي الثميلات) (موسوعة الكتاب المقدس، تحت
كلمة رعمسيس وهذا الوادي يقع في الشرق من النيل، وكل من يسافر إلى كنعان من هناك لا يعبر
النيل.وبما أنه لا يقع أي نهر بين عاصمة مصر القديمة وبين قادس التي وصل إليها موسى مع بني إسرائيل،
فلزم أن يكون المكان الذي عبره موسى وقومه بحرا أو جزءا كبيرًا فكل هذه القصص التي ذكرها
المفسرون لغو لا يصدقه القرآن الكريم.إنه يستعمل كلمة البحر ،واليم وكلمة (اليم) وإن كانت تطلق
على النهر أيضًا إلا أنها أكثر استعمالاً في البحر أو البحيرة المالحة.ولا يقع بين موطن بني إسرائيل في
مصر وبين كنعان إلا البحر أو البحيرات المنشقة منه، وليس هناك نهر جار.فالمكان الذي عبره موسى إما
هو بحر أو شرم منه.فكما ذكرت من قبل، انطلق فرعون مطاردًا بني إسرائيل بعد خروجهم من موطنهم بيوم على الأقل،
ولذلك سبقوه إلى ساحل البحر حيث كان الجَزْرُ قد بدأ.ثم لما لمحوا جيش فرعون قريبا منهم دخلوا
الطريق الخالي من الماء وقطعوا معظمه.ولما وصل فرعون إلى الساحل اندفع بجيشه وراءهم مع مركباته.وتسببت الأرض الرخوة في تأخير مسيرة فرعون إذ غاصت مركباته فيه وتعطلت.ولقد استغرق ذلك
وقتًا طويلا تمكن بنو إسرائيل أثناءه من الخروج من المنطقة، وخلفوا جيش فرعون وراءهم.وفاجأ المد
جيش فرعون وزاد في ارتباكه فلم يستطع أن يتقدم أو يتأخر.وفي النهاية أغرق الماء معظم جيشه معه.وبسبب اندفاع الماء خرجت جثثهم على الساحل فيما بعد.وقد أسلفت الرد على من يسأل : إذا كان موسى قد استفاد من ظاهرة المد والجزر، فأين المعجزة؟ وقلت
أن الله تعالى أتى به عند ساحل البحر في وقت بداية الجزر.أن المعجزة هي
وهنا ينشأ سؤال: لماذا لم يطاردهم فرعون سالكًا طريق البر اليابس بدلاً من الدخول وراءهم في هذا
الطريق الذي ظهر داخل الساحة المائية؟ والجواب أن بني إسرائيل عبروا على الأغلب من مكان قريب من
مدينة السويس يضيق فيه البحر إلى ثلثي ميل تقريبًا (موسوعة الكتاب المقدس.أما المنطقة الشمالية منها
فتكثر بها البحيرات والأرض الرخوة المتحركة الخطيرة.وقد توجه موسى إليها أول الأمر، ثم تركها
لخطورتها ووعورتها، ونزل إلى المكان الذي عبر منه.ويقول الكتاب المقدس: "وكان لما أطلق فرعون
الشعب أن الله تعالى لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال: لئلا يندم الشعب
٢٥٩
Page 322
إذا رأى حربًا ويرجعوا إلى مصر.فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف" (خروج: ۷: ۱۷- ۱۸).فلو اتجه فرعون إلى طريق البر لكان عليه أن يدور حول البحيرات شمالاً، ولكان بنو إسرائيل أثناء ذلك
قد أفلتوا منه بمسافة بعيدة وخرجوا من مملكته.ولذلك لم ير سبيلاً للحاق بهم إلا أن
يتبع خطاهم في
طريق البحر (راجع سفر الخروج ١٣ و ١٤ ، لتجد صورة إجمالية لخروج بني إسرائيل من مصر، وإن كان
يتضمن كثيرًا من الأخطاء والمبالغات).من
من أين عبر بنو إسرائيل؟ هذا موضوع يتناوله الباحثون الجدد فيرى بعضهم أن موسى عبر من قرب
بحيرة التمساح اعتمادًا على ورود ذكر نهر في التوراة..وأنها كانت متصلة بالبحر عن طريق قناة في زمن
سابق (موسوعة الكتاب المقدس، خروج).ويرى البعض الآخر أنهم لم يمروا قرب بحر القلزوم بل مروا
بالقرب من "زوآن" قريبا من البحر المتوسط (المرجع السابق.ويرى غيرهم أنهم لم يكونوا يعيشون في
مصر الأفريقية، وإنما عاشوا في "مصر" الواقعة في شمال الجزيرة العربية.ويرون أن بني إسرائيل أخطأوا
وكتبوا في التوراة "مصر" (نفس المرجع).وبحسب هذا الرأي، لو أنهم عبروا بحرا فعلاً لكان الشرق
إلى الغرب لا العكس، ولم يعبروا خليج السويس وإنما عبروا خليج العقبة.وإذا اعتبرنا موقع مصر التي في
الجزيرة العربية لوجدناها أبعد إلى الشمال ومن ثم لم يعبروا أي بحر، وتكون قصة العبور كلها مختلقة.ويتأكد من بحث الآثار والتواريخ القديمة أنه كانت هناك عدة مناطق تسمى "مصر" وكانت تقع في شمال
إفريقيا وجنوب الشام وشمال الجزيرة العربية، بل كانت هناك أماكن أخرى تسمى مصر أو مصران أو
مصرام أو مصرايم أو.مصرى.وبسبب ذلك عندما وجد هؤلاء الباحثون بعض ما ورد في التفاصيل عن
حادثة الخروج في التوراة لا ينطبق على مصر الإفريقية قالوا أنها وقعت في مصر التي بالجزيرة العربية،
ويحتجون على رأيهم بذهاب موسى إلى مدين، لأن مدين تقع قرب حدود مصر الجزيرة العربية.وإطلاق اسم مصر على عدة مناطق قد يُعَدّ عجيبًا لدى الكتاب الغربيين، ولكنه ليس كذلك عند العلماء
الذين يعرفون اللغة العربية، لأن كلمة "مصر" تعني في اللغة بلدًا أو مدينة.ويعرف اللذين عاشوا في مدن
كبيرة أو زاروها أن من يعيشون حول هذه المدن يشيرون إليها باسم "مصر" بدلاً من ذكر اسمها، فمثلاً
يقول أهل الريف عند زيارتهم للقاهرة أنهم ذهبوا إلى مصر.فلا عجب إذا أطلق العرب أو من لهم لغة
تشبه العربية اسم مصر على منطقة فيها بلدان كبيرة سواء كانت في الشام أو في الجزيرة العربية أو في
أفريقيا..وذلك في زمن لم توجد فيه مدن كبيرة.وما كان مرادهم من كلمة مصر أو مصرام وغيرهما إلا
أنها منطقة فيها بلدان وكان العيش في المدن أعجوبة عند قوم من أهل البادية كالعرب، وكانت المناطق
التي تكثر فيها المدن أمرًا محيرًا لهم، ولذلك كان من الطبيعي أن يطلقوا عليها اسم مصر أو أمصار أو ما
٢٦٠
Page 323
شابه ذلك.فلا يمكن الاحتجاج بكلمة "مصر" وحدها على أن أحداث خروج بني إسرائيل وقعت في
مصر من هذه الأمصار وليس مصر الأفريقية.إذًا، فبسبب اختلافاتهم في جزئيات الطريق الذي مرَّ منه بنو إسرائيل لا نستطيع أن نصرف النظر عن
المسألة الأساسية..وهي اتفاق القرآن الكريم والتوراة على أن ملوك مصر التي خرج منها بنو إسرائيل
كانوا يسمون فراعنة، وكانوا يحنطون جثث موتاهم، وهذا ينطبق على مصر الأفريقية وحدها.هذا، وتاريخ الأزمنة القديمة ليس محفوظًا بحيث نستطيع معرفة تفاصيله معرفة صحيحة مائة بالمائة.فعلينا
أن نتخذ ذلك الاتفاق الذي بلغ من الصحة سبعين بالمائة مثلا ونترك الاختلاف الذي ينحصر في الثلاثين
بالمائة المتبقية، ولا نرتكب حماقة فعل العكس.وهناك البعض الذين يحاولون أن يثبتوا من شهادة التاريخ السلبية أو الإيجابية أن بني إسرائيل لم يدخلوا
مصر ولم يعيشوا فيها أصلاً.ويُبنى استدلالهم على الأمور التالية:.1
عدم ذكر بني إسرائيل في الآثار المصرية القديمة.يتبين من أثر يعود إلى زمن الملك منفتاح - الذي يقال إن موسى أخرج بني إسرائيل من مصر
في عهده – أن بعض قبائل بني إسرائيل كانوا يعيشون في كنعان في العام الخامس من عهده.وتقول
التوراة إنهم خرجوا من مصر في عهده ودخلوا كنعان بعد حوالي خمسين سنة.صحيح
أن الآثار المصرية تذكر مجيء بعض القبائل الآسيوية إلى مصر، ولكننا إذا طبقنا هذه
الأحداث على بني إسرائيل تطابقت الأحداث ولم تتوافق التواريخ، وإذا توافقت التواريخ لم تطابق
الأحداث.فثبت أن كل القصة مختلقة.ولما كان القرآن الكريم يذكر دخول بني إسرائيل في مصر وخروجهم منها فلا بد لنا من الرد على هذه
النظريات، فنقول:
:أولاً : ليس ضروريا أن يعرف كل شيء بالآثار القديمة.فلو بادت أمة متقدمة من هذا الزمن المتحضر..فهل يمكن معرفة تفاصيل تاريخهم الكامل: عددهم وعاداتهم وعلومهم وفنونهم ودياناتهم ومذاهبهم..من
دراسة آثار مدينة أو مدينتين منها؟ فإن لم يكن ذلك ممكنا..فما أسخف الظن بأنه بالحفر والتنقيب في
بلد أو بلدين يمكن معرفة تفاصيل دقيقة كاملة عن أحوال أمة مضت منذ آلاف السنين! إنه أمر مخالف
للعقل، ولو بنينا عليه علما لكان ذلك استهزاء بالعلم نفسه إن الحصول على الشهادة الأثرية الإيجابية ذو
قيمة بلا شك وإن كان فيها احتمال خطأ كبير، ولكن القول بأن قوما لم يعيشوا في مكان لأننا لم نعثر
بعد على آثار لهم لقول خاطئ وخلاف العقل.كان الواجب على هؤلاء الكتاب تجنب ذكر ذلك في
كتبهم العلمية.أي وزن كان لبني إسرائيل في مصر؟ كانوا يعيشون عبيدا، ولم تعهد إليهم مسئوليات
٢٦١
Page 324
ذات قيمة حتى يكون لهم ذكر في الآثار التاريخية.وأبرز ما كان يميزهم هو دينهم المختلف عن دين
المصريين.وربما لم يكن حكام مصر في ذلك الوقت مصريين خالصين، ولذلك كانوا يخشون تآمر بني
إسرائيل مع الأعداء ضدهم.وفي مثل هذه الظروف لم يكن هناك داع لذكر اسم بني إسرائيل في الآثار
التاريخية.وإن كان لهم هناك ذكر فإن الآثار لا تعطي إلا نتفا من التاريخ وليس كل التاريخ.فسكوتها
عن ذكرهم لا يكون دليلاً على عدم مكوث بني إسرائيل في مصر.ثانيا: أما قولهم بوجود أثر فرعوني من زمن منفتاح أو ملك قبله يدل على أن بني إسرائيل وقتها كانوا
يعيشون في كنعان..فذلك قول لا وزن له أيضًا، لأن هذا الأثر الذي لم يتعين تاريخه، إذا كان من زمن
ما بعد يوسف وما قبل خروج موسى، فإنه يعني فقط أن جزءا من بني إسرائيل كان قد هاجر إلى كنعان
قبل خروج موسى إلى مصر، وأما إذا كان من زمن ما قبل يوسف أو ما بعد خروج موسى فهذا لا
يشكل دليلا خلاف ما نقول.ثالثا : أما قولهم بأنه مما لا شك فيه أن بعض الشعوب الآسيوية ورد ذكرهم في تاريخ مصر ولكنه لا
ينهض سببًا لاعتبارهم بني إسرائيل، فهو دليل سلبي محض.والدليل السلبي القائم على آثار ناقصة ليس
دليلاً، ومثله كمثل من يدعي بعدم وجود موضوع ما في كتاب ضاعت منه نصف صفحاته.فربما كان
الموضوع مذكورًا في الصفحات الضائعة.والآن أقدم أدلة قياسية على عيش بني إسرائيل في مصر:.1
يعترف هؤلاء المنكرون أنفسهم بأن اسم موسى موجود في اللغة المصرية القديمة.فيرون أن
أصل كلمة "موسي" هو "موسي" ومعناه الابن.( موسى والتوحيد، سيجمدون فرويد).وإذا كانت
هذه دعوى صحيحة فقد ثبت أن بني إسرائيل عاشوا في مصر الأفريقية، وطال عيشهم هناك حتى
تسمّوا بالأسماء المصرية.وهؤلاء يدعون أيضًا أن أسماء بعض أصحاب موسى –مثل حور التي وردت
في التوراة أسماء مصرية؛ ولو صح هذا لكان دليلاً أيضًا على عيش بني إسرائيل في مصر
خروجهم منها.أنهم
٢ لا تقول التوراة بأن آباء الإسرائيليين كانوا ملوكًا وحكامًا في مصر حتى نقول عنهم
اختلقوا هذه القصة تعظيمًا لشأنهم، وإنما تذكر أنهم عاشوا فيها عبيدا مضطهدين، فلا نجد سببًا
لتلفيق مثل هذه القصة.تفصيلات التوراة عن هذا الحادث تصدق كلها على مصر الأفريقية، منها ذكر الفراعنة،
وأسماء بعض ملوكهم التي أكدتها الآثار، وأسماء بعض الأماكن الواقعة في مصر والتي كانت آثارها قد
٢٦٢
Page 325
اندثرت جغرافيًا بصفة عامة، ولكن الحفريات الحديثة كشفت عن وجودها، وقوانين الفراعنة وآدابهم
ومخازن الغلال.وقد أكدت الآثار على صدق هذه التفاصيل الواردة في التوراة.ولنذكر ضمنًا أن القرآن الكريم قد ألقى الضوء على عقيدة المصريين باتصاف ملوكهم بصفات الإله.وقد تأكد هذا الأمر أيضًا باكتشافات الآثار المصرية القديمة.تؤكد كل هذه الآثار بوجود علاقة عميقة بين إسرائيل ومصر في ذلك الزمن.وأما ما يثار اليوم من
شبهات فسببها أن القائلين بها يريدون أن تكون كل هذه التفصيلات متطابقة تماما مع ما وجدوه من
معلومات من الاكتشافات الأثرية الناقصة أو في كتب التاريخ الناقصة وهذه مطالبة مخالفة للعقل..{
وكذلك يتضح من التاريخ اليوناني القديم أن المصريين كانوا يتحدثون بخروج بني إسرائيل من
مصر.ولكن هذه الروايات اليونانية خالية ومشوهة للحقائق أيضا، كمثل قولها أن بني إسرائيل كانوا
أولاد المصريين المصابين بالجذام، عاشوا معزولين عن سائر الناس بسبب مرضهم، وكانوا ينكرون آلهة
المصريين، فثاروا على المصريين فطردوهم.وقد ذكر هذه الروايات المؤرخ "أبديرا" المعاصر للإسكندر
الأكبر، والمؤرخ "منيثو" من هيلوبوليس (إسرائيل، لأدولف لودز).ولا شك أن هذه الروايات تخالف ما جاء في التوراة مخالفة تامة، ولكننا نتساءل لماذا قالها المصريون إن
كان بنو إسرائيل لم يعيشوا في مصر ولم يخرجوا منها؟ وأما سبب الاختلاف بين هذه الروايات وما ورد
في التوراة فهو أن المصريين كانوا أعداء للإسرائيليين، وهلك ملكهم مقهوراً ذليلاً أمام موسى، فقالوا أن
بني إسرائيل كانوا مرضى بالجذام، وطردناهم من بلادنا.فالتوراة والقرآن يبينان أن بني إسرائيل كانوا ذهبوا إلى مصر وخرجوا من هناك بعون الله تعالى ونصرته.وهذا هو الحق الواضح.وبعد ان تبين أن المراد بكلمة "مصر" هي مصر الأفريقية المعروفة فقد ثبت أن بني إسرائيل خرجوا من
مصر قاصدين كنعان أما التساؤل عما إذا كان طريق خروجهم من الجنوب أو الوسط أو الشمال فهذا
لا يحمل أهمية كبيرة من وجهة النظر الدينية ولكن فيما يتعلق بالبحث المتوافر وظاهرة المد والجزر
المذكورة في القرآن والتوراة فالأقرب إلى العقل أنهم اتجهوا من عاصمة مصر وقتئذ، وهي عند موقع تل
أبي سفيان، بادئين أولاً من الوسط أي إلى بحيرة التمساح الأقرب إلى كنعان، ولما اعترضت البحيرات
طريقهم اتجهوا إلى الجنوب وعبروا إلى سيناء من البحر في وقت الجزر قريبا من مدينة السويس، ومن
هناك اتجهوا إلى قادس.ويتبين من قوله تعالى: [وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أن المكان الذي عبر منه بنو إسرائيل البحر
كان قليل الاتساع، ولولا ذلك ما استطاعوا مشاهدة غرق آل فرعون في وسط البحر من الجانب الآخر.٢٦٣
Page 326
وقد سبقت الإشارة إلى أن عرض خليج السويس في أقصى شماله يبلغ حوالي ثلثي ميل.وإذا اعتبرنا أن
آل فرعون غرقوا في منتصف هذه المسافة مثلاً، فمعنى ذلك أن الإسرائيليين كانوا يشاهدون منظر غرقهم
واقفين على بعد أو ٦٠٠ متر.ويبدو أن فرعون وبعض حاشيته ما كانوا يعرفون السباحة، أو أن
الوقت كان مساءً، وخيّم الظلام، فضلوا الطريق وتخبطوا في المياه ودخلوا المياه العميقة فغرقوا.وحدث
نفس الشيء مع نابليون في الواقعة التي ذكرناها من قبل..فقد حل عليهم المساء عندما دخلوا في الطريق
اليابس الذي كشفه تراجع الماء وقت الجزر، وكانوا لا يزالون يسيرون فيه عندما جاء المد.ولما كانت
هناك كثير من البرك الصغيرة في الأرض اليابسة اتصل ماء البحر بماء البرك، ولم يستطيعوا أن يحددوا
الجهة المقصودة.فخافوا أن يتجهوا إلى المياه العميقة بدلاً من الشاطئ فغرقوا.عندئذ أمر نابليون زملاءه
أن يتقدّموا في الاتجاهات الأربعة على شكل علامة "+"، فإذا صادف فريق منهم الماء العميق حذر رفاقه
وارتدوا في الاتجاه الآخر.وهكذا تلمسوا طريقهم حتى خرجوا إلى الشاطئ ولما وصل نابليون إلى بر
الأمان استلقى على الرمال وقال بطريقة عفوية: لو غرقت اليوم لأثار العالم المسيحي كله ضجة وقال:
ها قد غرق فرعون آخر في البحر.وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظَالمونَ) (٥٢)
التفسير : تذكر هذه الآية إحسانًا إلهيًا آخر تنكر له بنو إسرائيل في زمن موسى العليا، و لم يألوا جهدًا
في تبديله من إحسان إلى عذاب.أمر الله تعالى موسى أن يخلو للعبادة في جبل كان في طريقهم إلى
كنعان، ويتلقى بعض توجيهات منه تعالى فذهب إلى الجبل.ولكن بني إسرائيل أحسوا بعد أيام أن
غيبته طالت عليهم وظنوا أنه مات أو تعرض لمكروه.فصنعوا تمثال عجل من حلي كانت معهم،
وقالوا هذا إلهنا، وعكفوا على عبادته.وأخبر الله تعالى موسى بما فعل قومه وأمره أن يسرع إليهم.وتذكر التوراة هذه الواقعة فتقول: "وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهوا
وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد ويتقرب موسى وحده إلى الرب وهم لا يتقربون.وأما الشعب فلا يصعد معهم....وأما الشيوخ فقال موسى لهم اجلسوا لنا ههنا حتى نرجع إليكم.وهُوَذا هارون وحورُ معكم، فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما..ودخل موسى في وسط
السحاب وصعد إلى الجبل.وكان موسى في الجبل أربعين نهارًا وأربعين ليلة" (خروج: ٢٤).وجاء في موضع آخر: "ولما رأى الشعب أن أبطأ في الترول من الجبل اجتمع الشعب على
هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا
نعلم ماذا أصابه.فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني
موسی
٢٦٤
Page 327
بها.فترع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون.فأخذ ذلك
مسبو
من
أيديهم
عجلا
وصوره بالإزميل وصنعه
مصر.فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدًا عيد الرب، فبكروا في الغد
وأصعدوا محروقات وقدموا ذبائح سلامة.وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعيد" (خروج
ا.فقالوا: هذه آلهتكم يا إسرائيل التي أصعدتكم من أرض
١:٣٢ إلى ٦).يتضح من هذه العبارات أن التوراة تروي أن الله تعالى أمر موسى أن يقضي بعض الأيام في الجبل.وقبل
أن يصعد موسى إلى الجبل أمر بني إسرائيل أن يطيعوا هارون وحور فترة غيابه.وبعد أيام ظن بنو
إسرائيل أن موسى قد مات فلم يرجع إليهم، وطلبوا من هارون أن يصنع لهم صنما.فلبى طلبهم وجمع
منهم حليهم وصنع لهم عجلاً.فقدموا له القرابين والأضاحي بمساعدة من هارون.ولقد ذكر القرآن هذا
الحادث في قوله تعالى : [ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمّ ميقاتُ ربه أربعين ليلة] (سورة
الأعراف : ١٤٣).ثم أضاف: [ واتخذ قوم موسى من بعده حُليهم عجلاً جسدًا له خوار.ألم يروا أنه لا
يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً.اتخذوه وكانوا ظالمين] (الأعراف: ١٤٩).وقال أيضا: ولقد قال لهم
هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري {} قالوا لن نبرح عليه
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى (سورة طه : ٩١ و ٩٢).وقد وجه هارون الله أنظار بني إسرائيل بقوله:
وإن ربكم الرحمن إلى أن الله تعالى برحمته الواسعة يتزل كلامه لهداية الناس..ولكن أي هدى
يعطيكم هذا العجل؟
هناك فرق كبير بين بيان التوراة والقرآن الكريم؛ فأولاً يبين القرآن سبب قلق بني إسرائيل، ويذكر أن
موسى كان قد أُمر في البداية بالخلوة على الجبل لمدة ثلاثين ليلة ولا بد أنه يكون قد أخبر قومه بهذه
المدة، ثم زاد الله تعالى عشر ليال أخرى تكميلاً للإحسان إلى موسى، إذ إن عدد الأربعين يدل على
الكمال في العالم الروحاني، وبسبب هذه الزيادة في الليالي أصاب قومه القلق، ولعل بعضهم ظن أنه قد
مات، أو خذلهم هروبا من تحمّل مشاق السفر ومخاوف الطريق.ونظرًا لحداثة عهدهم بالإيمان تأثروا بمن
حولهم من الأقوام الوثنية وصنعوا صنما يعبدونه.ولكن التوراة لا تبين سبب ما أصابهم من قلق.وثانيا: يصرح القرآن أن هارون لم يقع في هذا الشرك، وإنما هم الذين ارتكبوه، وحاول هارون
بكل جهد منعهم منه.أما التوراة فهي لا تكتفي بتوريط هارون النبي في هذا العمل الوثني، بل تقول إنه
قبل طلبهم بلا تردد، و لم يصنع العجل لهم فحسب، وإنما حرّضهم ودعاهم إلى عبادته.فلا حول ولا قوة
إلا بالله ! إن رواية التوراة هذه مخالفة للمنطق بحيث لا يمكن أن يقبلها أي عاقل ولا للحظة واحدة..لأن
معنى ما تقوله التوراة أن النبي الذي تعود على سماع كلام الله تعالى أله تمثالاً بلا حياة، لا يضر ولا ينفع،
Page 328
وعبده بنفسه وحث قومه على عبادته ومن يقبل مثل هذا الهراء السخيف سوى قساوسة النصارى
وأحبار اليهود..الذين ختموا بالرصاص على آذان عقولهم لتصديق كل ما ورد في أسفارهم من رطب
ويابس؟! ويبدو أن السامري الذي صنع هذا التمثال كان مشركًا بقلبه، وكان حريصا على أن يرتد بنو
إسرائيل إلى حمأة الشرك، ولعله كان صائغا فصاغ بنفسه أو مستعينًا بمن على شاكلته من الصائغين تمثالاً
عاديًا.ويعترض البعض بأن الله تعالى واعد موسى ثلاثين ليلة في البداية ثم جعلها أربعين، وهذا إخلاف للوعد.ومثال هذا الاعتراض كأن يعدك شخص بأن يعطيك ثلاثين درهما فيزيدها إلى أربعين.فهل هذا إخلاف
للوعد؟ إن كلام الله تعالى نعمة عظمة، وقد أتم هذه النعمة بأربعين ليلة بدلاً من ثلاثين.وإتمام النعمة لا
يعد إخلافًا للوعد، بل هو إحسان وإنعام.:
) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٥٣)
شرح الكلمات:
تم راجع شرح الكلمات للآية رقم ٢٩.عفونا: عفا عنه وله ذنبه وعفا عن ذنبه: صفح عنه وترك عقوبته وهو يستحقها وأعرض عن مؤاخذته.عفا الله عن فلان محا ذنوبه عفا عن الشيء: أمسك عنه وتتره عن طلبه (الأقرب).تشكرون شكره وشكر له أثنى عليه بما أولاه من المعروف (الأقرب).التفسير: يتضح من التوراة أن الله غضب على بني إسرائيل عندما اتخذوا العجل إلها وقال لموسى: (رأيت
هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة.فالآن اتركني ليحمى غضبي
ليحمى غضبي عليهم وأُفنيهم)
(خروج ١٠:٣٢)..وتقول أيضًا فتضرع موسى أمام الرب...فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله
بشعبه" (المرجع السابق (۱٤۱۱) أي لم يعاقبهم بل عفا عنهم.قوله تعالى: [ثم عفونا عنكم يعني أن عفوه تعالى كان عن عقوبة استحقوها كشعب، ولكن كبار
المجرمين نالوا العقاب الفردي و لم يعف عنهم.فالجرائم القومية على شقين: شق يتعلق بالقوم ككل،
وشق يتعلق بأفراد من القوم.هناك أناس يقومون بالدور الأكبر في الجرائم القومية.وهناك من يشارك
بنصيب أقل.ومنهم من لا يشارك فيها بجهده وإن كان مع المجرمين بقلبه ولسانه، وهناك من لا يشترك
بلسانه ولكن قلبه معهم.ثم هناك من ينساقون للمشاركة في الجريمة وقلوبهم غير مطمئنة إليها..وإنما
يشتركون فيها عن جُبن.والبعض لا يشتركون في العمل ولكنهم يؤيدونه بلسانهم فقط وقلوبهم منكرة
٢٦٦
Page 329
له.ثم منهم من لا يشترك فيه لا بالعمل ولا باللسان ولا بالقلب..ولكنهم لا يقاومونه ويسكتون عليه.وهناك أيضا من يكتفون بإبداء عدم الرضا عن الجريمة بلسانهم دون مقاومة جادة.كل هؤلاء يكونون
شركاء في العقوبة القومية، ولكن عند العقوبة الفردية يُعاقب كل شخص بحسب دوره.ويشير قوله:
[عفونا عنكم] إلى رفع العقوبة القومية عنهم نتيجة دعاء موسى ال، ولا يشير إلى رفع العقوبات
الفردية التي استحقها كبار المجرمين، إذ يتبين بعد آيتين أنهم عوقبوا قوله تعالى : [لعلكم تشكرون] يعني
أننا أسدينا إليكم هذا الفضل لكي تقدّروا رحمتنا الواسعة حق قدرها فتنتفعوا بها على الدوام.وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) (٥٤)
شرح
الكلمات :
الفرقان: فَرَق بينهما فُرقانًا فصل أبعاضهما.فَرَق لفلان أمرٌ أو رأي: تبين واتضح.فرق له عن الشيء:
بينه والفرقان: القرآن الكريم؛ كل ما فرق به بين الحق والباطل؛ النصر ؛ البرهان؛ الصبح أو السحر؛
انفراق البحر (أي انشقاقه)؛ التوراة؛ وقعة بدر (الأقرب).المعنى الأصلي للفرقان هو كل ما فُرِّق به بين
الحق والباطل، ولكن أهل اللغة ذكروا القرآن الكريم والتوراة وانفراق البحر ووقعة بدر كمعان للفرقان
على وجه الاستنباط، إذ ليست معاني لغوية للكلمة.لقد أوردوها لأن كلاً منها ميزت بين الحق
والباطل.تهتدون اهتدى الفرسُ الخيل: سار في أوائلها (الأقرب).فمعنى تهتدون أي لكي تسبقوا الناس وتكونوا
أئمة لهم راجع أيضا شرح الكلمات في سورة الفاتحة).التفسير: ذكر ضمنًا في هذه الآية ما أعطي موسى في الأربعين ليلة: كنا نعمل كل هذا لهداية بني
إسرائيل ولازدهارهم، ولكنهم اشتغلوا بعبادة العجل معرضين عن إله حي محسن.هذا التباين بين فعل
الله تعالى وفعل بني إسرائيل يبرز جريمتهم بجلاء بحيث من المحال ألا يتأثر منه أي إنسان عاقل.قوله تعالى: [لعلكم تهتدون إشارة إلى أننا كنا نعمل لهديكم وكنتم تعملون لضلالكم.فالكتاب
والفرقان اللذان أُوتيهما موسى على الجبل كان الغرض منهما أن يتحول الإيمان الإجمالي لدى بني
إسرائيل إلى إيمان تفصيلي ولكنهم أضاعوا في تلك الإيام ما كان بهم من إيمان ووقعوا في الشرك.سيدنا
العلمية لا
موسی
ورد اسم موسى أول مرة في القرآن الكريم في هذه الآية، لذلك يجمل بنا هنا أن نذكر أمورًا عنه.يتبين
من القرآن الكريم أن موسى كان من بني إسرائيل، وكان الحلقة الأولى من سلسلة النبوة في بني إسرائيل
٢٦٧
Page 330
التي
كان
عیسی الية الحلقة الأخيرة منها.جاء في القرآن أن الملأ من قوم فرعون قالوا له: أتذر موسى
وقومه ليفسدوا في الأرض] (الأعراف: ۱۲۸).وعلاوة على ذلك ورد في القرآن الكريم في أكثر من
عشرة مواضع أن بني إسرائيل هم قوم موسى ويمكن أن يكون المراد من القوم هنا هم المؤمنون به،
ولكن القرآن يبين أن موسى لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل، فلا بد أن يكون المؤمنون به بني إسرائيل
أنفسهم إلا ما شد وندر.ثم هناك آية أخرى توضح تماما معنى القوم..قال الله تعالى: [فما آمن لموسى
إلا ذرية من قومه] (يونس:٨٤).فالقوم هنا هم بنو إسرائيل في كل حال.وهناك من الباحثين الجدد
الذين يحاولون إثبات أن موسى لم يكن من بني إسرائيل بل كان من أصل مصري، ويستدلون على ذلك
بما يلي:
الأول: موسى اسم مصري، فيقال باللغة المصرية (موسى) للطفل.يقول برستود (Breasted): "توجد
لدى المصريين القدامى أسماء مثل آمن (موسى) و (بتاموسى) ومعناهما طفل آمون وطفل بتا.وآمون وبتا
إلهان من آلهة "المصريين" كتاب فجر الضمير Dawn of Conscience)
ويقول بروفسور سيجموند فرويد S.Freud: "وعلاوة على هذه الأسماء هناك أسماء مشابهة لها للملوك
المصريين مثل آه ،موسی ثُت ،موسی رع موسى موسى والتوحيد Moses&Monotheism).موسى" (موسى
ورع موسى هو الذي تذكره التوراة باسم ( رعمسيس) و (رع) هو إله الشمس عند المصريين.فمعنى
رع موسى الطفل الذي وهبه إله الشمس ويقول هؤلاء أن الأسماء التي مع كلمة موسى سقطت وبقي
اسم (موسى) فقط.الثاني: ويدعون أيضا أن التوحيد لم يكن معروفًا في القبائل الكنعانية، وإنما أسس عقيدة التوحيد أحد
ملوك مصر اسمه (أمنحتب الرابع).كان يعبد إلا يسميه (أتون) وأمر الناس بعبادته.وأُطلق اسم أتون في
الكتب القديمة على إله الشمس ويقال إنه كان هناك في هليوبوليس معبد كبير لإله الشمس يزاولون فيه
عبادته.وكان هناك كثير من العباد الذين يحملون أفكارًا فلسفية فبدأوا بالتدريج يسبغون على إله
الشمس صفة أخلاقية بدلاً من صفته المادية.ثم خلع عليه أمنحتب صبغة الألوهية وروّج له في مصر.وينقلون عنه قوله: أيها الإله الوحيد الفريد..لا إله سواك.وقد ذكر ذلك أيضًا (برستد) في كتابه (تاريخ
مصر History of Egypt) ويستدلون من قوله هذا على أنه كان مؤسس فكرة التوحيد، وأشاعها
بالإكراه في البلاد، وأمر بهدم معابد الآلهة الأخرى.ولما كان أمنحتب اسما وثنيًا استبدله باسم (أخناتون)
وبذلك نسب نفسه إلى الإله الواحد (أتون).الثالث: روّج موسى في بني إسرائيل عادة الختان وهي عادة مصرية، فثبت بذلك أن موسى كان مصريًا.٢٦٨
Page 331
الرابع:
لا
يوجد في تعاليم الملك المصري إخناتون ذكر البعث بعد الموت، وكذلك لا يوجد في تعاليم
موسى ذكره.الخامس كان المصريون يكرهون الخترير، وفي تعاليم موسى أيضا كراهية الخنزير.السادس : ورد عن موسى الله أنه كان لا يجيد النطق للتعبير عن أفكاره، وهذا يدل على كونه مصري
العليا
الأصل و لم يكن يجيد الحديث بالعبرانية.بهذه الأفكار يستدلون على أن موسى كان مصري الأصل، وأنه كان من أتباع فكر أمنحتب.ويقولون:
عادت الديانة المصرية الوثنية بعد موت (إخناتون) وحل الشرك محل التوحيد وعندما لم ير موسى
إمكانية نشر دين إخناتون الداعي إلى التوحيد بين المصريين اتجه إلى قوم بني إسرائيل غير المصريين الذين
كانوا هدفًا دائما لاضطهادهم.وكان من السهل عليه صرفهم عن العقائد المصرية بسبب كراهيتهم
لهؤلاء.وتقبل بنو إسرائيل دينه بسرعة، وعندما لم يعد لهم مكان في مصر بسبب اعتناقهم الدين الموسوي
هاجروا منها مع موسى إلى كنعان.والرد على هذه الأدلة بإيجاز :
دليلهم الأول:
قولهم إن موسى اسم مصري فلا بد وأن يكون سيدنا موسى مصري الأصل..قول سخيف.كان بنو
إسرائيل يعيشون في مصر عبيدا محكومين لذلك كان لا بد أن يتأثروا من حضارة المصريين وعاداتهم.وهذه ظاهرة مألوفة في الشعوب التي استُعمرت.لقد حكم الإنجليز بلادًا كثيرة، فتسمى العديد أهلها
من
بأسمائهم مثل إدوارد وجورج وفكتوريا وغيرها.فهل يحق لمؤرخ أن يستدل بهذه الأسماء أن هؤلاء من
أصل إنجليزي.يجب أن يقوم الاستدلال على منطق عميق ودراسة واعية للأحوال بنظرة واعية.وإني
لأتعجب كيف يميل هؤلاء المؤرخون الغربيون إلى استنباط هذه النتائج بسطحية وعجلة هكذا.هناك
آلاف الأمثلة كهذه الأسماء التي أخذتها الشعوب المغلوبة من المستعمرين، وإذا كان لا يحق لهم الحكم
على قوميتهم من مجرد الأسماء فكيف يحق لهم استنادًا إلى اسم موسى الجزم بأنه كان مصريًا.إذا كان
اسم (موسى) اسما مصريًا فقد سماه أبواه أو غيرهما بذلك تأثراً بالمصريين...فأي غرابة في هذا! وخاصة
أن القرآن والتوراة يذكران أن أم موسى وضعت وليدها وهو صغير في صندوق بأمر من الله تعالى وألقته
في النهر خوفًا من اضطهاد ،فرعون فعثرت عليه امرأة من الأسرة الملكية الفرعونية وقامت بتربيته.ولما
كانوا لا يعرفون له اسما فليس ببعيد أنهم سموه باسم مصري ودعوه موسى.ولو افترضنا في ضوء
الحادث بأن موسى اسم مصري فلا يحق لنا أيضًا الاستدلال على أن موسى كان مصري الأصل.ومن ثم
فاستنتاجهم هذا استنتاج واه وضعيف للغاية لا يؤبه له.هذا
٢٦٩
Page 332
بين
الحلفاء
تقول التوراة عن هذا الحادث فحبلت المرأة وولدت ابنا.ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر.ولما لم
يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له سفطًا من البردي وطلته بالحمر والزفت ، ووضعت الولد فيه.ووضعته
على حافة النهر.ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به فتزلت ابنه فرعون إلى النهر
لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر.فرأت السفط بين الحلفاء، فأرسلت أمتها وأخذته.ولما فتحته رأت الولد وإذا صبي يبكي فرّقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين.فقالت أخته لابنة
فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيين لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون:
اذهبي.فذهبت الفتاة ودعت أم.الولد.فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي
أجرتك.فأخذت المرأة الولد وأرضعته.ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون، فصار لها ابنا، ودعت
اسمه موسى، وقالت إني انتشله من الماء (خروج ٢:٢ إلى ١٠).وقد ذكر القرآن هذا الحادث في قوله تعالى: [وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في
اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين } فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا
وحَزَنا.إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك.لا تقتلوه
أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا.وهم لا يشعرون ] (القصص: ٨ إلى ١٠).ويشار إلى حادثة الإلقاء في
النهر في موضع آخر حيث يقول: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم) (طه: ٤٠).يتبين مما ورد في القرآن والتوراة أن امرأة من بيت فرعون أخذت موسى
التوراة أن هذه المرأة كانت بنت ،فرعون وهى التي سمته.وإذا كانت
عسى
يكون اسما مصريًا.هي
طفلاً رضيعا وربته.وتقول
سمته فمن الطبيعي أن
التي
ومع كل ذلك فلا أرى أنهم قدموا دليلاً كافيًا على كون (موسى) اسما مصري الأصل، لا عبرانيا.فهؤلاء يستدلون بأسماء مصرية كانت تتكون من جزئين أو أكثر أحدهما (موسى)، ولكننا نرى علماء
الألسنة قد اختلفوا في ذلك، وليس منهم واحد ذكر بأن نُطق الكلمة المصرية هو كنطق (موسى)
بالعبرانية، وإنما قرأوها (موسى) أو (مَيْس) أو (مَيْسُو) ومعناها الطفل، وتستخدم منفردة أو متصلة باسم
آخر.فقد ورد في الأسماء الملكية المصرية التالية: (تحتمس أحمس، رغميسو)..وكما هو ظاهر، هناك
بون شاسع بين نطق هذه الأسماء ونطق كلمة موسى.ذلك بالإضافة إلى أن ابنة فرعون، بحسب قول التوراة نادت الطفل باسم (موسى) قائلة: لأني انتشلته
من الماء.ولكننا لا نجد في اللغة المصرية كلمة مثل كلمة موسى تعني معنى الانتشال الماء.هناك
نعم
من
في العبرانية كلمة تعطي معنى مشابها لذلك مثل كلمة (موشي) التي تتركب من مقطعين: (مو) ومعناه
ماء، (شي) ومعناه شيء.والمعروف أن العبرانية والعربية لغتان متشابهتان بل إن العبرانية أصلها العربية.۲۷۰
Page 333
فيكون معنى كلمة (موشي) شيء مائي، أي الولد الذي انتشل من الماء، وانقلبت هذه الكلمة في العربية
إلى موسى، كما هو الحال في كلمتي (عيسى وإسماعيل وأصلهما العبري (يشوع ويشمائيل).وهذه
فصل
قرينة قوية على أن موسى عبراني الأصل، وأن رواية الكتاب المقدس في هذا الصدد ضعيفة.ثم إنه ليس مما يتفق مع العقل أن يمكث الطفل كل هذه السنين عند أمه ثم لا تسميه باسم من عندها.أرى أن أم موسى عندما أخذته من امرأة فرعون للرضاعة سمته (موشي) نظراً لنجاته من الغرق في الماء..ليذكرها هذا الاسم بالمعجزة الإلهية التي وقعت لها.ويبدو أنها حينما عادت به إلى بيت فرعون أخبرتهم
باسمه هذا وبينت لهم سبب هذه التسمية، فأعجبهم قولها ووافقوا عليه.وهذا هو البيان الأقرب إلى الواقع
والصواب، وخاصة لأنه ليس في اللغة المصرية كلمة مثل موشي بمعنى (ما انتشل من الماء).ثم إذا ألقينا نظرة على اللغة العربية بخصوص هذا الاسم وجدنا أنه يعني بالعربية (المقطوع) إيماء إلى أنه
من أسرته وتربى عند آل فرعون.كما أن لفظ "موشى" يعني في العربية الشيء المنتشل، حيث
يقال: أوشى الشيء: استخرجه.واسم الفاعل منه هو "موشي"، واسم المفعول هو "موسى"، فالمراد من
موشى: المنتشل.وهذا المعنى يطابق قول بنت فرعون الوارد في التوراة (لأنني انتشلته من الماء).فعندي أن
لفظ (موسى) كان في الأصل (مُوشَى) وينطق في العبرانية (مَوْشَى)، ومعناه الأصلي (من انتشل أو
استُخرج).والعجيب أن هؤلاء الباحثين المعاصرين يريدون إثبات أن بني إسرائيل لم يدخلوا مصر ولم يخرجوا منها
من ناحية، ومن ناحية أخرى يقولون : إن بني إسرائيل ذهبوا إلى مصر وأن كبيرهم موسى
الأصل وأن دينه كان دينا مصريًا.بهذا التعارض يمكن أن يدرك الإنسان ضعف أساس أقوالهم.الحق أن
هؤلاء القوم قاموا فعلاً ببعض التحقيقات الجيدة، ولكن أفسدهم شوقهم إلى تعميم النتائج التي يتوصلون
إليها في مسألة معينة على المسائل الأخرى كلها.وهذا يوقعهم في العثار.ومثلهم كمثل الذي يصنع إناء
من الطين ثم يتباهى بأنه صنع العالم كله إن صنع الإناء عمل جيد، ولكن لا يعني هذا أنه صار بذلك
صانعا للعالم كله.ولو لم يقع هؤلاء في سوء الفهم هذا لكان لتحقيقاتهم وزن أكبر كثيرًا.كان مصري
دليلهم الثاني:
قالوا: إن فكرة التوحيد مصرية الأصل لذا فموسى كان مصريًا.ونرد على ذلك بأنه لا يمكن القول بأن
فكرة معينة لا تنشأ إلا في ذهن شعب واحد فقط، وإلا فلا بد من التسليم بأن كل هذا الرقي العلمي في
العالم لم ينشأ سوى في خمسة رؤوس أو ستة من الناس، وأن سائر الخلق قد أخذوا عنهم.وهذا باطل
بالبداهة.هنالك أشخاص كثيرون في شتى مناطق العالم قاموا في صورة منفردة، بالتفكر فيما حولهم من
أحوال وأشياء، وتوصلوا إلى نتائج مشابهة ويحصل هذا التوارد بين أفكار مئات الناس في مختلف
۲۷۱
Page 334
الأقطار الفكرة الأساسية واحدة بشيء من التنوع الذي يحصل بسبب تعدد وتنوع البيئات في مختلف
الأمصار.وكذلك مسألة التوحيد لا يمكن القول بأنها نشأت في قلوب أهل قطر واحد.فالمشاهد عمليًا
أن كثيرًا من المسائل العملية قد بحثت في وقت واحد وفي بلاد مختلفة دون أن يرى أحد بما يقوم به.الآخرون ووصلوا إلى نتائج متشابهة؛ و لم يدعي أحد أن هناك سرقة علمية، ولكن قالوا أنه توارد أفكار.لذا لا القول بأن
يصح بأن فكرة التوحيد نشأت عند المصريين ولا يمكن أن تنشأ عند غيرهم، وأن موسى
مصري لأنه نشر التوحيد.ثم لو سلمنا جدلاً بصحة قولهم، فهل من السنن الكونية أن الفكرة المصرية لا ينشرها إلا المصري؟ هل
من المحال أن يقبلها إسرائيلي وينشرها في قومه؟
الله
سة نفس
كانت
هذا الرد من حيث النقد العلمي المحض، وإلا فإن موسى لم يذكر قط أنه مخترع فكرة التوحيد، كما لا
يقول بذلك الإسلام.فكل الأديان متفقة على أن الأنبياء لا ينشرون أفكارهم وإنما ينشرون وحي
تعالى، وأن فكرة التوحيد هي من تعليم الله للناس بالوحي منذ بداية العالم.إذا كان الله تعالى واحدًا، و لم
يزل منذ البداية يترل ،وحيه فمن البديهي أنه سيقول لكل نبي بأنه ،واحد، ومن المحال أن يوحي
لأنبيائه
السابقين بتعدد الآلهة، ثم يقول لإخناتون أنه واحد.لقد انخدع هؤلاء بسبب عدم فهمهم للوحي
وحقيقته.إن الدين إنما يتأسس على الوحي، وإذا لم يكن قائمًا على الوحي فلن يكون إلا وسوس
وهراء، وتكون شخصية موسى لا قيمة لها سواء كانت من المصريين أو بني إسرائيل أو غيرهم.عظمة موسى وأهميته بما نزل عليه من وحي إلهي.وإذا سلّمنا بالوحي الإلهي فلا بد من الاعتراف أن
التوحيد كان العنصر الأعظم من تعاليم جميع الأنبياء.وما كان الله تعالى لينتظر ظهور أمنحتب
(إخناتون) لإظهار وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى.نجد القرآن الكريم يقول لأهل مكة إن جدكم إبراهيم كان موحدًا وأنه كان قبل موسى بلا شك.ورغم
أن أهل مكة كانوا مشركين، لكنهم لم يجرؤوا على إنكار ما يقوله القرآن، حيث لا نجد واقعة واحدة في
التاريخ أنهم قالوا ولو كذبا أن إبراهيم كان مشركا مثلهم.وهذه شهادة تاريخية بأن قريشا الذين
كانوا يعيشون بعيدا عن بني إسرائيل وكانوا يعتبرون أنفسهم من نسل إبراهيم، يقرون بإن إبراهيم الة
كان موحدا.فإذا كان موسى كما يقولون قد تعلم التوحيد من أمنحتب المصري فمن علم إبراهيم
التوحيد؟ فادعاؤهم ليس صحيحا إطلاقًا، بل الواقع أن التاريخ يخبرنا بأن فكرة التوحيد كانت موجودة
منذ الزمن القديم، لأن الوحي الإلهي قد حفظ بذرة التوحيد حية في كل أنحاء الدنيا.فليس الشرك هو
الذي ولّد التوحيد، وإنما جاء الشرك بعد التوحيد في زمن الضلال والانحطاط.دليلهم الثالث:
۲۷۲
Page 335
قالوا إن عادة الختان مصرية..ولما كان موسى يُعلم بني إسرائيل الختان فثبت أنه كان مصريًا.هذا الاستدلال خاطئ حتى لو افترضنا أن الختان كان من عادات المصريين، أفلا يمكن أن نقول إن بني
إسرائيل قد أخذوه تأثراً بالبيئة المصرية أيام إقامتهم الطويلة في مصر؟
ثم إنه من
الخطأ القول بأن الختان كان شائعًا عند المصريين وحدهم.تقول التوراة إن الله تعالى قد شرع
الختان لإبراهيم الذي مضى قبل موسى ببضعة قرون.فقام بختان نفسه وأولاده وأوصاهم به.والدليل
على صدق ما جاء في التوراة بهذا الصدد هو أن الختان كان موجودًا لدى العرب الذين لم يكونوا على
علاقات اجتماعية مع بني إسرائيل، والذين لم يذهبوا إلى مصر قط، والذين يقولون إن هذه العادة جاءتهم
عن طريق جدهم إبراهيم وابنه إسماعيل.ويمكن أن يقول هؤلاء الباحثون العصريون أن المصري
علم بني إسرائيل الختان، ثم نسب هؤلاء هذه العادة إلى جدهم ،إبراهيم، ولكن ماذا سيقولون عن العرب
الذين لم يكن لهم بعادات بني إسرائيل اهتمام ولا يربطهم بموسى تعاطف، بل كانوا يشعرون بالنفور نحو
بني إسرائيل لكونهم إخوة من أُمَّيْن ضُرتين.فوجود الختان فيهم وعزوهم إياه إلى إبراهيم وإسماعيل
(عليهما السلام) يدل على أن هذه العادة جاءتهم عن طريقهما.موسی
والختان في العرب لم يزل موجودًا منذ زمن طويل، وقد شهد على ذلك المؤرخ (فلاس تارجي ٣٤٢
ق.م) (الموسوعة البريطانية.إلا أن الشهادة الكبرى هي الشهادة القومية للعرب سواء كانوا مسلمين أو
غير مسلمين.كما تقول الموسوعة اليهودية إن الختان كان ولا يزال موجودًا في أمم أخرى علاوة على المسلمين
واليهود، مثل نصارى الحبشة والقبائل الإفريقية الوحشية التي عدد من يختتن منها أكثر ممن لا يختتن.وكذلك كانت قبائل وسط أستراليا القديمة تقوم بالختان، ولم يكن يربطها بمصر صلة.Tribes of)
Central Australia
By Spencer & Gellen)
كذلك كان الختان موجودًا في سكان القارة الأمريكية كلها (الموسوعة اليهودية.وإذا كان كل هؤلاء
الشعوب يختتنون، فلماذا لا نقبل بوجود الختان في الإسرائيليين قبل موسى العلي.إن أقدم ثبوت للختان في مصر هو في الجثة المحنطة للملك المصري أمننحب Amen-en-heb
، ١٥٥٥:١٦14 ق.م) (الموسوعة اليهودية)، وهو زمن ما بعد هجرة يوسف العليا وأسرته إلى مصر.وهذا يثبت أن أقدم ثبوت للختان في مصر كان قبل موسى بقرنين، ويمكن أن نستنتج من هذا بسهولة
بأن يوسف كان يحظى بقرب خاص لدى الملوك المصريين، وبتوجيه منه أخذ الملوك وحاشيتهم من
الأمراء وغيرهم بالختان.ويرى علماء الآثار المصرية أن الختان كان شائعًا على العموم بين الملوك وكهنة
المعابد.۲۷۳
Page 336
دليلهم الرابع:
دین
أمنحتب لا يذكر البعث بعد الموت وكذلك دين موسى فثبت أن موسى مصري في هذا الدليل
عيبان كبيران: الأول: إن دين أمنحتب ليس معروفًا كله.فلم يترك كتابا ولا جماعة من أتباعه، وإذا كان
ترك كتابًا فليس موجودًا.فكيف يُجزم بأن دينه لم يتضمن هذا التعليم؟
والثاني: لم يثبت هؤلاء الباحثون عدم ذكر البعث بعد الموت في تعاليم موسى، مع أن تعاليمه والأنبياء
التابعين له تتضمن ذكر الحياة بعد الموت.ورد في التوراة أن الله تعالى قال لموسى: (مت في الجبل الذي
تصعد إليه، وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل هورضم إلى قومه) (تثنية ٥:٣٢).وكذلك يقول داود لربه: (نج نفسي من الشرير بسيفك، من الناس بيدك، يا رب، من أهل الدنيا.نصيبهم في حياتهم.بذخائرك تملأ بطونهم.يشبعون أولادًا ويتركون فضالتهم لأطفالهم.أما أنا فبالبر أنظر
وجهك.أشبع إذا استيقظت بشبهك) (مزامير ١٣:١٧ إلى ١٥).لا شك أن التوراة لم تذكر مسألة البعث بعد الموت بالقوة التي ذكرها دين زرادشت أو دين الإسلام أو
دين الهندوس، ولكن هذا يرجع إلى ميل اليهود إلى الدنيا ميلاً شديدًا.فعندما اندرست التوراة بحوادث
الزمن وجمعها اليهود مرة أخرى وجهوا كل اهتمامهم إلى جمع الأنباء التي تتعلق بالازدهار الدنيوي، و لم
يبالوا بجمع أمور خارجة عن اهتمامهم هذا فاختفت من كتبهم أشياء كثيرة منها مسألة البعث بعد
الموت أيضًا، ومع ذلك يوجد ذكره في التوراة والأسفار النبوية الأخرى كما أسلفت.دليلهم الخامس:
إن الخترير حرام عند بني إسرائيل وكذلك الحال عند المصريين.هذا الاستدلال ناتج عن عدم العلم.ليس صحيحًا أن المصريين كانوا يحرمون أكل الخترير، وكل ما
نعرفه من التاريخ المصري القديم أنهم كانوا لا يأكلون لحمه كثيرًا، ولكن ليس هناك دليل على تحريمه
عندهم (موسوعة الكتاب المقدس).بل إن المصريين كانوا يربون الخنازير.فورد أن (رني) الكاهن في
معبد (إلكاب) كان في حظائره ثلاثمائة خترير.ويقول (هيرودتس) أن المصريين كانوا يقدمون قرابين
الخنازير باسم الإلهين (ساليني Salene) ديونيسس Dionysus) أو (أوزريس Osiris).وكذلك
ذكر أنه كان على مقبرة (بماهيري Paheri) - الملك المصري من الأسرة الثامنة عشر - رسومات
خنازير.(موسوعة الكتاب المقدس.وكذلك قال البورفسور (أدولف لودز Adolph Lod) الأستاذ بجامعة السوربون في باريس:
(كان المصريون لا يأكلون لحم الخترير عادة، ولكنهم في الليلة الرابعة عشرة من شهور معينة كانوا
٢٧٤
Page 337
يقدمون قرابين الخترير في معابد (ساليني وديونيسس).وكان الكهنة يأكلون لحمه) (إسرائيل للبروفسور
لودز).كذلك ورد في موسوعة الكتاب المقدس أن السكان في آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا كانوا يعظمون
الخترير تعظيمًا خاصًا.وكذلك يقول بروفسور لودز : (كان الخترير حيوانًا مقدسًا لدى الكثير من جيران
بني إسرائيل، وكانوا يظنون أنه مقدس عند الرب.وكان أيضًا مقدسًا عند أهل بابل والسوريين حتى
سمى هؤلاء شهر تموز ختريرو) (المرجع السابق).فلست وحدي الذي يرى أن الخترير كان يلقى تقديرًا عند المصريين القدامى، بل تؤكد هذه المراجع
أيضًا أنهم كانوا يتجنبون أكل الخنزير لا عن كراهة بل تقديسًا له.أما اليهود فكانوا يكرهونه باعتباره
نجسا كما تذكر التوراة.فحرمة الختزير عند المصريين وبني إسرائيل لا تدل على كون موسى مصريًا.دليلهم السادس:
إن موسى لم يكن يجيد النطق بلسان بني إسرائيل لأنه كان مصري الأصل.وفيما يتعلق بعدم طلاقته فهذا صحيح وتقره التوراة والقرآن قالت التوراة فالآن هلم فأرسلك إلى
فرعون فتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر.فقال موسى الله من أنا حتى أذهب إلى فرعون حتى أخرج
بني إسرائيل من مصر) (خروج ۳ : ۱۰ و ۱۱).ثم بعد بعض توجيهات إلهية إلى موسى: (قال موسى
للرب : استمع أيها السيد: لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت
عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان.فقال له الرب : من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو
بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهَب وأنا أكون مع فمك.أعلمك ما تتكلم به) (خروج ٤:
١٠ إلى ١٢).وورد في القرآن الكريم [ و إذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالمين ) قوم فرعون ألا يتقون قال
رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون (الشعراء: ١١
إلى ١٤).يتبين مما يذكره القرآن أنه كان هناك شيء من الثقل بلسان موسى، لذلك رجا ربه أن يكلف هارون
بهذه المهمة.ويتضح أيضًا من التوراة أنه اعتذر إلى الله تعالى بثقل لسانه عندما أُمر بالذهاب إلى فرعون
ودعوته إلى الحق.الآن أمامنا خياران اثنان فإما أن نفسر هذا الاعتذار بأنه كان بلسان موسى
لكنة أو
كان عنده ضعف في الأعصاب بحيث إذا تحمس في النقاش لم يستطع التعبير عما في نفسه بوضوح، أو
كان يتعثر في نطق بعض الحروف والكلمات؛ وإما أن نفسر اعتذاره بأنه كان لا يحسن الكلام بلغة قوم
أمر بتبليغ الحق إليهم.فإذا أخذنا بالخيار الأول لبطل تماما استدلالهم بأنه كان مصريا؛ لأن لكنة اللسان
۲۷۵
Page 338
أو غيرها ليس خصوصية للمصريين، بل يمكن وجود هذا العيب في أي قوم آخرين.وإذا أخذنا بالخيار
الثاني لكان أيضًا دليلاً قاطعًا على أن موسى لم يكن مصري الأصل لأن التوراة والقرآن يقولان أيضا أن
موسى اعتذر بعدم انطلاق لسانه في الكلام عندما أُمر بالتبليغ إلى المصريين..أي أنه لا يجيد لغة
المصريين.فقد ثبت من كل هذه الأدلة أن موسى لم يكن مصري الأصل، بل كان من بني إسرائيل كما
العليا
تقول التوراة والقرآن الكريم.الكتاب
أما قول الله تعالى (وآتينا موسى الكتاب، فيعني أننا أعطينا موسى على الجبل بعض الأحكام والوصايا،
لأن معنى الكتاب هو الفرائض كما جاء في شرح الكلمات.لقد اعترض القسيس (ويري) في تفسيره لهذه الآية وقال إنه أحد الأمثلة العديدة الواردة في سورة البقرة
التي تكشف عن جهل محمد الله بتاريخ اليهود يقول القرآن إن موسى أوتي التوراة على الجبل، مع أن
التوراة تقول أنه أوتي هناك فقط عشر وصايا في لوحين من الألواح.أرى أن القسيس (ويري) أولاً يُحسن الظن بالتوراة أكثر مما تستحق، وثانيًا يُكن عداوة للقرآن تحول بينه
وبين التدبر فيه، ويرى أنَّ الاعتراض على القرآن كاف لنجاته في الآخرة.ونظرته إلى التوراة على أنها
صحيحة في هذا البيان بدون شهادة خارجية لنظرة تخالف المنطق السليم؛ فلقد قام كتاب النصارى
أنفسهم بتحريف أبواب وأبواب من التوراة بحيث لا يمكن تصديقها اليوم في أي شيء بدون شهادة
خارجية.يقول القسيس أن موسى أوتي الألواح على الطور، والقرآن يقول غير ذلك..فثبت أن هذا
قول كتاب كاذب من تأليف إنسان جاهل بالحقائق التاريخية (والعياذ بالله).من
ولقد نسي
القسيس (ويري) ما سبقت الإشارة إليه من أن إخوانه المحققين النصارى يرون أن ما ورد في
التوراة عن موسى وبني إسرائيل ودخولهم إلى مصر وخروجهم منها وغيرها من الأحداث لا أساس لها
الصحة؛ بل إنهم ينكرون وجود جبل الطور الذي تقول عنه التوراة أن موسى تلقى الألواح عنده.ومنهم من اختلف في تعيين موقعه بين مصر والشام وبلاد العرب.ورغم تلك البيانات التوراتية المجروحة
تاريخيا فإن القسيس يرمي محمد الله بالجهل بها !! والحق أن قوله هذا إنما يدل على جهله هو الفاضح
بحقيقة التوراة وبما نُشر عنها من بحوث علمية مستفيضة بأقلام النصارى أنفسهم.والدليل على ما يُكنّه هذا القسيس من تعصب شديد ضد القرآن أن القرآن لم يذكر قط أن كل التوراة
نزلت عند الطور، بل ذكر، كما تقول التوراة وكما يقول القسيس، بأن ما نزل هنالك إنما كان بعض
٢٧٦
Page 339
أحكام وألواح قال الله تعالى: [ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شئ فخُذها
بقوة وأمر قومك يأخُذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين] (الأعراف ١٤٦)
وتبين هذه الآيات أن الله تعالى أعطى موسى الألواح الطور، ولكن لا يقول القرآن فيها، كما لا
تدعي التوراة، أن موسى لم يُغط هناك شيئًا مع الألواح.إن ما أغطيه موسى عليه السلام على الجبل –
في أثناء انشغال بني إسرائيل بعبادة العجل - مذكور في سفر الخروج في الإصحاحات من ٢٠ إلى ٣١،
ولا داعي لذكرها كلها هنا وإنما نورد مضامينها بإيجاز شديد!
* في الأصحاح ۲۰ ذكر للوصايا العشر التي أوتيها موسى على الجبل.* في الأصحاح ۲۱ أحكام عن العبيد، من ثقب أذنه منهم، الإماء، جرائم القتل والغدر، وسب الوالدين،
والقصاص في الجروح والإصابات من الإنسان والحيوان.* في الإصحاح ۲۲ أحكام عن السرقة، إحداث الخسائر بالغير، الودائع، القرض، الزنا، السحر، مباشرة
الحيوانات، عبادة الأصنام، تعظيم الغرباء، الأرامل، الأيتام، الربا، تعظيم الحاكم، أول الثمار والمحاصيل." في الإصحاح ۲۳ أحكام عن التهمة الشهادة الكاذبة، العدل النصح الصدقة، السبت، عبادة
الأصنام، الأعياد، دم وشحم الأضحية، الملائكة.* في الإصحاح ٢٤ ذكر ذهاب موسى إلى الجبل.*
في الإصحاح ٢٥ توجيهات عن كيفية تقديم النذور عند تعمير المعابد، صنع المائدة، هيئة تابوت العهد،
المنارة الذهبية، الشمعدان.* في الإصحاح ٢٦ ذكر لأستار المسكن، والخيمة وغطاء الصندوق والأبواب.*
في الإصحاح ٢٧ تفاصيل عن مذبح المحرقات وأسبابها، فناء المسكن، وزيت السراج والأعمدة وغيرها.* في الإصحاح ۲۸ تخصيص هارون وأبنائه للكهانة، أحكام ملابسهم وهيئتهم.*
* في الإصحاح ۲۹ تقديم المحرقات لتقديس الكهنة، وعد الله تعالى ببقائه معهم.في الإصحاح ۳۰ ذكر لصنع مذبح للبخور ، وصفات لصنع الزيت المقدس والبخور.في الإصحاح ۳۱ توجيهات عامة وذكر تسلم اللوحين.كيف نسي القسيس كل هذه التعاليم الواردة في هذه الإصحاحات الاثني عشر، وزعم أن موسى لم يُعْطَ
على الطور سوى الوصايا العشر واللوحين؟ وكيف استساغ رمي القرآن الكريم بالجهل قائلا: كيف قال
القرآن إن موسى أوتي على الطور الألواح وغيرها معها؟
أما قول القسيس بأن القرآن يقول بترول التوراة كلها على موسى عند الطور فهو قول بلا دليل، لأن
كلمة الكتاب في قوله وآتينا موسى الكتاب والفرقان] لا تعني
الكتاب والفرقان] لا تعني كل الكتاب، بل تعني بعض الكتاب.۲۷۷
Page 340
تعلوا على
والقرآن الكريم يطلق اسم الكتاب على رسالة صغيرة أيضًا، فقد ورد فيه أن سليمان كتب رسالة إلى
ملكة سبأ وقال لرسوله [اذْهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا
أيها الملأ إني أُلقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا
وأتوني مسلمين (النمل: ۲۹ (۳۲).فقد أطلق اسم الكتاب على رسالة تتضمن بضع } -٣٢).فاستنتاج القسيس من كلمة (الكتاب) بأنه التوراة كلها ليس إلا دليلاً على اندفاعه للتهجم على القرآن،
سواء أضر هذا بالحقيقة أم أفادها.الفرقان
كلمات فقط.لقد نقل القسيس (ويري) في تفسيره للقرآن عن تفسير مسيحي آخر للقرآن إن هذه الكلمة من أصل
شامي، ويبدو أن محمدا كان مطلعا على تفسير للتوراة كتبه إفرايم الشامي)، الذي استخدم في
تفسيره كلمة (الفرقان) للتوراة مرات عديدة !!
والقسيس (ويري) متفق معه على أن كلمة (الفرقان) من أصل شامي، ولكنه يعارضه في رأيه أن محمدًا
كان مطلعا على ما كتبه شخص نصراني أو شامي أو عبراني، لأن بيان القرآن للأحداث يختلف كثيرًا
عن أحداث تاريخ الكنيسة..فهو بيان ذو مصدر سماعي وليس من الكتب فقط.ومسألة اطلاع النبي ﷺ أو عدم اطلاعه على كتاب شخص نصراني شامي مسألة لا علاقة لها بهذا
الموضوع.لقد ذهب الرسول الله إلى الشام مع قافلة تجارية لبضعة أسابيع فقط.فالزعم أنه تمكن من تعلم
الشامية ودراسة كتبها فكرة لا تخطر إلا ببال إنسان مختل العقل.لقد مكث إخوان القسيس الإنجليز في
الهند زمن الاستعمار زهاء أربعين سنة وربما لم يكن منهم إلا واحد بالألف يستطيع قراءة كلمات من
اللغة المحلية.وكان معظمهم لا يستطيعون حتى التحدث بها.ورغم هذه الخبرات والمشاهدات، فالقول
بأن النبي ﷺ قد تمكن خلال بضعة أسابيع من تعلم لغة الشام بل الاطلاع على كتبها، فضلاً
أعماله
التجارية، ليكشف عن تعصب تمكن من قلوب الأقوام المسيحية ضد النبي محمد
ﷺ.أما قولهم بأن الفرقان كلمة شامية فهو أيضًا دليل على جهلهم باللغة العربية.العجيب أن هؤلاء الذين لا
يعرفون بدائيات العربية يجلسون لكتابة تفسير للقرآن الكريم وهو القمّة التي لا تدانى في كمال اللغة
وفصاحتها وجمالها!
عن
إن الفرقان كلمة عربية الأصل ولها مشتقات عديدة تكثر في حديث العرب مثل: فَرق، فرق، فارق،
أفرق، تفرّق، تفارق ،انفرق افترق فاروق ،فراق فَرْق، فرُّوق، فرقان فُرْق، فرْقَ، فَرَقٌ، فَرِيقٌ، فَرْقاءُ،
فرقة، فُروق، فريقة، أفرَقُ، تفاريق، مَفْرَق مَفْرِق ،مُفرق، مُنفَرق، ومفرق وغيرها من اشتقاقات كثيرة.۲۷۸
Page 341
وإذا كانت هذه الكلمة شامية الأصل فمن أين أتت مشتقاتها هذه؟ وإذا كانت عربية الأصل، فكيف
يصبح مصدرها شاميا؟
نعم،
كان من
الممكن اعتبارها غير عربية إذا لم يكن وزنها موجودًا في هذه اللغة؛ ولكن نجد وزن
(فعلان) مستعملاً فيها بكثرة، منها مثلاً: سبحان وهو اسم الله تعالى؛ وقرآن، وهو اسم الوحي الذي
نزل على محمد ﷺ ، ونُعمان، وهو اسم إمام الفقه أبي حنيفة؛ وكُفران، أي الكفر؛ فُقدان، أي ضياع
الشيء، وغيرها من الكلمات الكثيرة.فعلى الرغم من أن للفرقان في العربية مشتقات كثيرة، وأن وزنها
عربي، وهناك مئات الكلمات تماثلها..إذ زعم أحد أنها شامية الأصل، فزعمه دليل على جهله المطبق.وسوف أُقدّم الدليل الأكبر على كونها عربية الأصل، وأن مادتها مستخدمة في العربية استخداما تاما، أما
من
الشامية والعبرانية..وهما في الحقيقة مشتقتان من العربية..فلم تستخدماها بنفس هذه الحكمة والشأن.وجدير بنا أن نعرف أنه من خصائص اللغة العربية أن اللفظ فيها لا يدل على معنى خاص فقط، بل يشير
أيضًا إلى المعاني الأصلية للحروف التي يتكون منها.فهناك ارتباط وثيق بين المعاني التي في الكلمات
المشتقة وفي حروف مادتها وفي الكلمات التي تتشابه في مبناها.ويتضح هذا الأمثلة التالية: فكلمة
الفرقان مثلاً التي تتألف من مادة (ف) ر ق )..لها معنى خاص بها، ولكن هناك حكمة وفلسفة توجد في
كلمة الفرقان وفي كل كلمة مشتقة من مادة (ف رق)، حيث تنطوي تلك الكلمات كلها على نفس
المعنى أو ضده..لأن المخالفة في المعنى هي بمنزلة المشاركة السلبية..فعند ذكر معنى من المعاني يرد معه
المعنى المخالف تلقائيا.وهناك كثير من الكلمات في العربية تعطي المعنى وضده، فمثلاً كلمة (الظن) تعني
الشك واليقين أيضًا، وكلمة (الرجاء) تعني الأمل والخوف أيضًا.وتسمى مثل هذه الكلمات في
الاصطلاح (أضداد).وقد ألف بعض اللغويين كتبا مستقلة في موضوع الأضداد في العربية، وجمع
بعضهم في مؤلفاتهم كل ما ورد في القرآن الكريم من أضداد.خذ مثلا كلمة الفرقان المتكونة من حروف (ف رق).إذا كونا كلمات بتغيير ترتيب هذه الحروف
لتضمنت كل كلمة منها المعنى الأساسي في مادة (ف رق).فهناك كلمات فَرْق، فقر، رفق، قَفْر،
رَقْف، قَرْف..وتحمل كل واحدة معنى خاصاً بها، ولكنها أيضًا تشترك في المعنى الأساسي لحروف (ف
ر ق)، سواء كانت هذه المشاركة إيجابية أو سلبية.وهذه المشاركة تسمى في الاصطلاح العربي
(الاشتقاق الكبير).وهذا يدل على أن كلمة الفرقان عربية.فمثلاً
تعني (فرق) البعد والخوف.يقال فرقهما أي أبعد أحدهما عن الآخر، وفرق أي خاف.والخوف
يتضمن معنى البعد أيضًا، لأن الإنسان إذا خاف شيئًا فرّ وابتعد عنه والفرقان مصدر فَرَق.جاء في
قاموس أقرب الموارد، وهو من وضع عالم نصراني: فرق يفرق فرقًا وفُرقانًا.۲۷۹
Page 342
وتعني (فقر) عدم الغنى، فهي تتضمن معنى البعد لأن الفقير بعيد عن الأغنياء.والبعد ضده الوصل، وهذا
المعنى أيضًا
موجود في مادة (فقر).يقال فقر حبات العقد أي نظمها ووصلها بالخيط.وكذلك يسمى
العمود الفقري فقرات الظهر لأنها موصولة كالعقد بخيط النخاع الشوكي، ويصل بعضها بالبعض.و(قرف) تعني فصل القشر عن الفاكهة وغيرها.يقال قَرَف الجرْحَ : أزال قشره.ومعنى البعد واضح بين
هذين المثالين.ويقال قرف فلانًا: عابه.وفعل العيب يؤدي إلى التفرقة والبعد.ويقال قرف لعياله: كسب
لهم.وقرف الشيء: خلطه وقارف الذنب قاربه وهذه الأفعال تفيد الوصل.وهكذا تجمع مادة (ق ر
ف) بين معنيي الفصل والوصل.ثم (قَفَر)، يقال قَفَرَ الأثر : تتبعه واقتفاه، وتقفّر أي جمع؛ وهذا يدل على الوصل.ويقال أقفر المكان أي
خلا.والقفر الخلاء من الأرض لا ناس فيها ولا كلأ وقفار خبز بدون إدام، يقال أكل خبره قفارًا.وفي
هذه الأمثلة
معنى
و(الرفق) تعني
البعد.اللين، وهو داع إلى الوصل والاجتماع.ورَفَق الناقة ربط عضدها.والمرفق: الموصل بين
الساعد والعضد والرفيق الصاحب والرفاقة الصداقة..وكل هذه معان تفيد القرب والوصل.و(الرَّقْف) تعني الارتجاف، وسببه الخوف، وقد سبق ذكر (فَرق) أي خاف.فكل هذه الكلمات المؤلفة من حروف(ف رق) تؤدي معاني من الفصل أو الوصل.وليس هذا
الاشتراك في المعنى مقصورًا على الكلمات المؤلفة من حروف (ف رق) فحسب، بل يوجد أيضا في
كلمات قريبة منها مخرجًا.فمثلاً لو وضعنا حرف (و) مكان (ف)، أو (ل) مكان(ر)، أو (ك) مكان
(ق) لتكونت كلمات تحمل معاني قريبة من (ف رق).وعلى سبيل المثال: فلق بمعنى فرق.فإذا كانت هناك كلمة في العربية، ولها شبيه من كلمات أخرى في مبناها ومعناها، ولها جذور أصلية في
اللغة العربية، فلا يمكن أبدًا القول بأنها كلمة غير عربية مستعارة من لغة أخرى.ومن اليسير علينا، بناء
على الاشتقاق الكبير، إثبات أن كلمة فرقان ليست إلا عربية الأصل.ولكن هذا ليس كتاب لغة بل
تفسير، فلا أرى مناسبًا أن ندخل في مزيد من التفصيل.لقد أسلفت القول أن الفرقان تعني لغةً الفرق أو التمييز بين شيئين.أما معناه الاصطلاحي فقد اختلف
فيه العلماء.ذكر ابن جرير عن أبي العالية أنه فسّر الفرقان بما فرق بين الحق والباطل.وروي عن مجاهد
قوله بأنّ المراد به الكتاب ومعناه الفارق بين الحق والباطل وعن ابن عباس أن الفرقان اسم جماعي
يُطلق على القرآن والتوراة والإنجيل والزبور.وعن ابن زيد أن الفرقان أوتي لمحمد وأيضا لموسى
ال، حيث ميز الله تعالى بين المشركين والمسلمين يوم واقعة بدر، وميز بين موسى وأعدائه في حادث
6
البحر.(تفسير ابن جرير).۲۸۰
Page 343
ويقول العلامة القرطبي أن البعض فسروا قوله: [آتينا موسى الكتاب بأن الله تعالى أعطى موسى التوراة
وأعطى محمدًا الفرقان، وحذف اسم النبي ﷺ اختصارًا.ولكن هذا المعنى باطل بالبداهة.ويضيف
القرطبي بأن الذين فسروا الفرقان بالكتاب يقولون إن الفرقان توكيد للكتاب.وهذا قول الزجاج
والفراء.وفسر بعضهم الفرقان أن الله تعالى نجاهم من المصيبة، أي أخرجهم من مصر.وقال ابن بحر أن
•
معنى الفرقان الحجة والبرهان.وقال غيرهم أن الواو ،زائدة والفرقان صفة للكتاب (تفسير القرطبي).وخلاصة هذه الأقوال أن المعنى الحقيقي للفرقان هو التمييز بين الحق والباطل، ولكنهم اختلفوا في تعيين
الشيء الذي أعطاه الله تعالى لموسى تمييزا بين الحق والباطل وأرى أن اعتبار الكتاب والفرقان شيئا
واحدًا لا يستقيم نظراً لما ورد في القرآن في مواضع أخرى.قال الله تعالى: [ولقد آتينا موسى وهارون
الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين] (الأنبياء: (٤٩).وتبين هذه الآية أن الفرقان أوتي لكل من موسى
وهارون، فلا يمكن أن يكون معناه التوراة.لقد وردت كلمة الفرقان في القرآن الكريم بالمعاني التالية:
١_ القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا] (سورة
الفرقان (۲) وقال [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان]
(البقرة:١٨٦)، أي أنزل فيه القرآن فيه هداية للناس وأدلة على الهدى، وأدلةٌ ذاتُ فرقان أي مميزة بين
الحق والباطل.فالقرآن الكريم مشتمل على الفرقان.٢_النجاة من المصائب والمشاكل ؛ قال الله تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا]
(الأنفال: ٣٠).إذا تدبرنا هذه الآيات وجدنا أن معنى الفرقان في الحقيقة هو ما يميز بين الحق والباطل.وإذا كان موسى
قد أوتي فرقانًا فمعناه أنه أوتي ما يستطيع به التمييز بين أصدقائه وأعدائه، وبين الحق والباطل.وإذا كان
الرسول ﷺ قد أوتي فرقانًا فمعناه أنه أوتي ما يميز به هو وأتباعه بين الحق والباطل، ولاستطاع به مخالفوه
معرفة الحق لو أرادوا.فإذا كان الله تعالى قد وعد المؤمنين بالفرقان فمعناه أنه سيرزقهم ما يستطيعون به
معرفة طريق الخلاص من المشاكل.لذلك فلا داعي لتضيق معاني الفرقان بيوم بدر أو نجاة
بني إسرائيل
من البحر فقط.لا شك أن غزوة بدر سميت فرقانًا، وكذلك خلاص بني إسرائيل سمي فرقانًا..ولكن
ليس هذا فقط ما أوتي النبيان الكريمان عليهما السلام، بل أوتي موسى ال عشرات المعجزات، وأوتي
آلاف المعجزات علاوة على ذلك.فإذا سمى القرآن معجزةً معينة فرقانًا – كما سمى بدرا فرقانًا
النبي
سنفسر الفرقان هناك بذلك المعنى الخاص، ولكنه إذا قال (فرقانًا) على إطلاقه فلا يصح تحديد معانيه
۲۸۱
Page 344
أنها قد
الله الرحمن.الحق أن كل نبي يُعطى شريعة سواء أُنزلت عليه أو على نبي سابق ويُؤمر باتباعها، وكذلك يعطى فرقانًا،
أي آيات تميز بين الحق والباطل.والفرقان هو الوسيلة الحقة لمعرفة صدقه ولجهل الناس هذه الحقيقة
رفضوا في كل زمن أنبياء صادقين أو وقعوا في شراك الكذابين.إن صدق أنبياء الله تعالى لا يتأسس على
أمر واحد وإنما يُعطون عشرات الآيات التي تشكل في مجموعها شهادة على صدقهم وعلوّ درجتهم.هناك من الناس من يحسبون أنفسهم مأمورين من الله تعالى بسبب بضعة أحلام وإلهامات، مع
تكون من قبيل وسوسة النفس والشيطان أو نتيجة أمراض ،وتخيلات، وقد تكون أيضا من
وإن تحقق حلم أو إلهام ليس دليلاً على أنه من الله تعالى، لأن بعض الأمور الخيالية والطبيعية قد تحدث،
فإلهامات بعض الطبائع الضعيفة ليست ميزة لها.وأما وحي الأنبياء له شأن خاص.إنه ذو سعة عظيمة،
ويناسب حاجات العصر وهو علاج لمفاسد الزمن.وإلى جانب أصحابهم العظام وإلهاماتهم العظيمة
الشأن فإنهم يمتازون حتى قبل دعواهم بحياة طاهرة معصومة.قال الله تعالى على لسان النبي ﷺ: [فقد
لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون (يونس: (۱۷).أي قد يكون هناك خطأ في الإلهام بسبب مرض
أو ضعف العقل..ولكن من الصعب أن يُنسب الضعف العقلي إلى إنسان له هذا الشأن.فالإلهام الصادق أيضا دليل، والحياة الطاهرة قبل الدعوى أيضا دليل، ولكنهما إذا اجتمعا أصبحا دليلاً
ثالثًا عظيما، وهو الفرقان
ثم يسوق القرآن الكريم دليلاً آخر على صدق الرسول قائلاً: ألا تنظرون إلى وجوه المؤمنين به؟
أليسوا في ذاتهم دليلا قويًا على صدقه؟ فالناس عمومًا على درجات وطبقات؛ منهم سيئو الخلق، ومنهم
الطامعون، ومنهم الجاهلون، ومنهم السدّج..ولكن يوجد بين المؤمنين به من تبوء مكانة عالية في فنه
وعقله وعلمه قبل الإيمان وإيمان مثل هؤلاء في حد ذاته دليل قوي على صدقه..فالذين كانوا ذوي
أناة وحلم، وكانوا من أهل العلم والحجة والبذل والعطاء والبر بالفقراء، ومن ذوي المهارة في مهنهم
وفنونهم..و لم يكونا من أهل الجهل وسوء العمل، ما الذي دعاهم للتعرض إلى الإساءة والتحقير من
قومهم..باتباع إنسان إن لم تكن فيه الآيات الدالة على صدقه؟
ثم ذكر الله تعالى أن آية صدق الرسول ﷺ هي هلاك مناهضيه.وهذا في حد ذاته دليل عظيم، ولكنه إذا
اجتمع مع الأدلة الثلاثة السابقة لشكل دليلاً له شأنه العظيم.كذلك
من
الأدلة على صدق الرسول ﷺ أنه قضى على المفاسد المنتشرة في زمنه، وأصلح الأخطاء
العلمية والعقائدية والعملية.وهذا بنفسه دليل قوي، ولو أضيفت إليه الأدلة السابقة لنهض صرحًا شامخًا
على صدقه.۲۸۲
Page 345
إننا نُقر بأن بعض الإلهامات تكون طبعية ،وخيالية، ونقر أن بعضها تتحقق أحيانا، ولكن من الصعب جدا
أن نصدق أن هذه الإلهامات الخيالية والطبعية التي هي نتيجة لضعف عقلي أو هذه الإلهامات الشيطانية
التي هي نتجية لضعف عقلي وخُلُقي..لم تجد غير شخص كان قومه يشهدون على طهارة حياته
ورجاحة عقله وموفور حكمته.وحتى لو سلمنا جدلاً بهذا الأمر المتعذر، فإنه من الأشد صعوبةً أن نقبل
أن شخصاً صالحًا اختل عقله وادعى أمورًا غير معقولة، ومع ذلك صدقه عقلاء قومه وفضلاؤهم الذين
كانوا يعرفونه عن قرب.ثم لو مضينا في التسليم بحصول هذا الخطأ أيضًا فمن الأشد استحالةً أن نقبل
بأن مثل هذا الشخص المخبول قام بإصلاح الأفكار الخاطئة المنتشرة في زمنه؛ سواء في العقيدة أو العلم
أو العمل.يُقرّ المعترض أن محمدا ﷺ ادعى تلقي الوحي السماوي؛ ويقر أن بعض هذا الوحي قد تحقق وإن كانة
مصادفة؛ ويُقر أن حياة محمد قبل دعواه كانت طاهرة تمام الطهر؛ ويُقر أن المؤمنين به كانوا ممن
يعرفونه عن كثب حق المعرفة، وكانوا مشهودًا لهم برجاحة العقل وسعة العلم وصالح العمل؛ ويُقر أن
هؤلاء الذين آمنوا بمحمد الله و قد انتصروا مصادفة، وأن أعداءهم انهزموا مصادفة أيضًا؛ ويُقر أن الشرك
قبيح وأن محمدا
ﷺ وفق في القضاء عليه؛ ويُقر بأن محمدا لله أصلح عشرات العقائد الفاسدة..بعد كل
هذه الإقرارات مجتمعة..من يستطيع القول أن محمدا ﷺ - والعياذ الله - كان مختل العقل أو تحت تأثير
الشيطان.يمكن أن يشكك أحد في كل دليل على حدة، وينظر إليه منفصلاً عن غيره كحادث من
حوادث المصادفات، ولكن اجتماع كل هذه الأدلة ومئات غيرها في إنسان لا يمكن أبدًا أن يكون من
المصادفات.وإذا كانت هذه الدلائل مجتمعة محل شبهة فليس في الدنيا شيء يتسم باليقين.ومثل هذه المجموعة من الدلائل هي الفرقان في نظري.وقد أوتيت مثل هذه المجموعة لموسى، وأوتيت
لداود، وأوتيت لعيسى ، وأوتيت لنبينا محمد، وأوتيت اليوم لمؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية سيدنا
المهدي والمسيح الموعود عليهم أزكى الصلاة والسلام.يعترض المخالف دائما على كل دليل بمفرده وينسى أن الاعتراض ممكن على كل شيء.يجب أن
يلاحظ الإنسان كيف اجتمعت عشرات الأدلة المتنوعة في المدّعي.إذا توافرت لأحد مثل هذه المجموعة
فيمكن الجزم أنه أوتي ،فرقانًا، وأنه من الله تعالى، وأن هذا الفرقان لا يمكن أن يُعطى لكاذب.بيد أن رسولنا محمدا ﷺ يمتاز عن سائر الأنبياء.ذلك أن هؤلاء أوتوا فرقانًا وكتابا، ولكنه أوتي
الفرقان وأوتي الكتاب الذي كان بنفسه فرقانًا.لقد كانت توراة موسى بحاجة إلى معجزات أخرى، أي
الفرقان كي يثبت صدقها؛ وكان وحي عيسى بن مريم يحتاج إلى معجزات أخرى، أي الفرقان، كي
يتبين صدقه؛ ونفس الحال بالنسبة لكتاب الفيدا الهندوسي، وكتاب الزند ال زرادشتي، ولكن الكتاب
۲۸۳
Page 346
الذي نزل على محمد ﷺ لا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان صدقه..لأنه بنفسه فرقان..أي إنه كتاب حي،
أدلة
ولو أن الناس نسوا المعجزات الأخرى فإنه رغم ذلك يُثبت صدق نفسه بنفسه..لما يحتوي عليه من
وبراهين؛ ومن أجل ذلك سُمي فرقانًا.وليس هناك كتاب سماوي من الكتب السابقة أوتي هذا الاسم.تعالى المؤمنين بالقرآن أنه : [ يجعل لكم فرقانًا أي لما كان هذا الكتاب فرقانًا فإن المؤمنين به
ووعد
الله
إيمانًا كاملاً يُعْطَون فرقانًا من الله.هذا الفرقان دليل يبلغ من القوة والشمول بحيث إذا فهمه الإنسان وحاول معرفة صدق الأنبياء على
ضوئه لم يصعب عليه أن يتعرف على مأمور زمنه.قوله تعالى: [لعلكم تهتدون].حرف (لعل) لا يفيد هنا الشك، بل هو من الأساليب الملكية، فيقول
الملوك في أوامرهم مثلاً : إننا نأمل من الشعب، والمراد أنه أمرٌ منهم للشعب، فالمعنى: أننا أعطينا موسى
نعمة الكتاب والفرقان لكي يهتدي بها بنو إسرائيل، ولكن الأسف أنهم ما استفادوا من الكتاب ولا من
الفرقان، ولم يقدروا نعمنا حق قدرها ومسخوا فطرتهم، فكانت عاقبة ذلك حرمانهم من الهداية.( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (٥٥)
شرح
الكلمات :
بارئكم: برأ الله الخلق: خلقهم.البارئ: الخالق.اقتلوا قتله: أماته بضرب أو حجر أو سُمّ أو علة قتله الجوع أو البرد كسر شدته.قتل الله الإنسان
وقاتله: لعنه (الأقرب).اقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا.وقيل عنى بقتل النفس: إماتة الشهوات.يقال: قتلت الخمر
بالماء إذا مزجته به.قتلت فلانًا وقتلته إذا ذلّلته (المفردات).وفي حديث السقيفة عندما اجتمع الصحابة
بعد وفاة النبي ﷺ لانتخاب خليفة له، واختلف بعضهم ومنهم سعد، فقيل فيه: قتل الله سعدا فإنه
صاحب فتنة وشر: أي دفع الله شره.وفي رواية أن عمر الله قال يوم السقفية : اقتلوا سعدا، قتله الله! أي
اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عداد من مات ،وهلك ولا تعتدوا بمشهده، ولا تعرّجوا على قوله.وفي
حديث عمر أيضًا: من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه، أي اجعلوه كمن قتل ومات..بألا تقبلوا له قولاً ولا تقيموا له دعوة.وكذلك الحديث الآخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما:
أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن قد مات (اللسان).٢٨٤
Page 347
فالقتل، علاوة على المعاني المعروفة يعني أيضًا: التذليل والمقاطعة.التفسير : بينت الآية السابقة أن بني إسرائيل عصوا الله تعالى بينما كان يحسن إليهم، وهنا ذكر أن أئمة
الكفر منهم كانوا يستحقون العقوبة، لأن العفو التام عنهم على جريمة الشرك كان من شأنه أن يشجعهم
على المعاصي.فقال: يا بني إسرائيل، لقد ظلمتم أنفسكم بالشرك ظلما عظيمًا، لذلك توبوا إلى بارئكم.ومعنى البارئ الخالق، ولكن هناك فرق بين الكلمتين فبرأ يعني خلق بدون عيب أو نقص.يقول
الزمخشري: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت الكشاف).وقد أيّده العلامة أبو حيان، وهو
من كبار علماء النحو واللغة.وتفسيره البحر (المحيط من أرقى التفاسير ، وقال بأن استدلال الزمخشري
هذا حَسَنُ ولطيف.وقد استنبط الزمخشري هذا بناء على المعنى الأصلي للبرء وهو الخلو من العيب والنقص.وقال صاحب اللسان أن الفرق بين الخلق والبرء أن الخلق يستخدم لكل مخلوق، أما البرء فيستخدم
عموما لذوي الأرواح..تقول العرب : خلق الله السماوات والأرض، وبرأ الله النسمة.وكأن البرء
يستعمل لإيجاد مخلوق أكمل وأرقى.وقد استخدم القرآن البرء لخلق المصائب (سورة الحديد: ٢٣)..وهذا الاستعمال بسبب المشاركة مع ذوي الأنفس والأرواح، وإلا فلا يعني ذلك أن البرء يستعمل لغير
ذوي الأرواح، يقول الله تعالى : [ هو الله الخالق البارئ] (الحشر: ٢٥).وقد جمعت الآية الصفتين، مما يدل
على أن هناك فرقًا بين معناهما.فالله تعالى بارئ بمعنى أنه لا يخلق الخلق فقط، بل يخلقه مزودًا بأخلاق
وقوى متطورة قابلة للازدهار.فكلمة البارئ في قوله تعالى: [توبوا إلى بارئكم] إشارة لطيفة لدحض الشرك الذي وقعوا فيه.لقد نحت
بنو إسرائيل صنما، والواضح أن الخالق أفضل من المخلوق، والناحت خير من المنحوت، والمصوّر أسمى
من الصورة لأنه قادر على رسم مثلها بل أفضل منها.أيها الحمقى، تخرون ساجدين
بأيديكم وهو جماد تافه ولا حياة فيه؛ ولكن الذي صنعكم بهذه الحياة صنعة كاملة فنسيتموه.إن الصانع
أفضل من ،صنعته وأنتم أعظم من الصنم الذي صنعتموه بأيديكم فلا يستحق عبادتكم، وأنا الذي
صنعتكم، فكان الأولى بكم أن تلتفتوا إلي وتعبدوني وحدي ولا تقعوا في هذا الشرك القبيح.فبقوله تعالى: [توبوا إلى بارئكم ألقى الضوء على ضرورة التوبة وكذلك على حقيقة أن التوبة الحقيقية
التي تكون إلى الله
وحده.وهكذا حَشَد في ثلاث كلمات معاني تحتاج إلى كتاب، فكأنه أدخل
هي
لما
صنعتموه
البحر في إناء.قوله تعالى: [فاقتلوا أنفسكم]..كما سبق في شرح الكلمات فإن القتل يعني القتل الظاهري، وكذلك
الإعراض والمقاطعة.لقد ذهب المفسرون إلى أن القتل هو قتل أهواء النفس، ولكن يتبين من
الكتاب
٢٨٥
Page 348
المقدس
أن بعض أئمة الجريمة عوقبوا بالقتل.ولقد ذكر الله تعالى أمر العفو العام أولاً، ثم أتبعه بذكر
شناعة هذه الفعلة من اليهود على وجه خاص، فيبدو من ذلك أن بعض الناس قد عوقبوا فعلاً بالقتل.تذكر التوراة في هذا الصدد قول موسى ال لبني لاوي: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل
واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد
صاحبه، وكل واحد قريبه، وفعل بنو لاوي بحسب قول موسى ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو
ثلاثة آلاف رجل) (خروج) ۲۷ : ۳۲-۲۸).ثم تقول التوراة إن موسى ابتهل إلى الله طالبا الرحمة وقال:
(آه، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب.والآن إن غفرت خطيتهم وإلا
فامحني من كتابك الذي كتبت) (خروج ۳۲:۳۲).ثم ورد أن الله تعالى عفا عنهم كقوم، ولكن لم يعف
عن أئمة المجرمين كأفراد بل قال سوف أحاسبهم يوم القيامة (المرجع السابق: ٣٤).القومي
يظهر من عبارات التوراة هذه أن هؤلاء المجرمين عوقبوا بالقتل، ثم رفع الله تعالى العقوبة القومية عنهم
رحمة لهم بسبب دعاء موسى، ولكن العقوبة يوم القيامة لكبار المجرمين لم تزل في انتظارهم.هناك شيء من الاختلاف بين بيان الكتاب المقدس وبيان القرآن الكريم، فقد ذكر القرآن أن العفو
كان أولاً، ثم كان تنفيذ العقوبة على قادة الجريمة، أما التوراة فتقول إن تنفيذ العقاب على قادة
المجرمين كان أولاً ثم صدر العفو القومي من الله تعالى.ولا نجد مصدرًا تاريخيا يتناول هذا الحادث
سواهما.ولكن رأينا عمومًا أن شهادة التاريخ عند توافرها في مناسبات الاختلاف الأخرى كانت دائمًا
في جانب القرآن الكريم؛ ومن ثم نجد أن بيان القرآن هو الأولى بالقبول.كما توجد هناك شهادة فطرية.فالعادة أنه عندما يرتكب فريق من الشعب جريمة قومية يثور ضدهم
الآخرون، وإذا صدر عفو كان عفوا عامًا، ثم يعاقب المحرضون وكبار المجرمين وهذه الشهادة أيضًا في
صف البيان القرآني.فعندما أخبرهم موسى بسخط الله على الجريمة ندموا، وعندما ابتهل موسى إلى الله
طمأنه الله تعالى بأن شعبه لن يهلك جميعه ولكن أئمة الكفر يستحقون عقابًا لازمًا.ورواية التوراة تقول إن الله تعالى أمر بقتل جميع الشعب، وتم تنفيذ الأمر، ثم لما ابتهل موسى إليه تعالى
عفا عمن نجوا من القتل.وهذا الترتيب التوراتي للأحداث غير طبيعي وظالم أيضًا؛ وكأن
من قتل فقد
قتل، ثم شمل العفو الآخرين بصرف النظر عن كونهم من أئمة الكفر أم من الأبرياء! وكأنه عند العقوبة لم
يلاحظ أهمية الجرم فسوى بين الجميع، وعند العفو أمر بوقف تنفيذ العقوبة فجأة، فنجا الباقون أبرياء
أن العقوبة التي تصدر بحسب القانون الشرعي تنفذ بحسب أهمية الجريمة.هذا، وإن كانت
سُنّة العقاب الطبيعي بطريق الكوارث والنوازل لها قواعد أخرى، فإنها تنزل بالجميع ولا تفرق بين أحد
ومجرمين، مع
منهم.٢٨٦
Page 349
من
وقعوا
فثبت مما سبق أنه بحسب قانون العدل والإنصاف فإن القرآن هو الصواب..الذي يقول بأن
جهلاً أو رهبة من الآخرين استحقوا العفو، وأما أكابر المجرمين فاستحقوا العقاب.ويجب تذكر أن قوله تعالى: [فاقتلوا أنفسكم] لا يعني أن انتحروا بل يعني اقتلوا أئمة الجريمة من أقاربكم
وأصدقائكم كما جاء في التوراة.ورد في القرآن الكريم ولا تخرجون أنفسكم من
دياركم] (البقرة : ٨٥)..معنى لا تخرجوا إخوانكم من ديارهم، وقال أيضا: [فلا تظلموا فيهن
أنفسكم] (التوبة : ٣٦ ) ، أي لا يظلم بعضكم إخوانه في الأشهر الحرم، وقال أيضا: [فإذا دخلتم بيوتا
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ] (النور: ٦٢.يعني: سلموا على أقاربكم وإخوانكم في
هذه البيوت.ويبدو أن الأمر كان بقتل أئمة الجريمة على يد أقربائهم وإخوانهم.وكان لهذا الأمر مصلحتان: الأولى
إيقاع العقوبة بالمجرم قتلا، وايقاع العقوبة بالمنفذ بقتل صاحبه بيده ومشاهدة مقتله بعينيه؛ والثانية: أن
نظام بني إسرائيل كان يقوم على القبائل والعداوة بين القبائل تكون شديدة، فلو كان منفّذ العقوبة على
أحد من غير قبيلته لثارت العداوات والأحقاد على أشدها، واشتغلوا بها ونسوا جريمة المقتول، ولغلبت
عليهم فكرة الثأر.فكان هذا الأمر الإلهي نجاة لهم من الوقوع في المزيد من الفتن وإصلاحًا لقلوبهم بطريق
شعورهم بالألم.لقد أُمر
بنو إسرائيل بهذا الأمر الإلهي لهذه الحكمة، ولربما عملوا به كرها ولكن فيما يتعلق بالرسول ﷺ
فإن أحد أصحابه تطوع بمثل هذه الخدمة مما يدل على أن الذين عاشوا في صحبته وصلوا إلى ذروة
مكارم الأخلاق.كان الرسول ﷺ قافلا من غزوة بني المصطلق فعرّجوا للراحة عند موضع.وكان هناك
بئر واحدة، وكان هناك زحام لكثرة الوُرّاد.واختلف شخصان على الماء وتشاجرا.وتصادف أن أحدهما
كان أنصاريًا والآخر من المهاجرين.ولما تصايحا انقسموا فجأة ولا شعوريًا إلى فريقين كادا يقتتلان.فانتهز رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هذه الفرصة التي سنحت له وقال مؤلبًا الأنصار: أنتم
بأنفسكم أركبتموهم على أعناقكم وإلا ما استطاعوا أن يذلونا هكذا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن
الأعز منها الأذل] (المنافقون: ۹)..يعني بقوله أن أعز رجل في المدينة، يريد بذلك نفسه، سوف يطرد منها
أذل رجل منها، يقصد النبي ﷺ والعياذ بالله، وهذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة من قوله.وربما يكون
مراده أن الفريق الأعز، أي الأنصار، سوف يطردون من المدينة الفريق الأذل ، أي المهاجرين.وأيا كان
المعنى فالنتيجة واحدة.وكان الصحابة وقتها في حماس وشجار، ولكنهم ما أن سمعوا هذه الكلمة الكريهة من عبد الله بن أبي بن
سلول حتى رجعت إليهم عقولهم، وفطن الأنصار فورًا إلى أنهم في لحظة امتحان شديد لإيمانهم، فأنهوا
۲۸۷
Page 350
الشجار على الفور وافسحوا المكان للمهاجرين، وأما المهاجرين فقد هدأوا كذلك.ثم أخذ الأنصار
يتلاومون بأنا لا نستحق الحياة بعد ما صدر من ابن سلول.ولما بلغ الخبر ابن رئيس المنافقين قرر أن أباه
لا يستحق الحياة بعد جريمته النكراء هذه فجاء النبي يا
الله ، وقال : يا رسول الله ، هل بلغك ما قاله عبد الله؟
قال : نعم.قال: يا رسول الله، هل له عقوبة غير القتل؟! إن كنت آمرا بقتله فمُرْني أضرب عنقه،
لأني أخاف أن يقتله غيري فتثور نفسي وأقتل قاتله فأقتل مؤمنًا بكافر.(السيرة النبوية لابن هشام).لاحظوا النظر الثاقب للصحابة ! فابن زعيم المنافقين لا يريد قتل أبيه الذي أساء إلى النبي ﷺ إلا بيده، إذ
كان يعرف أن المجرم مهما كان ذا مكانة وجاه فهو أبوه ، وإنما يريد قتله بيده لكيلا ينشأ في قلبه بغض
نحو أخ مسلم.فكأن الحكمة التي وجّه الله إليها أنظار بني إسرائيل بالوحي الجلي..توصل إليها أصحاب
الرسول بأنفسهم عن طريق الوحي الخفي الذي هو ثمرة نور إيمانهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه!
قوله تعالى: [ذلكم خير لكم عند
لكم عند بارئكم إشارة إلى ما ذكرت آنفًا..أي أن إنزال العقوبة بأئمة الشرك
خير لقومكم، لأن حالة قلوبكم سيئة لدرجة أن العفو لا يصلحها وحده، بل لا بد من قدر من العقوبة.ويشير أيضا إلى أن في قتل الأقارب بيد الأقارب، والأصدقاء بيد الأصدقاء خيرا لكم، لأن قتلهم بيد
غيرهم سوف يثير بينكم فتنة البغض والانتقام التي لن تنتهي؛ خصوصاً وأن دافع الانتقام عندكم شديد
لا تخبو ناره.قوله تعالى: [فتاب عليكم..يعني توجّه الله إليكم بفضله ورحمته..أي تناسى جريمتكم بعد توقيع هذه
العقوبة.وما ذكركم بها إن لم تكونوا قد ارتكبتم مزيدًا من الجرائم.وقوله تعالى : [إنه هو التواب الرحيم..أي يقبل التوبة مرة بعد مرة، وينظر إليكم بعين الرحمة الواسعة
المتكررة.وما حدث لكم فيما بعد كان بسبب ما ارتكبتم من المعاصي والمساوئ المستمرة، وهو دليل
على أنكم لم تقدروا العفو الإلهي العظيم الذي صدر رغم شناعة جريمتكم.تذكر التوراة أنه قُتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف، ولكن هذا مخالف للعقل تماما.فإذا كان أئمة الشرك
ثلاثة آلاف لكان عدد الجميع مئات الألوف.ولكن عدد إسرائيل في ذلك الوقت لم يكن بذلك
القدر، لا بحسب التاريخ ولا بحسب الأحداث.ففي زمننا هذا الذي تيسرت فيه وسائل السفر على شتى
الأنواع لا يستطيع مئات الآلاف بهذه التسهيلات عبور صحراء سيناء، فكيف استطاع بنو إسرائيل في
ذلك الزمن عبورها بوسائلهم البدائية مع نسائهم وأطفالهم وأمتعتهم؟ بحسب ما يتبين من القرآن،
وبحسب شهادة العقل لم يكن هؤلاء المهاجرون يتعدون بضعة آلاف وربما عدد القتلى بضعة أفراد وبالغ
کتاب التوراة فيما بعد وجعلوه ثلاثة آلاف.وحدهم
۲۸۸
Page 351
وإِذْ قُلْتُمْ يَا قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ) (٥٦)
شرح
الكلمات :
جهرة الجهرة ما ظهر قوله :[ نرى الله جهرة نراه عيانًا غير مستتر (الأقرب).التفسير: من عادة المتعنتين أنهم عندما يعجزون أمام الأدلة والبراهين يشترطون شروطًا سخيفة لا
يقصدون بها إلا التهرب من مواجهة الحقيقة في أيامنا هذه أيضًا هناك الكثيرون الذين إذا أثبت لهم
وجود الله تعالى بالبراهين قالوا لن نؤمن به ما لم نراه بأعين رءوسنا.لقد طالبت طائفة من بني إسرائيل
سيدنا موسى بمثل هذه المطالبة.ولقد سكتت التوراة عن ذكرها ولكنها مطالبه عامة تصدر من معارضي
الحق في كل زمن، وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها خصوم القرآن المجيد.ولما كان القرآن يدعي بكونه
وحيًا إلهيًا فليس ضروريًا أن يتقيد بما ذكرته التوراة ولا يضيف إليه جديدًا.وهناك تساؤل: عندما طالب بنو إسرائيل برؤية الله تعالى جهرة أخذتهم الصاعقة، ولكن موسى قد سبق
و طالب : [ ربِّ أرني أنظر إليك ] (الأعراف : ١٤٤) ، فلم يتزل عليه غضب الله...لماذا؟
والجواب أن موسى طلب ذلك عن حُب شديد، أما بنو إسرائيل فقد طالبوا بذلك كشرط لطاعتهم،
وقالوا: ما لم نراه عيانًا فلن نؤمن لك.وهذه مطالبة صدرت عن وقاحة وسوء أدب وشر، ولذلك
عوقبوا.ولو أنهم سألوا ذلك بعد قبول الحق كما فعل ،موسى، ما نزل بهم العقاب.قوله تعالى: [فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الصاعقة هي العذاب لغة.ويدل التأمل العميق في هذه
الكلمة على أنها تطلق على عذاب مصحوب بصوت شديد جدًا كعذاب الزلازل والرعود والعواصف.وأحيانًا تعني الصاعقة الموت والإغماء لأنهما مصاحبتان لهذه الكوارث عادة، ولكن المعنى الأصلي للكلمة
هو ما ذكر.وقد استعملت الصاعقة في القرآن في أكثر الأحيان بمعنى العذاب.قال الله تعالى: [فإن
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود (فصلت:١٤).ثم وضح صاعقة عاد هذه وقال:
فأرسلنا عليهم ريحًا صَرْصرا (فصلت: ۱۷)، ووصف صاعقة ثمود وقال فأخذتهم
الرجفة ] (الأعراف : ۷۹)..أي زلزلة شديدة فثبت بذلك أن الصاعقة في القرآن تعني العذاب.وفي هذه
الآية أيضًا وردت بمعنى العذاب.ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٧)
شرح
الكلمات :
۲۸۹
Page 352
الله
الموتى:
بعثنا بعثه بعثا: أرسله وبعثه أثاره وهيجه وبعثه على الشيء: حمله على فعله.وبعث
والبعث النشر (الأقرب).فمعنى بعثناكم أي رفعنا شأنكم ونهضنا بكم.أحياهم.التفسير : قوله تعالى: [ ثم بعثناكم من بعد موتكم] يعني في ضوء ما سبق من الكلام، أننا نهضنا بكم بعد
ذلتكم وهوانكم وجعلناكم معززين مكرمين؛ لأن قوله تعالى في الآية السابقة [وأنتم تنظرون] يدل على
أنهم لم يموتوا بمعنى أن حياتهم انتهت بل ماتوا معنويًا.فالآية تعني: لقد أزلنا عنكم عذابنا، وتوجهنا
إليكم بفضلنا ورحمتنا، وبدلنا حالة الموت التي كنتم فيها بسبب عذابنا إلى حياة طيبة ماديًا وروحيًا.لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الموت هنا يعني مفارقة الروح للجسد لبعض الوقت لا موتًا حقيقيا.فقد
كتب القرطبي عن المفسر المعروف قتادة : ماتوا وذهبت أرواحهم ثم رُدّوا لاستيفاء آجالهم.وقد ذكر ابن
كثير نفس القول عن ربيع بن أنس.وقال غيره: ماتوا موت همود يعتبر به الغير ثم أُرسلوا.وقال البعض:
معناه علّمناكم من بعد جهلكم تفسير القرطبي)..أي أن روحانيتكم ماتت بسؤالكم رؤية جهرة
فترل عليكم سخطه، ثم عفا عنكم، ووهبكم هداية روحانية، فعادت إليكم الحياة الروحانية، وهذا المعنى
الأخير قريب جدا مما ذهبنا إليه.الله
والدليل على أن الموت هنا ليس حقيقيًا أن القرآن لا يقبل فكرة رجوع الموتى الذين فارقوا الحياة إلى
الدنيا مرة أخرى.قال الله تعالى : حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رَبِّ ارْجِعُونِ { لعلي أعمل صالحًا
فيما تركتُ.كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (المؤمنون: ۱۰۰-۱۰۱).ومعنى ذلك أن من يموت لا يرجع إلى هذا العالم.إن أيام الحياة التي توهب للإنسان في هذه الدنيا تكتمل
في يوم يبدأ فيه دور جديد لحياة الآخرة.وأيام الحياة هذه لا تتجزأ إلى أجزاء بل هي وحدة واحدة
تكتمل مرة واحدة لا على فترات.ثم هناك اعترضات منطقية ترد على هذه العودة المزعومة إلى الدنيا لتكميل أيام الحياة المقدرة للإنسان.فمثلاً إذا رجع إنسان بعد الموت إلى الدنيا بحسب طلبه من الله تعالى وآمن لكان إيمانه اضطرارًا لا عن
طواعية ولا فضل له فيه.فالإيمان في هذه الدنيا يقتضي إعمال الفكر في أمر من الغيب، ولهذا السبب
تتضمن معجزات الرسل شيئا من الخفاء والستر، حتى يدفع هذا بعض الناس للاعتراض على معجزاتهم
البينة.ولو أن الإيمانيات تتأسس على تجارب كالتجارب المعملية كما هو حال الأشياء المادية الأخرى لم
يعد للإيمان بها ،مغزى ولاضطر الكافر والمؤمن لقبولها، ولضاع الهدف من الإيمان.فرجوع الموتى إلى
الدنيا يهدم الغرض من الإيمان وعلى الأقل لا يبقى لإيمان العائد إلى الدنيا مغزى.ولقد خطر هذا الأمر في بال بعض المفسرين القدامى.فقال العلامة الماوردي: واختلف في بقاء تكليف
أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة قولين: أحدهما بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من
من
۲۹۰
Page 353
تعبد، والثاني سقوط تكليفهم معتبرًا بالاستدلال دون الاضطرار (تفسير القرطبي).أي أن التكليف
مقصور على الاستدلال وإعمال العقل وليس على الإيمان الاضطراري.وهذا القول دليل على أن بعض المفسرين والعلماء القدامى أيضًا تنبهوا إلى أن رجوع الموتى إلى هذه
الدنيا يبطل أحكام الشريعة.وقد حاولوا إزالة هذا الشك من قلوبهم، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك كما
هو ظاهر من أقوالهم.فالحق أنه كلما ذكر القرآن إحياء الموتى أو رجوعهم إلى هذه الدنيا لم يعن إلا
إحياء معنويًا وروحانيا..مثل شفاء مريض بدا كالذي مات أو نهوض قوم بعد انحطاط وإدبار، أو تبدل
حالتهم من الكفر إلى الإيمان وما شابه ذلك من المعاني.الله
ومن المفسرين من قال إن بني إسرائيل عوقبوا بهذا العذاب بسبب اتخاذهم العجل إلها، ولكن هذا خطأ،
لأن الله تعالى ذكر هنا جريمة أخرى لهم وبكلمات لا لبس فيها إذ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى
جهرة، ثم قال الله: [فأخذتكم الصاعقة.كما أن العقوبة المذكورة هنا تختلف عن العقوبة التي نالوها
عند عبادة العجل.فثبت أن الحادثين منفصلان مختلفان.ويجب أن نعرف أن قوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعني لن نطيعك، ولا يعني لن
نصدقك أو لن نؤمن بك، فإنهم ما كانوا يشكون في نبوة موسى عليه السلام، وإنما كانوا يرفضون
طاعته ما لم ينالوا ما ناله من شرف الحديث الشفوي مع الله تعالى.وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (٥٨)
شرح
الكلمات :
ظللنا : ظلله تظليلاً غشيه وألقى عليه ظله.ظللنا عليكم الغمام: سخرناه ليظلكم (الأقرب).الغمام: السحاب، وقيل الأبيض منه.وسمي السحاب بالغمام لأنه يغُمُّ السماء أي يحجبها.(الأقرب)
المن: مَنْ عليه بالعتق وغيره أنعم عليه به من غير تعب ولا نصب، واصطنع عنده صنيعة وإحسانًا.والمن: كل ما يمن الله تعالى به مما لا تعب فيه ولا نصب؛ كل طل ينزل من السماء على شجر أو
ويحلو وينعقد عسلاً ويجف جفاف الصمغ كالسِّير خشت والترنجبين.(الأقرب)
السلوى: العسل؛ كل ما سلاك؛ طائر أبيض مثل السماني.وقيل السلوى اللحم لأنه يسلي الإنسان على
سائر الإدام (الأقرب).السلوى أصلها ما يسلي الإنسان.يقال: سليت عن كذا إذا زال عنك محبته
(المفردات).۲۹۱
Page 354
الطيبات طاب الشيء: لذَّ وزكا وحسن وحلا وجلّ وجاد.والطيب ذو الطيبة خلاف الخبيث؛ الحلال
(الأقرب).أصل الطيب ما تستلذ به الحواس وما تستلذه النفس.والطعام الطيب في الشرع: ما كان
متناولاً من حيث ما يجوز ، وبقدر ما يجوز، ومن المكان الذي يجوز (المفردات).التفسير ورد في التوراة: متى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون.في
المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو إسرائيل يترلون حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون
وحسب قول الرب كانوا يترلون جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا يترلون.وإذا تمادت
السحابة على المسكن أيامًا كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون.وإذا كانت
السحابة أيامًا قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا يترلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون.وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت في الصباح كانوا يرتحلون.أو يوما وليلة ثم
ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، أو يومين أو شهراً أو سنة، متى تمادت السحابة على المسكن حالةً عليه
كان بنو إسرائيل يترلون ولا يرتحلون ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون (عدد ٩ و ١٠ وخروج ٤٠).يتبين من هذه الفقرة أن السُّحب كانت تُظل مكانًا يريد الله تعالى أن يتزلوا فيه أثناء عبورهم سيناء، وإذا
أراد سفرهم أظلّتهم مرة أخرى في السفر ولكن سياق القرآن وكلماته تبين أن المراد من ظلال الغمام
هو المطر..لأن السحب الداكنة المظلمة ممطرة عمومًا.وبيان القرآن، كما عادته، تصحيح لبيان
التوراة، لأن وصف التوراة للسحب غير ضروري وغير معقول.فأي داع لإحاطة بني إسرائيل بالسحب
لتوجيههم إلى المكان المناسب لإقامتهم؟ كان يكفي أن يوحي الله تعالى لموسى ويخبره بذلك.لقد ذكر القرآن إلى جانب الغمام المنّ ،والسلوى ومن هذا يتبين أن تلك الفيافي المجدبة كان يعوزها
الطعام والماء.فكان الله تعالى يطفئ عطشهم بالسحب الداكنة الممطرة، ويزيل جوعهم بالمن والسلوى.إن من عادة الله المستمرة أنه
المستمرة أنه يَمُنُّ على عباده ببركات خاصة ليدرأ عنهم الأذى ويهيئ لهم الراحة.وما
فعل الله هذا في الماضي فقط، بل يفعله اليوم أيضا مع عباده الصالحين.فلا أن يراد بظلال الغمام أن
يصح
الله تعالى كان يأمر السحاب لتتحرك معهم لتظلهم دائمًا حيثما حلوا وارتحلوا..إذ إن ظلال السحب
المستمر نقمة لا نعمة.هي
ورد في التوراة: (وفي الصباح كان سقيط الندى حوالى المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية
شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض.فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟
لأنهم لم يعرفوا ما هو.فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا).(خروج١٣:١٦ إلى
۲۹۲
(10
Page 355
لقد سبق في شرح معاني الكلمات أن المنّ ما يناله الإنسان بدون تعب ولا نصب.وورد في الحديث:
(الكَمْأَة من المنّ الذي أنزل على موسى (مسلم، كتاب الأشربة).ويتضح من الحديث أن المن ليس اسما
لشيء معين، وإنما يطلق على كل ما يصلح للأكل وينمو في الصحاري وفوق الصخور والأشجار بدون
جهد بشري.فالمن هو الكمأة والترنجبين والمشروم والأشن والنبق وغيرها من ثمار النباتات البرية التي
تصلح للأكل كغذاء يسد الجوع.وتوجد هذه الأشياء في البراري والصحاري؛ حتى إن القوافل لتقتات
بها أسابيع.ويبدو أن الله تعالى هيأ لنبي إسرائيل في سني الهجرة هذه الأشياء بكثرة في برية سيناء،
فأغناهم إلى حد كبير عن الحاجة إلى الحنطة والبقول وغيرها.أما السلوى فهي أيضا خاص وعام كالمن.فالعام منها كل ما يسليك، والخاص طير يشبه السماني،
والعسل أيضًا.ورد في التوراة: (فخرجت ريح من قبل الرب، وساقت سلوى البحر وألقتها على المحلة
نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض.فقام الشعب
كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى.الذي قلل جمع عشرة حوامر.وسطحوها
لهم مساطح حوالى المحلة.وإذا كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حَمِي غضب الرب على
الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدًا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروتَ هَتَّاوَة، لأنهم هناك
دفنوا القوم الذي اشتهوا) (عدد ١١: ٣١-٣٤).كان بنو إسرائيل قد عاشوا عبيدا تحت الفراعنة لمدة طويلة، فأراد الله تعالى أن يعيشوا في البرية أحرارا
لزرع أخلاق الجرأة والشجاعة فيهم.فبدلاً من أن يُبلغهم كنعان في وقت قصير تركهم مدةً في صحراء
سيناء وما حولها من الأماكن، وهيأ لهم هناك أغذية بدون جهد وتعب من جانبهم، منها ما هو حلو
ومنها ما هو مالح ومنها ما هو صلب ومنها ما هو لين ومنها ما يُطهى ومنها ما يؤكل نيئًا..في تنوع
يرضي شتى الأذواق، ويسد الجوع، ويغذي الجسم، ويحفظ الصحة.فبالغمام هيأ الله تعالى لبني إسرائيل
الماء، وبالمن وفّر لهم غذاء من الفاكهة والخضر، وبالسلوى زودهم باللحم والعسل وغيرها من المأكولات
التي تسلي القلب.وكلمة: [أنزلنا] جديرة بالتأمل.فلا يعني هذا أن الله تعالى أنزل المن والسلوى من السماء، وإنما كانت مما
ينمو على الأرض.واستخدم لها كلمة [أنزلنا] لأنه تعالى هيأها لبني إسرائيل في ظروف غير عادية.فالترول يدل على الإعزاز والإكرام، أو توفير شيء في أحوال صعبة.وعلى الذين يقعون بسبب كلمة
(الترول) في أنواع الأخطاء في مسألة نزول المسيح المنتظر أن يتدبروا ويتنبهوا إلى هذه الأساليب القرآنية.فإذا كان إطلاق كلمة التزول على المن والسلوى وهما من نتاج الأرض ممكنا فلماذا لا يجوز استخدام
التزول لمجيء المسيح المنتظر الذي خُلقَ على الأرض؟ الحق أن ظهور نفس طاهرة مصلحة في مثل هذا
۲۹۳
Page 356
الزمن المشحون بأنواع الفسق والفجور..يسمى نزولاً في الاصطلاح الإلهي، وقد ورد للمسيح الموعود
أيضًا بنفس المعنى.وقوله تعالى: [كلوا من طيبات ما رزقناكم يشير إلى أن هذه الأغذية بالغة الفائدة لكم في هذه
الظروف، وسوف تسد حاجاتكم من الطعام والشراء.فالطيب يعني اللذيذ، الطاهر، الحسن، الحلو،
الممتاز..وهذا يعني أن ما رزقناكم به من غذاء يكفل لكم لذة الطعم، ويساعد على صلاح أخلاقكم،
وهو حسن حلو ممتاز في قيمته ومنافعه، فكلوا منه، وتخلقوا بمحاسن الأخلاق واستعدوا للمهمة الجليلة
صحيح
التي تنتظركم.ولا يعني قوله تعالى: [كلوا من طيبات ما رزقناكم أن الطيبات التي نزلت على موسى وقومه من المن
والسلوى هي الطيبات فقط، بل إن أي كلمة، مدحا كانت أو ذما، تعطي معنى نسبيًا؛ فالشيء الذي
يكون في وقت مفيدًا، أو لشخص مفيدًا..فإنه يكون ضارًا في وقت آخر أو لشخص آخر، والعكس
أيضًا.فالأشياء التي أُعطيت لبني إسرائيل، وإن كانت من الطيبات بوجه عام، ولكنها نظرا
لظروفهم عندئذ كانت طيبات لهم بوجه خاص، واستبدال أغذية أخرى بها لم يكن ليحقق الغرض الذي
من أجله تركهم الله تعالى في صحراء سيناء.ويبدو من عبارة التوراة التي أوردناها سابقا (عدد ١١: ٣١-٣٤) أن قدوم طير السماني كان بمثابة
عذاب لبني إسرائيل، لأن غضب الله نزل عليهم قبل أن يمضغوا أول لقمة من لحمه.ولكن القرآن الكريم
يقول على عكس ذلك..بأن هذا الطير جاء نعمة وإحسانًا لهم.والحق أن ما يقوله القرآن هو الصواب،
لأن توفير الغذاء في البيداء، ثم إنزال العذاب بسبب جمعه وأكله يُعدُّ ظلما.فلو كان الله تعالى نبههم من
قبل بأن طيور السماني ستأتيكم فلا تأكلوها لكان هناك مبرر للغضب عليهم، أو إذا كان السماني حراما
أكله على بني إسرائيل لاستحقوا العقاب؛ ولكن لم يكن عندهم أي حرمة لها.فإذا كانوا وجدوا شيئا
حلالاً وأرادوا أكله فأي مبرر للغضب والعذاب الذي ملأ الأرض بقبورهم؟ إنه لظلم عظيم، والله ليس
بظلام للعبيد..قائلاً:
والحق أن التوراة في مواضع أخرى نَفَتْ كون طيور السماني نقمة وقالت: (فكلم الرب موسى
سمعت تذمر بني إسرائيل.كلّمهم قائلاً: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزًا، وتعلمون
أني أنا الرب إلهكم.فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة.وفي الصباح كان سقيط ندى
حوالي المحلة.ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على
الأرض) (خروج ١٦: ١١ إلى ١٤).وتبين هذه العبارة أن طيور السماني جاءت بحسب بشارة الله تعالى،
وأمر الله موسى أن يأكلوها نعمة وفضلاً منه تعالى وبأكلها سيعرفون أني أنا الرب إلههم.٢٩٤
Page 357
كما ذكرت التوراة نعمة السماني مع نعمة المن و لم تذكر المن في أي مكان إلا بوصفه نعمة لا عذابًا.فيبدو أن ما
ورد في (عدد ١١) هو نموذج لحمق كاتب جاهل من كتاب التوراة..أدخل فيها أفكاره
الخاطئة، وإلا فالحق ما ذكره القرآن بأن المن كان إنعامًا كما كان السلوى أيضًا إنعاما.وقوله تعالى: [وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يبين أن بني إسرائيل لم يُقَدِّروا نعمنا فاستحقوا
عذابنا.كانوا يظنون أنهم بتنكرهم لنعمنا قد أضروا بنا ، و لم يدركوا أنه يستحيل أن يضرنا أحد.فالذي
يخالف أوامر الله تعالى لا يضر إلا نفسه، والذي يتنكر لنعمه يغلق بيده أبواب النعم عليه.وتوجد هذه
الآفة الرهيبة دائمًا فيمن يعرفون صدق الدين ثم لا يعملون به، ولقد أصابت اليوم أيضا المسلمين؛ فقد
اعتبروا كل أحكام الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وتضحية أعباء وضرائب، وإذا أدوها ظنوا أنهم
قد أحسنوا إلى الله تعالى إحسانا ومنّوا عليه منةً، وإذا لم يؤدوها حسبوا أنهم خدعوا الله تعالى أيما خدعة.أن الله تعالى غني عن كل شيء؛ لم تنفعه صلاة أحد أو صومه أو أو زكاته أو تضحيته، وإنما
مع
هي
حجه
لمصلحتنا نحن.فمنها ما هو لإصلاح قلوبنا، ومنها ما هو لإرتقاء فكرنا، ومنها ما هو لخير أجسامنا،
ومنها ما هو صالح لإزدهار مدنيتنا، ومنها ما هو لترشيد سياستنا، ومنها ما هو لإنماء اقتصادنا.فيجب
أن تتدفق قلوبنا شكرًا لله تعالى عندما نوفق لاتباع هذه الأحكام؛ لأنه سبحانه هدانا إلى الصراط
المستقيم، وعلمنا طرق الفلاح والازدهار.لو هلكنا ودُمرنا ما ضره ذلك شيئًا، ولو نجونا وفزنا ما نفعه
ذلك شيئا.فويل للجهل وتعسا له لأنه يسوق الإنسان إلى طريق مخالف للعقل والذكاء، فيندفع إليه
اندفاعا.ويبدو من قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أن بني إسرائيل ارتكبوا بعض المعاصي
بصدد المن والسلوى أيضًا.وموضوع السلوى كما أسلفت هو من الموضوعات التي تخلط فيها التوراة
وتتخبط، وأما المن فنجد فيها عصيانهم بشأنه.تقول التوراة أن موسى منعهم بأمر الله من ادخار المن
عندهم، ولكنهم لشدة جشعهم كانوا يدخرونه.وكذلك منعهم من جمعه يوم السبت، ولكنهم خرجوا
يوم السبت الجمعه فلم يجدوه (خروج ۱٦ : ۱۹ ،۲۹).وتشير كلمات القرآن الكريم هذه والآيات القادمة
أيضًا إلى أنهم وقعوا في مثل هذا العصيان أو كفروا بنعمة السلوى.وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ
لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) (٥٩).شرح
الكلمات:
۲۹۵
Page 358
القرية: الضيعة؛ المصر الجامع (مدينة كبيرة)؛ وقيل كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا؛ جمع
الناس..قريت الماء في الحوض: جمعته فيه.وقيل المدينة ما حولها سور والقرية ما ليست كذلك
(الأقرب).الباب المدخل؛ أو ما يُسَد به المدخل (الأقرب).سُجدًا : راجع معاني الكلمة في آية ٣٥.:
حطة مصدر من استحط فلانًا :وزره سأله أن يحطه عنه.وحطة: خبر لمبتدأ محذوف وتقديره (أمرك أو
مسألتنا حطة) (الأقرب).وقوله تعالى: قولوا حطة] أي حُط عنا ذنوبنا (المفردات).نغفر : غفر الشيء غفرا : ستره غفر الله له ذنبه غطى عليه وعفا عنه غفر الله الأمر بغفرته: أصلحه بما
ينبغي أن يصلح به (الأقرب).خطايا: الخطيئة الذنب، وقيل المتعمد منه.والفرق بين الخطيئة والإثم أن هذا يكون عمدًا، والخطيئة تكون
عمدًا وبدونه (الأقرب).نزيد زاد الشيء: نما.وزاد الشئ أنماه.وزاد فلان أعطى الزيادة فمعنى : [ستريد]: سننمي؛ سنعطي
المزيد.المحسنين: أحسن إليه وبه عمل حسنًا وأعطاه الحسنة وأحسن أتى بالحسن.أحسن الشيء جعله
حسنًا وأحسن عملاً علمه علمًا حسنًا، يقال فلان يُحسن القراءة (الأقرب).التفسير قوله تعالى : [ ادخلوا الباب سُجدًا] يعني ادخلوا المدينة مطيعين متخلقين بأخلاق تليق بأمة نبي
أنبياء الله تعالى..حتى تتركوا في أهلها أثرًا طيبًا.من
وقوله تعالى: [قولوا حطة يعني ادعوا الله تعالى أن يعفو عنكم تقصيركم حتى لا تؤثر حياة المدينة فيكم
تأثيرا سلبيًا.لقد مرَّ بنو إسرائيل أثناء عبورهم برية سيناء إلى أرض كنعان بقبائل تقطن القرى والمدن
(موسوعة الكتاب المقدس)، وكان مسموحا لهم أن يدخلوا هذه القرى لبعض الوقت ترويحا لأنفسهم.وقد أشير في هذه الآية إلى إحدى هذه القرى أو المدن، و لم يصرح القرآن باسمها و لم يكن هناك داع
لذلك، لأنه لا يسرد لنا تاريخ خروج بني إسرائيل وإنما يشير إلى أحداثه تكميلاً لبيان مواضيعه.إنه يهتم
بالعبرة التي في القصة وليس بالأسماء والتواريخ.يقول: ادخلوها وتمتعوا بأطايب حياة المدينة لبعض
الوقت، وليكن سلوكهم أمام أهلها سلوك المؤمنين المطيعين، وداوموا على الدعاء والاستغفار حتى لا
تتأثروا من مساوئ أهلها.وإذا فعلتم هذا فلسوف نكبح جموح قلوبكم إلى الذنوب، ونعينها على الخير.٢٩٦
Page 359
وقوله تعالى: [وستريد المحسنين يعني أن ما ذكرنا من النعم ليست كل ما لدينا، بل لو أحسنتم وأطعتم
وصايانا حق الطاعة لزدناكم نعمًا وأفضالاً..أي إذا كانت قلوبكم تقاوم نزعات الشر الآن فلسوف
نزیدها قوة فتوفقون لأعمال البر أحسنها وأفضلها.والزيادة تعني النماء والإنماء الذي يمكن أن يتضمن أيضا البركة في الأولاد والأموال.فيكون معنى الآية:
إذا عملتم بوصايانا وأحسنتم العمل باركنا في ذريتكم فتكثرون وتعمرون القرى والبلاد الكبيرة.ولا
تمدوا أعينكم إلى ما يتمتع به أهل هذه القرية من زينة الدنيا وأموالها..بل استمروا في طاعة الله
والاستغفار نبارك في أموالكم ونضاعفها لكم أضعافا ونعطكم أحسن مما في أيديهم.يقول القسيس (ويري) معلقا على هذه الآية بأن خَلْطَ القرآن بين هذه الأحداث التي وقعت بعضها في
برية سيناء، وبعضها في الأرض المقدسة، وبعضها لم تحدث أصلاً في أي مكان، ثم سَرْدَه إياها بترتيب
يخالف الترتيب الواقعي لدليل على أن نبي العرب كان، والعياذ بالله، يجهل أحداث التوراة جهلاً تامًا.إني دائما أنظر إلى هذا القسيس نظرة إشفاق، فقد أضاع عمره كله عبيًّا.كان من واجبه كقسيس أن
يدرس كتابه المقدس أكثر من أي كتاب آخر، ولكنه للأسف لم يدرسه إلا قليلاً.ولو أنه درسه
بتأمل لم
للحظة أنه مرجع تاريخي موثوق به يسرد الأحداث سردًا صحيحًا منطقيًا.إن بيانات كتابه
يتصور
المقدس متعارضة تعارضًا يجعل من المستحيل على أي شخص أن يعين على ضوئها تاريخ خروج بني
إسرائيل من مصر.بل إن الكتاب النصارى أنفسهم يعترفون بأن تاريخ الخروج المذكور في التوراة لا
يستحق الاعتبار، كما أن ترتيب أحداثه ترتيب غير سليم.كتب البروفسور ستاننج J.F.Stanning ، من جامعة أكسفورد: لقد كتبوا في بداية سفر الخروج
أحداثا وقعت في آخر أيام هجرة موسى.كما أن حادثتي تحلية موسى لمياه بحيرة (مارا)، ونزول المن
والسلوى..لم تردا في التوراة في مكانهما الواقعي..لأن حادث المنّ وقع بعد الذهاب من سيناء، ولا
علاقة له بحادث طيور السماني.وكذل جاء في سفر العدد حادث الطيور في آخر أيام الهجرة، ولكن
سفر الخروج ذكره في بداية الهجرة(الموسوعة البريطانية).لقد سبق أن ذكرت أن التوراة (سفر الخروج ١٦: ١١-١٢) تذكر أن الله تعالى بشر موسى بأنكم
ستأكلون طيور السماني قبل حلول المساء كنعمة إلهية منه ولكن التوراة تعارض نفسها فتقول (سفر
العدد ۱۱ : ۳۳ أن عقاب الله تعالى نزل ببني إسرائيل الجمعهم هذه الطيور، وأهلك منهم الآلاف قبل أن
يمضغوا لحمها.فسفر الخروج يعتبر قدوم الطيور نعمة، وسفر العدد يصفها نقمة؛ وكلا السفرين عند
أهل الكتاب وحي نزل على موسى!
۲۹۷
Page 360
أنه
هل يستطيع أحد التوفيق بين هذين البيانين؟ والآن إذا صدق القرآن بيان سفر الخروج لقال القسيسون
إن صاحب القرآن جاهل بالتاريخ لأنه يعارض ما ورد في سفر العدد من التوراة! ولو أن القرآن وافق ما
ورد في سفر العدد لقالوا إن صاحب القرآن لا يعرف التاريخ لأنه يخالف ما ورد في سفر الخروج ولو
وافق الاثنين معًا لكان حاله مثل التوراة في تقديم بيانات غير معقولة.إن القرآن لم ير حاجة للخوض
فيما ورد في سفري الخروج والعدد، وإنما حكى الله ما كان في علمه أحداث.وهكذا صدق القرآن
أحداث التوراة، ونفى ما ورد فيها من أحداث غير حقيقية وزاد بيان ما سكتت عنه
من
التوراة وكان فيه عبرة..فالله تعالى ليس بحاجة لأن يتبع ما كتبه مصنفو التوراة.ما كان صادقًا
من
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ) (٦٠)
الكلمات :
شرح
رجزًا: الرجز؛ القذر؛ عبادة الأوثان العذاب، الشرك (الأقرب).والرجز لغةً الاضطراب وتواتر الحركة،
عذاب الزلزلة رجزًا.وسُمي الشرك وعبادة الأوثان رجزًا لأن اعتقاد المشرك يشوبه
ولذلك سمي
الاضطراب.التفسير : يقول الله تعالى لبني إسرائيل: إنكم كفرتم بنعمنا.لقد أردنا أن تروّحوا أنفسكم وتتمتعوا
بطيبات القرية لفترة من الزمن ليزول عنكم التعب والملل، ولكنكم استهزأتم بأوامرنا ونعمنا وقلتم كلمة
لم تؤمروا بها.أُمرتم بأن تقولوا [حطة..أي أن تدعوا بالمغفرة وستّر ضعفكم، ولكنكم استبدلتموها
=
من
بقولكم: (حنطة) أي نريد القمح.يبدوا أنهم عندما دخلوا القرية خطرت ببالهم أرغفة ساخنة من الخبز
واستولى عليهم الشوق إليها وانشغلوا بها عن وصية الاستغفار، فأخذوا يرددون (حنطة) بدلاً
[حطة]، فعذبهم بسبب هذا الاستهزاء والعصيان.انظروا كيف أن هذا الخطأ الذي يبدو بسيطا قد جلب غضب الله عليهم! والسبب وراء ذلك أن
الإنسان لا يستطيع أن يتقدم في الخير إلا إذا كان جادًا..وإلا ما أمكن له أبدًا أن يحقق ارتقاء روحانيا
أو نفعًا قوميًا مهما قام به من عبادات أو قدم من خدمات، بل إن هؤلاء الهازلين يدفعون أحيانًا قومهم
إلى هوة الدمار الرهيب..وحقيق بهم أن يغدروا بقومهم أو ملتهم بسبب دوافع تهييج أو طمع تافه.وللأسف قد أصاب المسلمين هذه الآفة اليوم.دعنا من العلمانيين الذين لا يهتمون بالدين..فإن المتدينين
كالمشائخ والمتصوفين أيضًا يقعون في الاستهزاء بالدين.فيتلون مثلاً آية في غير مناسبتها، أو
منهم
۲۹۸
Page 361
يذكرون حديثا على سبيل المزاح، مع أن كلام الله تعالى ورسوله أسمى من
الله تعالى ورسوله أسمى من أن يُستهزأ به ويتخذ ذريعة
للنكات الفكاهية.إن الاستهزاء بهما جد خطير.إنه يسود القلب، ويميت الروحانية، ويقتل التقوى.والتغلب على هذا الإثم لا يتطلب من الإنسان جهدًا كبيرًا، وإنما يكفيه قدر من الحذر والاحتياط.وبهذا
الجهد البسيط يستطيع إصلاح قلبه إصلاحًا يهيئه للقيام بمهمات خطيرة.فلا تتخذوا آيات الله وكلام ورسوله ذريعة للسخرية والاستهزاء أبدًا إن هذه المعصية لا متعة فيها، بل
إنها تفتك بقلب الإنسان فتكا.والأولى بكم أن تخشع قلوبكم عند سماع كلام الله تعالى ورسوله.فمن
أحبه الإنسان استمع لذكره واحترم قوله هل يسخر عاقل من أبيه وأمه؟ فإذا كانوا لا يستهزئون
بآبائهم وأقوالهم فكيف يستسيغون السخرية بالله تعالى ورسوله وبكلام الله ورسوله..ليضيعوا في لحظة
ما كسبوه في عبادة العمر كله؟ حَذارِ ثم حَذار!
سعد
قوله تعالى : فأنزلنا على الذين ظلموا رجزًا من السماء ]..العذاب الذي أصابهم إنما أتاهم من الأرض،
ولكن الآية الكريمة تذكر أنه نزل من السماء.وهذه الكلمات أوضح وأقوى من الكلمات الواردة في
الأحاديث النبوية التي تناولت نزول المسيح المنتظر، إذ ليس فيها حديث صحيح يذكر أنه (يتزل من
السماء) بل (يترل) فقط.أما هنا فتقول الآية بصريح العبارة أن الله تعالى أنزل عليهم العذاب من
السماء.وقد قال الصحابة والأئمة أن الرجز معناه العذاب العام، أو الطاعون أو البَرَد.فقال الشعبي:
الرجز إما الطاعون وإما البرد.وقال سعيد بن جبير المفسر الشهير : هو الطاعون.وذكر ابن أبي حاتم عن
بن مالك وأسامة بن يزيد وخزيمة بن ثابت الصحابيين عن رسول الله ﷺ : إن هذا الوجع والسقم
رجزٌ عُذب به بعض الأمم قبلكم (تفسير ابن كثير).والطاعون مرض مادي أرضي، تتهيأ أسبابه كغيره من الأمراض على هذه الأرض، ولكن الله تعالى
استخدم له عبارة الترول من السماء.وإذا قال أحد بأن الله تعالى من السماء يصدر الأمر بتفشي
الطاعون، لذلك استخدم كلمة التزول من السماء؛ فأقول : نفس الحال بالنسبة للمسيح.فهل ينزل الأمر
بتفشي الطاعون من السماء ولا يتزل الأمر من السماء بمجئ عيسى؟ فإذا كان الطاعون يُعبر عن تفشيه
بتروله من السماء، فلماذا لا يُقال لأنبياء الله الذين يعيشون ويبعثون من الأرض أنهم ينزلون من السماء؟
یک
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦١)
شرح الكلمات :
۲۹۹
Page 362
استسقى استسقى الرجل : طلب السقي وإعطاء ما يشربه (الأقرب).قوم القوم: الجماعة من الرجال خاصة، وقيل تدخله النساء على تبعية.وقوم كل رجل شيعته وعشيرته.وقوم النبي: من يُبعث إليهم رجالاً ونساءً (اللسان).ويقال لجماعة الرجال قوم لأنهم يقومون بإنجازات
كبيرة (الأقرب).قلنا: أي أوحينا راجع شرح الكلمات في الآية ٣١.فانفجرت: فَجَر الماء يفجر: بجسَه وفتح له طريقًا فجرى.فجر القناة: شقها، وقيل شقها شقا واسعا.انفجر الماء: سال وجرى (الأقرب).فمعنى :انفجرت تدفقت؛ سالت وجرت.مشربهم المشرب الماء؛ الوجه الذي يُشرب منه ؛ شريعة النهر (الأقرب).لا تعثُوا عَلَي يَعْثَى أفسد؛ بالغ في الفساد أو الكبر أو الكفر (الأقرب).وعني: أفسد أشد الفساد.والعثو: أشد الفساد (اللسان)، العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يُدرَك حسا، والعَتَيُّ فيما يُدرك
حكمًا (المفردات).فمعنى لا تعثوا لا تفسدوا أشد الفساد ؛ لا تتمادوا في الفساد والكبر والكفر.مفسدين: أفسد الشيء ضد أصلحه.أفسد بين القوم : أوقع بينهم العداوة والفرقة.الفساد: الجدال؛
النقصان ؛ أخذ المال ظلمًا؛ القحط.(الأقرب)
التفسير: تتحدث هذه الآية عن نكران بني إسرائيل لنعمة أخرى.لقد كانوا بحاجة إلى الماء في موضع
كان نزول المطر فيه شحيحا.فدعا موسى ل للسقيا.فأمره الله تعالى أن يضرب حجرًا معينًا.العليا وعندما
ضربه تفجرت منه اثنتا عشر عينًا.ووجدت كل جماعة منهم ماءً وعينت لها موردًا.يعترض القساوسة على هذه الآية ويقولون أن التوراة لم تذكر مثل هذا الحادث، وهذا عندهم دليل على
جهل صاحب القرآن! ولكن كما أسلفت لا اعتبار بورود حدث في التوراة أو عدم وروده فيها.لا
شك أن المؤرخ مضطر للتقيد بسرد أحداث عن بني إسرائيل كما ذكرت في التوراة أو في كتب التاريخ
الأخرى، ولكن القرآن الذي يعلن أنه وحي الله تعالى، لا حاجة له ليلتزم فقط بما جاء في تلك الكتب.أفلم تقع أحداث في الدنيا سوى ما ذكرته التوراة وكتب التاريخ؟ وهل هناك خطر على الله جل وعلا
ألا يذكر إلا ما جاء فيها؟ إن القرآن المجيد كلام الله تعالى، وأنى لعلم المؤرخ أن يبلغ
شأن العلم الإلهي؟
من حق منكر القرآن أن يطالبنا بإثبات أنه كلام الله حقًّا، فإذا أثبتنا أنه كذلك فلا بد من
شهادة القرآن هي الأوثق والأقوى من شهادة مؤرخ وشهادة كتاب منسوخ أو ممسوخ.ولكن لا يجوز
لنا أن نلبس كلمات القرآن معاني معارضة للقرآن نفسه، أو للعقل الذي خلقه الله تعالى، أو للغة.أن تعتبر
Page 363
وأرى من الضروري هنا ذكر أن المستشرق سيل (Sale)، قد كتب في ترجمته للقرآن الكريم أن سائحًا
في القرن الخامس عشر ذكر أنه وجد آثارا لاثنتي عشرة عينًا في صخرة بجبل حوريب وإن كانت بعضها
قد جفت.(ترجمة القرآن، سيل)
لكافية
الله
ثم نجد في التوراة الأمر الإلهي لموسى بضرب صخرة في جبل حوريب، ولكن لا نجد هناك ذكر اثنتي
عشرة عينا (خروج٦:١٧).وفي موضع آخر نجد ذكر اثنتي عشرة عينًا في مكان آخر، و لم يذكر هناك
الضرب بالعصا (خروج ٢٧:١٥).على أية حال..هذه الشهادة من سائح نصراني على وجود اثنتي عشرة عينًا في جبل حوريب
لإفحام هؤلاء المعترضين النصارى الطاعنين في القرآن الكريم.لقد أخطأ بعض المفسرين أيضًا في فهم هذه الآية..فظنوا أن موسى كان يحمل معه حجرا، وكلما
احتاج بنو إسرائيل للماء يضربه بالعصا ويفجر منه اثنتي عشرة عينًا ! الحق أن هذا القول لا يصف معجزة
إلهية وإنما يعبر عن مهزلة عقلية.فإذا كان الله تعالى هيأ في بعض المناطق الماء لبني إسرائيل بإنزال المطر من
الغمام كمعجزة لزم أن تكون معجزة تدفق الماء من الحجر بضرب العصا أيضًا خاضعة لسنن
الكونية.إن المعنى الحقيقي للآية هو أن الله تعالى أمر موسى بضرب حجر بعصا فانفجرت منه بالضرب
اثنتا عشرة عينًا والذين تيسر لهم زيارة الأماكن الجبلية يعرفون أنه عندما ينصهر الجليد فوق قمم الجبال
يرتفع مستوى الماء الباطني الجاري تحت وجه الأرض، ويمكن أن يخرج متدفقا بمجرد الضرب من عصا.ومثل هذه العيون توجد أيضًا في البراري..وهي تحدث طبقا لسنن كونية معروفة.وتكثر مثل هذه
المواقع في صحراء الجزيرة العربية حيث الواحات ذات عيون الماء والنخيل.لقد وجه الله تعالى موسى
بالوحي إلى موضع كهذا، وكان الماء قريبًا من سطح الأرض، وكان عليه حجر، فأمره الله تعالى أن
يحركه بالعصا ليتدفق الماء من ورائه، ففعل.ليست المعجزة أن الماء خرج من الحجر، كما ليست المعجزة
أن الماء تولّد فجأة في باطن الحجر وخرج منه وإنما المعجزة أن الله تعالى دله بالوحي على وجود
وراء حجر معين يسد جريانه.ولا مبرر لنكران مثل هذه المعجزة، كما لا داعي أيضًا لتصويرها بصورة
مخالفة لسنة الله في الكون.الماء
ويبدو ان الحجر لم يكن كبيرًا ولا عميقًا فتشقق بالضرب بالعصا، وخرج الماء من اثني عشر موضعًا من
هذه الشقوق.ومن خبر هذه الجبال يعرف أن العديد من العيون تتدفق من موضع واحد أحيانًا.وقد
شاهدت بنفسي في موضع جبلي بكشمير عيونا كثيرة تفيض من مساحة صغيرة لا تتجاوز أمتارا، وربما
كان عددها اثنتي عشرة عينًا.
Page 364
ويبدو
أن الغرض من عدد اثني عشر أن بني إسرائيل كانوا قبائل عديدة كثيرة الشجار فيما بينها، وهكذا
هيأ الله تعالى لكل منها موضع شرب على حدة.وقوله تعالى: [قد علم كل أناس مشربهم لا يعني أن الله تعالى عين لكل قبيلة موضع شرب لهم، وإنما
القوم أنفسهم اتخذوا مواضع شرب لهم.الماء كان يتدفق بوفرة ومن مواضع متفرقة ليتيسر لبني إسرائيل
الحصول على كفايتهم منه بدون مشقة، فلا يقع بينهم خصومة أو شجار.وقوله تعالى: [كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين..لقد هيأ الله تعالى لكم في كل
موضع كفايتكم من الطعام والشراب، فاشكروا صنيعه وتوكلوا عليه ولا تتكالبوا على الأسباب.إن كل
فساد في الدنيا يرجع إلى الاعتماد على الأسباب فيظن الإنسان أنه إن لم يجد أرضًا كذا أو مسكنا كذا
أو دابة كذا لأصابه الضرر والخسران..فيتخاصم مع أخيه وتستمر سلسلة لا تنتهي من الفساد والفتنة.يقول الله تعالى هنا لبني إسرائيل: انظروا كيف حررناكم من كل هذه المتاعب من بحث عن طعام
وشراب وغير ذلك، فإذا كنا نسد كل حاجاتكم فلا داعي للفساد والتباغض والشجار مع الجار.يجب
ألا تفسدوا على الأقل في هذه الأيام، كما يجب أن تتجنبوا الفساد في المستقبل تذكرًا لهذه النعم.وكما سبق أن ذكرنا أن العُثُو هو أشد الفساد فمعنى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين] لا
تفسدوا في الأرض متعمدين ، لأنه قد يصدر من الإنسان فعل يترتب عليه فساد ولكن بدون قصد وتعمد
منه، فعلى المؤمن أن يسعى لاتقاء مثل هذه المواقع أيضًا، وعلى الأقل يجب أن يتجنب أعمالاً وأمورًا
يعرف أنها تؤدي إلى الفساد.وهذا مما تعنيه الآية.وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
وَقَثَّائِهَا وَفُومهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذي هُوَ أَدْنَى بالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (٦٢)
شرح الكلمات
نصبر صبرتُ نفسي على كذا حبستها الأقرب).الصبر لغة المنعُ والحبس، وفي الاصطلاح حبس
النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش (التاج).(لمزيد من
الشرح راجع شرح الكلمات في الآية ٤٦).
Page 365
بقلها : البقل ما ينبت في بَزْره لا في أرومة ثابتة.وقال ابن فارس كل ما اخضَرت به الأرض بقل.والفرق بين البقل ودق الشجر أن البَقْلَ إذا رُعِيَ لم يبقَ له ساق، والشَّجرُ تَبقَى له سُولٌ وإِن دَقَّتْ
(التاج).والبقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا جَل (اللسان).قثائها: القثاء نوع من الفاكهة يشبه الخيار تسميه عوامنا (المقتى) (الأقرب).فومها: الفوم لغة في الثوم.والفوم الحنطة الحمص الخبز؛ وسائر الحبوب التي تخبز؛ السنبلة (الأقرب).تستبدلون: استبدله واستبدل به: أخذ هذا مكان ذاك (الأقرب).أدنى مشتق من الدنو عند البعض بمعنى الأقرب، وعند الآخرين من الدناءة أي الأخس والأرذل
(اللسان).ويعبّر بالأدنى تارة عن الأصغر فيقابَلُ بالأكبر، وتارة عن الأرذل فيقابل بالخير، وتارة عن
الأول فيقابل بالآخر، وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى.(المفردات).اهبطوا هبط من موضع إلى آخر: انتقل إليه(الأقرب).مصراً : المصر: الحاجز بين الشيئين؛ الحد بين الأرضين خاصة ؛ وقيل الحد في كل شيء؛ الكورة أي المدينة
والصقع؛ وكل كُورة يقسم فيها الفيء والصدقات (الأقرب).ضربت ضربه بيده وبالعصا: أصابه وصدمه بها.ضرب على يديه: أمسك.ضرب القاضي على يد
فلان: حجر عليه ومنعه التصرف.ضرب عليهم الجزية : وضعها وأوجبها عليهم وألزمهم بها.ضرب عليه الذلة : أذلَّه (الأقرب).ضُربت عليهم الذلة: التحفوها (المفردات)..باءوا باء رجع باء به رجع به.(الأقرب) باء بذنبه احتمله وصار المذنب مأوى الذنب؛ كان عليه
عقوبة ذنبه (اللسان).غضب : الغضب : ثوران دم القلب إرادة الانتقام، وإذا وُصف الله تعالى به يراد به الانتقام دون غيره
(المفردات).لمزيد الشرح راجع شرح الكلمات للآية (٧).باء بغضب من الله : حلَّ مُبوَّءًا ومعه غضب الله أي عقوبته.و(بغضب) في موضع حال..أي رجع وجاء
وحاله أنه مغضوب.واستعمال (الباء) تنبيهًا على أن مكانه الموافق يلزم فيه غضب الله فكيف غيره من
الأمكنة (المفردات).فمعنى [باءوا بغضب من الله] : صاروا عرضة لغضب الله ؛ صارت بيوتهم محلاً لغضب الله.يقتلون: سبق شرحها في الآية ٤٥.ومن معاني قَتَلَه أهلكه قاطعه أذله؛ أبطل عمله.وعلاوة على
ذلك نضيف ما يلي: يقال هو قاتل الشتوات(جمع شتاء) أي يُطعم فيها ويُدفئ (اللسان).فمعنى :
يقتلون النبيين]: يهلكونهم؛ يقاطعونهم؛ يسعون إلى إبطال أعمالهم؛ يحاولون إذلالهم.
Page 366
الحق: حقه يحقه حقا: غلبه على الحق.وحق الأمرُ : وجب وثبت.حق الأمر: أثبته وأوجبه؛ كان على
يقين منه.وحق الخبر: وقف على حقيقته (الأقرب).الحق يقال في الفعل والقول والواقع بحسب ما يجب
وفي الوقت الذي يجب (المفردات).عصوا: عصاه ؛ خرج عن طاعته وخالف أمره وعانده (المفردات).يعتدون اعتدى عليه ظلمه الأقرب).الاعتداء: مجاوزة الحق (المفردات).الاعتداء والتعدي والعدوان:
الظلم.اعتدى فلان على الحق أو فوقه: جاوز عن الحق إلى الظلم (اللسان).فمعنى: [يعتدون]:
يتجاوزون الحق؛ يظلمون.التفسير : تذكر هذه الآية نكرانًا آخر للجميل ارتكبه بنو إسرائيل، ويبدو أنه يتعلق بنعمة المن والسلوى.لقد عاش بنو إسرائيل على طعام المن والسلوى مدة طويلة، ومن حين لآخر كانوا يدخلون بعض المدن
ويمكثون فيه للتمتع بما فيها من طعام وشراب.ولكنهم لم يستطيعوا الصبر على طعام واحد في البراري،
وإن لم يكن واحدا بل كان متنوعًا.كانوا معتادين على العيش في مدن مصر عيشة مدنية، مولعين
بالمشويات والمقليات وغيرها من لذائذ الطعام الذي يأكله أهل الحضر، فتبرموا من أكل الأغذية البرية.وهكذا لم يُقدِّروا الحكمة من وراء هذه المعيشة والأغذية.وبلغ بهم الضيق أن قالوا لموسى لن نصبر عن
طعام واحد.إذا كنت تصبر أنت عليه ولا ترى حاجة إلى استبداله..فعلى الأقل ادْعُ الله لأجلنا كي
يخرج لنا من الأرض أنواع الخضروات والبقول..أي يسمح لنا بالإقامة والاستقرار في مكان نستطيع فيه
الزراعة وإنتاج هذه المحاصيل من غلال وبقول وخضار فأجابهم الله تعالى: أتطلبون الطعام الأقل نفعًا
لكم وتتخلون عن الأجود والأنسب؟
لقد اختلف المفسرون في معنى خير وأدنى فقال البعض أن المراد من خير] اللحم ومن [أدنى] الخضار.ولكن هذا خطأ.فالخضار خير واللحم أيضًا خير.ولم يأمر الله تعالى في الشرع أنه إذا وجد طعام جيد
فلا تأكلوا غيره.فالنفس البشرية أحيانًا تشتهي العدس مع تيسر لحم الطير، وليس في هذا ما يثير سخط
الله
الحق أن في كلمتي (خير، وأدنى مقارنة بين ما كانوا يجدونه في البرية من أغذية بدون جهد وتعب، وبين
ما يحصل عليه أهل المدن بعد سعي ومشقة.لقد تركهم الله تعالى في هذه البرية لكي يزيل عنهم أثر
العبودية ويُطهرهم من المعاصي وسيئ العادات التي ترسخت في نفوسهم بصحبة المصريين، ولكي لا تثور
فيهم نزعات الشرك نتيجة مخالطتهم الأمم الأخرى، فقد أراد الله تعالى لهم أن يظلوا في صحبة موسى
٣٠٤
Page 367
باستمرار ليرسخ فيهم عقيدة التوحيد وقد وفّر الله لهم كل ما يتيسر في البادية من أطعمة..أما
الخضروات والأطعمة الشهية فلا تتيسر إلا في المدن والقرى.إذا، فلم يكن مراد بني إسرائيل من مطالبتهم مجرد تلك الأطعمة، بل كانوا في الحقيقة يريدون أن يُسمح
لهم بالعيش في المدن والقرى لأنهم تبرموا من الحياة البدوية.ولا يعني قوله تعالى: [أتستبدلون الذي هو
أدنى بالذي هو خير..لماذا تريدون الحنطة والخضراوات والبقول بدلاً من الكمأة والسماني والعسل
وغيرها..وإنما المراد : لماذا لا ترغبون عن هذه المعيشة المفيدة التي تؤهلكم للحكم والملك وحياة العزة
والكرامة..إلى معيشة لن تبرحوا فيها مزارعين عاديين؟ فمطالبتكم هذه صادرة إما عن حمق وغباء، وإما
عن عدم ثقة وإيمان في وعود الله تعالى وبشاراته.تظنون أن موسى يكذب عليكم وتقولون في أنفسكم:
هيهات أن يكون لنا مُلك وحُكم في يوم من الأيام! فلماذا نحرم أنفسنا من أن نكون فلاحين على الأقل.نأكله في مصر
مجانا
منهم
ولما كان كلا السببين يدلان على عدم الإيمان وفتور الهمة عنفهم الله تعالى وأبدى لهم غضبه.لقد ذكر عدم صبرهم على طعام واحد في التوراة حيث قال بنو إسرائيل: (قد تذكرنا السمك الذي كنا
والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم) (عدد ٥:١١).قوله تعالى : [ اهبطوا مصرًا ]..ذهب بعض المفسرين تجاهلاً لقواعد اللغة العربية أن مصرًا] تعنى
مدينة مصر العاصمة المعروفة، وقد هلل لجهلهم هذا كتاب النصارى وسخروا بسببه من القرآن الكريم.ورأي جهلة المفسرين هؤلاء واعتراض كتاب النصارى كلاهما باطل.إن كلمة (مصر) علم غير منصرف
لا يقبل التنوين بحسب قواعد العربية، وقد وردت في القرآن الكريم غير منصرفة كقول يوسف
ال لأهله : [ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين] (يوسف: ۱۰۰)، وقول فرعون أليس لي ملك
مصر (الزخرف: ٥٢).وأما [مصرًا] في آيتنا هذه فتعني بلدة أيا كانت وقال الله تعالى لهم: ادخلوا أية
بلدة أو مدينة تجدوا فيها الأشياء التي تطلبونها.وقوله تعالى: [وضُربت عليهم الذلة..ألزمهم الله الذل والهوان لأنهم فضلوا الزراعة على عيش يؤهلهم
للحكم والسلطان في الأرض المقدسة التي وعدوا بها.ومن عجيب قدرة الله تعالى أن بني إسرائيل وإن
كانوا قد نالوا الملك بحسب البشارات الإلهية إلا أن إخلافهم المتكرر لعهودهم مع الله تعالى صار وبالاً
عليهم حتى حُرموا من الملك فيما بعد لأكثر من عشرين قرنا و لم يبق لهم إلا أعمال التجارة والزراعة.جاء في شرح معاني الكلمات أن باء بالشيء يعني أنه صار محلاً دائما له.فيعني قوله تعالى [وباءوا بغضب
من الله أنهم حلوا البلاد وهم يحملون غضب الله فوق رؤوسهم، وكأن الموطن الذي يلجأ إليه الإنسان
وراحته صار مصدر عذاب وشقاء لهم.وتؤكد الأحداث أن أرض كنعان موطن بني
إسرائيل لم تزل بؤرة للمصائب والآلام.ليكون
أمنه
سبب
٣٠٥
Page 368
قوله تعالى: [ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون].كان إنكار آيات الله تعالى بسبب معارضتهم لأنبيائهم.لما ضاع احترامهم للأنبياء ضاع منهم
احترامهم لكلام الله تعالى وإيمانهم ،به وكان سبب معارضتهم الأنبياء أنهم كانوا عاصين آثمين.وإن
العارفين بقاعدة العلّة والمعلول يسعدهم أسلوب القرآن الكريم، حيث يذكر الخير أو الشر ثم يُتبعه ببيان
سببه وأصله..حتى يعرف الإنسان مصدر الشر فيقطعه من جذوره فلا يعود مرة أخرى.وقوله تعالى: ويقتلون النبييين بغير الحق لا أن إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم قتلاً جسديًا؛
فهُم لم يقتلوا إلى ذلك الوقت أيا من أنبيائهم.لقد ورد القتل في اللغة لغير القتل المادي أيضًا، ومن
معانيه: اللعنة؛ المقاطعة والإعراض؛ المساس بالشيء؛ إزالة تأثير شيء مثل الجوع والبرد والشراب؛
التخريب والإيذاء.وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذه المعاني : قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات
الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذي يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم](آل
عمران:٢٢).هذه الآية تتعلق بزمن الرسول ﷺ، ولا يعني القتل هنا إلا أن الأعداء كانوا يهاجمونه أو
الله
بني
يعني
بني
يحاولون قتله، أو يعرقلون جهوده..لأنهم لم يقتلوا رسولنا الله وما كانوا ليقتلوه وقد عصمه الله تعالى.كذلك جاء في القرآن المجيد: [وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي
وقد جاءكم بالبينات من ربكم ] (غافر : ۲۹)..فمعنى القتل هنا فقط أنهم أرادوا قتل موسى.فايتنا هذه يمكن أن تعني أن
إسرائيل كانوا يريدون قتل موسى وهارون أو كانوا يقاطعونهما، أو
يعرضون عنهما، أو يخاصمونهما، أو يعرقلون طريقهما في نشر الدعوة.ومن أجل ذلك كانوا يُحرمون
من الخير ويتمادون في الشر.وكان السبب وراء معارضتهم لأنبياءهم أنهم كانوا أهل طيش تحتاج
طبائعهم إلى اتزان واعتدال.كانوا دائمًا يتجاوزون الحد في كل شيء.ومن كان طبعه هكذا يُحرم من
خير كثير، ويقع في كبار الذنوب.إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٦٣)
شرح
الكلمات :
هادوا: هاد الرجل يهود هودا: تاب ورجع إلى الحق.هاد المذنب إلى الله: رجع إليه.هاد في المنطق: أداه
بسكون ورفق هاد الرجلُ: دخل اليهودية (الأقرب).
Page 369
النصارى هم أتباع المسيح ابن مريم الناصري ، وهو جمع نصراني نسبة إلى بلدة (الناصرة) في
فلسطين.وقال البعض نسبة إلى بلدة (نصران).وقال آخرون أنه جمع نصري نسبة إلى قرية (نصرة)
(الأقرب).قوال الراغب: إن أتباع المسيح ابن مريم سموا نصارى لأنه عندما قال من أنصاري إلى الله
قالوا: نحن أنصار الله (المفردات)..ولكن هذا غير صحيح، والحق أن النصراني منسوب إلى قرية الناصرة.الصابئين: جمع صابئ.صبأ الرجل صبنًا: خرج من دين إلى دين آخر.والصابئون قوم يعبدون النجوم؛
وقيل قوم يزعمون أنهم على دين نوح، قبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار (الأقرب).صالحًا: صلح الشيء: صار مناسبًا لا عيب فيه.هذا يصلح لك: يناسبك.صالحه: وافقه.وأصلح بين
القوم أزال ما بينهم من خلاف (الأقرب).فالعمل الصالح هو الخالص من الفساد وذو الفائدة والمناسب لمقتضى الحال.أجرهم: الأجر: الثواب (الأقرب والأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويًا
(المفردات).خوف وحزن راجع) الآية ٤٠.التفسير قوله تعالى: [هادوا] هنا بمعنى تهودوا.وردت كلمة (هاد) في العبرانية أيضا بنفس هذا المعنى.وكلمة يهودي تعريب لاسم عبراني أطلق على بني إسرائيل بعد السببي إلى بابل.فكانوا يسمون تابع
الديانة اليهودية (بيهودي) بالعبرانية و(يهوداي) بالأرامية، و(يا أودائي) بالبابلية القديمة، وكلها مشتقة من
اسم يهوذا المنطقة الجنوبية من دولة بني إسرائيل، التي كان يحكمها ذرية سليمان العليا وقبيلته، وكانت
عاصمتها أورشليم (موسوعة الكتاب المقدس والموسوعة اليهودية).كانت ذرية يهوذا بن يعقوب ذوي
قوة في هذه المنطقة، وكان اسمها بالعبراني بيهودا، فسُمِّي ساكنها بيهودي.ولقد سبقت الإشارة إلى
انقسام دولة بني إسرائيل إلى شمالية تسكنها القبائل العشر التي تمردت على حكم رحبعام بن سليمان؛
وإلى جنوبية تضم قبيلتي بنيامين ويهوذا، وكانت تحكمها ذرية سليمان وقبيلته يهوذا.لقد ضلت القبائل
الشمالية، واقتصر بعث الأنبياء في أهل الجنوب، ولذلك سميت المنطقة باسم اليهودية تمييزا لها عن سائر
بني إسرائيل وإشارة إلى أن دین هو الصحيح.واشتق اصطلاح (يهودي) للدلالة على هذا المعنى،
ثم عرَّبها العرب في لغتهم.ولما كانت كلمة (يهود) تشابه صيغة المضارع للكلمة العربية(هاد)..صاغوا
لها صيغة الماضي (هاد) بمعنى دخل في اليهودية.ولكن كلمة (هاد) العربية لها معان مختلفة أخرى لا علاقة
أهلها
لهذه المعاني باليهود ولا تشير إليهم.فيجب ألا يغتر بها أحد ويربط بين مدلولاتها وبين كلمة(يهود).
Page 370
ويهودي تعني لغة: ساكن منطقة يهودا، واصطلاحًا: تابع صادق لدين موسى.والعجيب أنه كلما
ذكرهم القرآن الكريم مشيرًا إلى دينهم سماهم اليهود، وكلما تحدث عنهم كشعب سماهم بني إسرائيل؛
الكتاب المسيحيون القرآن الكريم بالجهل بتاريخ بني إسرائيل، في حين أن كتابهم الإنجيل
ومع
ذلك
يرمي
قد استخدم الأسمين استعمالاً خاطئًا، وعني باليهود الشعب الإسرائيلي، ولا يزال أهل الغرب يكررون
نفس
الخطأ
(راجع
تفسير
الآية
رقم.(٤١
وقوله تعالى: [والنصارى ويطلق عليهم أيضًا المسيحيون والناصرة التي يُنسبون إليها قرية في الجليل
وكانت تسمى في القديم بلدة المسيح لأنه أقام مع أهله فيها قبل أن يعتمد من يوحنا (يحيى) النبي عليهما
السلام (انظر متى ١٤:٤، مرقص ٩:١، لوقا ٢٦:١، يوحنا ٤٦:١، أعمال ٣٨:١٠).وبسبب انتساب
أتباع المسيح إلى هذه القرية سماهم اليهود الأوائل في كتبهم (النصارى)، وأخذها عنهم العرب.ومن عجائب قدرة الله تعالى أن المناهضين للمسيح المنتظر في أمة محمد المصطفى أيضا يسمون أتباعه
(القاديانيون) نسبة إلى بلدة إمامهم.وهذه مشابهة تثير التأمل.وكان الرومان يسمون أتباع المسيح النصرانيين (أعمال ٥:٢٤) ، ولكن العجيب أن الناصرة التي نسب
إليها أتباع المسيح لم يزل اليهود يملكونها لقرون طويلة، أما النصارى فلم يسكنوها إلا أخيرا (موسوعة
الكتاب المقدس).ورد في الإنجيل أن الأب المجازي للمسيح، يوسف النجار، كان يقيم في الناصرة بناء على رؤية رآها:
(وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل.وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما
قيل بالأنبياء إنه سيُدعى ناصرا) (متى (۲۳،۲۲:۲).و لم يرد في التوراة أي ذكر لهذه الأنباء التي تحدث
عنها متّى..أي (يتم ما قيل بالأنبياء).فإما أن هذا النبأ إلهام لولي من أوليائهم أو أن كاتب الإنجيل ذكره
من عند نفسه فراراً من بعض الاعتراضات.قوله تعالى: [والصابئين].لا وجود لهذا القوم في أيامنا هذه، وإن قيل أن في العراق أقوامًا يُظن بأنهم من
أصل صابئ.وكانت هناك في القدم فرقة مسيحية تعيش في بابل تسمي بالصابئة وأيضا Elkesitas، وكانوا
يشبهون أتباع يوحنا المعمدان (موسوعة الكتاب المقدس).وكذلك أطلق اسم (الصابئين على أقوام تعبد النجوم كانت موجودة في وقت من الأوقات في العراق
والجزيرة العربية، وكانت عاصمتهم ( حرَّان) (الموسوعة البريطانية).الحق أن هؤلاء كانوا يسكنون في منطقة سبأ، وتحول الاسم من السابئين إلى الصابئين، وكانوا يعبدون
النجوم، ويؤمنون بشريعة سماوية.ولا يتبين من التاريخ هل تسموا بأنفسهم بهذا الاسم أم أطلقه الناس
Page 371
عليهم.ويروي التاريخ أن بعض هذه الطائفة كانوا لا يزالون في زمن الملك العباسي المأمون.قيل إن
المأمون رأى بعضهم في طريقه عند غزوه لبلاد الروم، وعندما لاحظ شعرهم الطويل ولباسهم العجيب
وطقوسهم الدينية الغربية أمرهم بأن ينضموا إلى دين من ديانات أهل الكتاب وإلا قتلهم.فاتخذوا اسم
(الصابئين) بعد مشورة فقهاء المسلمين (الموسوعة البريطانية).وأرى ان العبارة الأخيرة غير صحيحة،
فقد يكون فريق صغير من القبيلة الصابئة انفصل عنها وعاشوا طويلا بعيدين حتى نسوا اسم الدين، ولما
شرحوا ذلك للفقهاء أخبروهم أنكم الصابئة.ويذكر التاريخ الإسلامي أن أهل حران كانوا على اتصال
بحكومات المسلمين قبل المأمون بزمان.لا نستطيع من القرآن الكريم تحديد من هم الصابئون، ولكني أرى أنهم عند العرب أهل الكتب
السماوية..لأن الكثير منهم ينسبون هذه التسمية إلى أنفسهم.كان العرب يعرفون اليهود والنصارى
فأطلقوا عليهم هذين الاسمين، وسموا من سواهم من
الأمم التي حسبوا أن لها كتبًا سماوية بالصابئين.وعندما ظهر الإسلام أطلق المشركون على المسلمين اسم صابئين إلى أن استأنسوا باسم الإسلام
والمسلمين وكان إذا أسلم أحد قالوا صباً فلان ولا أرى حرجًا في أن نقول أن القرآن الكريم استخدم
هذه الكلمة بمفهوم العرب وعنى بالصابئين أهل الكتب السماوية سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم
ممن ينتسب إلى كتاب.والمراد بالآية الكريمة أن كل هؤلاء المنتسبين إلى أي دين سماوي، إذا آمنوا بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا
وعملوا بحسب هذا الإيمان فلن يهلكوا.وكما يتبين من تفسير الآيات السابقة فإن القرآن ابتداء من
الركوع الرابع عند قوله تعالى: [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة..]تناول موضوع
أن محمدا رسول الله ﷺ ليس بدءًا من الرسل، وإنما كانت قبله سلسلة طويلة من النبوة منذ القديم.فأول
إنسان كامل بعث نبيًا أيضًا.ثم في الركوع الخامس عند قوله تعالى: [يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم] بين أن النبوة
لم تقف عند آدم ال ، بل لم يزل الأنبياء يُبعثون إلى زمن قريب من محمد رسول الله.فقد وضع
موسى الة الأساس لسلسلة من الأنبياء في بني إسرائيل جيران العرب.كما ذكر أن الله تعالى أخبر عن
طريق إبراهيم العلم أنه سيقيم سلسلة عظيمة من النبوة عن طريق ابنيه إسماعيل وإسحاق كليهما.وما
دامت النبوة بدأت بأمر الله تعالى واستمرت وما دام الأنبياء السابقون قد أنبأوا بظهور نبي عظيم في بني
إسماعيل فلا مبرر للاستغراب من ادعاء أحد بالنبوة.ويتبين من الركوع الرابع أيضا أن كل نبي لقي معارضة، فآدم واجه الاعتراضات من قبل الشيطان
وذريته.أما الملائكة فلم يعترضوا ولكنهم أبدوا استغرابًا وحيرة لخلقه.ويتكرر نفس الأمر عند ظهور
Page 372
كل نبي حتى إنه لم يسلم من الاعتراضات موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام.فكيف يصح
إنكار محمد ﷺ بحجة أن بعض الناس يعترضون عليه في بعض الأمور؟
ثم ذكر القرآن قبل هذه الآية وبعدها أن الله تعالى عندما يخص قوما بفضله فإنه يتم عليهم فضله، ولكنهم
عندما يتعدون الحدود في الكفران بنعمه تعالى فإنه ينقل فضله إلى غيرهم.لقد انتقل فضل النبوة من آدم
مرورًا بأولاده الكثيرين إلى بني إسرائيل.وإذا كان فضل الله قد انتقل من بني إسرائيل بسبب أعمالهم
المنكرة المتواترة لزمن طويل إلى بني إسماعيل..فلماذا يغضبون من فعل الله هذا؟
ولماذا يغضب أهل مكة أيضًا؟ لا مبرر لسخط بني إسرائيل لأنهم بأنفسهم دَعُوا فضل الله تعالى من بيوتهم
دَعا، كما لا يجوز لأهل مكة أن يشتكوا من إضاءة سراج نور الله تعالى في بيوتهم، ومن نزول شآبيب
رحمة الله
على قلوبهم الذاوية.فليفرحوا بذلك فإنها مناسبة فرح وابتهاج وليست مناسبة حزن واكتئاب.وتبدو آيتنا هذه عجيبة في هذا السياق، وكأنها شاذة لا رابط بينها وبين ما قبلها وما بعدها..فأي رابطة
بين ذكر اليهود القدامى وبين المسلمين أو المؤمنين عامة والنصارى والصابئين؟ وجواب ذلك أن الآية
السابقة تناولت موضوع نزول الغضب الإلهي على اليهود بصورة دائمة لأنهم كانوا يقاومون أنبياء الله.وهذا موضوع مرعب تنخلع منه القلوب.والفطرة الإنسانية لا تطمئن إلى المرور به إلا إذا وجدت حلا
لمشاكلها.فعندما يقرأ الإنسان أن الله تعالى أنزل فضله على قوم نزولاً مستمرًا متواترا لمدة طويلة..ولكنهم عصوه مرة بعد أخرى، وقاوموا أنبياءه..فإنه يفكر في الطريق الذي يجنبه هذا المآل الخطير.فترد
الآية على هذا السؤال الفطري بأن المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا صادقًا
ويعملون صالحاً
بحسب إيمانهم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو الصابئين أو أي قوم آخر..سوف ينالون الثوب
من عند الله تعالى.هذا
أن الضمان لأمن دائم للإنسان هو إيمانه بالله واليوم الآخر وعمله الصالح.فلا تظنوا أن الإنسان يتعثر رغم إيمانه الصادق.كلا إن عثار بني إسرائيل واستحقاقهم غضب الله تعالى
عليهم لم يكن رغم صدق إيمانهم، بل ضعف إيمانهم فإذا كان اليهود قد تعثروا وكذلك النصارى
وغيرهم من الأمم الصابئة..فإنما كان ذلك لأنهم لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر إيمانا حقا، وأنهم لم يعملوا
صالحا بحسب إيمانهم.اليهود لم يكونوا صادقي الإيمان بالله تعالى ولذلك عبدوا العجل، ولم يكونوا
مؤمنين حقا باليوم الآخر ومن أجل ذلك تتبعوا كل ما يتعلق باليوم الآخر وحذفوه من كتبهم الدينية.ونفس الحال كان مع النصارى، فلم يكونوا صادقي الإيمان بالله تعالى وإلا ما اتخذوا عبدا
إلها، ناهيك عن ذكر العمل الصالح عندهم..لأن الكفارة أبطلت ضرورته!
فيقول الله تعالى : لا تخافوا من سوء حال اليهود وقراءة أنباء غضب الله عليهم؛ فتظنوا أنه إذا كان قوم
مثل اليهود الذين بُعث فيهم هذا العدد الضخم من الأنبياء يمكن أن يفسدوا فكيف يطمئن إنسان على
يعني
من
عباد
الله
۳۱۰
Page 373
مصيره الروحاني؟ إن الفلاح الروحاني ممكن يقينًا إنما عليكم أن تصححوا إيمانكم بالله واليوم الآخر وأن
تكونوا صادقين فيه، وأن تعملوا صالحًا، وعندها لن يحيد بكم شيء عن جادة الصواب، ولن تحرموا أبدًا
من فضل الله ونعمه.ومثل هؤلاء لا خوف على مستقبلهم ولا حزن على ما فرط منهم في الماضي.وجدير بالذكر أن قوله تعالى: [الذين آمنوا] يتضمن المؤمنين من جميع الأمم، وأن قوله تعالى: [والذين
هادوا والنصارى والصابئين يذكر هؤلاء خاصة للتأكيد وكأن الآية تقول: إن كل المؤمنين بالله واليوم
الآخر عامة واليهود والنصارى والصابئين خاصة..إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا
الإيمان سينالون أجرهم من الله تعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبناء على هذا المفهوم لا يكون
المعنى وقفًا على المسلمين وحدهم وإنما يعمّ جميع المؤمنين من كل الأمم.سواء كانوا هندوسا أو أتباع
زرادشت أو أتباع كونفوشيوس أو اليهود أو النصارى أو الصابئين.ثم توضيحا للمعنى الإجمالي لقوله (الذين آمنوا أتبعه بقوله (والذين هادوا والنصارى والصابئين)، وهم
من أهل الديانات المجاورة للعرب، وذكرهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.وبذلك أزال القنوط
الذي يمكن أن يتطرق إلى قلب مؤمن إذا قرأ سوء أحوال اليهود ومصيرهم، وبين أن سبيل الإيمان ليس
محفوفًا بالأخطار إلى هذا الحد كما يبدو من حالة اليهود إنهم بأنفسهم أهلكوا أنفسهم، وإلا فالطريق
الروحاني فسيح ممهد وليس وعراً..إذا كان الإنسان مؤمنًا بالله واليوم الآخر عاملاً بالصالحات لانحلت
أمامه كل المشاكل والمسائل بنفسها.فلا يجد صعوبة في معرفة الأنبياء، ولا تنغلق أمامه المسائل الروحانية
والأخلاقية، ولا يحس مللاً في أداء العبادات، ولا ثقلاً في الوفاء بحقوق العباد.أحد،
ومن محاسن القرآن الكريم وكمالاته أنه كلما تناول موضوعًا فيه من الوعيد ما قد يقنط بسببه فتح
على الفور باب الأمل، وكلما ذكر موضوعًا فيه من البشارة والسرور ما قد يُسبب غفلة وتكاسلا عند
البعض، أتبعه بما يولد خشية الله وتقواه، ذلك كي يبقى الإيمان في حالة الاعتدال بين الرجاء والخوف.أما الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل فليست كذلك ؛ فهي إذا تناولت موضوع حـ
الله تعالى للبشر
مضت في ذلك حتى ولّدت الغفلة في قلب الإنسان، وإذا تحدثت عن غضب الله تعالى استفاضت فيه حتى
تمكن القنوط من الفؤاد.وهناك علاقة أخرى لهذه الآية بما سبقها من الآيات، ففي هذه تذكير لبني إسرائيل بما ارتكبوه من
ضروب العصيان، وكان لا بد أن يتأثر ذوو الطبائع الكريمة وأهل خشية الله تعالى من بني إسرائيل برؤية
هذه الواقعات المؤلمة مجتمعة في موضع واحد فيصيبهم الهول ويستولي عليهم القنوط، فيظنوا أنهم لم يبق
لقومهم سبيل للغفران والنجاة.فأزال الله هذا الاحتمال وقال لهم: لقد فُتحت لكم اليوم بالإسلام أبواب
لرحمة الله تعالى.فكل إنسان سواء كان مسلماً أو يهوديًا أو نصرانيا أو صابنا أو تابعا لأي كتاب
۳۱۱
Page 374
سماوي آخر- إذا صحح إيمانه بحسب تعاليم الإسلام وعمل الصالحات، فبوسعه اليوم أيضًا أن يتقدم في
مجال الروحانية، وينال قرب الله تعالى، ويرث أفضاله، ولن تحول بينه وبين هذا ما ارتكبته أمته في الماضي
من معاص.وقد يتساءل أحد: إذا كانت الحالة الإيمانية لبني إسرائيل بهذا السوء والانحطاط فلماذا فضلهم الله على
الآخرين؟ الجواب: لا يمكن أن تقاس حال قوم بحال عوامهم فقط، وإنما تقدر قيمتهم أحيانًا بحالة
الخواص منهم، وأحيانًا باستعدادهم الفطري خذوا مثلاً حال اليهود اليوم فإنهم بالرغم من بعد عهدهم
بأنبيائهم، وعلى الرغم من تعرضهم لشتى أنواع الاضطهاد طيلة هذه القرون، فلا تزال مقاليد الاقتصاد
العالمي بأيديهم، وبسبب ذكائهم ودهائهم يتفوقون على غيرهم في مجال الاكتشافات العلمية على
اختلاف نواحيها.وهذا يدل على تمتعهم بمواهب فطرية وملكات خاصة تميزهم عن كثير من الناس.هذا
من ناحية استعدادهم القومي، وأما من ناحية قدرات الخواص منهم فيكفيك دليلاً على ذلك أنه لم يُبعث
في قوم عدد من الأنبياء بقدر ما بُعث فيهم.فتمتُّعُ هذا العدد الكبير بالجوهر الروحاني والقرب الإلهي
لدليل على فضيلة هذا القوم فاختيار الله تعالى إياهم لأفضال خاصة لم يكن من فراغ أو من قبيل
التحكم، بل كانوا في الحقيقة أهلاً لها.ومع تميز بني إسرائيل بتلك الميزات الفردية والقومية إلا أن عيبهم أنهم كانوا يستخدمون هذه المواهب
الفطرية في تحقيق الازدهار المادي على حساب الرقي الروحي.كما أن تمتعهم بقوة الذكاء على وجه
عام جعلهم يحسدون أنبياءهم ويأبون احترامهم بحسب المكانة الروحانية التي بوءهم الله إياها.ودفعهم
هذان العيبان إلى التقهقر في الميدان الروحاني، فحرموا من نعمة النبوة.فتمتُّع بني إسرائيل بأفضال الله
الخاصة ثم جلبهم سخط الله عليهم مرة بعد أخرى ليس بأمرين متعارضين بل قد حدثا واجتمعا فعلاً
فيهم.هذا من ناحية ارتباط آيتنا هذه بما قبلها وما بعدها من الآيات.أما من ناحية معناها المستقل فقد يراد
بقوله تعالى (الذين آمنوا المسلمون أيضًا، وبذلك تكون هذه الآية نبأ عظيم الشأن إذ تبين طريقا سهلاً
للفصل بين الأديان المختلفة.ذلك أن أحدًا لا يستطيع رؤية أحبائه يتعرضون للإيذاء والهلاك، فكيف
يمكن أن يخذل الله أحباءه ليذلّوا ويُهانوا؟ فالدين الذي يتلقى نصرًا وتأييدا من الله لدين حق، والدين
المحروم من نصرة الله وتأييده ليس مرضيّا عند الله تعالى.ولقد نبه الله الناس بذكر أديانهم بأن كل واحد
منهم يدعي بالإيمان الصالح الذي يرضي الله تعالى، ولكن آية صدق الصادق في إيمانه بالله واليوم الآخر
وصلاح العمل هو أن يكون أسمى من أن يتطرق إلى قلبه خوف أو حزن، وإنما يكون في حال طمأنينة
وسكينة.۳۱۲
Page 375
ولإدراك الظروف التي طُرح فيها هذا المعيار لبيان صدق الأديان، علينا أن نعرف أن هذه السورة نزلت
في السنوات الأولى بعد الهجرة، عندما كان الإسلام ضعيفًا غض الإهاب، وكان العرب يعادون الرسول
ويتعطشون لدمه.وكان هناك فئة قوية من أهل المدينة دخلوا الإسلام نفاقًا يتربصون به الدوائر
ويحيكون المؤامرات لاستئصال شأفته.كما كان في المدينة وما حولها ثلاث قبائل من اليهود لا يدخرون
وسعا في عداء الإسلام والسعي للقضاء عليه وكانت هناك أيضًا قبائل نصرانية بالقرب من المدينة.وكان أهل الشام والنصارى يكنون عداءً شديدًا للإسلام وكانوا على عدة منازل من المدينة.وكان عدد
المسلمين رجالاً ونساءً وصغارًا لا يتجاوز ثلاثة آلاف أو أربعة.في هذه الظروف الحالكة والجو العدائي المحيط بالمدينة من كل ناحية أعلن الله تعالى على لسان نبيه
أن المؤمنين بالله واليوم الآخر العاملين صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.كان العدو المتربص
بالمؤمنين لا يزيد عنهم آلاف المرات فحسب، بل كانوا فضلا عن ذلك يتفوقون عليهم في المال والجاه
والسلطة والعدة والعتاد تفوقًا رهيبا.فقال لهم النبي ﷺ : لا شك أنكم أكثر منا عدة وعددًا وتدعون
أنكم على حق، ولكننا نخبركم أن من ينجيه الله تعالى من الشدائد والمصاعب سيكون هو الصادق عند
الله، ومَن وَقَع فيها رغم توافر وسائل الأمن والراحة فهو على الباطل.أيُّ الأديان ثبت صدقه بهذا المعيار ؟ أرى أننا لسنا بحاجة للإجابة على هذا التساؤل من عند أنفسنا.فكتب أعداء الإسلام تلقي ضوءاً كافيًا عليه، حيث تبين الفرق الشاسع بين حالة المسلمين بعد الهجرة
بسنين عندما تم هذا الإعلان القرآني وبين حالتهم بعد بضع سنين، وكيف أن المسلمين الذين حاصرهم
العدو من كل جانب انطلقوا في الأرض شرقا وغربا حتى ملأوها، وانقلب حزنهم وخوفهم سرورًا
وحبورًا، وأقض الخوف والحزن مضاجع أعداء الإسلام الذين كانوا ينعمون بالراحة والأمان.وكان هذا
هي الجماعة التي تؤمن بالله واليوم
حقا وتعمل صالحًا، وأما إيمان أتباع الأديان الأخرى فليس إلا إيمانًا تقليديًا فارغا، وأن أعمالهم لا
شهادة عملية لا تُمارى
الآخر حقا
تحظى برضاء الله تعالى.من
عند
الله
عز وجل على أن جماعة المسلمين
ولا يمكن لأحد أن يقول إن غلبة الحكومات المسيحية اليوم على المسلمين دليل على أن الله تعالى ليس
مع الإسلام.فالوعد الإلهي بعدم الخوف والحزن عند الصراع الديني لم يكن إلا لقوم يؤمنون به وباليوم
الآخر إيمانا صادقًا، ويعملون الصالحات.لكن المسلمين في هذا الزمن وطبقًا لأنباء النبي - معرضون
عن الإسلام ولا يعملون بالقرآن.ويُشبه حالهم حال بني إسرائيل في زمن المسيح الناصري ال؛
ووقوعهم في أنواع الحزن والخوف إنما هو عقاب لهم وتحقق للنبأ الذي أخبر به رسولنا.ولكن هناك
وعد أيضًا بأنهم إذا آمنوا بالمسيح المنتظر والمهدي الموعود لهم على لسان محمد المصطفى ، استحقوا
۳۱۳
Page 376
هذا الوعد الإلهى مرة أخرى وذهب عنهم الحزن والخوف وارتد أعداؤهم عنهم أذلاء مهانين.ولن
تكون هذه الغلبة في حق الإسلام بالمفهوم المادي ولن تتم بأسباب الحرب والقتال العسكري وإنما هي
غلبة روحانية عدتُها السلاح الروحاني والفكري، وذريعتها الحجة والبرهان.وقد ظهر المهدي المنتظر
والمسيح الموعود، وإن الله تعالى ينجيه هو وأتباعه من الحزن والخوف بآيات خارقة للعادة، ويهين
أعداءهم عند المواجهة.لقد انخدع البعض في فهم هذه الآية إذ ظنوا أن القرآن لما ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين زوال
الحزن والخوف فدل بذلك على أن كل أمة تؤمن بالله واليوم الآخر ناجية.وهذا فهم غير صحيح؛ لأن
الإيمان بالله واليوم الآخر يشمل كل المبادئ والتعاليم الإسلامية.قال الله تعالى: (إن الذين يكفرون بالله
ورسله ويريدون أن يُفرِّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينا ) (النساء: ١٥١-١٥٢).وتبين هذه الآية أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسل، والإيمان برسول يتضمن الإيمان بكتابه.وقال تعالى أيضًا: (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون) (الأنعام:۹۳).وتوضح
هذه الآية أن الإيمان بالآخرة يشمل الإيمان بالقرآن والقيام بالعبادات المفروضة.فثبت أن الإيمان
بالله واليوم الآخر ينطوي على كل ما يتفرع منه من مبادئ وتعاليم أخرى.قوله تعالى: (وعمل صالحا..العمل الصالح هو المناسب للضرورة والظروف، وهو الذي يزيل الفساد
والخراب، وما ليس كذلك يكون سببًا للفساد والشر مهما بدا حسنًا في عيون الناس.فلو أن شخصا
مثلاً في الصلاة وأمامه حريق ينبغي عليه إطفاؤه، أو تشاغل بتلاوة القرآن وهناك منكر يُرتكب فلا
ينهى عنه، أو امتنع عن الجهاد في سبيل الله بحجة الصيام، فرغم أن هذه الأعمال كلها حسنة، لكنها لا
توصف بالصلاح ولا تكون عاقبتها حسنة لأنها لا تتناسب والأحوال.كما أن بعض الأعمال تبدو في
حد ذاتها شرا ولكنها إذا ناسبت الحال أصبحت أعمالاً صالحة تستحق الثواب.فلو أنك ضربت شخصا
ضربة لتقتل بها حشرة سامة تقف على كتفه وتوشك أن تلدغه، فقد فعلت عملاً صالحا،
الضرب وحده عملاً سيئًا.ولو دفعت إنسانًا فأوقعته على الأرض إنقاذا له من قذيفة قاتلة لكان هذا
أيضًا عملاً صالحًا، وإن كان إسقاط شخص على الأرض عملاً غير سليم.فالحق أن ما ينال به الإنسان الثوابَ هو العمل الصالح.لا شك أن أعمال الخير هي التي تكون الأعمال
في معظم الأحوال، ولكن الإنسان في بعض الحالات يجعل من فعل الخير عملاً غير صالح فلا
يستحق عليه ثوابًا، كما يصبح عمل الشر صالحا
عمل الشر صالحًا عند الضرورة بشرط أن تكون النية هي طاعة أمرٍ أهم
آخر من أوامر الله تعالى.خرج النبي ﷺ ذات مرة للجهاد، وكان بعض الصحابة صائمين صوم تطوع،
شرع
الصالحة
وإن كان
٣١٤
Page 377
وعندما وصلوا إلى غايتهم اشتد بهم التعب وأخذ بهم كل مأخذ.أما المفطرون فأخذوا يعدون المكان،
وينصبون الخيام ويجمعون الحطب ويأتون بالماء.فلما رأى النبي الله ذلك قال سبق المفطرون الصائمين
أجرًا.تعلمنا هذه الواقعة أن الصوم، وإن كان عملاً حسنًا، ولكن إذا كان هناك عمل آخر أنفع وأجدى
يتطلب قوةً وجهدًا أصبح الصوم عملاً أدنى.ولسوء الحظ أن المسلمين يقاسون اليوم من هذا الخلل،
فنجد الكثيرين منهم يعملون أعمال الخير، ولكن قلما تجدهم يعملون الصالحات.إن الإسلام في محنة
قاسية؛ يشن عليه العدو الهجمات من كل حدب وصوب، ولكن آلاف الآلاف من المسلمين يقضون
جُلّ وقتهم في الصلوات والأذكار ولا يلتفون إلى ما يصيب الإسلام.مساجدهم عامرة ولكنهم لا يبالون
بخراب بيت الإسلام فلا شك أن هذه الصلوات والأذكار مردودة في وجوههم، وما داموا لا يبالون
بعمارة بيت الإسلام فإن الله تعالى أيضا لن يعمر قلوبهم بتجلياته وآيات محبته.ثم هناك مئات الآلاف منهم الذين هم في بادئ الأمر، منهمكون في إصلاح حال المسلمين من حيث
التعليم والاقتصاد والسياسة، ولكنهم غافلون عن الصلاة والصوم ،وغيرهما فكانت أعمالهم هذه سياسية
دنيوية محضة، لأنها تخلو من طعم الروحانية.يهتمون بضرورات الجسم، ويتجاهلون ضرورات الروح.وهذه الأعمال أيضًا ليست أعمالاً ،صالحة وإنما العمل الصالح هو الذي تُراعى فيه كل الظروف
والضرورات.فالبيت الذي ينقص أحد جدرانه لا يُعَدُّ بيتًا صالحا لحماية الإنسان.هذه حال بيت ينقصه
جدار واحد، فما بالك إذا لم يكن إلا جدار واحد ؟ كانت هناك ضرورة ملحة قصوى أن يبينوا للناس
محاسن تعاليم الإسلام بعملهم من ناحية ثم كان عليهم من ناحية أخرى حماية الإسلام بسيوف الأدلة
والبراهين.ولو أنهم راعوا هذين الأمرين لم يُصب الإسلام أبدًا هذا الضعفُ والهزال، ولم يصبح
متمردين متهورين أو جبناء فارين، بل لَتَحَلُّوا بمكارم الأخلاق، فبذلوا أعظم التضحيات، وكانوا أهل
مع تواضع، وأهل شجاعة وثبات؛ و لم تستطع أمة مقاومتهم ويجب أن نتذكر أن كلمة (صلاح)
لا تستخدم في العربية أبدًا بمعنى الشر.فلا يمكن أن تكون أعمال الكذب والسرقة وقطع الطرق وما
شابهها من الصلاح في شيء حتى وإن كانت تهدف لمنفعة أحد.شرف
المسلمين
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم
تَتَّقُونَ) (٦٤)
شرح
الكلمات :
۳۱۵
Page 378
الميثاق : عقد مؤكد بيمين وعهد (المفردات).رفَعنا رفعه رفعًا ضد وضعه رُفع له الشيء: أبصره عن بعيد (الأقرب).الطور: الجبل جبل قرب أيلة يضاف إلى سيناء (الأقرب).اذكروا : ذكر الشيء: حفظه في ذهنه (الأقرب).وقوله تعالى واذكروا ما فيه ادرسوا ما فيه(اللسان).راجع أيضا شرح معاني الكلمات للآية ٤١.موسی
التفسير : المراد من قوله تعالى (أخذنا ميثاقكم): الوصايا العشر وما نزل معها من تعاليم أخرى على
عند جبل سيناء.وتقول الآية لبني إسرائيل: تذكروا تلك الوصايا التي أوتيتموها وأنت واقفون عن
سفح الجبل، والتي أعرضتم عن سماعها قائلين: لا نريد سماعها حتى لا نهلك.وفي قوله تعالى (ميثاقكم) أُضيف الميثاق إلى بني إسرائيل لأنه كان ذا شهرة وأهمية كبيرة لديهم، لقد
وضع فيه الأساس لعلاقات كان ستنشأ بين الله تعالى وبينهم.وفي نفس الميثاق وبسبب معاصيهم
المتكررة، قدَّر الله تعالى أن النبي الموعود صاحب الشرع الجديد لن يظهر في بني إسحاق، بل سيظهر في
بني إسماعيل.وكأن إضافة الميثاق إليهم تذكرة لبني إسرائيل بأهمية هذا العهد، ولا
هذا أنه لم يكن
لبني إسرائيل عهود أخرى مع الله تعالى.يعني
قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور: الطور يعني في العبرانية الجبل أيا كان(قاموس العهد القديم).ومن
معاني الطور في العربية أيضا الجبل.ولكن العرب عندما سمعوا من اليهود أن الله تعالى تكلم مع موسى
على الطور أي الجبل، ظنوا أن الطور بالعبرانية يعني ذلك الجبل الخاص في سيناء، فسموه (جبل الطور).واستخدم القرآن الكريم كلمة الطور بمعنى الجبل فقط.قال الله تعالى:(وشجرةً تخرج من طورِ
سَيْناءَ) (سورة المؤمنون: ۲۱).وقال: (والتين والزيتون وطور سينين)(سورة التين).لقد أخطأ البعض في فهم قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور)، وظنوا أن الله تعالى رفع الجبل وجعله
كالمظلة فوق رؤوس بني إسرائيل.وقد استغل المستشرق رُدول Rodwell هذا الخطأ من بعض
المفسرين وطعن به في الإسلام وقال : لقد أخطأ اليهود في فهم عبارة واردة في التوراة ونقل القرآن عنهم
هذا الخطأ.لقد انخدع المفسرون بكلمتي (رفع) و(فوق) مع أنهما تدلان أيضًا على مجرد الارتفاع.جاء في حديث
الهجرة النبوية أن أبا بكر قال بصدد اشتداد الحر وقت الظهيرة: رفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه
الشمس) (البخاري، كتاب المناقب)، يعني رأينا صخرة مرتفعة قريبًا منا لها ظل فأوينا إليها.وورد في
القرآن الكريم: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
٣١٦
Page 379
وتظنون بالله الظنونا * هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا) (الأحزاب:۱۲،۱۱).فمعنى قوله
(جاء وكم من فوقكم ومن أسفل (منكم أنهم جاءوكم من الناحيتين المرتفعة والمنخفضة من الأرض.فالمعنى الصحيح للآية أن اليهود كانوا واقفين بالقرب من الطور عندما أعطاهم الله تعالى بعض الوصايا
وأخذ منهم العهد للعمل بها.فقد ورد في التوراة: وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أن صارت
رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، وصوتُ برق شديد جدًا.فارتعد كل الشعب الذي في المحلة.وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل.وكان جبل سيناء كله يدخن من
أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدًا.فكان صوت
البرق يزداد اشتدادًا جدًا وموسى يتكلم والله يجيب بصوت ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل،
ودعا الله موسى إلى رأس الجبل.فصعد موسى.فقال الرب لموسى انحدر حدر الشعب لئلا يقتحموا إلى
الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون وليتقدس أيضًا الكهنة الذين يتقربون إلى الرب لئلا يبطش بهم
الرب.فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلاً: أقم
حدودًا للجبل وقدّسه.فقال له الرب ،اذهب انحدر، ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة
والشعب فلا يقتحموا لئلا يبطش بهم الرب.فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم..)(خروج ١٦:١٩ إلى ٢٥).وقد نُسب رفع الطور إلى الله تعالى في قوله ( ورفعنا فوقكم الطور)، لأنه هو الذي أوصاهم بالمكث
أسفل الجبل كما هو وارد أيضًا في التوراة.واستخدام كلمة (رفعنا) و(فوق) إشارة إلى أن ميثاق الطور هذا له صفة الدوام، إذ إن هذا العهد قد
الطور وليس هذا فحسب، وإنما يشير أيضًا بطريق المجاز اللطيف إلى أن الطور سيبقى دائما
محلقا فوق رؤوسهم يُذكّرهم بهذا العهد.وليس العهد ليوم أو يومين وإنما له ارتباط دائم بالحياة القومية
أخذ
لبني إسرائيل.قوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة): لقد وضع الله اللبنة الأولى للشريعة الموسوية على جبل في برية سيناء
وقد ذكر هذا في سفر خروج ۱۹،۲۰.ويتبين من قول التوراة: (الرب إلهنا قطع هنا عهدًا في حوريب)
أخذ
(تثنية ٦:٥)، أن موسى تلقى الوصايا العشر إلى جانب تعاليم أخرى على صخرة حوريب، وهناك
من بني إسرائيل الميثاق بالعمل بها.وقد شرحنا هذا عند تفسيرنا لقوله تعالى (وإذ أتينا موسى الكتاب
والفرقان (البقرة : (٥٤.وهذا كان في الحقيقة أساسًا لنعمة عظيمة الشأن ولكنهم كفروا بهذه النعمة
أيضا كما تبين الآية التالية.۳۱۷
Page 380
منهم
عندئذ،
إسرائيل،
وتؤكد آيتنا هذه بأن على بني إسرائيل أن يذكروا دائما ذلك العهد الذي أخذه الله
ويتمسكوا به بقوة، ويعملوا به بصدق، لكي ينجوا من المصائب جميعًا.وقد ورد هذا التأكيد في التوراة كالآتي: ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم.استمع
الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم، وتعلّموها واحترزوا لتعملوها) (تثنيةه: ١)
وقد ورد مضمون قوله تعالى (لعلكم تتقون في التواة كالآتي: فقال موسى للشعب لا تخافوا لأن الله إنما
جاء لكي يمتحنكم، ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا) (خروج ۲۰ : ۲۰).ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (٦٥)
شرح الكلمات:
توليتم تولّى أدبر.تولّى عنه : أعرض عنه وتركه الأقرب).فمعنى توليتم رجعتم مدبرين؛ أعرضتم
وتركه(الأقرب).عنه
وتركتموه.فضل الفضل: الإحسان والابتداء به بلا علة (الأقرب).التفسير : جاء في التوراة: (وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق، والجبل يدخن.ولما
رآه الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد، وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا
نموت)(خروج ۲۰ : ۱۸-۱۹).وجاء فيها أيضًا: وجهًا لوجه تكلّم الرب معنا في الجبل من وسط النار.أنا كنت واقفًا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب لأنكم خفتم من أجل النار
و لم تصعدوا إلى الجبل) (تثنية ٥: ٤-٥)
يتضح من هذه العبارة أن الله تعالى حين دعا بني إسرائيل ليشرفهم بكلامه مشافهة خافوا بسبب الزلزال.فيعني قوله تعالى (ثم (توليتم أنهم فروا من هناك مدبرين، ولم يريدوا سماع كلام الله تعالى.ويقول عز
وجل بأنه إن لم يُحطَّكُمْ فضله ورحمته العاقبكم، ولمحا اسمكم من أمة رسوله وأصبحتم من الخاسرين.وكما ورد في التوراة (تثنية۱۸: ۱۸) قدر الله تعالى بسبب رفضهم سماع كلامه أن يكون النبي الموعود
المثيل لموسى من خارج بني إسرائيل، من إخوتهم بني إسماعيل.(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (٦٧-٦٦)
شرح
الكلمات :
۳۱۸
Page 381
السبت سبت الرجلُ يسبُت ويسبت سبنا: استراح.وسبت الشيء: قطعه.سبت الرأس: حلقه.سبت:
قام بأمر السبت.السبت الدهرُ؛ يوم من أيام الأسبوع بين الجمعة والأحد (الأقرب).ويسمى سبتًا لأنه
عطلة للراحة عند اليهود.خاسئين: خسَأْتُ الكلب فخَساً؛ زجرتُه مستهينا به فانزجر (التاج).خسأ الكلب: طرده: الخاسئ من
الكلاب المبعد المطرود ولا يُترَك أن يدنو من الناس.(الأقرب)
نكالاً : نكل بفلان: صنع به صنيعا يحذر غيره إذا رآه.والنكال اسم ما يُجعل عبرة للغير.(الأقرب)
موعظة وعظه : نصحه وذكّره ما يلين القلوب من الثواب والعقاب؛ وفي المصباح: وما يسوق إلى التوبة
إلى الله وإصلاح السيرة وأمره بالطاعة الموعظة كلام الواعظ من النصح والحث والإنذار (الأقرب).ويقول الخليل : الوعظ هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب (المفردات).يوم السبت
التفسير كل المعاني التي ذكرت لكلمة (السبت) في شرح الكلمات يمكن أن تصدق هنا.إذا قرأنا قول
:
الله هذا منفصلاً عن الآيات السابقة فيعني: عندما أنعمنا عليكم بالمال والراحة انغمستم في الشر فأنزلنا
عليكم الذل والمهانة.وإذا قرأناه بربطه مع الآيات السابقة فيعني أن الوصايا التي فرضناها عليكم عند
الطور كان من بينها احترام السبت ولكنكم عصيتم هذه الوصية.جاء في التوراة: "احفظ
لتقدّسه كما أوصاك الرب إلهك.ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع فسبت للرب
إلهك.لا تعمل فيه عملاً ما..أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك
الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك.واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك
الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة.لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ
(تثنية ٥ : ۱۲ -(١٥).وقد ورد مثل ذلك المعنى في سفر خروج (۲۰: ۸-۱۱)
ويتبين من الفقرة السابقة أنها فعلاً من وحي الله تعالى لموسى..الذي لا يزال محفوظا إلى وقتنا هذا.وفيه بيان لحكمة أعمال الإنسان وتعليم سام للعناية بالضعفاء والفقراء.وكلمة (سبت) العربية تشبه كلمة (ثبات) في العبرية التي تعني الراحة كما هو معنى السبت في العربية.وممن معاني كلمة (ثبات) العبرية القطع والختم (موسوعة الكتاب المقدس، والقاموس العبري للعهد
القديم).وكلمة السبت العربية أيضًا تعني القطع والختم.يوم
السبت"
يرى علماء العبرانية عموما أن السبت لم يسم بهذا الاسم لأنه يوم راحة، وإنما لأن الناس ينهون فيه عمل
الأسبوع.۳۱۹
Page 382
وكلمة (سَبَة) تعني باللغة البابلية القديمة دعاء التوبة.ويرى البعض أن كلمة السبت من أصل بابلي
ومعناها يوم التوبة والدعاء (موسوعة الكتاب المقدس).يوم
يتبين من عبارة التوراة السابقة أن يوم السبت قد حُصص لينال الخدم والعمال والعبيد وأهل القبيلة راحة
وليعبدوا الله تعالى.وهاتان الغايتان من الأهمية بمكان، ولا بد من أخذهما في الاعتبار.كان اليهود
يسبتون في هذا اليوم (السبت)، وتؤكد التوراة أن يوم السبت هو الذي خصص لهذا الغرض، ولأجل
ذلك سمي يوم السبت بهذا الاسم..وإلا فإن المعنى الأصلى للسبت أنه عطلة وعبادة؛ ولأجل ذلك
يمكننا القول إن سبت بني إسرائيل، أي عطلتهم وعبادتهم كان يوم السبت، وأن سبت المسلمين، أي
عطلتهم وعبادتهم، هو يوم الجمعة؛ فقد ورد في التوراة: "في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر
وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه" (خروج ۲۰: ۱۱)
وخروج ۲ : ۲
لقد اعترف النصارى بأهمية تقديس السبت ولكنهم عينوا لذلك يوم الأحد، ذلك أن الأمم والملوك
الأوروبيين عندما أبدوا ميلاً إلى المسيحية اشترطوا لدخولهم فيها أن يكون الأحد يوم العطلة، وقبل
القساوسة هذا الشرط لتنصيرهم، وهكذا سبقوا اليهود في انتهاك حرمة السبت؛ لأن اليهود كانوا
يسبتون أحيانًا ويقومون بعمل خير فيه، ولكن النصارى قرروا أن يكون يوم السبت يوم عمل دنيوي
واتخذوا يوم
الأحد عطلة.ولو كان هذا العمل بأمر من الله تعالى لما كان مثار اعتراض، ولكنهم فعلوه
من تلقاء أنفسهم بعد المسيح الناصري ال بقرون.وكان المسيح نفسه يقدس يوم السبت، ولكنه لم
يكن يغالي في ذلك كما فعل اليهود؛ فقد قال: "السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل
السبت" (مرقس ٢٧:٢).ومعنى ذلك أنه إذا دعت الضرورات الحقة فلا داعي للتشدد في التمسك
بحذافير أحكامه، ولا يمكن أن يكون السبت مانعا من أداء أمور الدين، ذلك لأن اليهود اعتقدوا خطأً أنه
لا يجوز في يوم السبت التبليغ والوعظ وغير ذلك من أعمال الخير، مع أن السبت فُرض للمنع من
الشؤون الدنيوية لا الدينية.إن الأقوام المسيحية كانوا في بادئ الأمر يسبتون وواظبوا على ذلك لمدة طويلة (الموسوعة اليهودية،
وموسوعة الكتاب المقدس.في حين أن تقديس الأحد، الذي كان يومًا مقدسًا عند الشعوب الآرية،
كان جاريًا في الأمم غير اليهودية منذ زمن الحواريين.فقد كتب بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس:
"في كل أول أسبوع (أي الأحد ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئتُ لا يكون
جمع حينئذ" (الرسالة الأولى (۱٦ (۲ يتبين من هذا أن أهل كورنثوس كانوا يتخذون يوم الأحد عطلة
لهم.۳۲۰
Page 383
وكذلك ورد عن بولس: "وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزًا خاطبهم بولس وهو
مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل أعمال ۷ (۲۰).ويتبين من هذا أن الأمم غير
الإسرائيلية كانت تقيم احتفالات عامة يوم الأحد لأنه ربما كان يوم عطلتهم القومية.وفي أيامنا هذه
أيضا يضطر المسلمون الذين هم تحت حكم الإنجليز إلى إقامة إجتماعهم يوم الأحد، لأن الإنجليز
المسيحيين اتخذوا الأحد يوم عطلتهم.ويقول بعض الكتاب أن النصارى شرعوا في تقديس الأحد حتى لا يخالفهم الأمم غير اليهودية.ولكن
بارناباس يقول في رسالته أن سبب ذلك قيام المسيح من الموت في ذلك اليوم (الموسوعة اليهودية).وهناك حركة بين النصارى اليوم تسمى (جماعة اليوم السابع تدعو إلى الاحتفال بالسبت يوم السبت
بدلاً من يوم الأحد.صلاة
وكذلك عيّن الإسلام يوماً للسبت أي للراحة والعبادة، وهو يوم الجمعة.ولم يتحدد يوم الجمعة للسبت
عن قياس من المسلمين بل بأمر من الله تعالى..فلا مجال للاعتراض عليهم.لقد خص الإسلام يوم الجمعة
بهذه الفضائل: أن يكون يوم عطلة، وأن تزداد فيه العبادة، وأن يكون يوم اجتماع قومي، ويوم غُسل
ونظافة، وعيادة المرضى وغير ذلك من أعمال البر للمجتمع والقوم.نعم، يُسمح بعد الفراغ من
الجمعة أن يذهب الناس إلى شؤونهم الدنيوية، ولكن الأنسب أن يشتغلوا بعدها أيضًا بذكر الله تعالى.ولكن الأسف أن المسلمين بدورهم لم يقدروا سبتهم، حتى أن صلاة الجمعة كانت قد اختفت تماما لمدة
من الزمن في الهند، اللهم إلا في المدن الكبيرة.والآن قد بدأوا يهتمون بها، ولكن حتى اليوم لا يبلغ عدد
المهتمين بأدائها أكثر
من
%1
منهم..إنا لله وإنا إليه راجعون! ولقد وافقت الحكومة بعد تلقيها
مذكرات من مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبعد جهود من أبناء الجماعة، على السماح بساعة
عطلة لأداء صلاة الجمعة، ولكن المسلمين مع ذلك لا ينتهزونها، بل إن البعض يقول علنًا للمسئولين
الحكوميين بأن طلب عطلة ليوم الجمعة إنما كان بنية فتنة وفساد من الأحمديين، فلن نشترك فيها.وأما عن اعتداءات اليهود في السبت فقد قال القرآن الكريم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة
البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم
بما كانوا يفسقون (الأعراف: ١٦٤).ويتضح من هذه الآية أن اليهود كانوا يصيدون السمك يوم
السبت للمنافع التجارية.وأما ما ذكر أنها كانت تأتي يوم السبت بكثرة فليس في هذا معجزة كما قال
بعض المفسرين، بل الواقع أن من عادة بعض ذوي القلوب الرحيمة أن يلقوا بالطعام إلى الحيونات في
أيامهم المقدسة، وتعتاد الحيوانات على هذا التوقيت فتأتي طلبًا للطعام.ويبدو أن بعض اليهود من أهل
كان هذا قبل انقسام الهند بسنوات حين كان الإنجليز يحكمونها (الناشر).۳۲۱
Page 384
الخير كانوا يلقون بشيء من طعامهم على الشاطئ يوم السبت كصدقة منهم، فكانت الحيتان تجتمع
هناك للأكل في ذلك اليوم على وجه خاص.وعندما لاحظ بعض الأشرار ذلك بدأوا صيد الحيتان يوم
السبت.وقد شاهدناهم يلقون الحبوب والدقيق في بعض الأنهار، فيجتمع عندئذ الأسماك بكثرة تثير
العجب، ولا ترى ذلك في وقت آخر أو في موضع آخر من النهر.ولقد ذكرت التوراة بعض اعتدءات اليهود في السبت فقالت: "وفي تلك الإيام رأيت في يهوذا قومًا
يدوسون معاصر في السبت، ويأتون بحزم ويحملون حميرًا، وأيضًا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر
وعنب وتين وكل ما يُحمل فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام.والصوريون الساكنون بها كانوا يأتون
بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم" (نحميا١٣: ١٥-١٦).وذكر انتهاك
حرمة السبت في مواضع أخرى منها إرمياء :۱۷ ۲۲ ۲۷ ، وحزقيال ۲۲ : ۸.قوله تعالى (كونوا قردة خاسئين)..أخطأ بعض المفسرين في فهم هذه الآية فظنوا أن المعتدين في السبت
مسخوا قردة حقًا.ولكن هذا غير صحيح، لأن القرآن ذكر هذا في موضعين آخرين مبينا أنهم لم يمسخوا
بالفعل قردة وإنما كان ذلك على سبيل التشبيه قال الله تعالى: قُلْ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةً عند
الله من لَعَنَه الله
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعَبَدَ الطاغوت أولئك شر مكانًا وأضل عن
سواء السبيل * وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا
يكتمون (المائدة: (٦١-٦٢).فيتبين من هذه الآية أن الجماعة التي لعنت ومسخت قردة وخنازير كانت
تأتي إلى الرسول وتقول نفاقا أننا آمنا مع أن قلوبهم مليئة بالكفر والثابت من القرآن الكريم
والحديث والتاريخ أن هذه الجماعة كانت من البشر لا من القردة والخنازير فيتضح من ذلك أن الآيتين
تعنيان أن هؤلاء فسدت أخلاقهم حتى صارت كعادات القردة والخنازير؛ وليس معناهما أنهم في الواقع
صاروا قردة وخنازير شكلاً وخُلقًا.ويقول القرآن الكريم في مكان آخر عن اعتداء بني إسرائيل في السبت: (فلما عتوا عما نُهُوا عنه قلنا لهم
كونوا قردة خاسئين * وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك
لسريع العقاب وإنه غفور رحيم * وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) (الأعراف : ١٦٧-١٦٩).يدرك كل متدبر لهذه الآية أن هؤلاء
القردة لم يكونوا قردة حقيقية وإنما شبه قوم العصاة بالقردة، وأنهم سيبقون إلى يوم القيامة، وأنه سيكون
فيهم الصالحون والطالحون، وسوف يتعرضون لأنواع الابتلاءات ليعودوا إلى الله تعالى.فما دام القرآن
بنفسه يشرح معنى كون بني إسرائيل قردة وخنازير فلا مجال لقبول رواية تخالفه.۳۲۲
Page 385
بعد سماع
هذا الشرح يقول البعض: أي غرابة أن يكون القادمون إلى الرسول ﷺ هم نفس القوم من
اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير فعلا؟ فالجواب لهؤلاء: (أولاً) إن الصفات التي ذكرها القرآن المجيد
لهؤلاء لا تسمح بالأخذ بهذا التأويل السخيف، و(ثانياً) إن المفسرين القدامى الذين ذهبوا إلى المعنى
الظاهري هم أنفسهم لم يقبلوا بأن هؤلاء الممسوخين بقوا إلى زمن الرسول.يقول ابن أبي حاتم عن
ابن عباس: (جُعلوا قردة فواقًا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل.وقال الضحاك عن ابن عباس:
"فمسخهم الله قردةً بمعصيتهم..يقول إذًا، لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام.قال ولم يعش مسخّ قط
فوق ثلاثة أيام، و لم يأكل و لم يشرب و لم ينسل" (تفسير ابن كثير).فهؤلاء أنفسهم يرون أن الممسوخين
لا يحيون فوق ثلاثة أيام، ولكن القرآن يقول بأن هؤلاء الممسوخين سيبقون إلى يوم القيامة مغلوبين
بأيدي الآخرين وأنهم كانوا يأتون الرسول الله من حين لآخر ويحاربونه فكيف يصح المسخ بالمعنى
المادي؟
ثم إن قواعد اللغة العربية لا تجيز تأويلهم الواهي.فمن قواعد اللغة العربية أن صيغة الجمع بالواو والنون
أو الياء والنون هي لجمع المذكر العاقل.وقد وُصفت القردة في الآية بأنهم (خاسئين).فعاملهم معاملة
ذوى العقول، وإلا لقال (قردة خاسئة).وقد روى هذا المعنى الذي ذهبنا إليه بعض علماء السلف أيضًا.يقول التابعي والمفسر الكبير مجاهد:
مُسخت قلوبهم و لم يُمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله.لهم.وقال أبو العالية: معنى (قردة خاسئين)
أذلة صاغرين.وقال بنفس المعنى قتادة وربيع وأبو مالك ابن كثير والدر المنثور).وفي اللغة يقال: قرد
فلان أي ذلّ.وكذلك ذكر الإمام الراغب في مفرداته أن العلماء من قال: جعلت أخلاقهم
كأخلاقها أي القردة.من
أما المراد الحقيقي من جعلهم قردة فقد ذكره القرآن المجيد كما يلي:
أولاً : صاروا أذلاء مهانين.فكما أن القرد يرقص ويقفز بحسب إشارة القراد ولا يستطيع مخالفة أوامره..كذلك تسلطت على اليهود حكومات، ولن تزال تسلط وتعاملهم كما تشاء ولا يكون لهم دخل في
6
الحكم.ثانيا: القرد حيوان مقلد.وقد مسخت قلوب جماعة من بني إسرائيل بحيث خلت من خشية الله، وكانت
كل أعمالهم عن تقليد أعمى وقشورًا بلا ،لب حتى أن بعضهم إذا أتوا إلى المسلمين تظاهروا بالإسلام،
وإذا رجعوا إلى قومهم تبعوا دينهم.ثالثا: القرد شبق إلى الشهوة الجنسية، فيقال فلان) أزنى من (قرد وقد تفشت الدعارة في اليهود كثيرًا.۳۲۳
Page 386
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ
منَ الْجَاهِلِينَ ) (٦٨)
شرح الكلمات:
هُزُوًا هزا به
:
ومنه:
سخر (الأقرب).أتتخذنا هزوا أتجعلنا هدفًا للاستهزاء؟
الجاهلين: الجهل فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل (المفردات).التفسير: كان بنو إسرائيل يعيشون في مصر، وكان المصريون يعظمون البقرة كثيرا، لذلك استولت
عظمتها على قلوب بني إسرائيل أيضًا.وكذلك يتبين مما سبق في هذه السورة (الآية ٥٢)، ومما جاء في
إسرائيل عندما اتخذوا الصنم إلها كان على صورة العجل؛ مما يدل على أن
بني
التوراة (خروج٣٢) أن
تعظيم البقرة في قلوبهم وصل إلى حد تأليهها.ولما كان الهدف الأساس للأنبياء القضاء على الشرك
وإظهار جلال الإله الواحد الأحد، الخالق المالك لكل مخلوق..فكان ضروريًا أن تتضمن شريعة موسى
من التعاليم ما يستأصل من قلوب بني إسرائيل تعظيم البقرة، ولولا ذلك لمالوا بعد مدة إلى عبادتها مرة
أخرى.ولذلك أمرت شريعة موسى في عدة مناسبات بذبح البقر.ومن الواضح أن الذين يذبحون حيوانًا
مرة بعد أخرى لا يمكن أن يخلعوا عليه صفات الألوهية.تشير هذه الآية إلى أن موسى الله أمر قومه بذبح بقرة، فأرادوا مماطلته ولكنهم في النهاية اضطروا
كارهين إلى الامتثال لأمره.وذكر الله تعالى هنا نكرانًا آخر للجميل ارتكبه بنو إسرائيل؛ فَبَعْد عبادة
العجل وتلقي عقوبات شديدة، وبعد توبة وخجل..لم يكن متوقعا من هذا الجيل نفسه أن يسقط في
وحل الشرك مرة أخرى ولكنهم لم يتخذوا من ذلك كله أي عبرة، بل مالوا إلى الشرك.ويبدو أنه،
لسوء حظهم، ولد عندهم عجل جميل بشكل غير عادي..كان يشبه العجل الذي يعبده المصريون،
فَهَفَت قلوبهم إلى تعظيمه.فأمر الله أن سنة
يقيم ذبح البقر لكي يقتلع من قلوبهم هذه الميول
الشركية.ولما كاد المريب يقول خذوني، فقد أحسوا أن هذا الأمر يخص عجلهم الجميل المحبوب،
وتداولوا فيما بينهم حول هذا الأمر، وبدلاً من أن يبادروا إلى ذبح أي بقرة حتى يتم تنفيذ الأمر الإلهي
بدون هتك سترهم، انهالوا على موسى بوابل من الأسئلة حول صفات تلك البقرة وعلاماتها،
أن الله تعالى يريد بقرة خاصة.وكانت نتيجة هذا النقاش أن الله تعالى أعطاهم علامات دقيقة تنطبق على
عجلهم الجميل الذي بدأ تعظيمه يتولد في قلوبهم، فاضطروا آخر الأمر إلى ذبحه، ووقفوا موقف الخجل
موسی
ظنَّا
منهم
والإحراج.٣٢٤
Page 387
ويدلنا تاريخ المصريين القديم أنهم عبدوا حيوانات كثيرة، ولكن أهمها العجل الذى كانوا يختارونه
ومن
هذه
بمواصفات خاصة، وأقاموا له التماثيل وشيّدوا له المعابد، ووضعوا صوره على جدرانها.العجول (عجل أبيس) الذي اتخذوا يوم ميلاده عطلة وعيدا ويوم وفاته مأتما وحزنا.وكانوا يحنطونه
ويدفنونه في مقابر خاصة، ويبحثون بعده عن عجل مثله.وكانوا يعتبرونه مظهرا لإله الشمس.وكانوا لا
يجيزون أكل هذه الحيوانات.وقد استمرت هذه العادة فيهم إلى رعمسيس الثاني أيضًا.،(New Standard Dictionary & Encyclopedea of Religions& Ethics
The Nile& Egyptian Civilisation by Moret A.)
وكان بنو إسرائيل متأثرين بهذه العقائد المصرية، وعندما رأوا هذا العجل الجميل الذي تميز بمواصفات
خاصة مالوا إلى الشرك.لقد اختار القرآن كلمة (بقرة)، ولكنها تستعمل للمؤنث والمذكر.ولا تذكر التوراة هذا الحادث بمثل
تفصيل القرآن له، ولكن كما سبق أن ذكرت أن ذكر حادث تاريخي في التوراة أو عدمه لا يعنى شيئًا
مقابل كتاب سماوي محفوظ.ومع ذلك فقد جاء في التوراة ذكرُ تضحية بعجل ذي علامات تشبه
المذكورة في القرآن، حيث قيل إن الله تعالى قال لموسى: (كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء
صحيحة لا عيب فيها، ولم يَعْلُ عليها نير.فتعطوها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج
المحلة وتذبح
قدامه.ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بأصبعه، وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع
مرات.وتحرق البقرة أمام عينيه..يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشب أرز
وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك
يدخل المحلة، ويكون الكاهن نجسا إلى المساء.والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء، ويرحض جسده بماء،
ويكون نجسا إلى المساء.ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر.فتكون
بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة.إنها ذبيحة خطية) (عدد ۱۹: ۲-۹)
لجماعة
لا تذكر هذه العبارة ما دار بين موسى وبينهم من أسئلة وأجوبة كما ذكر القرآن، ولكن يدرك الإنسان
بتأمل قليل أن التوراة ذكرت هذا الحادث كحادث عادي والحكمة في ذبح مثل هذه البقرة هي إزالة
الشرك من قلوب بني إسرائيل، ووقايتهم من تأثير الأمم الأخرى، وربما لهذه الحكمة سُمّى الماء الذي
خلطت به دماء البقرة ماء بنجاسة..أي غُسلت به نجاسة الشرك وحفظوا منه.فلو أنهم استمروا في ذبح
مثل هذه العجول والبقر التي كان يعبدها المصريون لزال من قلوبهم نحس الشرك.لقد جاء في كتب الحديث اليهودية هذا الحادث بتفصيل أكثر مما جاء في التوراة.فقد ورد في (مثتا) باب
كامل عن الحادث.ووردت رواية عن الربي نسيس أنه لم يوجد بعد موسى ال بقرة بتلك المواصفات
٣٢٥
Page 388
(موسوعة الكتاب المقدس).وفي هذا البيان من أحاديث اليهود تصديق كامل لما ورد في القرآن من أن
الله تعالى أمرهم بذبح بقرة خاصة تتميز بجمال غير عادي وبعلامات معينة لا تتوفر في كل الأزمنة.وقوله تعالى : (قال أعوذ بالله أن أكون من (الجاهلين إشارة إلى أن الاستهزاء والسخرية في أمور الدين من
شأن الجهال.والأسف أن الكثير من الناس لم يفهموا هذه الحقيقة، فتقسو قلوبهم بالضحك من أمور
الدين وعدم الجدية فيها.قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا
مَا تُؤْمَرُونَ) (٦٩)
شرح الكلمات:
فارض : فَرُضت البقرةُ : كبرت وطعنت في السن.لا فارض ولا بكر: لا مُسنة ولا فتية (الأقرب).بكر: البقرة الفتية (الأقرب).وبكر في قوله تعالى : (لا) فارض ولا بكر..هي التي لم تلد.(المفردات)
عوان: النصف.أي الشابة المكتملة الشباب (الأقرب).التفسير: أمرهم الله تعالى بذبح بقرة أيا كانت، فبدأ اليهود يسألون عن علاماتها، لأن قلوبهم كانت
تخشى على عجلهم المحبوب.فقال الله تعالى : إنها لا) فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما
تؤمرون)..أي لا تعرضوا أنفسكم للإحراج والإذلال بكثرة السؤال.لكن اليهود لم يمتنعوا.قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
(۷۰)
شرح
الكلمات:
صفراء فاقع فقع لونه اشتدت صفرته الفاقع الخالص الصفرة؛ الخالص الصافي من الألوان أي لون
كان.والمشهور أنه صفة للأصفر (الأقرب).التفسير: رغم الإشارة الإلهية بأننا نستر عليكم فلا تهتكوا ستركم بالأسئلة، لكنكم لم تنفكوا عنها، بل
تسألون فقلنا إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.مضيتم
لقد وصفت التوراة البقرة بأنها حمراء بينما يصفها القرآن بأنها صفراء.وإذا اعتبرنا هذا خلافا فقد سبق
القول بأن القرآن وهو الوحي السماوي المحفوظ، هو الأحق بالاعتبار عند الاختلاف مع التوراة لأنها
غير محفوظة من التحريف.ولكني لا أراه اختلافًا لأن بعض الألوان متشابهة وتوصف من مختلف الزوايا
٣٢٦
Page 389
بأسماء مختلفة، واللون الأصفر الفاقع من تلك الألوان.فمن ناظر يسميه أصفر، وآخر يسميه أحمر.فلو
وضعنا الزعفران أمام أشخاص لاختلفوا في تسمية لونه ولقال البعض إنه أصفر، وقال آخرون إنه أحمر.ويبدو أن لون تلك البقرة كان يسمى عند اليهود أحمر وعند العرب أصفر.ولما كان القرآن بالعربية
سُمّي ذلك اللون أصفر.قوله تعالى: (تَسُرُّ الناظرين) من قواعد اللغة العربية جواز استعمال فعل للمضاف بحسب المضاف إليه
تذكيرا وتأنيثا.ولما كانت كلمة (لون) مضافة إلى الضمير (ها) العائد إلى البقرة..جاء الفعل (تسر)
بصيغة التأنيث بحسب الضمير ،(ها)، وقال: تسر الناظرين والمعنى يسر لون البقرة الناظرين.ويجوز أن يكون الضمير عائدًا بالمعنى أي تسر صفرتها الناظرين لأن المراد باللون الصفرة.ويجوز أيضًا أن يكون الضمير عائدًا إلى ،البقرة، أي البقرة تسر الناظرين فالجملة صفة أخرى للبقرة.)
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (۷۱)
شرح الكلمات :
تشابة تشابه الرجلان أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا.(الأقرب)
التفسير: لم يتوقف اليهود عن السؤال، وطلبوا علامات أخرى للبقرة.ولما كانوا يشكون في أن الله تعالى
يريد بقرتهم المعظمة، قرروا في نفوسهم أنهم إذا أُمروا بذبحها فسيذبحون، ولذلك قالوا: (وإنا إن شاء الله
لمهتدون).قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (۷۲)
شرح الكلمات :
مُسَلَّمَة : سلّمه الله من الآفة: وقاه إياها (الأقرب).فمعنى مسلمةٌ أنها سليمة من المرض والعيوب.شية: وشيت الشيء وشيا: جعلت فيه أثرًا يخالف معظم لونه (المفردات).شية: كل لون يخالف معظم
لون الفرس وغيره (الأقرب).فمعنى (لا شية فيها) أنها ذات لون واحد لم يخلط بلون آخر.التفسير : قال الله تعالى : إن هذا العجل لم يستخدم للحراثة ولا للسقي..أي أنه معفى من العمل تعظيمًا
له وتكريما، ولا يؤذيه أحد، ولذلك ليس به أثر لجرح أو ضرب.وهذا وصف للثيران التي يعظمها الناس
تعظيما عقائديا.وهكذا بين الله تعالى كل علامات ذلك العجل المحبوب.فقالوا: الآن جئت بالحق، أي
۳۲۷
Page 390
لقد صدق حدسنا بأن الله يقصد هذا العجل.والواقع أن قول الله تعالى كان حقا من قبل ومن بعد.كان
الله يريد أن يعودهم على ذبح البقر دون أن يهتك سترهم، وأن يذوب هذا الشرك من قلوبهم شيئا فشيئا
حتى يزول.ثم بيّن أنهم ذبحوها كارهين.وقولهم (الآن جئت بالحق بعد سلسلة من أسئلة لا داعي لها لدليل واضح على أن أفكار الشرك بصدد
عجل معين كانت تولدت في نفوسهم.ثم إن اتخاذهم العجل إلها عند ذهاب موسى إلى الجبل دليل آخر
يؤكد ذلك.ومن الثابت في تاريخ المصريين أنهم كانوا يعبدون العجل الحي ويعبدون تمثاله أيضًا.وكذلك بنو إسرائيل عبدوا العجل تمثالاً ثم أضمروا عبادته حيًّا.ثم إن لون العجل دليل على تأليههم إياه؛ لأن التمثال الذي صنعوه كان من ذهب أصفر، وإن كلمة
صفراء التي أطلقت على لون البقرة تستخدم للذهب أيضًا.وتاريخ المصريين القدامى يخبر أنهم اعتبروا
العجل مظهرًا لإله الشمس وهي صفراء اللون كذلك.وهذا دليل آخر على أن لون العجل كان أصفر،
وأن اليهود اعتبروه مظهرا لإله الشمس.ولو صح هذا القياس لأدركنا بسهولة أن لون البقرة كما ذكره
القرآن أنسب من اللون الأحمر الذي جاء في التوراة.وقوله تعالى (وما كادوا يفعلون أي ما كادوا يذبحون ذلك العجل لشدة حبهم له..لأنهم تحت تأثير
المصريين ظنوا أنه متصف بقدر من الألوهية.ما أكثر أوامر الله حكمةً! لقد أباح الله تعالى للمسلمين ذبح البقرة كغيرها من الماشية للقضاء على
الشرك المتعلق بها والموجود في بعض بلاد العالم حتى اليوم.وللأسف أن بعض المسلمين في البلاد التي
تقدس فيها البقرة، كالهند مثلا، يُبدون استعدادا للتخلي عن هذا الحق المشروع بدون أي نفع ديني،
وهناك غيرهم الذين يخرجون بهذه الحيوانات المعدة للذبح في احتفال يجرح شعور جيرانهم من أتباع دين
آخر.وكلا العملين باطل غير جائز.على المؤمن إصلاح نفسه، ولا يجوز له إيذاء جاره.ما أنصف ما
قدَّمه مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية من اقتراح إلى الجيران من أتباع الديانات الأخرى كالهندوس..يقول عليه السلام في كتابه (رسالة صلح بأننا نعتبر صلحاء الهندوس (کرشنا) و(رام شندرجي) من
أنبياء الله تعالى بحسب تعاليم القرآن الكريم.ولو أن الهندوس احترموا رسولنا محمدا لضحينا لهم مقابل
ذلك وامتنعنا عن ذبح البقر في بلادهم.ولكن الأسف أن الهندوس لم يقبلوا هذا العرض المنصف.(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ) (۷۳)
شرح الكلمات:
۳۲۸
Page 391
ادار أتم أصلها تدارأتم درأه دفعه، وقيل دفعه دفعا شديدا تدارأ القوم: تدافعوا في الخصومة واختلفوا.الدرء: الميل والعوج في القناة، يقال: قَوَّمت درء فلان أزلت عوجه والدرء: الخلاف (الأقرب).وقال الزجاج : معنى (فادار أتم) فتدار أتم أي تدافعتم أي ألقى بعضكم إلى بعض (اللسان).مخرج أخرج الشيء: أبرزه (الأقرب).التفسير: قوله تعالى: (نفسا يعني نفسا عظيمة أو نفسا غير معروفة، لأن التنوين يفيد المعنيين.والآية
تخاطب قوم اليهود وتقول: تذكروا:
(۱) عندما قتلتم نفسًا عظيمة أو أردتم قتلها.(٢) أو عندما عاونتم على قتل أو محاولة قتل إنسان عظيم وساعدتم غيركم على هذه الجريمة.(۳) أو عندما قتلتم أو أردتم قتل إنسان ما.ثم أخذتم تتنصلون من الجريمة ورمى بعضكم بعضا بارتكابها،
أو أنكرتم معرفتكم بالقتل والقاتل.وأضعف هذه المعاني قتل إنسان مجهول، لأن اليهود كقوم ما كان لهم مأرب في قتل إنسان لا أهمية له،
ولا معنى لأن يختلفوا في قتله.فيبدو أن المراد من (نفسا) شخص عظيم لم يذكر اسمه لأنه بنفسه متبادر
إلى الذهن.وقوله تعالى: (والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني سوف يهتك الله تعالى سر القاتل ومن تآمر على القتل،
ويمكن أن يعني أن الله تعالى سوف يُظهر العناد والبغض المكتوم في صدور القاتلين الذي دفعهم إلى
جريمتهم.فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٧٤)
شرح
الكلمات:
اضربوه: ضربه بيده وبالعصا: أصابه وصدمه بها.ضرب الشيء بالشيء: خلطهما.ضرب له مثلا:
وصفه وقاله وبينه ضربه بالسيف: أوقعه به (الأقرب).ببعضها بعض كل شيء: طائفة منه، وقيل جزء منه، ويجوز كونه أعظم من بقيته كالثمانية من العشر
(الأقرب).والباء حرف جر يفيد عدة معان في العربية منها الإلصاق نحو أمسكت بزيد، ومجازا يقال: مررت بزيد؛
الثاني: التعدية نحو ذهبت بزيد؛ الثالث: الاستعانة نحو نجوت بالفرار الرابع: السببية نحو لقيت بزيد
۳۲۹
Page 392
الخسارة؛ الخامس: المعية نحو اهبطوا بسلام.السادس: التبعيض نحو شرب بماء البحر؛ السابع: القسم نحو
بالله ؛ الثامن: التأكيد (الأقرب).ويمكن أن يعني هنا إما السببية أو الإلصاق.وقد استخدم القرآن الباء بمعنى السببية في قوله تعالى: (فبما
نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم.يُحيي: راجع شرح الكلمات للآية ٢٩.التفسير قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى) يعني بادئ النظر : هكذا يُحيي الله الموتى الحقيقيين
ويرجعهم إلى الحياة الدنيا ولكن هذا المعنى خلاف للقرآن، ولذلك فهو غير مقبول؛ لأنه يقول بأن
الموتى الحقيقيين لا يرجعون إلى الدنيا..راجع) تفسير الآية ٥٦ لمزيد البيان).ويمكن أن يعني: كذلك يُحيي الله الذين يشبهون الموتى، أو كذلك يقيم الله كرامة الموتى ويحفظها، أو
كذلك يحفظ الله الناس من الهلاك.والمعنيان الأخيران يصدقهما القرآن أيضا حيث قال: ولكم في
القصاص حياة يا أولى الألباب (البقرة : (۱۸۰).أي أيها العقلاء إذا عاقبتم القاتل بعقوبة مناسبة لقلت
جرائم القتل في المستقبل، وأنقذت أرواح كثيرة من الهلاك.وبحسب هذه المحاورة القرآنية يعني إحياء
الموتى هو إنقاذ من يُحتمل قتله.وفي القصاص حياة بمعنى أن كرامة القتيل لا تضيع وإنما تبقى قائمة
محفوظة تزيل من قلوب أهله البغض والشحناء، لأنهم بدون قصاص يرون أن فقيدهم أهين وأذل.وهذا
الأسلوب موجود عند العرب.قال الشاعر الحارث بن حلزة من أصحاب المعلقات:
ملْحَقَ فَالصَّا قب فيها الأموات والأحياء
إن نبشتم ما بين
يريد..أيها الأعداء، لو نبشتم بين ملحة والصاقب لوجدتم هناك أموانًا وأحياء.أي نحن قوم أهل شجاعة
وحمية، كلما قتلتم منا قتيلاً أحييناه بأخذ ثأره منكم.أما قتلاكم فهم أموات لأنكم لم تستطيعوا أخذ
ثأرهم منا.وبناء على هذا يعني قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى أنه عز وجل يُحيي مَن يموت في سبيله بأخذ
ثأره من القاتل.أما المعنى الأول بأنه يُحيي مَن يكون حاله كحال الموتى فهو كثير في الأساليب المستخدمة في الحياة
اليومية.فنطلق اسم الشيء على شبيه له فمثلاً إذا أصيب أحد بجرح كبير وتألم كثيرا، فإنه يقول: لقد
مت.والمعنى أني قد صرت كالميت من الألم والتعب.فيمكن أن يكون معنى الآية: هكذا يُحيي الله الذين
يكونون كالموتى، و لم يبق أمل في حياتهم، ورغم أن العلوم الدنيوية تجزم بهلاكهم، لكن الله تعالى ينقذهم
بفضله.۳۳۰
Page 393
وقوله تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون..أي يريكم آياته كي ترتدعوا عن المعاصي والذنوب؛ لأن
معنى العقل هو ربط الشيء ومنعه، كما شرحنا من قبل.وتسمى قوة العقل عقلا لأنها تمنع الإنسان من
الأخطاء والذنوب.ويبدو من هذا القول الإلهي أن الأمر المذكور هنا آية من الله تعالى يستفيد بها
العقلاء، ويمكن أن يتقوا بها من الذنوب والشرور، أو ينجوا من الكفر والعصيان.والحادث المذكور في هذه الآية والتي قبلها يتعلق عند المفسرين بقتيل من بني إسرائيل.وبيان هذا أن
شخصا قتله أخوه أو ابن أخيه.فأمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وقد مرّ ذكر ذبحها، ثم أمر
بضرب القتيل ببعض أجزائها، وقد اختلف المفسرون كثيرًا في هذا البعض، وعندما ضربوه بجزء منها قام
القتيل حيًا وأخبر عن قاتله (تفسير فتح البيان).ولا نرى داعيًا للدخول في التفاصيل المختلفة التي أوردها المفسرون حول اسم القاتل والمقتول وسبب
القتل وأين وجدت الجثة وما إلى ذلك، لأنها كلها من اجتهاد المفسرين ولا أساس لها من القرآن
والحديث.ومن أجل ذلك، وبعد ذكر هذه الراويات قال ابن الأثير : "والظاهر أنها مأخوذة من
إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تُصدَّق ولا تُكذِّب فلهذا لا يُعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا"
(ابن كثير).وقد قال صاحب فتح البيان عند ذكر أجزاء هذه البقرة: "ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه
من القول بغير علم، ويكفينا أن نقول: أمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضها".كتب
بني
الحق أن القرآن صريح، وتعاليم الإسلام لا تقبل هذه الراويات وإن كانت منسوبة إلى بعض الصحابة.يقول المفسرون أن الله تعالى أمر بذبح البقرة بعد حادث قتل النفس للعثور على القاتل، ولكن القرآن
ذكر حادث ذبح البقرة أولاً، ثم ذكر حادث قتل النفس بعده.والقرآن الكريم كتاب الله تعالى، وهو
يفوق كل المعايير الإنسانية للفصاحة والبلاغة وليس هناك إنسان - وإن كان بسيط العقل - يقبل
الحادث بالترتيب الذي يقول به المفسرون فلو أن أحدًا ذكر الحادث لقال : اذكروا عندما قتلتم نفسا
واختلفتم في قتلها فأمرناكم بذبح بقرة وضرب القتيل بشيء منها، وعندما فعلتم ذلك قام القتيل حيًّا.ولكن القرآن الكريم ذكر الحادث بترتيب معاكس.فلماذا يقول المفسرون أن البقرة ذُبحت للتعرف على
القتيل؟ إن مثل هذا الترتيب المعكوس لا يليق بكتاب من صنع البشر، فما بالك بكتاب هو من وحي
تعالى..وهو القمة في الفصاحة والبلاغة؟!
وقد خطر هذا الاعتراض أيضًا ببال بعض المفسرين القدامى مثل الإمام الرازي، ولكنه ردّ عليه ردًّا
واهيا، وقال: ليس ضروريًا أن يذكر القرآن الأحداث بترتيبها الأصلي..لأن الناس يذكرون السبب قبل
الحكم وبعض الأحيان يقدمون الحكم على السبب.الله
۳۳۱
Page 394
ولكن هذا الجواب لا هنا، وإنما
يصح
فمثلا يرى شخص جثة قتيل ثم يذكر هذا لزملائه ويقول: مات فلان ثم يبين التفاصيل بأنه كان ذاهبًا
فرأى جثته في مكان كذا وكذا.أما المفسرون فلا يقدمون ما حدث متأخراً فحسب، بل يؤخرون الأهم
ويقدمون الأقل أهمية، ولا يوجد في قولهم الحكمة التي يكون بسببها التقديم والتأخير.فمجرد القول
بالتأخير والتقديم بدون ذكر حكمة قول غير كاف ولا يعتد به؛ وإلا لزم بأن هذا الجزء من القرآن خال
من الحكمة..إذ قدّم وأخرّ بلا مبرر.إن حادث ذبح البقرة أهم من حادث القتل وكان لا بد من هذا
عندما يكون ما يؤخر أقل أهمية وما يقدم أكثر أهمية..يصح
الترتيب، وهذا ما فعله القرآن الكريم.فثبت أن حادث ذبح البقرة منفصل تماما عن حادث قتل النفس.ثم إن القرآن قد استأنف حادث ذبح البقرة بقوله : (إذ ) ، وكذلك بدأ ذكر حادث قتل النفس أيضا بقوله
(إذ)، كما فعل في بداية ذكر كل حادث مرّ ذكره في الآيات السابقة وكلها أحداث مستقلة منفصلة
عن بعضها.وهذا دليل بيّن على أن هاتين الحادثتين منفصلتان.ومما يؤيد رأيي أيضًا أنه لا معنى لضرب القتيل لإحيائه بجزء من جسم البقرة، فلو أراد الله تعالى إحياء
القتيل كمعجزة ما كان هناك داع لذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها، وإنما كان يمكن إحياؤه بدعاء
موسى..بمثل ما يظن عامة المسلمين خطأ أن عيسى كان يُحيي الموتى بدعائه.وإذا قيل إن هناك أثرًا
طبيًّا في لحم البقر يساعد على إحياء الموتى، فحق لنا أن نتساءل: لماذا لا يظهر هذا الأثر الآن؟ وإذا قيل
إن هذا الأثر الطبي كان في ذلك النوع الخاص من البقر فنسأل: لماذا أمر الله تعالى أولاً بذبح أي بقرة؟
ولم لم يأمر بذبح البقرة المطلوبة منذ البداية؟ ثم إنه ليس من الصعب العثور على مثل هذه البقرة ليجربوا
عليها بحسب عقيدتهم؟
إذًا، فلا نجد أي مبرر معقول لربط هذين الحادثين إلا مبرر قبول الروايات الإسرائيلية! ولكن المشكلة أن
الروايات الإسرائيلية المعتمدة أيضًا لا تقبل هذا الربط.فالتوراة لا تذكر حادثا ذبحت فيه البقرة لهذا
السبب.ورد في التوراة: (إذا وُجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا
يُعلم مَن قَتَلَه..يخرج شيوخك وقضاتك، ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل.فالمدينة القربى من
القتيل..تأخذ شيوخ تلك المدينة عجلةً من البقر لم يحرث عليها و لم تحرَّ بالنير.وينحدر شيوخ المدينة
بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي.ثم يتقدم الكهنة
بنولاوي، لأنهم إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل
خصومة وكل ضربة.ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة
العنق في الوادي، ويصرحون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم، وأعيننا لم تبصر) (تثنية ٢١: ١-٩)
۳۳۲
Page 395
والظاهر من هذه العبارة أنهم لم يؤمروا بذبح البقرة ليضربوا القتيل بجزء من جسمها، ولم يفعلوا هذا، و لم
يقم القتيل حيًّا، ولم يخبر باسم القاتل، وإنما الحكمة في ذبحها أن يزول تعظيم البقرة من قلوب بني
إسرائيل، وأيضًا أن يكلموا بالصدق عند الشهادة بغُسل أيديهم على البقرة التي كانوا يكنون حبها
وتعظيمها في نفوسهم.وما دام الأمر الواقع هكذا فأي مبرر لفرض معان على القرآن يأباها ترتيب
القرآن للأحداث؟، ولا نجد مؤيدا لها في التوراة؟ ولماذا نقبل ما يرفضه العقل والنقل، ونتيح للعدو فرصة
=
للطعن في القرآن الكريم والاستهزاء به؟ إن ما يقوله القرآن واضح تماما ومتسلسل تسلسلاً طبيعيًا.كان
بنو إسرائيل في ذلك الزمن على استعداد صريح لعبادة البقر، وتذكر التوراة الأمر الإلهي بذبح البقرة
والحكمة منه التي تطابق المعنى القرآني..أي محو تقديس البقر من قلوبهم.وما دام هذا المعنى الذي يسوقه المفسرون يعارض العقل، ويخالف ما ورد في التوراة، ويخل بالترتيب
القرآني اللطيف، ويتعارض مع تعاليم القرآن الصريحة ولا يسانده قول من رسول الله ﷺ.فلم يبق لنا إلا
طريق وحيد..ألا وهو الفصل بين الحادثين ونبذ قول المفسرين هذا و النظر في تفسير الآية من منظور
آخر.ولو أننا سلمنا بآراء المفسرين جدلاً، فأيضا لا نستطيع تفسير الآية بأن القتيل عاد إلى الحياة بضربه بجزء
من جسم البقرة ثم أخبر باسم القاتل، وإنما نقول بأنه حدث هنالك شيء عند ضرب القتيل عُرف به
وهذه حيلة علمها
الله
تعالى
للعثور
على
القاتل.القاتل.وهذا ما ذكره سيدنا المهدي والمسيح الموعود ال ، في كتابه إزالة) أوهام).ولكن كما يبدو من
6
السياق فإنه ذكر هذا المعنى استدراجًا للمعارض من طريق قريب، ولم يسلم معه بإحياء الموتى مونا
حقيقيًّا لأن الآية لا تذكر ذلك، بل قال: إذا قبلنا قولك جدلاً فإنما تعني الآية فقط أنه بضرب القتيل
حدث شيء عُرف به القاتل.أن
أقول: في بلادنا أيضًا يضع الناس صبغا أسود على شيء داخل غرفة، ويطلبون من المشتبه فيهم
يدخلوا ويلمسوا هذا الشيء.فمن التصقت يده بذلك الشيء فهو السارق ويفعل ذلك الجميع ما عدا
السارق فإن يدخل ولا يلمسه، ومن ثم لا يكون الصبغ الأسود على يده، فيُعرف.بمثل هذه الحيلة مع
البسطاء يمكن اكتشاف الجاني.ولعل موسى الي اتبع حيلة كهذه بتوجيه من الله لاكتشاف القاتل؛ أو
أنه عندما ضرب القتيل بجزء من البقرة أخذت الرعدة القاتل خوفًا فعُرف أو أن القتيل عندما ضرب
تحرك جسده فظن القاتلُ أنه سينهض حيًّا فغُشي عليه خوفًا أو اعترف بنفسه.ومع ذلك لا يعني هذا أن
القتيل بالفعل قام حيًّا وأخبر بالقاتل، وإنما أخذنا بهذا المعنى على سبيل الافتراض لنجنّب القرآن الاعتراض
والتناقض.وإلا فإني أرى أن هذه الآية تتحدث عن موضوع منفصل مستقل عن الآية السابقة.۳۳۳
Page 396
والمراد من
وقبل أن أبين المعنى الأصح عندي، أود أن أذكر معنى آخر بينه بعض علماء جماعتنا، واعتبروا فيه
الحادثين منفصلين تماما.يرى هؤلاء العلماء أن المراد من نفسا هو المسيح ابن مريم الناصري ال،
قتلتم أي حاولتم قتله، أو جعلتموه شبيهًا بالقتيل، ومعنى الآية: اذكروا يا بني إسرائيل
عندما حاولتم قتل نفس عظيمة، أي عيسى ال ، أو آذيتموه حتى كاد يموت..أي حاولتم قتله على
الصليب.أما قوله تعالى فادار أتم فيها..فيمكن إرجاع ضمير (ها) فيه إلى النفس أو إلى حادثة القتل،
والمراد أنكم اختلفتم في هذه النفس بعد حادثة الصلب، أو أنكم اختلفتم في حادثة الصلب ذاتها.ويكون
المعنى، وبالنظر إلى الاختلاف في النفس أنكم اختلفتم في المسيح، فقال بعضكم إن جثته سُرقت بعد أن
مات، وقال بعضكم إنه نزل من الصليب حيًّا وفرَّ من القبر ؛ ويكون المعنى، بالنظر إلى الاختلاف في
الحادثة: أن بعضكم ظن أن المسيح قد مات على الصليب وظن البعض الآخر أنه لم يمت على الصليب.وقوله تعالى : والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني أن الله تعالى سوف يكشف الستار عن حقيقة هذه
الاختلافات في يوم من الأيام.وها قد كشف الله تعالى هذا الستار حيث أثبت الإمام المهدي والمسيح
الموعود الله في هذا الزمن بالبراهين الناصعة من القرآن والأناجيل والتاريخ، أن المسيح ابن مريم الله،
علق ولا شك على الصليب، ولكنه لم يمت عليه، وإنما أُنزل عنه حيًّا، ومكث في القبر حيا ثلاثة أيام، ثم
لحق بحوارييه.ويفسر هؤلاء العلماء قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها بأننا أمرنا الملائكة أن يضربوا هذا الشعب
ويعذبوه بسبب جريمة قتل المسيح..وكأن الضمير (ه) في اضربوه يرجع عندهم إلى قوم اليهود
القاتلين، وأن الضمير (ها) في (ببعضها) يرجع إلى جريمة القتل، ومعنى (بعض الجريمة) أن يعاقبهم الملائكة
في الدنيا ببعض ما استحقوه من العقاب بسبب الجريمة، وأما العقاب الكامل فسيكون في انتظارهم يوم
الحساب.ولسوف نذكر إن شاء الله واقعة صلب المسيح الله بالتفصيل عند شرح الآية رقم ١٥٨ من سورة
النساء، ولكني أود هنا أن أذكرها بإيجاز كي يفهم القارئ ما يقصده هؤلاء العلماء.لقد اختلفت الأمم
في واقعة صلب المسيح الناصري ال؛ فيرى اليهود أنهم علقوه على الصليب، وأماتوه عليه، ثم أُودعت
جثته في قبر حيث سرقها مريدوه وأعلنوا بين الناس أنه عاد إلى الحياة مرة أخرى، لكي يحموه من طعن
اليهود بأنه مات على الصليب ومن مات عليه يكون كاذبًا وملعونا..استنادًا إلى ما ورد في التوراة أن
من مات على الخشبة فهو ملعون.."لأن المعلق ملعون من الله" (تثنية ۲۱ : ۲۳)، وما ورد في الإنجيل:
(لأنه مكتوب: ملعون كلٌّ مَن عُلّق على خشبة) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٣: ١٣).٣٣٤
Page 397
أما النصارى فيرون أن المسيح علق على الصليب بلا شك، ومات عليه وصار ملعونًا، ولما كان صلب
بدون ذنب جناه لذلك قام من الموت..وهكذا نجا من اللعنة التي تحملها عن يطب خاطر لتخليص الناس
من عقوبة الخطية.ويرى المسلمون عامة في هذه الأيام أن المسيح لم يعلق على الصليب، بل عُلّق مكانه شخص آخر، أما
المسيح
فأخذه الله إلى السماء.ولكن هذه العقيدة لا تستند إلى حديث صحيح.وما دام الرسول ﷺ
يذكر أية تفاصيل عن رفع المسيح إلى السماء حيًّا لم يبق لنا إلا الرجوع إلى التاريخ، ولكننا لا نجد في
التاريخ أيضًا سندا لذلك.ومعنى ذلك أن بعض شرار اليهود والنصارى دسوا روايات من تاريخهم إلى
تراث المسلمين.الصليب
ولقد رفض مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية هذه العقائد الثلاثة، وأثبت من القرآن والإنجيل والتاريخ
أن المسيح عيسى ابن مريم اللي علق على الصليب حيًّا، ولكنه نجا من الموت عليه، وذلك بحسب أنبائه
التي تفوه بها قبل هذا الحادث، والتي لا تزال محفوظة في الإنجيل إلى يومنا هذا.لقد أُنزل من
مغشيا عليه لشدة الآم الجروح، وبقي هكذا في حالة ضعف شديد لحوالي ثلاثة أيام في غرفة كالقبر،
وعندما استرد عافيته قليلا خرج من هناك بمساعدة بعض حوارييه، ثم ذهب إلى قبائل بني إسرائيل العشر
الضالة لدعوتهم إلى الحق طبقًا لنبوءته: (ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة..ينبغي أن آتي بتلك
أيضًا) (يوحنا ١٦:١٠).فذهب إلى هذه القبائل التي يذكر التاريخ أن الملك بختنصر البابلي سباها إلى
العراق وبلاد فارس، ومن هناك شتّتها في المناطق الشرقية من دولته أفغانستان وكشمير.يرى علماء
الأحمدية هؤلاء أن هذه الآية تشير إلى هذا الحادث، وتقول لبني إسرائيل إن اعتداءاتكم لم تقتصر على
زمن موسى بل امتدت إلى زمن المسيح أيضًا، الذي حاولتم قتله وجعله ملعونًا؛ ولكن الله تعالى سوف
يكشف أسرار هذا الحادث.وهذا التفسير ينطبق على هذه الآية إلى حد كبير، ولكني أرجح معنى آخر ؛ وقبل الدخول في ذكره أود
بيان أن المفسرين القدامى وقعوا في هذا الخطأ لأنهم ظنوا أن الحادث المذكور في قوله تعالى وإذ قتلتم
نفسا) يتعلق بزمن موسى ، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الأحداث والاعتداءات الصادرة من بني
إسرائيل في زمن موسى انتهى ذكرها إلى قوله تعالى وما كادوا يفعلون ، وابتداء من قوله تعالى إذ
قتلتم نفسا ) بدأ ذكر اعتداءاتهم التي صدرت في زمن محمد رسول الله.والدليل على ذلك أن الله
تعالى يقول بعد هذه الآية ثم قست قلوبهم..أي لم تأخذوه عبرة، ثم يحذرهم فيقول وما الله بغافل
عما تعملون..مما يدل أن الذين قست قلوبهم هم الذين قتلوا نفسا، ولذلك حذرهم.ثم قال بعدها
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم..أي يا أصحاب محمد ﷺ، هل تطمعون في إيمانهم؟
۳۳۵
Page 398
وهم
هناك حادثة من زمن الرسول ﷺ لم تزل مثار اعتراض من قبل أعداء الإسلام وهي حادثة قتل الزعيمين
اليهوديين كعب بن الأشرف وأبي رافع سلام بن أبي الحقيق، وذلك بأمر من النبي.يقول المعترضون:
يجوز قتل أحد في الحرب أو بسبب الحرب، ولكن هذين الرجلين لم يشتركا في الحرب ولم يحضا على
الحرب، فلماذا قتلا؟ وأرى أن آيتنا هذه رد على هذا الاعتراض حيث بين الله تعالى فيها أن هذا القتل
كان بسبب جرائم قومية تقع مسئوليتها على اليهود ولا اعتراض على موقف الرسول ، لأن ما نفذه
كان بأمر إلهي، وكان قصاصا مشروعا لجرائمهم.وبيان ذلك أن الله تعالى عندما كتب للمسلمين النصر في وقعة بدر احترقت قلوب اليهود حسدًا،
الذين عقدوا اتفاقية أمن مع الرسول الله عند قدومه مهاجرا إلى المدينة كما أخذت نار البغض تستعر في
نفوس المنافقين من المسلمين.والحق أن هذه الحرب كسرت شوكة كفار مكة من ناحية، ومن ناحية
أخرى أقضت
مضاجع اليهود والمنافقين..لأنهم كانوا يظنون أن قدوم المسلمين إلى المدينة أمر عادي
مؤقت لا خطورة فيه؛ ولكنهم بعد وقعة بدر حسبوا للمسلمين ألف حساب.ونتيجة لذلك شرع
المنافقون في حبك المؤامرات السرية ضد المسلمين من جهة ومن جهة أخرى أخذ زعيم اليهود كعب
بن الأشرف في إثارة اليهود بمختلف الطرق ضد المسلمين، وكان يعاضده في ذلك الزعيم اليهودي ابن
الحقيق.عن
كانت غزوة بدر في السابع أو التاسع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وبعدها بادر كعب
بالذهاب إلى أهل مكة يرثي قتلاهم ويثير حميتهم ويحرضهم على قتال المسلمين والثأر منهم.وفضلاً
ذلك اندفع في شره بالتشبيب بنساء المسلمين ليزيل من قلوب أهل مكة رعب المسلمين ويشجعهم على
الاشتباك بهم حتى إنه شبب بزوجة العباس عم النبي و و قد أدى ذلك إلى إثارة المسلمين من ناحية، ومن
ناحية أخرى شجع يهود المدينة على الشر حتى بدأوا يطعنون في النبي
ﷺ وفي المسلمين علنًا، ويعاكسون
السيدات المسلمات في المدينة.وذات مرة ذهبت امرأة مسلمة إلى السوق عند صائغ يهودي لشراء شيء من الحلي.وكان هناك جماعة
من بني قينقاع ومع أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب إلا أن المسلمات كن يحتجبن إذا خرجن إلى
السوق الذي فيه اليهود حياء منهن واتقاء من شرهم.وكانت هذه السيدة تستر وجهها من اليهود.فقال أحدهم: ارفعي حجابك عن وجهك، فرفضت.فربط أحدهم خمارها بشيء، وعندما قامت
منصرفة سقط عنها الخمار وانكشف وجهها فضحك اليهود.فرأت في ذلك إهانة شديدة لها،
فاستغاثت.وكان هناك مسلم يمر قريبا من الدكان فقفز لإغاثتها واشتبك مع اليهودي فقتله.فتكاثر
٣٣٦
Page 399
اليهود على المسلم فقتلوه أيضا.وكان هذا الحادث بمثابة إلقاء البترين على النار.فتوتر الجو وساءت
العلاقات بين المسلمين واليهود أكثر.السيرة النبوية لابن هشام، أمر قينقاع)
و لم يكن هذا الحادث عملاً فرديًا بل انعكاسا قوميًا نتيجة للتحريضات التي قام بها ابن الأشرف يريد بها
فتنة في المدينة حتى ينجحوا في قتل النبي ﷺ يقول ابن سعد: (فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي
والحسد، ونبذوا العهد (الطبقات لابن سعد).وتوتر الجو بحيث كان الصحابة يشعرون بالخطر
ويتحسبون هجوما من اليهود على النبي.فقد ورد في التاريخ أن الصحابي طلحة بن البراء مرض في
تلك الأيام مرضا شديدا، ولما احتضر كان الوقت ليلاً.فجمع أهله ووصاهم بألا يخبروا النبي ﷺ بموته،
بل يدفنوه بأنفسهم لكيلا يأتي النبي ﷺ إلى بيته ويشترك في جنازته وقت الليل.أراد الرجل بوصيته هذه
ألا يتعرض الرسول ﷺ لهجوم مباغت من اليهود وقال: "فإني أخاف عليه اليهود وأن يُصاب بسيي".الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني)
يتبين مما يسبق مدى تمادي اليهود في شرورهم وفتنتهم حتى أن المسلمين كانوا في خوف دائم على حياة
النبي.وكل إنسان منصف إذا لاحظ تحريض اليهود لكفار مكة على الهجوم على المدينة من ناحية،
ومن ناحية ثانية تشبيبهم العلني بنساء المسلمين بين قبائل العرب ومن ناحية ثالثة اعتداءهم الفاضح في
وضح النهار على حرمة نساء المسلمين ومن ناحية رابعة مؤامراتهم لاغتيال الرسول..أقول إذا
لاحظ كل ذلك فلن يعتبر هذا الحادث عملا فرديا..بل جريمة قومية لليهود.اللهم إلا أولئك المتعصبين
من النصارى الذين تجاهلوا ظروف التوتر والشر في المدينة؛ وقالوا مات واحد من اليهود ومات آخر من
المسلمين وانتهت القضية.حياة محمد، سير وليم ميور).بعد هذا الحادث أمر الرسول ﷺ بإجلاء بني قينقاع من المدينة، وبقتل كعب بن الأشرف رأس الفتنة،
وبقتل أبي رافع صهره ومعينه الأكبر على التحريض على المسلمين وزعيم قبيلة بني النضير..لأنهما
القاتلان الحقيقيان للمسلم واللذان توليا التحريض على قتل الرسول..يصرخ المؤرخون النصارى
حتى اليوم قائلين إنهما قتلا بدون جرم ارتكباه، ولكن الحقيقة أن قتلهما لا وزن له أمام الفتنة الهوجاء
التي تولوا كبرها.أرى أن آيتنا هذه تشير إلى نفس الحادث وتقول: إنكم صنعتم ما صنعتم من المعاصي والجرائم في زمن
موسى، واليوم عندما هيأ الله لكم فرصة أخرى للتقرب إليه..إذا بكم تصرون على شروركم الماضية،
وتتآمرون لقتل نفس عظيمة، ثم ترفضون تحمل مسئولية هذه الجريمة وتحاولون التنصل منها؛ ولكن
مكائدكم هذه لن تغنيكم من الله شيئًا، لأنه يعلم رءوس الشر والفتنة وسيهتك سرهم..أي علم الله
۳۳۷
Page 400
تعالى أن كعب بن الأشرف هو الذي يتولى كبر هذه الفتنة، ولسوف يهيئ الأسباب لينال العقاب على
بعض جرائمه.قال الله تعالى قتلتم نفسا ، ولكن الأحداث التي ذكرتها تبين أنهم أرادوا قتل الرسول ﷺ و لم يقتلوه
ذلك أن كلمة القتل لا تعني فقط القتل الفعلي بل تعني أيضًا إرادة القتل ومحاولته والتدبير
فعلا!
وسبب
سلسلة
الله وقد
له..كما قال الله : وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي
جاءكم بالبينات من ربكم)) ((غافر : (۲۹) فالقتل هنا بمعنى إرادة المصريين لقتل موسى ال، وهو المراد
في آيتنا هذه..لأنهم قد حرّضوا على قتل هذه النفس العظيمة، ودبّروا لذلك بطريقة كأنهم أوشكوا على
قتله فعلا.ثم إنهم كانوا فعلا قد قتلوا نفسا مسلمة..وإن كانت نفس واحد من عامة المسلمين، ولكن
الغرض الحقيقي من قتلها أن تثور فتنة حتى يتمكنوا من قتل نبينا محمد.فيمكن أن يكون المراد من
قتلتم نفسا قتل هذا المسلم الذي قتله بنو قينقاع؛ وكانت نفسا عظيمة بمعنى أن قتلها كان حلقة في
يريدون لها أن تمتد إلى نفس النبي.ولا يظنن أحد أنه كيف يمكن لليهود وهم قلة أن يجدوا في أنفسهم هذا الحماس ضد المسلمين.كانوا
قلة فعلا، ولكنهم كانوا واثقين من مساندة ممن لم يسلم من أهل المدينة عموما ومن المنافقين خاصة..لأن أهل المدينة كانوا حلفاءهم منذ سنين طويلة قبل هجرة المسلمين إليها.وعلاوة على ذلك، كان
اليهود يعتبرون أنفسهم أكثر ثقافة وتنظيما من غيرهم.ورد في التاريخ أنهم بدأوا يقولون بعد وقعة بدر:
"يا محمد إنك ترى أنا قومك !؟ ولا يغرنّك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة.إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.السيرة النبوية لابن هشام، أمر بني قينقاع
بعد هذا التمهيد نأخذ في تفسير الآية الكريمة.إن المخاطبين في قوله تعالى وإذا قتلتم نفسا ) هم اليهود،
والمراد بالنفس هو الرسول ﷺ أو الشخص أو الأشخاص الذين قتلهم اليهود تمهيدًا لقتل الرسول.فادار أتم فيها أي أنكرتم تآمركم وتخطيطكم لاغتيال النبي ﷺ أو اختلفتم في قتل المسلم الذي قتلته
جماعة منكم ثم أنكر كل واحد منكم مسئولية القتل والله مخرج ما كنتم تكتمون..أي أن الذي
حرّضكم على قتل هذا المسلم أو قتل النبيل سيفضحه الله تعالى؛ أو أنكم في الظاهر تشببون
بالمسلمات وتنتهكون حرمتهن وتهاجمون المسلمين، ولكن هدفكم الأبعد هو قتل النبي ، ولسوف
يظهر الله تعالى هذه الخطة الشريرة التي تدبرونها.فإن كنتم اليوم تحاولون إخفاء وإنكار خطتكم هذه،
وتتهربون من القرائن الدالة عليها.فلسوف تكشف الأحداث عن ذلك كشفا تاما.وبالفعل كشفت الأحداث فيما بعد عن نوايا السوء هذه عند اليهود؛ فقد دعا يهود بني
مرة للحديث معه في بعض المسائل الدينية، وكان خطتهم أن يغتالوه عندما تسنح فرصة لذلك، ولكن
النضير
النبي
۳۳۸
Page 401
الله تعالى حماه من ذلك حيث أطلعه على تدبيرهم فغادر ،موقعه حيث كانوا سيلقون عليه صخرة من
أعلى الجدار أبو داود، كتاب الخراج، باب خبر بني النضير.ثم إن يهودية من خيبر دعته للطعام، وقدّمت له كتف شاة مسمومة وما أن تناول النبي منه لقمة
حتى أخبره الوحي بذلك، فلفظها.وكان مسلم آخر أكل منها لقمة فمات (السيرة النبوية لابن
هشام، المسير إلى خيبر).معه
وهكذا يتضمن قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون نبأ غيبيا بأنهم لن ينفكوا في تأمرهم وسوف
يفضحهم الله ويكشفهم متلبسين.قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها..أي قلنا هاجموا بالسيف هذا الذي يريد قتل محمد ﷺ أو يمهد لقتله
بقتل أحد المسلمين، واقتلوه بسبب بعض جرائمه.يُقال ضربه بالسيف أي أوقع به وهاجم به لقتله وقد
قال ببعضها..أي بسبب بعض جرائمه، لأن عقوبة جرائم كعب بن الأشرف لا تتم في هذه الدنيا،
ولا يغطي قتله كل العقوبة، بل إنه ليستحق على جرائمه عذابًا في الآخرة أيضًا..لأن القرآن الكريم
يصف عقوبة جريمة القتل العمد قائلاً ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها) (النساء: ٩٤).ومن الثابت أيضًا في القرآن الكريم أن القاتل يُقتل أيضًا.فالقاتل - إذًا له عقوبتان: الإعدام في الدنيا
وعذاب جهنم في الآخرة.فكأن الله يقول هنا : عاقبوه عقاب الدنيا بقتله، أما بقية عقابه فسيكون بعد
موته.وأما قولنا بأن قوله تعالى ببعضها يعني ببعض جرائمه، فمثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: (واسأل
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)، وتقديره : اسأل أهل القرية ورجال القافلة.وقوله تعالى كذلك يُحيي الله الموتى يعني أن الأعداء يريدون إهلاك أنبيائه وجماعاتهم، لكنه تعالى
بحسب وعده مع الأنبياء يحفظهم منهم، وعندما يكونون في نظر العدو في عداد الموتى يكتب الله
لهم
حياة جديدة.فمن سنة الله المستمرة أنه لا يسمح للعدو بالنجاح في قتل النبي الأول والنبي
سلسلة النبوة للأمة، لأنهما النموذج الحقيقي للإحياء القومي.فقد كان موسى هو الحلقة الأولى من
سلسلة النبوة للأمة الموسوية، وكان عيسى الحلقة الأخيرة منها والإحياء القومي الذي تم لبني إسرائيل
الأخير في
على أيدي هذين النبيين لم يتم مثله على يد سائر أنبيائهم.ثم إن قوله تعالى كذلك يُحيي الله الموتى
إشارة إلى الإحياء العام الذي يتم في العالم بالنبي الأول والنبي الأخير من أية سلسلة، وتخبر الآية أن
أعداءهما يُبادون لأنهم لو لم يهلكوا لا يتم إحياء الدنيا.ومن ثم فلا اعتراض على هلاك الأعداء وقتلهم،
بل الاعتراض على بقائهم.۳۳۹
Page 402
وقوله تعالى (ويريكم آيته لعلكم تعقلون الغرض من إراءة هذه الآيات هو منع هؤلاء من الشر
وتوجيههم إلى الخير.لقد عاقب الله تعالى اليهود وحفظ رسول الله له وصحابته من كل شر ظاهر أو
خفي، وكان في هذا آية لقوم عاقلين؛ فأسلم بسببها بعض اليهود ولكن معظمهم لم ينتفعوا بها.إذًا، فهاتان الآيتان جواب على الاعتراض الذي لا يزال يروج له كتاب النصارى واليهود بأن النبي ﷺ
قتل ابن الأشرف وأبا رافع بدون جريمة ارتكباها يقول الله تعالى بأنهما تسببا في قتل بعض المسلمين،
وليس ذلك فحسب بل تآمرا وخططا لقتل الرسول.والتآمر على قتل إمام جماعة أو ملك أو رئيس
دولة هو بمثابة قتل القوم كلهم.وقد أطلق أهل الغرب على هذه الجريمة اسم (الخيانة العظمى) High)
(Treasion، ويعاقب مرتكبوها بالإعدام، وليس ضروريًا أن يكون المجرمون قد أفلحوا فعلاً في تنفيذ
المؤامرة.وفي هذه الأيام أيضًا يعاقب الجواسيس بالإعدام النقاد من اليهود والنصارى يعترضون على
قتلهما، ولكنهم يغضون النظر عن تآمرهما وتخطيطهما وتحريضهما على قتل النبي.فهل في العالم
حكومة لا تعدم من يتآمر على قتل رئيسها وكبار المسئولين فيها الحق أن أي حكومة لن تقصر في
إعدامه إلا إذا كانت لا تعرف قيمة رئيسها، فترى أن قتله لا يشكل جريمة كبرى ولا يضرها شيئا.أما
صحابة الرسول ﷺ فقد كانوا يحبون نبيهم أشد الحب ويجلونه أعظم الإجلال ويمكن أن يتبين الإنسان
مقدار حبهم له بما ذكرناه آنفا
عن الصحابي بن البراء الذي أوصى أهله ألا يدعوا النبي إلى جنازته
ليلاً حتى لا يتعرض لخطر اليهود إن اليهود والنصارى لا يدركون قيمة صلاة جنازة في قلوب
الصحابة- يؤديها الرسول ﷺ على أحدهم.ولو أنهم فكروا بدون تعصب منهم في تضحية هذا
الصحابي، لأدركوا أن حياة النبي ﷺ كانت في خطر شديد من اليهود في ذلك الوقت..حتى إن
الصحابي ضحى بنعمة صلاة الرسول التي كانت باليقين أحب وأعز إليه من ماله وأهله وأولاده وحتى
نفسه! ولو لم يكن الخطر داهما وحقيقيًّا لم يحرم الصحابي نفسه من هذه النعمة.طلحة
(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ) (٧٥)
شرح
الكلمات :
قسَت قسا قلبه صلب وغلظ.قسا الدرهم : زاف الأقرب).القسوة الصلابة في كل شيء، وقسوة
القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع (اللسان).٣٤٠
Page 403
يتفجر: تفجر الماء سال وجرى (الأقرب).يشفق: أصله يتشقق.شق الشيء: صدعه وفرّقه.تشقق الحطب: تصدع وتفرق (الأقرب).يهبط هبط من الخشية تضاءل وخشع (الأقرب) الهبوط : الانحدار (المفردات) (ولمزيد من الشرح انظر
:
الآية ٣٧).خشية: خشيه خشية خاف واتقاه والخشية: الخوف.وفي الكليات الخشية أشد من الخوف، وتكون
عظمة المخشي، والخوف من ضعف الخائف (الأقرب).الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون
ذلك عن علم بما يُخشى منه، ولذلك خُص العلماء بها في قوله تعالى: إنما يخشى
من
العلماء.(المفردات)
الله
من عباده
غافل: غفل عنه غفلة: تركه وسها عنه.غفل الشيء: ستره (الأقرب).الغفلة سهو يعتري الإنسان من
قلة التحفظ والتيقظ.يقال: أنت غافل أي لا تُعنى بشيء (اللسان).الغفلة
هو الذهول عن
الشيء
(التاج).فمعنى قوله تعالى (وما الله بغافل عما تعملون أي ليس ساهيًا عن أعمالكم؛ ما كان ليستر
أعمالكم على الدوام؛ لا ينسى أعمالكم بل يرتب عليها النتائج؛ يعنى بأعمالكم.التفسير قوله تعالى م قست قلوبكم.تبين كلمة ثم هنا أن مضمون هذه الآية يتعلق بالتي قبلها.والمراد: كان يجب أن تلين قلوبكم لرؤية الآيات الإلهية التي ذكرت من قبل، ولكن قلوبكم زادت قساوة
وشقاوة.والدليل على ذلك أنه بعد قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع، وإجلاء بني قينقاع من المدينة،
وبني قريظة في شرورهم وفتنتهم أكثر من ذي قبل.وقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة..أي صارت قلوبكم صلبة كالأحجار، بل أقسى منها.في كل لغة تقريبا تشبه قساوة القلب بقساوة الحجارة، وهنا أيضًا ورد نفس التشبيه والمراد أن قلوبكم
غير مستعدة لقبول تعاليم الله تعالى وأحكامه.إن بعض الأحجار يمكن إن تلين ولكن قلوبهم لا تلين.ولا
تمادى يهود بني
النضير
يدل حرف (أو) هنا على الشك وإنما بمعنى أن قلوب بعضهم قاسية مثل الأحجار وبعضها أقسى منها.وقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار..أي أن هناك أحجارا تنشق من ضغط الماء
الجاري وراءها فيسيل منها غزيراً كالأنهار وهذه الظاهرة تُلاحظ بكثرة في المناطق الجبلية حيث تنشق
الأرض الحجرية تحت تأثير ضغط الماء المنحدر تحت سطح الأرض من قمم الجبال، فتسيل المياه غزيرة.ولكن اليهود قست قلوبهم لدرجة أنه إذا سال ماء الكلام الإلهي لم تفسح له الطريق وأنكروا آيات الله
تعالى ظاهرا وباطنًا.٣٤١
Page 404
وقوله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه
منه الماء أي من الأحجار ما يتشقق بضغط الماء، ولكن لا
يسيل منه الماء نهرا وإنما يخرج منه القليل.والمراد أن الخير يظهر من بعض الناس بقدر كبير، ومن بعضهم
بقدر يسير.فمنهم من يكون كالأحجار الصلبة التي تحجز وراءها عيون ماء كبيرة..أي يقاومون الحق
في البداية مقاومة شديدة، ولكنهم في نهاية الأمر يقبلونه ويفسحون له الطريق..حتى يتدفق الحق منهم
من يقاومون الحق ويذعنون له آخر الأمر، ولكن لا يكون إيمانهم بقوة النوع الأول.أما اليهود فليس فيهم من يُعَدّ من هؤلاء أو هؤلاء بل هم أشد قسوة من الأحجار، فلا يقبلون الحقائق
السماوية بأي صورة، ولا يفسحون لها طريقا إلى قلوبهم ضيقًا أو واسعًا.بقوة.ومنهم
أيضًا
وقوله تعالى (وإنَّ منها لما يهبط من خشية الله) يمكن أن يُفهم بطريقين:
الله
أولاً : بإرجاع الضمير في (منها) إلى الحجارة..أي أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله.ولا يعني
ذلك أن الحجارة تعقل وتشعر كالإنسان بل لا بد من تقدير محذوف هنا..أي أن من الأحجار ما يهبط
أسباب خشية
تعالى كالعواصف والزلازل والفيضانات والصواعق..التي تسقط الأحجار وتفتتها.والمعنى انقلابات شديدة وتطورات عظيمة في الأرض والسماء، ولكن قلوب هؤلاء اليهود المتعصبين لا
تميل إلى خشية الله، ولا تخر ساجدة أمام الله.من
وثانيا : بإرجاع الضمير في (منها) إلى القلوب أي أن من القلوب ما تخر ساجدة بخشية الله.ولا عجب في
إرجاع الضمير إلى الاسم الأبعد (القلوب) بدل الاسم القريب (الحجارة)، فهذا الأسلوب متبع في القرآن.قال الله تعالى التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) (الفتح: ١٠)...فضمير
(الهاء) في تعزروه وتوقروه يرجع إلى (الرسول)، ثم يعود الضمير في (تسبحوه) على الله تعالى.وقال الله
في مكان آخر ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود الله فإن خفتم
ألا
الله
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود
فأولئك هم الظالمون (البقرة: ۲۳۰).فالضمير لجمع المخاطب في تأخذوا يرجع إلى الأزواج، ثم
ضمير الجمع للمخاطب في خفتم راجع إلى الذين يصلحون بين الزوجين.فهذا الأسلوب متبع في
اللغة العربية ويسمى "انتشار الضمائر الجواهر الحسان للثعالبي)
وقوله تعالى (وما الله بغافل عما تعملون يبين أن هذه الآيات القرآنية تتحدث عن اليهود المعاصرين
للرسول وتقول : إن أعمالكم الشريرة ضد نبينا ليست بمستورة عن الله تعالى، ولسوف يعاقبكم بها.(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٧٦)
٣٤٢
Page 405
شرح
الكلمات :
تطمعون: طمع فيه : حرص عليه (الأقرب).والطمع نزول النفس إلى الشيء شهوةً له.طمع فيه وبه:
حرص عليه ورجاه (التاج).والطمع ضد اليأس (اللسان).فمعنى أفتطمعون)) أَفَتَرْجون؟ أَفَتَحْرِصون؟
أن يؤمنوا لكم آمن له خضع له وانقاد وآمن به صدقه وآمنه هيأ له الأمن (الأقرب).فمعنى
(أفتطمعون أن يؤمنوا (لكم هل تحرصون أو ترجون أن يقبلوا قولكم أو ينقادوا لكم
فريق: الفريق الطائفة من الناس، وقيل أكثر من الفرقة.وربما أطلق الفريق على الجماعة..قلت أو كثرت
(الأقرب).يحرفون حرفه: غيّره وحرّف الكلام غيره عن مواضعه (الأقرب).تحريف الكلام أن تجعله على حرف
من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين (المفردات).التفسير : من أسلوب القرآن الكريم عمومًا أنه عندما يستخدم صيغة آمن به) فيعني التصديق والإيمان
بالمفهوم المعروف كقوله تعالى (والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك) (البقرة:٥)؛ وعندما
يستخدم صيغة آمن (له فيعني الطاعة والانقياد والتصديق الجزئى لا الإيمان الكامل..كقول إخوة يوسف
لأبيهم (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) (يوسف: ۱۸) ، أي لن تصدق قولنا في هذا الصدد.قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعود ضمير المخاطب في كلمة (لكم) إلى جماعة المؤمنين، لا إلى
الله تعالى ورسوله والمراد أن بعض المسلمين يُحسنون الظن باليهود ويصدقون وعودهم بالتعايش معهم
في سلام ووئام..ولكن الله تعالى يقول إنكم مخطئون في هذا الظن لأن الوفاء بالوعد نابع عن شرف
النفس أو خشية الله.ومن يلجأ إلى الكذب والخداع فلا يتوقع منه الوفاء بالعهد.ولجوء اليهود إلى هذه
السيئات دليل كاف على ألا اعتبار لوعودهم وأقوالهم؟
ثم يقول وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).إِن
التحريف عمل سيئ، ولكن إذا وقع فيه الإنسان لعدم فهم أو لِسَهْو فذلك لا يدل على سوء
المحرف بل على جهله وخطئه.وأما اليهود فيحرفون كلام الله عمدًا وبعدما عرفوا معناه جيدًا؛ ومن
يرتكب مثل هذا الافتراء والظلم في حق دين قوم أو في حق ديانته وقومه هو فكيف يُتوقع منه أنه سيفي
بعهده شرفا وأمانة أو خشية من
إذا كان المراد من كلام الله تعالى كتب اليهود، كما قال عامة المفسرين القدامى، فأيضًا لا يتوقع من قوم
يرتكبون هذه الخيانة في حق دينهم أنفسهم أن يكونوا أمناء مع غيرهم من الأمم.الله تعالى.قصد
من
٣٤٣
Page 406
وإذ كان المراد من كلام الله تعالى القرآن الكريم، كما رأى بعض المفسرين وكما أرى أنا أيضًا، نظرًا
للسياق، فلا يبقى لقول اليهود المحرفين أيُّ اعتبار ؛ لأن كلام الله تعالى هو أغلى كتر عند أي قوم،
وتكون مشاعرهم تجاهه حساسة للغاية.فإذا كان اليهود معتادين على تحريف معاني القرآن وإلباسها
لباسًا مخالفا للمراد منها، مجرحين مشاعر المسلمين الحساسة، فكيف يتوقع منهم
أن يوفوا بعهدهم مع
المسلمين في المعاملات الدنيوية؟ إذا جرحت أشد مشاعر الإنسان حساسية فكيف يتوقع منك ألا تجرحه
في مشاعره العادية؟
يتبين من هذه الآية أنه كان من عادة اليهود أن يأخذوا آيات القرآن الكريم مبتورة عن سياقها أو
يلبسوها معنى مخالفا للمراد منها، ويعرضوها للناس هكذا لإثارتهم ضد الإسلام.وهذه العادة لم تزل في
أعداء أنبياء الله تعالى منذ القدم.لم يُبعث نبي إلا ولجأوا إلى هذا الأسلوب الشائن ضده، بل ليس هناك
حقيقة إلا وحاربها مخالفوها بهذه الحيلة..لأن معارضة الحق تضطر الإنسان إلى الكذب، إذ لا يستطيع
معارضة الحق وإثارة الناس ضده إلا إذا ألبسه لباس الباطل.وإن الافتراء على عقائد الآخرين لهو أكبر
جريمة تُرتكب على وجه البسيطة اليوم أيضًا، وهذا ما يحول دون قبول الناس للحق.لو أن الناس صمموا
ألا يلبسوا دين معارضيهم لباسًا كاذبًا، وأن يعرضوه أمام أنفسهم وأمام الآخرين كما يقول به أهله..لم
يتعذر معرفة الحق، ولزالت الفرقة والشقاق والنفاق بين الأمم في أسرع وقت.وإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا حَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
ليُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (۷۷)
کلام
کلام
=
فسير بين الله تعالى في الآية السابقة أن اليهود يعاملون المسلمين تعصب شديد، حتى إنهم يعرضون
الله تعالى أمام الناس بمعان محرفة ليثيروهم ضد المسلمين.وفي هذه الآية بين أنهم لا يسخرون من
الله
تعالى فحسب، بل يسخرون من المسلمين ويعاملونهم في غير إخلاص.فعندما يقابلونهم
يتظاهرون أمامهم بأنهم يؤمنون بصدق الإسلام من قلوبهم، بل يخبرونهم بأدلة أقنعتهم بصدقه، ويخبرونهم
بالأنباء التي وردت في كتبهم والتي تنطبق عندهم على محمد رسول الله ، وتنطق بصدقه؛ ولكنهم
عندما يرجعون إلى أصحابهم من اليهود يلوم بعضهم بعضًا قائلين كيف تخبرون المسلمين بأمور سوف
يأخذونها حجة عليكم في دينكم؟ إن أسلوبهم هذا يدل على أنهم لا يخالفون المسلمين بسبب الدين فقط،
بل يعادونهم عداء سياسيا وحضاريا..إذ إنهم لا يكتفون بالاعتراض على الإسلام فقط، بل إن علاقاتهم
الدنيوية بمعارفهم من المسلمين ليست جادة مخلصة، وإنما ملؤها المكر والخداع.٣٤٤
Page 407
وهذا الجانب الأسود من أخلاق اليهود خطير جدا، لأنهم بأسلوبهم هذا يعترفون بأن ما يذكرونه
للمسلمين هو
مما أنبأ الله تعالى به في كتبهم، وأنه يثبت صدق الإسلام، ولكنهم لا يريدون أن يطلع عليه
المسلمون كيلا يستخدموه ضدهم.وكأنهم بسلوكهم هذا يودون الاستمساك بجاههم المادي وعزهم
الدنيوي حتى لو أدى ذلك إلى اعتبار أن كلام الله تعالى باطل وأن مشيئته لم تنفذ.ومن كان هذا خلقه
فأي منفعة ترجى منه لقيام الدين وإرساء الأخلاق الحميدة؟ بل إن هلاكه خير للدين والدنيا.وهذا
الخلق من اليهود الذي برز عند بعث النبي لا
لا له الدليل قوي على أن هذا القوم لم يعودوا مستحقين لنعم الله
ﷺ
تعالى؛ وكان من المناسب أن يظهر النبي الموعود في قوم غيرهم.وقوله تعالى (أتحدّثونهم بما فتح الله (عليكم يمكن أن يفيد مفهومين: الأول، إذا كان صدق الإسلام قد
انکشف عليكم بالأدلة العقلية أو بالآيات والمعجزات، فلماذا تذكرون ذلك أمام المسلمين، والثاني، لماذا
تخبرون المسلمين بالأنباء التي وردت عن محمد رسول الله ﷺ وقد تحققت في شخصه وأكدت صدقه؟
وكلا المفهومين ينطبقان هنا في آن واحد.فكان اليهود على صنفين: صنف لم يكن واقفا تماما على ما
في التوراة، ولكن قلوبهم استيقنت بصدق الرسول الله بعد سماع الأدلة العقلية وشهود المعجزات التي
ظهرت على يده ، وصنف آخر كانوا مطلعين تماماً على ما ورد في التوراة من أنباء عن النبي الموعود
تحققت في شخص النبي محمد و وانكشف عليهم صدقه.وكان هؤلاء يذكرون هذه الأنباء للمسلمين
ويقولون لهم أن رسولكم صادق بحسب نبأ كذا في سفر كذا من كتبنا.وقوله تعالى (ليحاجوكم به عند ربكم.هناك إشكال حول عبارة عند ربكم) أريد توضيحه: المعنى
(عند
العام لهذه الجملة أن بعض اليهود قالوا لبعضهم: هل تذكرون للمسلمين الأنباء الواردة في كتبنا، أو
تعترفون أمامهم أن صدق نبيهم قد ظهر لكم من الأدلة العقلية؟ ألا تفكرون أنهم سوف يحتجون بها
عليكم عند ربكم ليثبتوا عليكم جريمتكم؟
قد يعترض هنا معترض ويقول: إن الله تعالى هو عالم الغيب عند المسلمين واليهود، فكيف يُعقل أن يلوم
بعض اليهود إخوانهم لوضع الحجة في يد المسلمين ليرفعوها في وجوههم يوم القيامة أمام الله تعالى؟
والجواب (أولاً): يصح هذا الاعتراض إذا سلّمنا بأن كل الناس متساوون في إيمانهم بالله.وهذا غير
صحيح.إذ من الناس من يعتقدون بأن بعض البشر يعلمون الغيب.وهناك من يظنون أن الله تعالى لا
يعلم كل الغيب.وقد ورد في القرآن الكريم عما سيكون بين الله تعالى وبين الكفار من حوار يوم
القيامة: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين (الأنعام: (٢٤)، أي عندما تقوم الحجة
على الكفار يوم القيامة سوف يرددون كلامًا واحدًا ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين.ومثل هذا
الجواب أمام علام الغيوب ليس إلا جهلاً فاضحا، ولكن مثل هذه الأفكار الحمقاء موجودة في بعض
٣٤٥
Page 408
الناس
فعلاً.فهناك فلاسفة يعترفون بأن الله عالم علمًا كليا ،إجماليًا، ولكنهم ينكرون علم الله للأشياء
علما تفصيليا بكل جزئياتها.و لم يكن بعيدًا عن مثل هؤلاء الفلاسفة من اليهود أن يقولوا لإخوانهم: لماذا
تطلعون المسلمين على ما في نفوسكم حتى يحتجوا به عليكم يوم القيامة والواقع أن مثل هذه الأفكار
الخاطئة كانت تصدر منهم.فمثلا قالوا إن إبراهيم كان يهوديًا، مع أن اليهودية بدأت بموسى، بل ما
وصف اليهود بهذا الاسم إلا بعد سليمان عليهم السلام وكان إبراهيم قبل هؤلاء بقرون عديدة.فعندما
يصيب الأقوام الانحطاط والإدبار يتسرعون في قول مثل هذه الأقوال اللامنطقية والمتضاربة..لأن إيمانهم لا
يتأسس على برهان ودليل، بل على ما يسمعونه دون تدبر.ومصدر هذا الذي يسمعونه أناس يحملون
أفكارًا متضاربة، لذلك تكون حصيلة ما يصل إليهم معلومات متضاربة.ثم إن الإنسان عندما يحمل
عقيدة مخالفة للعقل يضطر لإثبات صدقها للقول بما يخالف العقل أيضًا.وإن الدين الحق لا يحقق النجاح
إلا لأنه لا تضارب فيه.وعندما يخلو الإنسان إلى نفسه ساعة يبرأ فيها من التعصب يصيده الحق، وهكذا
تزدهر الجماعات الربانية.هم
كلمة
و (ثانيا): أن كلمة (عند) لها في العربية عدة معان منها مكان الحضور أي بحضور ربهم، وتعني أيضا
بحسب الاعتقاد أو الحكم فيقال هذا عند فلان حرام أي بحسب رأيه، ويقول القرآن الكريم عن الذين
رموا الآخرين بالزنا (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون) (النور:١٤)..أي أن هؤلاء
الذين اتهموا الآخرين بالزنا و لم يأتوا بأربعة شهداء هم بحسب حكم الله تعالى الكاذبون.ولا تعني
(عند) هنا في علم الله تعالى أو في حضوره، إذ من الممكن أن يكون الشخص في اتهامه صادقًا ولكن لم
يستطع أن يأتي بالشهداء الأربعة، فهو في علم الله تعالى صادق، ولكنه بحسب حكم الله تعالى كاذبًا ولا
يعتد بقوله، لكيلا يشجع ذلك الكاذبين على رمي الآخرين افتراء بالزنا بدافع العداوة دون أن يأتوا
بالدليل الكافي..وإلا فالله يعلم الصادق من الكاذب بدون شهادة.وقال بعض العلماء أن (عند) هنا بمعنى (في)..أي ليحاجوكم به في ربكم، بمعنى: في الأمور المتعلقة بالله
تعالى (البحر المحيط).وقوله تعالى (أفلا تعقلون) خطاب لليهود، ويتبين منه أن الإسلام لا يرضى بالإيمان نفاقا بدون إخلاص،
ولأجل ذلك استنكر فعل اليهود هذا حيث كانوا يعترفون أمام المسلمين بالإيمان مع عدم توصلهم إلى
الإيمان الصادق.ولو كان التصديق باللسان وحده مُجديًا في الإسلام لأشاد القرآن بإعلانهم هذا ولهياً
لهم الفرص لمزيد من التقارب مع المسلمين ولإظهارهم بمظهر المؤمنين.كما يقول الله تعالى هنا لليهود:
إن العاقل يأتي عملاً يُكسب كرامة له ولقومه، ولكن قائل هذا القول يعترف أنه خائن الله تعالى، إذ يفهم
٣٤٦
Page 409
مشيئته ويعرف أنباءه،
فهل هذا تصرف عاقل؟
سمع
ومع
ذلك يعلن على الملأ أنه يقف سدا يحول دون تحقق أنباء الله وتنفيذ مشيئته.كما أن قوله تعالى (أفلا تعقلون) ردّ على مزاعم بعض الكتاب من النصارى الذين قالوا إن محمدا لله
أحداث التوراة من اليهود وذكرها في القرآن فالظاهر أن من يستقي معلومات من مصدر يحاول
توطيد الصلة به، لا قطعها.فإذا كان نبينا الله يفعل هكذا، وحاشاه أن يفعل لم يكن ليهتك ستر اليهود
ويكشف فسادهم، بل كان عليه أن يهيئ الفرص للتقارب معهم.أولا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) (۷۸)
التفسير : في هذه الآية أيضًا رد على الكتاب النصارى الذين يتهمون نبينا محمدًا المصطفى ﷺ بسماع
واقعات من التوراة ووضعها في القرآن الكريم..إذ تقول إن الله تعالى يخبر نبيه بكل خبر ضروري.ألا
يعلم اليهود أن الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أي أنه تعالى ذكر في القرآن أخبارا لم يكونوا
يعرفونها، وذكر فيه أيضًا أخبارًا وردت في التوراة.أفلا يفهمون من ذلك أنه إذا لم يذكروها في التوراة
لم ينقص ذلك من مضامين التوراة شيئا.ما زال أعداء الحق يعترضون على أنبياء الله تعالى بأنهم صُنع أحداث ،زمنهم، إذ إنهم يدعون نبوتهم
متأثرين بالتيارات الفكرية المعاصرة لهم.لا شك أن الله تعالى عندما يريد بعث نبي يوجه قبل مجيئه أنظار
الناس إليه، فيأخذ الناس في الحديث عن أنباء سابقة ويقولون إن هذا زمن تحققها، ويستنتجون من بعض
العلامات أنه سيبعث في هذا العصر.وهكذا يجب أن يكون لأن تهيئة الأسباب والمناخ في الدنيا لقبوله
أمر ضروري لا يمكن أن يغفل عنه الله تعالى.فإذا أتى الموعود استند أيضًا إلى تلك الأنباء التي بدأ علماء
زمنه قبل مجيئه يتطلعون إلى تحققها.فالاستدلال من هذه الظاهرة أن الأنبياء من صنع
استدلال واه جدًا.هل يرون أنه لا بد من بعث النبي أولاً ثم أن يهيئ الله الأسباب لمعرفة صدقه؟ لو فعل
الله ذلك لكان معناه أنه تعالى بنفسه يريد حرمان الناس من الهداية أو هل يريد هؤلاء المعترضون أن
الله تعالى الأسباب لمعرفة الأنبياء، ويظهر علامات لتحقق الأنباء السابقة..ولكن لا يجوز أن ينتفع
عند بعثه وإلا عُدَّ من الذين يتأثرون بالأفكار السائدة في زمنه؟ وسخف هذا القول واضح
يهيئ
بها النبي
أحداث عصرهم
=
بالبداهة، لأن عدم انتفاع المبعوث بما هيأ له الله تعالى من آية لإظهار صدقه يعتبر خيانة في حق
ودينه والنبي لا يكون خائنا أبدا.الله
فلا اعتبار لمثل هذه الاعتراضات سواء أكانت على الأنبياء السابقين عليهم السلام، أو على نبينا محمد ﷺ
أو على الإمام المهدي والمسيح الموعود ال.وترد هذه الآية ردًا رائعًا على هذا الاعتراض حيث تقول
٣٤٧
Page 410
بأن القرآن يبين أموراً توجد في كتبكم، كما يذكر أموراً لا توجد عندكم؛ إن الله تعالى، العليم بكل
الأمور، لا يحتاج كتابه إلى علم من لدن الآخرين، كما لا يمكن أيضا أن يسكت عن شيء لمجرد أنه
ذَكَرَه من قبلُ في كتاب سابق..لأن ذلك وأد للحق، وكتاب الله تعالى أسمى من ذلك وأجلّ.وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله ليَشْتَرُوا به ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ ممَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ ) (۸۰-۷۹)
شرح الكلمات :
أماني: جمع أُمنية؛ ما تتمناه؛ الكذب؛ ما يُقرأ؛ المقصود والغاية.التفسير : من معاني الأُمنية (ما يُقرأ، ويكون المراد من الآية أن من اليهود من يقتصر علمهم على قراءة
صحفهم فقط..وليسوا بقادرين على فهمها تماماً.وهذا بالمفهوم المحدود لكلمة (أُمِّيُّونَ)، وليس بمعناها
العام أي من لا يستطيعون القراءة أصلاً، فالمقصود منها من لا يعرف دقائق اللغة، ولا يدرك من المعاني
إلا الظاهر منها.فالآية تدمع اليهود بأن منهم من لا يجتهد لدراسة عميقة لكتبهم، وعندما يقرءون فيها
كلمات ذات أوجه يختارون منها وجهًا يخالف سنة الله ومشيئته، تاركين منها ما يطابق سنته ومشيئته.وفي هذا الموضوع عبرة كبرى للمسلمين..لأن حالهم هكذا أيضًا.فمعظمهم لا يعرفون معاني القرآن
الكريم، ومن عرفها منهم فإلى حد محدود جدًا.لا يلتفتون ولا يريدون الالتفات إلى ما في القرآن من
مضامين كثيرة ومفاهيم غزيرة..بل من يحاول ذلك يرمونه بالتأويل والكفر.ولأجل ذلك سُدّت أمامهم
أبواب خزائنه، وأصبح ماؤه الجاري لهؤلاء راكدًا آسنًا.أو لم يفكروا أن ما عابه القرآن على اليهود لا
يمكن أن يكون جمالا فيهم.ومن معاني الأمنية: ما يتمناه المرء، وعليه تكون كلمة (أميون) بمفهومها العام..أي من لا يستطيع القراءة
والكتابة إطلاقًا.والمراد من الآية أن من اليهود من لا يستطيعون قراءة كتابهم، أو أنهم يستطيعون تلاوته
من الذاكرة ولكن بدون معرفة للمعاني، ويظنون أنهم إذا قرأوا صحفهم هكذا أو سمعوها بلا فهم لمعانيها
كفاهم هذا للنجاة.وكأن كتاب الله تعالى يولّد أمنية فقط في قلوبهم ولا يهبهم علما ونوراً.وهذا هو حال المسلمين أيضا فهناك الملايين منهم الذين لا يقدرون على القراءة من المصحف، والملايين
منهم من يقدرون على قراءته ولكنهم لا يعرفون معانيه وكلتا الفئتين تعوزهم الرغبة في قراءة القرآن
وفهم معانيه.يكتفون بسماع شيء من القرآن يتلوه أحد المقرئين أو غيره، أو يرددون قدرا يسيرًا بدون
٣٤٨
Page 411
فهم
لما يرددون، ويحسبون أن هذا يكفيهم لنجاتهم.والواقع أنهم لم يسمعوا القرآن ولم يقرأوه، وإنما
سمعوا أنغام القراءة ونظروا في بعض السطور المرقومة.إن القرآن الكريم اسم للمضمون الذي تنطوي
عليه كلماته، ومن لم يقرأ هذا المضمون مدركًا أنه هو المراد من الكلمات فلم يقرأ القرآن.ومن لم يفهم
هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى لهداية العالم فأنى له أن يدعي الإيمان بدين صادق؟ إنني لا أقول أن من
لا يعرف معاني القرآن فعليه ألا يقرأه، لأن مثل هذه القراءة، على الأقل، تذكره بغايته؛ ولكني أقول: من
الضروري أن يجدوا في قلوبهم رغبة لفهم معانيه، وأن يحاولوا تعلمها وما دامت هذه الرغبة موجودة
والمحاولة جارية..فلا شك أنهم سوف يعدون عند الله من الناجين.أما إذا كانت الرغبة مفقودة والمحاولة
معدومة فكيف يرضون تعالى بمحض أمانيهم؟
الله
من قول الله
ومن معاني الأمنية الكذب..فيكون المراد من الآية أن اليهود من الأميين الذين لا يعرفون عن كتبهم إلا
الكذب.لا يعرفون معاني كلام الله تعالى ولكن يريدون أن يحسبهم الناس من العلماء وهم في الحقيقة لا
يعلمون شيئًا.وأي خير في مثل هؤلاء اليهود لأنفسهم أو لسواهم؟ وكيف يستحقون أن يتزل عليهم
فضل الله تعالى وهم أعداء دينه؟ يسيئون إلى الله تعالى إذ يُلقون بجهلهم عليه جل وعلا، ويضلون البسطاء
بقلة علمهم.وللأسف أن مثلهم في المسلمين كثيرون فمنهم من لا يستطيعون قراءة القرآن، ولكنهم
يرددون على الناس ما سمعوه من قصص وأساطير جمعوها من هنا وهناك، ويوهمونهم أنه
وسنة رسوله؛ ثم يلحون عليهم أن يؤمنوا ويعملوا بها.ومنهم من يلمون بالعربية قليلاً ولكنهم محرومون
من الكفاءة لفهم دقائقها وإدراك مراميها، وبسبب علمهم الناقص بالقرآن يَضلُّون ويُضلون.ومنهم من
يستطيعون تلاوة القرآن ويتعالون بذلك على العامة الذين لا يعرفون التلاوة، ويتظاهرون أمامهم بالمهارة
في علوم القرآن الواقع أن هؤلاء هم السوس الذي ينخر في أساس الإسلام.فلو أن المسلمين اهتموا
بقراءة القرآن وحاولوا تدبره وفهمه فهما صحيحًا، ولم يتبعوا الكاذبين و لم يسيروا وراء أهوائهم..لم ير
الإسلام هذا اليوم الأسود الذي يُحزن قلب كل مسلم مخلص.يبين قوله تعالى (وإن هم إلا يظنون أن كل هؤلاء الأصناف من الناس الذين مر ذكرهم يعتمدون على
الظن ولا علم عندهم.وقوله تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ضرب من جمال الإيجاز والبلاغة في أسلوب القرآن
الكريم.إذ تبدو هذه الآية وكأنها تعقيب يكمل الآية السابقة، ولكنها في الحقيقة تعرض صنفًا آخر من
أهل الكتاب.فالآية السابقة تذكر أولئك الذين لا يعرفون العبرية ولا اطلاع لهم على ما في أسفارهم من
مفاهيم دقيقة، فيضلون ويُضلون؛ أو الذين يقرأون صحفهم أو يحفظون جزءاً منها ولكنهم لا يعرفون
معانيها، وإنما يتمسكون ببعض تفاسير من علمائهم ويذكرونها للناس في غير مناسبتها على أنها التعاليم
٣٤٩
Page 412
الحقة في كتبهم.فكأن الآية السابقة تتناول ذكر الجهال منهم.وأما هذه الآية فتتناول العلماء منهم،
وتبين أن أولئك اليهود الذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يوهمون الناس أنها من عند الله..سوف يتزل الله
بهم عذابه.واستخدام حرف (الفاء) في قوله تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب يدل على أن الضلال الذي وقع فيه
الجهلة كانت نتيجة لما ينتحله هؤلاء الكتاب العالمون الذين فسدت ضمائرهم؛ فنسبوا إلى الله ما كتبوه
من عند أنفسهم.وفضلاً عن ذلك تذكر الآية هنا علماء اليهود الذين خلت قلوبهم من الأمانة والتقوى،
وتسببوا في ضلال الآخرين وهلاكهم بما قدموه لهم من تفاسير وفتاوى باطلة على أنها كلام الله تعالى،
فهؤلاء سيتحملون مسئولية فسادهم ومسئولية إضلال العامة ومن على شاكلتهم.هذه العبارة الوجيزة والكلمات المعدودة بين الله تعالى أولاً أن في اليهود علماء ولكنهم يستغلون
أسوأ استغلال، وثانيًا أن هؤلاء العلماء مسئولون عن ضلال ،الجهال وثالثا أنهم سيلقون عقابًا
بسبب جريمتهم ذات الشقين: ضلال وإضلال.وقوله تعالى ليشتروا) به ثمنا قليلاً) يبين أن هؤلاء العلماء يفسدون دينهم لأغراض دنيوية، ولا حرج
عندهم لو ضاع الدين إذا سلمت لهم الدنيا.ففي
علمهم
مضاعفا
وقد يتساءل أحد: لماذا قال يكتبون الكتاب بأيديهم وكل كاتب يكتب بيده؟ والجواب أن الله تعالى
قال (بأيديهم) تأكيدًا بأنه كتبوا ذلك بأنفسهم هم، لأن فعل (كتب) يعني أيضا الإملاء على الآخر
ليكتب لك.ورد في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: "أكتُبث لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا"
(البخاري، كتاب المغازي)..مع أن الثابت من القرآن والتاريخ أنه لم يكن يعرف الكتابة.فقوله ﷺ
"أكتب لكم" إنما يعني أُملي على أحدكم.فبذكر (أيديهم) في الآية أشار إلى العلماء الذين يجيدون
القراءة والكتابة كيلا يظن أحد أن الآية تتحدث عن الجَهَلَة الذين مرَّ ذكرهم في الآية السابقة.قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يبين أن هؤلاء العلماء لا يستحقون عذابًا
ضعفًا بل ثلاثة أضعاف أولاً ، لأنهم أضلوا الجهال؛ وثانيًا، لأنهم نسبوا إلى كلام الله تعالى ما ليس فيه؛
وثالثًا، لأن الباعث على التحريف والتزوير لم يكن خيرا، بل كسب متاع دنيوي قليل.وتبين هذه الآية فلسفة هامة للثواب والعقاب.فالأعمال السيئة على نوعين: سيئة تقع عن جهل وغفلة،
وسيئة ترتكب عن عمد.ثم هذه السيئة العمد أيضًا على قسمين: الأول ما يكون باعثه فكرة خيرة وإن
كانت خاطئة؛ والثاني ما يكون دافعه فكرة شريرة.فمثلاً إذا قتل شخص غيره عن خطأ أو جهل فهذه
جريمة بلا شك ولكن مرتكبها إما أن يُعفى من العقاب تماما أو يُعاقب عقابًا خفيفا إذ كان مقصرًا في
الاحتياط والحذر.ولكن هناك قاتلاً آخر قتل متعمدا ظنًا منه أن الرجل قد قتل ولده أو أحدًا من
صلحاء
۳۵
Page 413
قومه.فهذه جريمة منكرة ولا شك ولكن باعثها خير.ثم هناك قاتل ثالث قتل أحدا ليسلب نقوده
لينفقها على الملذات الدنيوية..فهذه جريمة سيئة وباعثها أيضًا سيئ، وبالتالي فقد ارتكب جريمتين: القتل
والطمع، فيستحق عذابًا مضاعفا
وكذلك الحال للحسنات فهي أيضًا على أنواع فقول القرآن أنهم يعذبون بسبب ما كتبت أيديهم،
ويعذبون لأنهم فعلوا ذلك لكسب متاع الدنيا القليل..قد بين نكتة لطيفة للأخلاق، وفتح بابا للعلم لمن
أراد أن يتزود بالتقوى.يستنتج النصارى من هذه الآية أن القرآن الكريم يعترف ضمنًا بحفظ كتابهم المقدس إلى زمن النبي ،
وإلا ما اعترض على تحريف كتاب كان محرفًا من قبل.والجواب أولاً، أننا لم نفسر الآية بإنها تتحدث
عن تحريف التوراة أو الإنجيل، لذلك فاستناجهم باطل وفي غير محله.ثم لو فسرنا الآية بهذا المعنى أيضًا
وأنها تتهم اليهود بأنهم كانوا يحرفون كتابهم أيضا في زمن الرسول ﷺ فليس معناه أن كتابهم كان
بالضرورة سليمًا من التحريف قبل ذلك.نعم، يحق لهم القول أنه ما وجه الاعتراض على تحريف ما هو
محرف أصلاً؟
والجواب: لا شك أن اليهود كانوا قد بدأوا قبل نزول القرآن بالتحريف في التوراة حتى
قبل المسيح أيضا، واستمرارهم في التحريف أيضًا أمر سيئ ،ومشين ومن ذلك لا بد من التسليم بأن
التوراة كتاب سماوي ولكنه محرف مبدل.إذا كان هناك كتاب من صنع الإنسان وظنه أحد خطأ أنه
كتاب من الله..ثم حرفه بأكمله فلا بد من اعتباره محرمًا..لا بمعنى أنه يحرّف كتابا ربانيا، بل لأنه يحرف
الله تعالى.جاء في القرآن الكريم : (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله
يعلم إنك لرسوله.والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) (المنافقون:(۲).فعلى الرغم من أن المنافقين كانوا
يشهدون بالحق الذي شهد عليه الله بنفسه إلا أنهم عُدُّوا كاذبين لأنهم لم يكونوا يؤمنون في قلوبهم بما
تشهد به ألسنتهم، وكما أن تظاهر المرء بالإيمان بشيء حق لا يؤمن به قلبه يُعَدُّ نفاقًا، كذلك فإن
التحريف في كتاب محرف أصلاً على أنه كلام الله تعالى يعتبر علامة كفر وجريمة يستحق مرتكبها أن
يُحذره الله في كتابه.إن التوراة لم تكن إلى زمن الرسول ﷺ محفوظة، بل كانت محرفة مبدلة، ولكن
اليهود كانوا يعتبرونها محفوظة وغير محرفة، وأنها من بدايتها إلى نهايتها كلام الله تعالى، وإذا كانوا مع هذا
الاعتقاد يخفون مضامينها أو يحرفون فيها فهذا دليل على سوء إيمانهم وقبح فعالهم.كتابا يحسبه من
ور
ثم إنه يجب تذكر أن التوراة حتى في شكلها الحالي تتضمن آلاف الحقائق، فإذا حرَّفوها اليوم أيضا كانوا
مجرمين.وهناك معنى آخر لهذه الآية هو أن اليهود يعتقدون أن التوراة ضاعت عند غزو الملك البابلي بختنصر
لأورشليم وهدم معبدها، ثم ألفها فيما بعد النبي عزرا فكأن تاريخ اليهود أيضا يؤكد أن التوراة الأصلية
۳۵
Page 414
لم يعد لها وجود، بل إن بعض الناس جمعوها وصححوها، فكانت بمثابة الأحاديث النبوية عند المسلمين.وكما أن الأحاديث النبوية لا يمكن تسميتها كتاب الله كذلك لا يمكن تسمية التوراة كتاب الله لأنها
صارت عرضة لاحتمال الخطأ..ولا سيما أن اليهود لم تكن عندهم قط عادة حفظ التوراة عن ظهر
غيب، كما أن الشهادات الداخلية للتوراة تؤكد أنها ليست بشكلها الأصلي..بل أضيف إليها كثير من
الزوائد والتفاسير والروايات الخاطئة.فيمكن أن تعني الآية أيضًا أن هؤلاء اليهود يعرفون بأنفسهم حسب
شهادة تاريخهم أن كتابهم لم يسلم من أيد ،محرفة، ومع ذلك يصرون أنه كتاب الله تعالى.لا شك أنه
كان كتاب الله في بادئ الأمر، ولكن بعد كل ما حدث له على أيدي المحرفين من زيادة ونقص، لا يجوز
تسميته كلام الله ووضعه بإزاء كتاب هو كلام الله الخالص.فإن ذلك ظلم وإجحاف.أما النصارى فقد ساروا خطوة أبعد من اليهود فيقولون إن كل الأناجيل كلام الله تعالى.ولكنك لو
فتحت كتابهم وجدت فيه إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ورسائل بطرس ورسائل
بولس ورسائل كيت ورسائل كيت.فكيف يمكن أن تكون أناجيل البشر ورسائلهم كلام الله تعالى؟
أنه يوجد في الإنجيل كلام الله، ولكن هذا لا يعني أنه كتاب الله..لأن البشر بكلماتهم ألفوا
صحيح
بعض الأمور التي لم يسمعوها من الله تعالى مباشرة وإنما سمعوها من نبيهم، أو لم يسمعوها حتى منه؛ بل
استنتجوها من سماع أمور من لسان النبي ثم ذكروها بكلماتهم.وهذه الأجزاء من كتابهم لا تشكل أكثر
من اثنين أو ثلاثة بالمائة، أما ما عدا ذلك فهو من بنات أفكارهم أو من روايات غير محققة.فاعتبار مثل
هذه الكتب أنها كتب الله ثم تأسيس دين عليها ثم وضعها بإزاء كتاب هو كلام الله تعالى لظلم كبير.كما يمكن أن يكون في هذه الآية إشارة إلى عشرات الكتب الأخرى الموجودة لدى اليهود والنصارى
التي يعتبرونها من وحي
الله تعالى، أو بمنزلة الكتب السماوية..ولكنهم بأنفسهم يشكون في صحتها.لقد
نشر النصارى مجموعة هذه الكتب باسم (أبو كريفا Apocrypha)، ويعتبرها مؤلفوها وبعض
المذاهب المسيحية كُتبًا إلهامية، ولكن النصارى في مجموعهم لا يعتبرونها كتب الله ولا يعترفون بصحتها.أفلا تستوجب اللوم أمة تعترف بنفسها أن عندها أناجيل تُعتبر أسفارا سماوية، وهي ليست كذلك، ثم
أليس من حق القرآن الكريم أن يزجر أفرادها ويكشف للعالم خطأهم ويحاول إصلاح هؤلاء المجرمين؟
وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّه مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (۸۱)
٣٥٢
Page 415
شرح الكلمات:
يخلف : أخلف وعده: لم يتمه (الأقرب).التفسير الآية تتحدث عن طائفة من اليهود كانوا يعتقدون أنهم مهما ارتكبوا من الذنوب فإن الله تعالى
لا يعذبهم إلا لأيام محدودة، لأنهم أولاد أحباء الله تعالى الحق أن اليهود قد حذفوا من التوراة عقيدة
الحياة بعد الموت، فلم يبق هناك ثواب وعقاب لو قرأ الإنسان كل العهد القديم لم يجد فيها مسألة الحياة
بعد الموت صراحة كما هو وارد في القرآن وإنما لا بد من إعمال الفكر والجهد الشديدين لاستنباط
هذه المسألة.كانت أغلبية اليهود ترجو كل الثواب في هذه الدنيا وترى أن كل العقاب أيضًا فيها،
وكان قليل منهم ما زالوا يؤمنون بالحشر والنشر.ولكنهم أيضًا كانوا يحسبون أنهم لن يعاقبوا لزمن
طويل لأنهم أحباء الله، وكانوا يرون أنهم بعد عقاب أيام معدودة سيتحولون إلى رماد، ويوضع هذا
الغبار على أقدام الصلحاء.وكان يرى البعض الآخر أنهم ينالون الغفران بعد عقاب محدود.يذكر سيل Seale، في ترجمته للقرآن أنه من المسلّمات عند اليهود أن أحدهم مهما كان شريرا، وأيا
كانت فرقته أو طائفته، لن يبقى في الجحيم أكثر من أحد عشر شهراً أو سنة على الأكثر..ما عدا (داتن
وأيبرام) والملحدين..لأن الأولين تمردا على موسى وجمعا شرذمة للقضاء عليه (سفر عدد ١٦).وأهلكهما الله بعذاب خاص.ويقول كتابهم التلمود (البابلي أن اليهود ما عدا الكفار و(جير وبوم) لن
يمكثوا في الجحيم إلا اثني عشر شهرًا ثم يصبحون رمادًا يُذرّ على أقدام الصلحاء.وجاء في تلمود بابا ميزيا Baba Miya ) ، أن كل اليهود سيدخلون جهنم، ولكنهم سيخرجون
منها إلا الزناة وهاتكي حرمة الجيران.وجاء في تلمود (أير وبين لن تمس نار جهنم اليهود الآثمين لأنهم سوف يعترفون بذنوبهم على أبواب
الله تعالى منها.جهنم، فيرجعهم
وجاء في تلمود (بركوت Barakot أن المرتد والرومي والإيراني سوف يدخلان جهنم، أما عصاة
اليهود فلن يدخلوها.وورد فيه أيضًا أن هناك خطورة ضئيلة على بني إسرائيل من دخول جهنم، ولكن
اليهودي المرتد عليه خطر كبير من دخولها، وكذلك غير اليهود) (الموسوعة اليهودية).تبين هذه المقتبسات أن معظم اليهود كانوا يعتقدون أنهم لن ينالوا إلا عقابًا محدودًا.وقد ذكر صاحب
(البحر المحيط أن اليهود كانوا يرون أنهم عبدوا العجل أربعين يومًا وسيعاقبون في النار أيضا أربعين
يوما.وقد استكثر بعض منهم الأربعين يوما وقالوا لن ندخل إلا سبعة أيام ويدل هذا على أن مثل هذه
الأفكار كانت موجودة عندهم في زمن النبي.٣٥٣
Page 416
يقوله الله تعالى لرسوله اسألهم هل أخذتم من الله عهدًا في هذا الشأن؟ إذا كنتم قد حصلتم على مثل
هذا العهد فلن يخلف الله عهده إن العقاب مسألة في يد الله تعالى وحده وليس في يد كهنتكم حتى
يحكموا بما يشاءون.إذا كان الله تعالى قد عقد معكم عهدًا فلا بد أن يكون عندكم في التوراة، ويعلنه
موسى أو غيره من الأنبياء، ولكن أنبياءكم ساكتون عن هذا، أما علماء التلمود فيقولون به بحسب
اجتهاداتهم أو أمانيهم.أليس هذا إهانة في حق الله تعالى ودينه؟
ثم يقول: إذا لم يكن هناك عهد إلهي لكم فهذا يعني أن علماءكم لفّقوا هذه الأفكار من عند أنفسهم.والبين أن الافتراء على الله معصية كبرى.الحق أن فساد الأديان يرجع إلى هذه المفتريات التي اختلقها الناس ونسبوها إلى الله تعالى كذبا وزورا.والمسلمون أيضًا كلما اختلفوا فيما بينهم في أمر من أمور دينهم لفقوا شيئًا ونسبوه إلى الإسلام..تدعيما
لرأيهم.القرآن ساكت والحديث صامت عما يقولون بل أنهم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بما
يقولون..ولكنهم لا ينفكون يرددون أن الإسلام يقول كذا وكذا.ندعو الله تعالى أن يوفق المسلمين
ليتنبهوا إلى هذا العيب فلا يتلاعبوا بالقرآن ولا يأخذوا في أيديهم ما هو حق
الله
وحده.بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) (۸۲)
شرح الكلمات :
6
بلى حرفُ تصديق مثل "نَعَمْ ، وأكثر ما تقع بعد الاستفهام، وتختص بالإيجاب سواء كان ما قبلها مثبتًا
أو منفيًا نحو : أقام زيد؟ الجواب بلى، أي قام.وأما قام زيد؟ والجواب بلى أي قام.(الأقرب)
کسب: کسب الشيء: جمعه.كسب الإثم: تحمله.(الأقرب)
التفسير: (بلي) حرف تصديق لما بعده سواء كان ما قبله صحيحا أو خطأ.فمعنى قوله تعالى (بلى من
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أن لا شك أن من ارتكب سيئة متعمدا ، ثم تغلبت عليه خطاياه بحيث
يضعف فيه تأثير الخير ويضيع منه، فإنه يدخل النار، ويبقى فيها مدةً طويلة.ويشير كسب السيئة وإحاطة الخطيئة بفاعلها إلى أن الخطيئة وحدها لا تُدخل مرتكبها في جهنم، بل لا
بد من توافر العلم والإرادة وغلبة الخطايا عليه وإحاطتها به.وهذا هو التعليم الحكيم الذي يرتاح إليه
قلب الإنسان، ولا يطمئن إلى عقيدة الكفارة التي يعتقد فيها النصارى بأن من آمن بالموت الصليبي
للمسيح غفرت له كل الذنوب؛ أو عقيدة الهندوس بالنجاة المحدودة التي تلقي بالإنسان في دورة التناسخ؛
أو عقيدة أتباع زرادشت عن التمايز النسلي القرآن يقول بأن الدين ذريعة للنجاة، ولا يعني مجرد اعتناق
٣٥٤
Page 417
ما أن الإنسان ينال به حقوقاً خاصة، وإنما يتأسس قانون النجاة على اعتقاد سليم ونية حسنة وسعي
صادق.إن العقيدة تساعد على النجاة، ولكنها ليست ضمانًا لها، بل إنها في بعض الأحيان تجعل المرء
عرضة للعقاب؛ لأن الذي يخطئ عن علم يستوجب عقوبة أشد، والذي يضل رغم توافر أسباب الهداية
يُعَدُّ أكبر جرما، فلا تظنوا أنكم باعتناق الدين نجوتم من العقاب، وإنما يوجهكم الدين إلى أعمال وأفكار
تساعدكم على النجاة.أما إذا لم يُصلح دينكُم أعمالكم وأفكاركم فليس في ذلك ما يدعو للاطمئنان،
بل هو مظنة للخطر.ما أقرب هذه النظرية إلى الفطرة وما أسماها عن أي اعتراض!
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (۸۳)
التفسير : ذكر الله تعالى من قبل أحوال أصحاب النار، وهنا ذكر أحوال أصحاب الجنة، وبين أنه
لاستحقاق عقاب النار شروط ثلاثة هي العلم والإرادة وغلبة الشر على الخير، ولاستحقاق نعيم الجنة
أيضًا شروط هي: الإيمان والعمل الصالح بحسب هذا الإيمان.يعني
فقط
لقد ذكرت من قبل أن اعتناق الدين ليس ضمانًا للنجاة وإنما يساعد على تحقيقها.وقد بين الله تعالى في
هذه الآية أن الذين يؤمنون ويعملون عملاً صالحًا يدخلون الجنة.ويمكن أن يتساءل أحد: ألا ينفع العمل
الصالح الإنسان بدون إيمان؟ فالجواب أنه لا يصح القول بأن العمل الصالح بدون الإيمان لا ينفع، وإنما
الصحيح أن العمل الصالح لا يتولد بدون الإيمان.فلو أننا فكرنا بعمق لوجدنا أن العمل لا
صنع شيء بالجوارح بل إن نشاط العقل أيضًا عمل.فلو أن الإنسان أراد بأحد سوءًا أو خيرا، فإن نيته
عمل في حد ذاتها وإن لم تخرج إلى حيز التنفيذ.إذا كان قلب الإنسان مليئا بأفكار أو نوايا سيئة ضد
الآخرين، فيحسد الناس ليل نهار ويريد بهم الشر..فلا يمكن أن نبرئه من سوء العمل، وإنما نقول بأنه
يتمكن من تنفيذ شره بيده أو جوارحه..ولكنه كان سيئ العمل
والحق أن القرآن الكريم يبين أن التعريف الصحيح للعمل الصالح لا يمكن إلا بمعونة الله ورسوله.وإذًا،
فبدون الإيمان لا يستطيع الإنسان معرفة العمل الصالح.ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يستطيع معرفة أي
قدر من العمل الصالح بدون الإيمان، بل هناك مئات الأجزاء منه يعرفها الإنسان بدون الإيمان؛ ولكننا
نقول بأن التعريف الصحيح الكامل للعمل الصالح لا يمكن بدون الإيمان.فعلاً
ثم إن القرآن يذكر نتيجتين للعمل الصالح إحداهما أن الإنسان ينال على الأعمال الصالحة ثمارها الصالحة
في هذه الدنيا، وكذلك الحال بالنسبة للأعمال السيئة.فالصادق يُذاع صيته، والكاذب تسوء سمعته.والصادق يثق به الناس، والكاذب لا اعتبار لقوله عندهم.والأمين يستودعه الناس أماناتهم فينتفع بها، بل
يُقبل الناس على توظيفه وينال مرتبًا ،أعلى وأما الخائن فلا يؤتمن ولا يقترب منه أحد.ولكن آيتنا هذه
لم
٣٥٥
Page 418
من
له".ومعنى
لا تتحدث عن الثواب الدنيوي أو النتيجة الدنيوية، وإنما تتحدث عن الجنة.وينشأ السؤال: ما دام
الإنسان قد نال الجزاء في الدنيا على عمله الذي قام به فلم ينال ثواب الجنة أيضا؟ إذًا، لا بد، لنيل الجنة،
أن يكون قد عمل عملاً آخر طاعة الله تعالى، وهذا هو الإيمان، ولأجل ذلك كان الرسول ﷺ
يؤكد ضرورة الإيمان كلما ذكر عملاً يُدخل الجنة، فقال مثلاً: من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر
ذلك أن الإنسان ينال الأجر الدنيوي على عمله، وينال الأجر الأخروي على عمل زائد..وهو الإيمان إن الذي يصدق في كلامه سيحصل على ثواب دنيوي صيتًا حسنا ونجاحا وازدهارا..ولكنه لو صدق في قوله إيمانا بالله وطاعة له يكون قد عمل عملين: قول الصدق، وإرضاء الله تعالى
بطاعته.وأجر الطاعة يناله الإنسان في الآخرة في صورة الجنة.فشرط الإيمان الذي قرره الله تعالى لا يقلل من قيمة العمل الصالح وإنما يبين أن العمل الصالح إذا صاحبه
الإيمان زادت قيمته ولا ينال عليه الإنسان الإنعام في هذه الدنيا فقط، بل ينال إنعامًا ثانيًا في الآخرة
أيضًا.فالذين يقولون بأن الإسلام يقلل من قيمة العمل الصالح مخطئون إن العمل الصالح الذي تعمله الله
ينتفع به الناس فيردون لك الصنيع بقدر استطاعتهم في الدنيا، ولكن هذه المكافأة من الناس لا يمكن أن
تكون ثوابا من الله على العمل الصالح الذي قمت به لمرضاته، وإنما هناك مكافأة عليه عند الله في الآخرة.وبما أن الوسائل عند الله غير محدودة فلذا ينال صاحب العمل الصالح جنة غير محدودة.فالقرآن الكريم لم
يقلل قيمة العمل الصالح بشرط الإيمان، وإنما بين أن العمل الصالح إذا كان مصحوبًا بالإيمان زاد قدره
وزادت مكافأته.إن الإنسان إذا نوى عند قيامه بعمل صالح أنه يفعله إرضاء الله تعالى، وفي ذهنه صورة
واضحة للعمل الصالح، بناء على إيمانه بالله ورسوله وبنور تعاليمه..فلا بد أن تكون مكافأته أعظم من
من يعمل الخير الناس وحدهم.ولا ينال هذا الجزاء في الدنيا بل في الآخرة أيضًا..لأنه بربط
العمل بالإيمان وبرضا الله تعالى يزداد قدر المكافأة ويمتد زمنها.مكافأة
العمل الصالح كلما ذكر القرآنُ العمل أشاد بالعمل الصالح، أي المناسب للظروف..فالصلاة في وقت
الصلاة، والجهاد في وقت الجهاد، وكل عبادة وفرض من فروض الدين في وقته هو العمل الصالح.كما
القرآن بذكر العمل الصالح نظرنا إلى أن العمل الحسن أحيانًا يكون سيئا..كالرحمة في موقف
وجه
يقتضي الانتقام واللين في ظرف يقتضي الشدة، وما إلى ذلك.وبذكر (أصحاب الجنة بعد ذكر أصحاب النار أشار القرآن الكريم إلى أن الناس على نوعين: نوع من
أهل النار، منهم من يعذَّب عذابًا مؤقتًا، ومنهم من يعذب عذابًا طويلاً؛ ونوع من أهل الجنة، منهم من
ينال نعيما عارضا، ومنهم من ينال نعيما أبديًا، لأن كلمة (أصحاب) تدل على معنى الدوام.ثم هناك
أناس تكون فترة مكثهم في الجحيم أقل من السابقين أو فترة مكثهم في الجنة أقل من السابقن.ويتبين من
٣٥٦
Page 419
من
العذاب
القرآن الكريم أن أهل هذا العذاب المؤقت أو أهل هذه الجنة المؤقتة سوف ينالون أولاً قسطًا
ثم بعد نيل الغفران يدخلون الجنة الأبدية (أصحاب الجنة هم الذين يدخلونها من أول يوم، وإلا فكل
إنسان سوف يدخل الجنة آخر الأمر.ولكن الآرية الهندوس على عكس ذلك؛ فيظنون أن الله تعالى سوف يعذب الناس أولاً، وقبل اكتمال
العذاب يبدأ في الإنعام عليهم، ويستمر في الإنعام، ثم يبدأ في العقاب لما تبقى من ذنوبهم، فيخلقهم
آخر.وهذا التعليم ينم عن بغض وحقد، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا.خلقا
****
***
المراجع والمصادر
القرآن الكريم
تفسير القرآن العظيم لابن كثير
تفسير ابن جرير
تفسير فتح البيان للنواب صدیق حسن خان
تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي
الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي
تفسير البحر المحيط لأبي حيان
تفسير الكاشف للزمخشري
تفسير معالم التتريل
الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي
مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد الطاهر
"
تفسير القرآن للمستشرق "ويري (Wherry)
تفسير القرآن للمستشرق "ردول"(Rod Well)
مقدمة ترجمة القرآن للمستشرق "سيل" (Sale)
الكتاب المقدس
القاموس العبري للعهد القديم
الصحاح الستة
٣٥٧
Page 420
الموطأ للإمام مالك
مسند أحمد بن حنبل
مشكوة المصابيح
سنن الدارمي
السيرة النبوية لابن هشام
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير
السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي.الفتوحات المكية للصوفي محيى الدين بن عربي
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني
الطبقات الكبرى لابن سعد
شرح المواهب اللدنية للزرقاني
المفردات للراغب
لسان العرب
تاج العروس
أقرب الموارد
الكليات لأبي البقاء
فقه اللغة للثعالبي
منن الرحمان للمرزا غلام أحمد القادياني
إزالة الأوهام للمرزا غلام أحمد القادياني
کتاب شریمد بوران
ستیارت بركاش لباندت دیانند جی
Encyclopedia of religions and Ethics edited by James
Hastings.Published by T and T Clark.Edinburgh 1908–1936.13 Vol.The New Encyclopedia Britannica 15th Edition 1991.Published by Encyclopedia Britannica Inc.٣٥٨
Page 421
Encyclopedia Judaica Published by Keter Publishing
House 1972 16Vols.(From Original Sources)
Life of Muhammad by Sir W.Muir New and Revised
Edition 1923 John Grant.Edinburgh.The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon by Benjamin
Davidson 1848.Samuel Bagster & Sons London.Hebrew-English Lexicon- All the Hebrew and Chadlee
words in th eold Testament Scriptures, with their meanings in
English 1882 by William Osburn Jnr(Herbern Student Manual)
1882.Moses and Monotheism by Sigmund Freud.Published
1932 Hogarth Press.Institute of Psychoanalysis.The Nile and the Egyptian Civilization by Alexandre
Moret.Published 1927.Kegan Paul.Trench.Trubner.A Comprehensive Commentary on the Quran by Elwood
Morris Wherry 1882.Israel.by Adolphe Lodz.Dawn of Conscience, by Prestood.The History of Egypt, by T.H.Breasted; 2nd edition.Tribes of Central Australia.by Spencer & Gellein.709